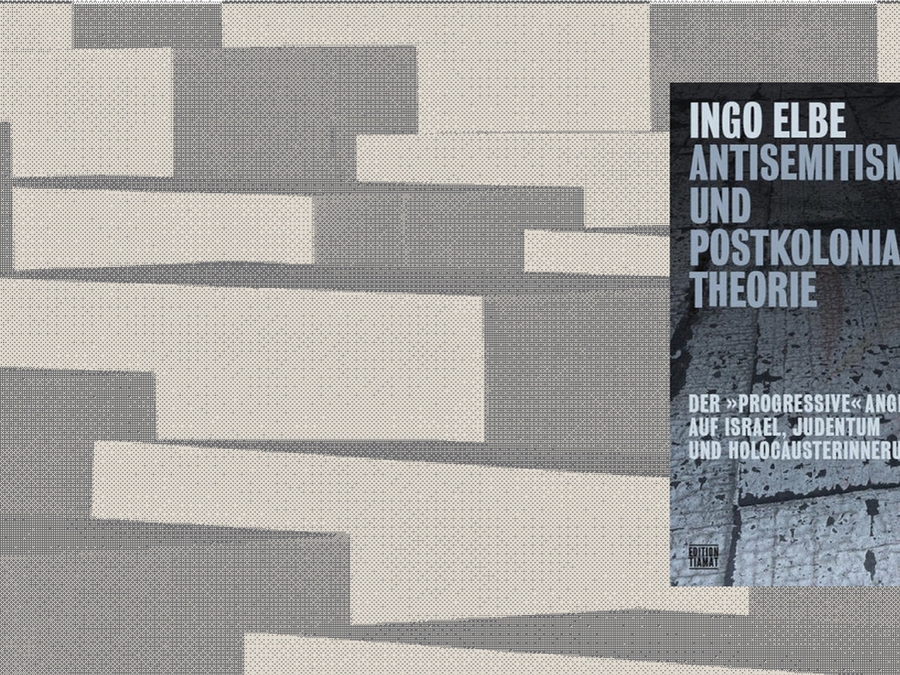الصهيونية: عنصرية بلا/مع حدود
في 9 مارس/آذار 2025، اختُطف محمود خليل على يد سلطات دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) ونُقل إلى مكانٍ مجهول، لينتهي به المطاف في مركز احتجاز في لويزيانا. كانت قضيته الأولى ضمن سلسلة محاولات متواصلة من الحكومة الأميركية والغستابو الخاص بها (جهاز هتلر السري الاستخباري) لتهديد وإسكات وإزالة أصوات التضامن مع فلسطين، فيما وصفه البعض بـ «الرعب الفلسطيني»، أي جعل المنتقدين عرضة للترحيل باسم أجندة أوسع نطاقاً من تفوق العرق الأبيض والصهيونية.1باختصار، يُمثل هذا استخداماً أدواتياً للمنطق العنصري في استخدام وتنفيذ قوانين الحدود لأغراض سياسية. هذه الحالات المتزايدة مروعة، وإن لم تكن استثنائية. إنها تتشابه مع قضية الثمانية من لوس أنجلوس، الذين ألقي القبض عليهم في العام 1987 وواجهوا الترحيل بسبب مشاركتهم في النشاط السلمي المؤيد للفلسطينيين.2 وكما تشير نورا عريقات، مستشهدة بفكر إيمي سيزير، يمكن فهم هذه الأحداث على أنها «تأثير ارتداد»: العنف والقمع المسموح بهما في المستعمرات يظهر لاحقاً داخل الوطن، أي الدولة المستعمِرة نفسها، ويُعيد إحياء الأنظمة الاستبدادية ويُعزز مؤسسات العقاب والاحتجاز، بدءاً من الشرطة والعسكرة وصولاً إلى تشديد أمن الحدود.3 وكما سنبيّن أدناه، فإن المرحلة الحالية تشهد دفعاً للإرتداد الاستعماري الأميركي والأوروبي في ظلّ الإبادة الجماعية في غزة - التي نفذت باسم «الأمن» الإسرائيلي - وآليات الترحيل العنصرية التي تعمل إلى حد كبير بالتصدير الأساسي لإسرائيل: تقنيات المراقبة والفصل العنصري.
إنّ مشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني رأسمالي في جوهره، متشابك بعمق مع نظام تراكم عالمي. إنها تُصدّر تكنولوجيات المراقبة والسجن والقمع إلى بلدان حول العالم بهدف الحد من حركة المهاجرين وأمننتها وتجريمها
في هذه المقالة، نحاجج بأنّ سياسات إسرائيل وتطبيقاتها للتطهير العرقي والإبادة الجماعية لها تداعيات عالمية. إنّ منطق وممارسات الحدود الصهيونية توسعية وتضييقية في آن واحد. في «الشرق الأوسط»، تتجاوز التطلعات التوسعية للمشروع الصهيوني حدود فلسطين التاريخية لتشمل مساحات وطنية ذات سيادة، من «وادي مصر إلى نهر الفرات»، عابرةً الحدود المؤقتة لإسرائيل الحالية.4 وفي الوقت نفسه، تُضيّق هذه الدولة العرقية التوسعية نطاق الأراضي المتاحة للسكان الأصليين في المنطقة، وتحصرهم في معسكرات جغرافية محاصرة، وتقيّد حركتهم، وتزيد من استبعادهم واحتمال إبادتهم. على المستوى العالمي، تتناغم وتعزّز الخطابات الصهيونية، وأنشطة «لوبياتها»، وعلاقاتها الدبلوماسية والتجارية، مع أنظمة الحدود العنصرية في أماكن أخرى. إنّ مشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني رأسمالي في جوهره، متشابك بعمق مع نظام تراكم عالمي. إنها تُصدّر تكنولوجيات المراقبة والسجن والقمع إلى بلدان حول العالم بهدف الحد من حركة المهاجرين وأمننتها وتجريمها.
الحدود الصهيونية في الشرق الأوسط
تماشياً مع أسس الصهيونية وممارسات الكيان الصهيوني، يهدف المشروع الصهيوني إلى إقامة «إسرائيل الكبرى» من خلال ضم جميع الأراضي الفلسطينية على الأقل، بالإضافة إلى لبنان والأردن وسوريا وأجزاء من العراق والسعودية ومصر. وهذا مُكرّس في «القوانين الأساسية» لإسرائيل (لا يوجد حدود في قوانينها)، التي تُشكّل الإطار شبه الدستوري للدولة، حيث لا تعترف إسرائيل بحدود محددة لا في خطاباتها السياسية ولا في خططها العسكرية. بمعنى آخر، تُعبّر هذه القوانين عن حدود قيد الإنشاء. وبينما نكتب هذه السطور، لا تزال القوات الإسرائيلية محتلّة أراضٍ لبنانية ذات سيادة، وتصادر أراضٍ في الضفة الغربية وتعتدي على السكان، ما أدّى إلى تشريد 40 ألف فلسطيني بشكل جماعي إلى الآن، وبدأت بالتوغل في عمق الأراضي السورية.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواصل السياسات العرقية الإسرائيلية تقييد حركة الفلسطينيين وحياتهم في الضفة الغربية. وأسْهَمَ بناء جدار الفصل العنصري («الجدار الأمني») في ضمّ المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يزيد من عزلة القرى الفلسطينية. وتتفاقم هذه القيود بفعل حملات هدم المنازل ومصادرة الممتلكات المكثفة التي ينفذها الكيان الإسرائيلي، حيث تقوم الشرطة والجيش بحماية المستوطنين، ما يحرم الفلسطينيين من أي سبيل قانوني أو حماية.5 ولتعزيز مشروعها التوسعي، تفرض إسرائيل عدداً من الشروط والقيود من خلال مجموعة واسعة من أدوات منع التنقل، بما في ذلك تصاريح المرور، ونقاط التفتيش المتنقلة والدائمة، والطرق الالتفافية، والأسوار، والبوابات المعدنية الإلكترونية، والمناطق الأمنية، كما ويُجبر الفلسطينيون على الحصول على تصاريح للتنقل في حياتهم اليومية (الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو المستشفى)، ويقضون معظم أوقاتهم بانتظار الحصول على تصاريح غير مضمونة للمرور عبر البوابات العسكرية. أمّا في قطاع غزّة، فقد خضعت غزة منذ العام 2007 لحصار بري وبحري وجوي كامل، قبل وقت طويل من بدء الإبادة الجماعية المستمرة منذ العام 2023.6 ولقد حّول الحصار غزّة إلى ما وصفته الكثير من منظمات حقوق الإنسان بأنه سجن في الهواء الطلق، يسيطر على الضروريات الأساسية ويمنع مرورها في كثير من الأحيان، ويفرض ظروف «الموت البطيء» ويضبط بدقة نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية.7 وكما كتب ربيع إغبارية، فإنّ ممارسات المستوطنين هذه - الاحتلال والتفتيت والفصل العنصري والإبادة الجماعية - تشكل معاً استمراراً للنكبة: النزوح الجماعي وطرد الفلسطينيين أثناء وبعد إنشاء إسرائيل في العام 1948.8
هذا التوسع الاستيطاني الاستعماري ليس عرضياً، بل يرتكز على منطق استيطاني يتبنى صراحةً الاستيلاء على الأراضي وهندسة الديموغرافيا. في تدوينة كاشفة، (تمّ حذفها لاحقاً) في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» التي توصف ب«المعتدلة»، بعنوان «المجال الحيوي (الليبنسروم) اللازم للانفجار السكاني في إسرائيل"، تُطرح حجة لضم الضفة الغربية واستيطانها باعتباره «ضرورياً» لإفساح المجال للمستوطنات (غير القانونية) سريعة النمو.9 الليبنسروم، أو «المجال الحيوي»، وهي كلمة ألمانية تعني «مساحة المعيشة»، كانت السياسة النازية الرسمية لتوسيع الاستحواذ على الأراضي بالتزامن مع الهيمنة العنصرية. هذه السياسات لا تعكس مجرد رأي صحيفة، بل هي أيديولوجية الصهيونية ذاتها كمشروع.
لا تعيد الصهيونية إنتاج العنف الاستعماري خارجياً على الفلسطينيين فحسب، بل توسمه أيضاً داخلياً من خلال التقسيم الطبقي الداخلي وتشكيل الطبقات العنصرية والاستغلال
منذ البداية، بدّدت إقامة إسرائيل إمكانية التعايش مع سكان فلسطين الأصليين، إذ سعت إلى إقامة «دولة يهودية». وكما جادل إيمي سيزير، فإنّ الفاشية كانت عنفاً إمبريالياً عائداً إلى الوطن؛ أي «ارتداد» الاستعمار الذي يضرب أوروبا نفسها. يكتب سيزير في كتابه «خطاب حول الاستعمار»: «ما لا يمكن لأوروبا أن تغفر لهتلر ليس الجريمة في حد ذاتها... بل الجريمة ضد الرجل الأبيض... حقيقة أنه طبق على أوروبا إجراءات استعمارية كانت حتى ذلك الحين مخصصة حصرياً لعرب الجزائر، و«عمال الهند» و«زنوج أفريقيا».10 في هذا الإطار، لا تُمثل المحرقة قطيعة مع الحداثة الاستعمارية، بل ذروتها كشكل من أشكال العنف الاستعماري المتجه نحو الداخل.
اكتسبت الصهيونية زخماً في هذا السياق، مستغلةً الاضطهاد الذي لحق باليهود الأوروبيين لترويج أخلاقي وسياسي بفلسطين.11 ولكن بدلاً من أن ترتد هذه الأعمال العنيفة إلى أوروبا ذاتها، انعكست إلى الخارج، متخذةً شكل مشروع صهيوني في فلسطين أعاد صياغة الغزو الاستعماري كشكل من أشكال التعويض التاريخي. تُعبّر نايومي كلاين عن هذه الدينامية بوضوح في كتابها «Doppelganger: A Trip into the Mirror World» (المُشابه: رحلة إلى العالم المرآة):
«في حين استعمرت القوى الأوروبية من موقع قوة وادعاء تفوق حضاري، استند ادعاء الصهيونية بفلسطين بعد المحرقة إلى صيغة معاكسة: إلى استغلال اليهود وضعفهم. كانت الحجة الضمنية التي سوقّها الكثير من الصهاينة آنذاك هي أن اليهود قد اكتسبوا الحق في استثناء من إجماع ما بعد الاستعمار - استثناء نشأ بسبب إبادتهم الحديثة. من خلال فهمهم للعدالة، إذ قال الصهاينة للقوى الغربية: إذا كان بإمكانكم إقامة إمبراطورياتكم ودولكم الاستعمارية الاستيطانية من خلال التطهير العرقي والمجازر وسرقة الأراضي، فإن القول بعجزنا عن ذلك يُعد تمييزاً ضدّنا. إذا طهرتم أرضكم من سكانها الأصليين، أو فعلتم ذلك في مستعمراتكم، فإن القول بعجزنا عن ذلك يُعد معاداة للسامية. كان الأمر كما لو أن السعي إلى المساواة يُعاد صياغته ليس كحق في التحرر من التمييز، بل كحق في التمييز. إنّ الاستعمار يُصاغ كتعويض عن الإبادة الجماعية.12
إن هذه الرواية عن الضحية الاستثنائية - المتجذرة في معايشة الأشكناز للإبادة الجماعية - قد تجاهلت منذ فترة طويلة تاريخ اليهود غير الأوروبيين، حتى مع اعتماد الصهيونية على وجودهم الديموغرافي لزيادة عدد الدولة الاستيطانية مع إخضاعهم لتسلسلات هرمية عنصرية منهجية.13 وبهذه الطريقة، لا تعيد الصهيونية إنتاج العنف الاستعماري خارجياً على الفلسطينيين فحسب، بل توسمه أيضاً داخلياً من خلال التقسيم الطبقي الداخلي وتشكيل الطبقات العنصرية والاستغلال.14 وحول هذه المفارقة التاريخية للضحية الدائمة، يلاحظ أسامة مقدسي أنه «بينما كان اليهود في أوروبا ضحايا لمعاداة السامية الغربية التي بلغت ذروتها في الهولوكوست، يظل الفلسطينيون ضحايا للصهاينة اليهود الإسرائيليين وأنصارهم وممكنيهم وحلفائهم في الغرب، بما في ذلك الصهاينة المسيحيون».15 وفي هذا السياق، يُعاد توظيف تكفير أوروبا المستمر عن جرائمها، والذي يتجلى في مواقف معاداة «معاداة السامية» — كسلاح لتبرير الممارسات العنصرية في إنفاذ الحدود. وفي هذه العملية، تعيد خطابات الحدود العنصرية إنتاج «صراع الحضارات» جديد، حيث يُسقط الشعور القومي بالذنب الأوروبي على شخصية المهاجر العربي/المسلم/ضحية العنصرية ويتم طرد هذا «التهديد الأجنبي» كنوع من طقوس التطهير.
«تصدير» الحدود الصهيونية
خارج «الشرق الأوسط»، يتقاطع اليوم منطق الحدود الصهيونية مع أنظمة الحدود العنصرية البيضاء التي تتضمّن مجموعة من الخطابات والممارسات العنصرية. لا شك أن مجموعة واسعة من الأبحاث المكثفة تُبرز بالفعل أوجه التشابه بين ممارسات الحدود العنيفة التي تنتهجها إسرائيل وديناميات العنصرية والمراقبة العنصرية المماثلة بالمقارنة مع الدول الأخرى. في الواقع، صُممت البنية التحتية للمراقبة والأمن في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، من نواحٍ كثيرة، على غرار نقاط التفتيش الإسرائيلية واستراتيجيات أمن الحدود الأوسع نطاقاً. وكما تُجادل أبو لبن وباكان بإثبات «أصبح النضال الفلسطيني اليوم رمزاً لكل من «صراع الحضارات» و«الحرب على الإرهاب» بطرق تتردد أصداؤها خارج إسرائيل/فلسطين».16 لقد أصبحت شخصية «الإرهابي الفلسطيني»، التي تُمثل محوراً أساسياً في سردية الأمن الإسرائيلية بعد العام 1948، نموذجاً عالمياً في خطاب مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر. بعد أحداث 11 أيلول/سبتمبر، اندمجت هذه الشخصية في عملية إعادة بناء أوسع نطاقاً للإرهابي المسلم/العربي كعدو مشترك لإسرائيل والديمقراطيات الليبرالية الغربية، ما شرعن توسيع أنظمة المراقبة، وضوابط الحدود، والتنميط العنصري، والتدابير الأمنية الاستثنائية. وقد أُسقطت صورة إسرائيل كضحية دائمة على الولايات المتحدة والغرب، ما عزّز الأيديولوجيات المعادية للإسلام، وتبرير إضعاف الإجراءات القانونية الواجبة، والحياد القانوني، وحماية حقوق الإنسان.
في هذا السياق، رسّخت إسرائيل مكانتها كسلطة عالمية في مكافحة الإرهاب، مُصدّرةً ممارساتها الأمنية إلى الخارج بنشاط - وهي عملية وُصفت بـ«أسرلة» المراقبة. وقد لجأت قوات الشرطة في جميع أنحاء أميركا الشمالية وأوروبا بشكل متزايد إلى برامج التدريب الإسرائيلية، ما أدى إلى عواقب وخيمة. وسُهّلت عسكرة الحدود من خلال الدعم المادي وغير المادي من إسرائيل، من خلال تدريب سلطات إنفاذ قوانين الهجرة (ICE) وحرس الجمارك والحدود (CBP)، بالإضافة إلى نشر أيديولوجيات مراقبة الحدود والتنميط العنصري نفسها، المُجرّبة والمُختَبَرة على الفلسطينيين لعقود.17 يعكس هذا الانتشار العالمي لعقيدة الأمن الإسرائيلية «فلسطنة» العقد العنصري، إذ يُعامل الأفراد ذوو الأصول العرقية - مواطنين وغير مواطنين على حد سواء - كتهديدات متأصلة تحت ستار مكافحة الإرهاب. وهكذا، وبعيداً من أوجه التشابه بين الدول، فإن استخدام تقنيات التحكم في السكان والمراقبة والإخلاء يُعزز بشكل متبادل القومية الإقصائية في جميع السياقات الوطنية. وبدلاً من مجرد التشابه بين هذه «الحالات» الوطنية، فإنها تشكل بعضها بعضاً من خلال شبكات معقدة من العلاقات الرأسمالية العنصرية الاستعمارية.
في أمستردام، أدت الاستفزازات العنصرية لمشجعي مكابي الإسرائيلي في خلال أحداث 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في الدوري الأوروبي لكرة القدم إلى إثارة أكاذيب عن «المذبحة التي لم تكن»، ولكنها مع ذلك أدت إلى تضخيم المشاعر المعادية للأجانب والمهاجرين الموجودة.18 في ألمانيا، فإن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لا يصور اليهود فقط على أنهم مجموعة متجانسة تمثّلها إسرائيل وتعمل على قمع النشاط المؤيد للفلسطينيين، ولكنه أيضاً بمثابة أداة لتعزيز الأجندات المعادية للمهاجرين والمعادية للمسلمين والقومية البيضاء.19 في كندا، وعلى الرغم من القيود والعنصرية المعادية للفلسطينيين المضمّنة في برنامج الإقامة المؤقتة للحكومة (TRV)، يضغط مركز إسرائيل والشؤون اليهودية (CIJA) على الحكومة الكندية للحد من الحصص القليلة لأقارب الغزيين الكنديين، ما يضمن عدم تمكن أي فلسطيني من الهروب من الإبادة الجماعية إلى كندا.20 وفي رسالتهم، عبّر المركز عن «مخاوفه» بشأن «أمن الحدود» مع عنوان رئيس عن اعتقال رجلين يُزعم أنهما ينتميان إلى داعش.21 وهذه ليست سوى أمثلة قليلة حيث يصاحب مكافحة ما يُسمى «معاداة السامية» (والتي يتم تحديدها على أنها انتقادات للفظائع التي ترتكبها إسرائيل أو استعمارها الاستيطاني) إثارة العنصرية المعادية للفلسطينيين وكراهية الإسلام.22
هذه الجهود ليست معزولة. ففي الكثير من الدول الاستيطانية والأنظمة القومية العرقية، استغلت المنظمات والمسؤولون الصهاينة هياكل محلية للعنف العنصري لتبرير قمع إسرائيل للفلسطينيين وبناء تحالفات عابرة للحدود الوطنية قائمة على منطق إقصاء مشترك. وقد كشف مسؤول كبير في إدارة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) مؤخراً عن اعتمادهم على موقع «كناري ميشن» (Canary Mission) المناهض للفلسطينيين (والممول جزئياً من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية) لاستهداف الطلاب وترحيلهم. أعلنت جماعة بيتار الأميركية اليمينية المتطرفة عن فخرها بإعداد «قائمة ترحيل» لحملة إدارة ترامب المناهضة للهجرة، والتي تضمنت أسماء مئات الطلاب الدوليين.23 ويتردد صدى منطق هذه الإجراءات في مبررات خطابية أخرى للعنف. ففي تعليقه على مسيرة العودة الكبرى في العام 2018، قال المدير الوطني الفخري لرابطة مكافحة التشهير Anti-Defamation League: «اسأل نفسك السؤال التالي: لو وقف المكسيكيون على الحدود وساروا، مليون مكسيكي أو 20 ألف مكسيكي، فماذا ستفعل أمريكا؟ كما تعلم، سيحاولون أولاً استخدام الغاز المسيل للدموع، [...] ثم سيضطرون في النهاية إلى إطلاق النار».24 في الواقع، هذه ترجمة ومناشدة لسيادة البيض في الولايات المتحدة لتبرير جرائم الحرب الإسرائيلية. في الهند، شهدت علاقة نتنياهو المتنامية مع حكومة مودي وأيديولوجيتها الهندوسية توقيع اتفاقية ثنائية للتنقل في العام 2023، حيث تُفضّل إسرائيل الهندوس صراحةً في توظيف العمالة في الهند، مُستثنيةً المسلمين خوفاً من التضامن مع فلسطين. يعكس هذا التفضيل التقارب المتزايد بين إسرائيل والهند كدولتين عرقيتين، على الرغم من النفي الرسمي لأي تحيز عرقي ديني.
تُوسّع الصهيونية وتُكثّف الأنظمة العنصرية في أماكن أخرى، مُساهمةً في تشديد المراقبة والرقابة وإقصاء السكان المُصنّفين عرقياً، وخصوصاً أولئك الذين يُشتبه بهم من خلال سيناريوهات التهديد العابرة للحدود
لقد حوّل احتلال إسرائيل المطول للأراضي الفلسطينية البلاد إلى دولة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العسكرية وتكنولوجيا المراقبة، مستخدمةً هذه الأراضي كحقل تجارب للأسلحة وأنظمة المراقبة، وكذلك كمنصة انطلاق لسوق عالمية للسيطرة العسكرية.25 يتتبع تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، تحولاً من اقتصاد الاحتلال الاستيطاني الاستعماري إلى اقتصاد الإبادة الجماعية، حيث طورت قاعدة بيانات تضم حوالي ألف كيان مؤسسي متواطئ في تهجير الفلسطينيين والقتل الجماعي والتشريد وتدمير البنية التحتية، وتستفيد من ذلك. إن اقتصاد الإبادة الجماعية، الذي كيّفت فيه الشركات عملياتها لتصبح مكونات لآلة قتل جماعي، ليس استثناءاً، بل سمة من سمات الرأسمالية العالمية التي تعمل من خلال العنف العنصري والحصار والتهجير، محولةً الإبادة إلى تراكم للثروة. وكما توضح ألبانيزي:
«بعد تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصبحت الأسلحة والتقنيات العسكرية المستخدمة في تهجير الفلسطينيين أدوات للقتل الجماعي والتدمير، ما جعل غزة وأجزاء من الضفة الغربية غير صالحة للسكن. تطورت تقنيات المراقبة والاحتجاز، التي تُستخدم عادةً لفرض الفصل العنصري، إلى أدوات للاستهداف العشوائي للسكان الفلسطينيين. أُعيد استخدام الآلات الثقيلة التي استُخدمت سابقاً في هدم المنازل وتدمير البنية التحتية والاستيلاء على الموارد في الضفة الغربية لطمس معالم غزة الحضرية، ومنع النازحين من العودة وإعادة بناء مجتمعاتهم».26
الكثير من الشركات المذكورة في تقرير ألبانيزي - أمازون، ومايكروسوفت، وبالانتير، وغوغل - هي أيضاً متعاقدة رئيسة في إنفاذ قوانين الهجرة الأميركية، ومراقبة السجون، والشرطة الاستباقية.27 لا تعمل هذه الشركات التقنية العملاقة بالتوازي فحسب: بل إنها تساعد في دمج البنى التحتية للقمع الممتدة من مراكز احتجاز دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) إلى غزة المحاصرة. من خلال توفير برامج الشرطة الاستباقية، والخدمات السحابية cloud services، وأدوات الذكاء الاصطناعي لكل من دائرة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) والجيش الإسرائيلي، فإنها تُمكّن دائرة عابرة للحدود الوطنية من العنف العنصري الذي يربط المنطق السجني للسيطرة الأميركية على الهجرة بآلية الإبادة في فلسطين. هذا ليس تصديراً أحادي الاتجاه؛ بل إنه يُشكل حلقة تغذية مرتدة حيث يتم تحسين أساليب القمع المُطوّرة في فلسطين، وإعادة نشرها، وإعادة استيرادها عبر الحدود العسكرية عالمياً.
مثلما تعتدي إسرائيل على أراضي الدول المجاورة عبر سعيها لإنشاء ما يُسمى «المناطق العازلة» (أي احتلال أراضيها)، أنشأت الولايات المتحدة نسختها الخاصة من المنطقة العازلة بين أراضي شعب توهونو أودهام الأميركي الأصلي في أريزونا وولاية سونورا المكسيكية لمراقبة المعابر الحدودية. وباعتبارها جداراً حدودياً عالي التقنية، ألحق إنشاء البنية التحتية الإسرائيلية لأنظمة «إلبيت» Elbit Systems ضرراً بالغاً بأراضي الأميركيين الأصليين هذه، منتهكاً بذلك مواقع دفن أجدادهم، حيث يُجبر أفراد مجتمعهم على العيش في منطقة شديدة الحراسة والعسكرة.28 أي أنه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الهند والسلفادور، وعبر «الكتلة الاستعمارية الاستيطانية»، يُمثل «المجمع الصناعي الحدودي» الإسرائيلي «التقاءً بين مراقبة الحدود والعسكرة والاستثمارات التجارية».29
تعمل الصهيونية كعنصرية بلا/مع حدود: فهي تفرض حدوداً عرقية صارمة من خلال بناء دولة إثنوقراطية، تُهجّر وتُقصي باسم التوسع الإقليمي. ومع ذلك، فإن منطق وتقنيات العنف العنصري الذي تولّده لا تقتصر على الحدود المؤقتة لدولة إسرائيل. فمن خلال الصادرات العسكرية والتحالفات الدبلوماسية والتقاربات الأيديولوجية، تنتقل الممارسات الصهيونية عبر البنى التحتية الأمنية العالمية، وتترسخ في ذخائر قائمة من التفوق الأبيض وكراهية الإسلام. وبذلك، تُوسّع الصهيونية وتُكثّف الأنظمة العنصرية في أماكن أخرى، مُساهمةً في تشديد المراقبة والرقابة وإقصاء السكان المُصنّفين عرقياً، وخصوصاً أولئك الذين يُشتبه بهم من خلال سيناريوهات التهديد العابرة للحدود. إن استعمار إسرائيل الاستيطاني لفلسطين، والاقتصاد السياسي للاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية الذي يرتكز عليه، لا يعملان بالتوازي مع الرأسمالية العنصرية العالمية فحسب: بل إنهما متأصلان فيها مادياً، مُحافظين على منطقها العنيف ومُعيدين إنتاجه عبر الحدود. وهكذا، فإن الصهيونية هي مشروع ترسيم الحدود bordering ووسيلة للسيطرة العنصرية بلا حدود.
نحو تضامن سياسي عابر للحدود الوطنية مناهض للصهيونية
كما ذكرنا، فإن طموحات الصهيونية في إقامة دولة عابرة للحدود الوطنية توسعية وتضييقية في آن واحد. مشروعها الاستيطاني الإثنوقراطي يوسع «الفضاء الوطني» للمستوطنين من خلال ممارسات حدودية إقصائية داخل الشرق الأوسط. إن تصدير منطق وتقنيات الحدود الصهيونية يعزز ويكثف أنظمة الجمود القائمة (أي قيود الحركة المتعلقة بالهجرة) في أماكن أخرى، والمتمثلة في كراهية الآخر والاستشراق وكراهية الإسلام. إن الأيديولوجية الصهيونية وممارساتها القائمة بالفعل تُعيد إنتاج التهجير والطرد العنصري، سواءً في القريب أو البعيد، في فلسطين التاريخية أو على الصعيد الدولي. إن رفضاً عالمياً للصهيونية ضروري لتعزيز تضامن سياسي عابر للحدود الوطنية، متجذر في سياسات مناهضة العنصرية والرأسمالية وعدالة المهاجرين.
ولبناء تقارب هادف بين الحركات المناهضة للحدود والمعادية للصهيونية، يجب أن ينتقل التضامن من الاصطفاف الرمزي إلى العمل الجماعي المستدام. وهذا يتطلب تفكيك الحدود التي تفرق نضالاتنا، وتشكيل جبهة موحدة ضد الأنظمة المترابطة للرأسمالية العنصرية، والاستعمار الاستيطاني، وإمبريالية الحدود.30 هذا ليس مجرد مبدأ نظري، بل ضرورة سياسية: حرية التنقل، وحرية الإقامة، وحرية العودة، كلٌّ لا يتجزأ، ولا يمكن استعادة هذه الحريات إلا من خلال تعميق التضامن العابر للحدود، إذ يجد منطق الصهيونية المتعلق بالحدود - المتجذر في نزع ملكية الأراضي على أساس عرقي، والهندسة الديموغرافية، وتجريم التنقل - صدىً في الهياكل السجنية للدول الاستيطانية مثل كندا والولايات المتحدة. كما تُصدّر تقنيات الحدود الإسرائيلية، وأسلحة السيطرة على الجموع، وبرامج المراقبة، وتكتيكات الشرطة، وتُختبر بنشاط على السكان الأصليين ذوي الأصول العرقية في جميع أنحاء العالم. وبدوره، فإنّ أنظمة الترحيل، ومنع اللاجئين، والسجن الجماعي تتشكل من خلال منطق أمني عالمي يربط العنف الذي تمارسه الدولة في فلسطين بنضالات المهاجرين والسكان الأصليين في أماكن أخرى.
إنّ أنظمة الترحيل، ومنع اللاجئين، والسجن الجماعي تتشكل من خلال منطق أمني عالمي يربط العنف الذي تمارسه الدولة في فلسطين بنضالات المهاجرين والسكان الأصليين في أماكن أخرى
على العمل السياسي الملموس أن يجعل هذه الروابط واضحة وقابلة للتنفيذ وذات مغزى تنظيمي. ويشمل ذلك حملات مشتركة تعرقل برامج إنفاذ القانون والتبادل العسكري بين إسرائيل والدول الغربية؛ واستجابات منسقة لعمليات الترحيل والاعتقال تُبرز دور الشركات العسكرية الصناعية الصهيونية في بناء البنية التحتية للمراقبة؛ وأنشطة مشتركة تُدمج تجريم المعارضة المؤيدة للفلسطينيين في سياق قمع نشطاء العدالة للمهاجرين والحدود.31
وكما تساءل محمود خليل عقب احتجازه من قِبل دائرة الهجرة والجمارك الأميركية: «ماذا يُظهر احتجازي عن أميركا؟»32 وعلى الرغم من إطلاق سراحه، لا تزال قضية ترحيله مستمرة كجزء من نمط أوسع من القمع الحكومي يستهدف من يجرؤون على معارضة الإمبراطورية. وتكشف قضيته - كقضايا رميسة أوزتورك، وبدر خان سوري، وآلاف المهاجرين المُجرَّمين في دول الاستيطان - كيف صُممت أنظمة السجون والحدود الحكومية لعزل وقمع الناس. هذه الأساليب ليست جديدة: إنها تُحاكي نمطاً راسخاً، حيث قوبل التضامن مع فلسطين بالمراقبة والقمع والتجريم، تحديداً بسبب القوة التي اكتسبتها هذه التضامنات عبر الزمان والمكان.
في الواقع، لحركات التضامن مع فلسطين تاريخٌ عريق. فهي ليست ظاهرةً حديثة، بل متجذرة في النضالات الأممية، لا سيما في خلال حقبة حركات التحرر في العالم الثالث، حين برزت فلسطين كركيزةٍ أساسية في المقاومة العالمية. منذ ستينيات القرن الماضي، لم يُنظر إلى التحرر الفلسطيني كقضيةٍ منفردة أو معزولة، بل كجزءٍ من أفقٍ أوسع مناهضٍ للاستعمار والإمبريالية، متشابكاً مع النضالات في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، وفي الدول الأصلية التي تقاوم الاحتلال الاستيطاني. ويواصل هذا الإرث اليوم حركاتٌ مثل «حياة السود مهمة» (Black Lives Matter) و(Idle No More) و«حماة المياه في ستاندينغ روك» (Standing Rock)، التي كشفت كيف أن العنصرية ضد السود، وتهجير السكان الأصليين، وتدمير البيئة، مرتبطةٌ بالأنظمة العالمية نفسها التي تُمكّن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني. تُذكرنا هذه الحركات بأن المقاومة المحلية متشابكةٌ دائماً في دوائر القوة والإمكانات العابرة للحدود الوطنية.
كما تُذكّرنا الحركة العمالية، فإنّ صاحب العمل غالباً ما يكون أفضل مُنظّم. وينطبق الأمر نفسه في هذه الحالة: إذ يُفضح عنف الدولة المنطقَ المشترك للجمود العنصري والهيمنة الاستعمارية، وبذلك يُحفّز، من دون قصد، أشكال تضامن جديدة. وقد تجلّى هذا بشكل خاص في الحركة العمالية، حيث رفض عمال الموانئ واللوجستيات تحميل أو تفريغ البضائع المرتبطة بالفصل العنصري الإسرائيلي والإبادة الجماعية.33 إن حالات الرفض هذه ليست مجرد أعمال احتجاج؛ بل هي رفضٌ مادي للتواطؤ وتعبيرٌ عن وعيٍ متنامٍ يُدرك الروابط بين العمل المُستغلّ والحدود المُسلّحة والاحتلال الاستعماري. في هذا التقارب تكمن إمكانية تضامنٍ عابرٍ للحدود الوطنية، مُلغي للعبودية، ومُناهضٍ للاستعمار، قوي بما يكفي لتحدي حدود الحاضر. وكما هتف المُنظّمون والمجتمعات في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، لا أحد منا حرّ حتى تتحرر فلسطين!
نشر المقال في الأصل في مجلة The Spectre.
- 1
- 2
David Cole, “Mahmoud Khalil and the Last Time Pro-Palestinian Activists Faced Deportation,” New Yorker, March 18, 2025, https://www.newyorker.com/news/the-lede/mahmoud-khalil-and-the-last-time-pro-palestinian-activists-faced-deportation
- 3
Noura Erakat, “The Boomerang Comes Back,” Boston Review, February 28, 2024. https://www.bostonreview.net/articles/the-boomerang-comes-back/.
- 4
Theodor Herzl, The Complete Diaries of Theodor Herzl, ed. Raphael Patai (New York: Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960), available at at https://ia903407.us.archive.org/2/items/the-complete-diaries-of-theodor-herzl/The%20Comple
- 5
Mohamed El-Kurd, “Tomorrow My Friends and Neighbors May Be Forced Form Our Homes By Israeli Settlers,” Nation, November 20, 2020, https://www.thenation.com/article/world/east-jerusalem-settlers/.
- 6
Francesca Albanese, “Anatomy of a Genocide,” Human Rights Council, A/HRC/55/73/, July 1, 2024, https://docs.un.org/en/A/HRC/55/73.
- 7
“Gaza: Israel’s ‘Open-Air Prison,’ at 15,” Human Rights Watch, June 14, 2022, https://www.hrw.org/news/2022/06/14/gaza-israels-open-air-prison-15; Amnesty International, Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity (London: Amnesty International, 2022), available at https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/; “The Gaza Strip,” B’Tselem, November 11, 2017, updated February 26, 2023, https://www.btselem.org/gaza_strip.
- 8
Rabea Eghbariah, “Toward Nakba as a Legal Concept,” Columbia Law Review 124, no. 4 (May 2024): 887–992 https://www.columbialawreview.org/content/toward-nakba-as-a-legal-concept/, available at https://www.columbialawreview.org/wp-content/uploads/2024/06/May-2024-1-Eghbariah.pdf.
- 9
Dan Ehrlich, “Lebensraum Needed for Israel’s Exploding Population,” Times of Israel (blog), December 4, 2024, post archived via Archive.ph, https://archive.ph/NGnNv; Maya Mehrara, “Israel needs ‘Lebensraum’ Says Blog by Major National Newspaper,” Newsweek, December 6, 2024, https://www.newsweek.com/israel-needs-lebensraum-says-blog-major-national-newspaper-1996635
- 10
Aimé Césaire, Discourse on Colonialism, trans. Joan Pinkham (New York: Monthly Review Press, 2000), 36.
- 11
Zachary Foster, “The Forgotten History of Jewish Anti-Zionism,” Palestine Nexus, May 13, 2024, https://palestinenexus.com/articles/jewish-antizionism.
- 12
Naomi Klein, Doppelganger: A Trip into the Mirror World (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2023), 270.
- 13
Mari Cohen, “Can Genocide Studies Survive a Genocide in Gaza?” Jewish Currents, December 19, 2024, https://jewishcurrents.org/can-genocide-studies-survive-a-genocide-in-gaza; Ella Shohat, “ Sephardim in Israel, Zionism from the standpoint of its Jewish victims,” Social Text, no. 19–20(1988): https://www.jstor.org/stable/i220055; Avi Shlaim, Three Worlds: Memoirs of an Arab-Jew (London: Oneworld Publications, 2024); Massoud Hayoun, When We Were Arabs: A Jewish Family’s Forgotten History (New York: The New Press, 2019).
- 14
Jake Romm, “Idée Fixe: Holocaust Trauma and Zionist exterminationism,” Parapraxis, July 2025, https://www.parapraxismagazine.com/articles/ide-fixe; Tom Mehager, “Yes Mizrahim support the right. But not for the reasons you think,” +972 Magazine, February 27, 2020, https://www.972mag.com/mizrahim-right-wing-ashkenazi-supremacy/.
- 15
Ussama Makdisi, “On the Victims of the Victims,” Jewish Currents, January 17, 2025. https://jewishcurrents.org/on-the-victims-of-the-victims.
- 16
Yasmeen Abu-Laban and Abigail B. Bakan, “The ‘Israelization’ of Social Sorting and the ‘Palestinianization’ of the Racial Contract: Reframing Israel/Palestine and the War on Terror,” in Surveillance and Control in Israel/Palestine: Population, Territory, and Power, ed. Elia Zureik, David Lyon, and Yasmeen Abu-Laban (New York: Routledge, 2011), 280.
- 17
Jewish Voice for Peace, “Immigration and Customs Enforcement (ICE) and Deadly Exchange,” Deadly Exchange, accessed May 10, 2025, https://deadlyexchange.org/immigration-and-customs-enforcement-ice-and-deadly-exchange/.
- 18
Sana Saeed, “No, There Were No Antisemitic Pogroms in Amsterdam. Here’s What Really Happened,” Mondoweiss, November 9, 2024, https://mondoweiss.net/2024/11/no-there-were-no-antisemitic-pogroms-in-amsterdam-heres-what-really-happened/
- 19
Josephine Becker, “Germany then and now: Guilt, white supremacy and sustaining genocide, from the far-right to the radical left,” Human Geography 18, no. 1 (2025): 70-77, https://doi.org/10.1177/19427786241299043; “Bad Memory,” Jewish Currents, July 5, 2023, https://jewishcurrents.org/bad-memory-2.
- 20
Canadians for Justice and Peace in the Middle East (CJPME), Intended to Fail: Systemic Anti-Palestinian Racism and Canada’s Gaza Temporary Resident Visa Program (Montreal: CJPME, 2024), https://assets.nationbuilder.com/cjpme/pages/9076/attachments/original/1726604311/Intended
- 21
Tweet by Centre for Israel and Jewish Affairs (@CIJA), X, August 28, 2024, 4:31 p.m., https://x.com/CIJAinfo/status/1828893110304399472.
- 22
Faisal Bhabha, “Fighting Anti-Semitism by Fomenting Islamophobia: The Palestine Trope, A Case Study,” in Systemic Islamophobia in Canada: A Research Agenda, ed. Anver M. Emon (Toronto: University of Toronto Press, 2023).
- 23
Anna Betts, “Pro-Israel group says it ‘has deportation list’ and has sent ‘thousands’ of names to Trump officials,” Guardian, March 14, 2025, https://www.theguardian.com/us-news/2025/mar/14/israel-betar-deportation-list-trump.
- 24
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), gaza’s “great march of return—one year on—impact on palestine refugees and unrwa services (Amman: UNRWA, 2019), https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/gaza_gmr_one_year_on_report_eng_final.pdf; Erin Axelman and Sam Eilertstein, Israelism, directed by Erin Axelman and Sam Eilertsen (Tikkun Olam Productions, 2023), https://www.israelismfilm.com/.
- 25
Michelle Buckley and Paula Chakravartty, “Labor and the Bibi-Modi ‘Bromance,’” Boston Review, April 11, 2024, https://www.bostonreview.net/articles/labor-and-the-bibi-modi-bromance/.
- 26
Francesca Albanese, “Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967 (Advance unedited version),” Human Rights Council, A/HRC/59/23, June 16, 2025, available at https://www.un.org/unispal/document/a-hrc-59-23-from-economy-of-occupation-to-economy-of-genocide-report-special-rapporteur-francesca-albanese-palestine-2025/
- 27
Surveillance Resistance Lab, “Who’s Behind ICE?: The Tech and Data Companies Fueling Deportations” (Surveillance Resistance Lab), https://mijente.net/wp-content/uploads/2023/02/Who-is-Behind-ICE-The-Tech-and-Data-Co
- 28
Loewenstein, The Palestine Laboratory.
- 29
Rashid I. Khalidi and Sherene Seikaly, “From the Editors,” Journal of Palestine Studies 51 no. 1 (2022): 1–3, https://doi.org/10.1080/0377919X.2021.2016320; Rhys Machold, Fabricating Homeland Security: Police Entanglements across India and Palestine/Israel (Stanford: Stanford University Press, 2024); Itxaso Domínguez de Olazábal, “Interwoven Dynamics of Israel and El Salvador as Nodes in a Global Carceral Archipelago Dominated by US Imperialism,” Middle East Critique (2025): 1–23, https://doi.org/10.1080/19436149.2025.2485692; Craig Mokhiber, “WEOG: The UN’s Settler-Colonial Bloc,” Foreign Policy in Focus, September 4, 2024, https://fpif.org/weog-the-uns-settler-colonial-bloc/; Petra Molnar, “All Roads Lead to Jerusalem: A Lucrative Border Industrial Complex,” Transnational Institute, December 19, 2023, https://www.tni.org/en/article/all-roads-lead-to-jerusalem.
- 30
“L.A. Under Siege: Trump Sends in National Guard as Protests Continue over Militarized ICE Raids,” Democracy Now!, June 9, 2025. https://www.democracynow.org/2025/6/9/los_angeles_protests_immigration_ice_raids.
- 31
“‘This Is All Retaliatory’ : Judge Blocks Mahmoud Khalil’s Deportation as Trump Vows More Arrests,” Democracy Now!, March 11, 2025. https://www.democracynow.org/2025/3/11/mahmoud_khalil_ice_columbia_university_palestine
- 32
Mahmoud Khalil, “What Does My Detention by ICE Say About America?” Washington Post, April 17, 2025, https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/04/17/mahmoud-khalil-columbia-student-ice-detention/
- 33
Rafeef Ziadah and Katy Fox-Hodess. “European Dockworkers Refuse to Load Weapons Aimed at Palestine,” Labor Notes, June 12, 2025, https://www.labornotes.org/2025/06/european-dockworkers-refuse-load-weapons-aimed-palestine; Ashok Kumar, “Morocco’s powerful port workers union seeks to block Maersk’s ‘military shipment’ to Israel,” New Arab, April 15, 2025, https://www.newarab.com/news/morocco-port-workers-block-maersks-arms-shipment-israel; Basma El Atti, “Indian Port Workers Refuse to Load Weapon’s for Israel’s War, ” Jacobin, February 21, 2024, https://jacobin.com/2024/02/india-transport-worker-union-palestine-israel-weapons.