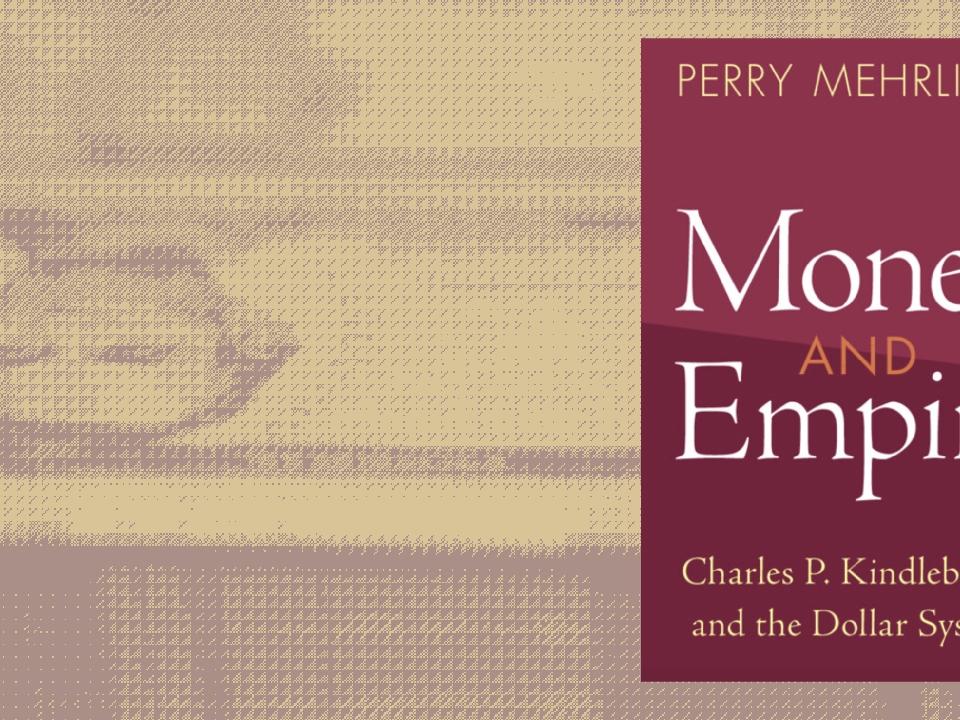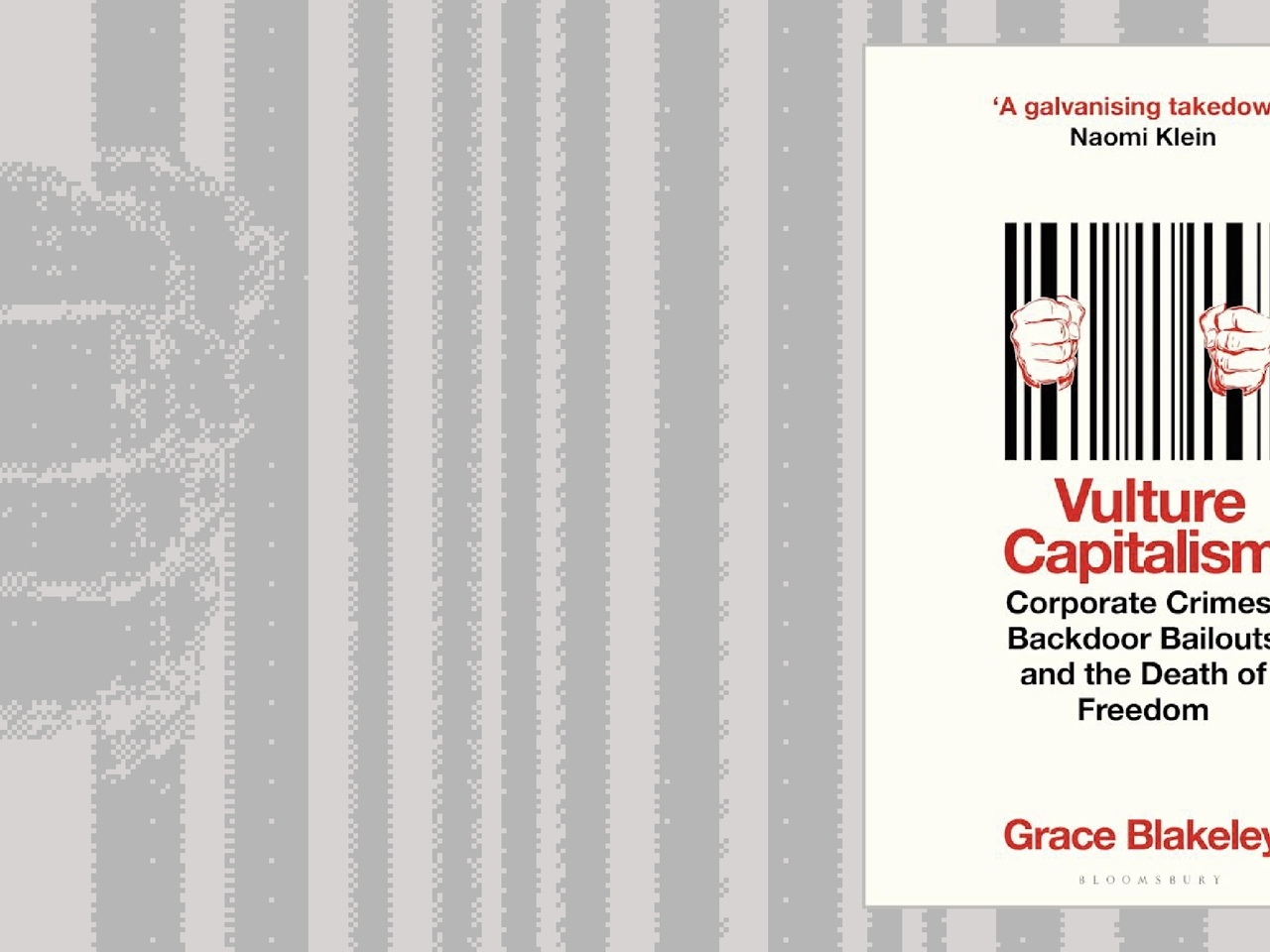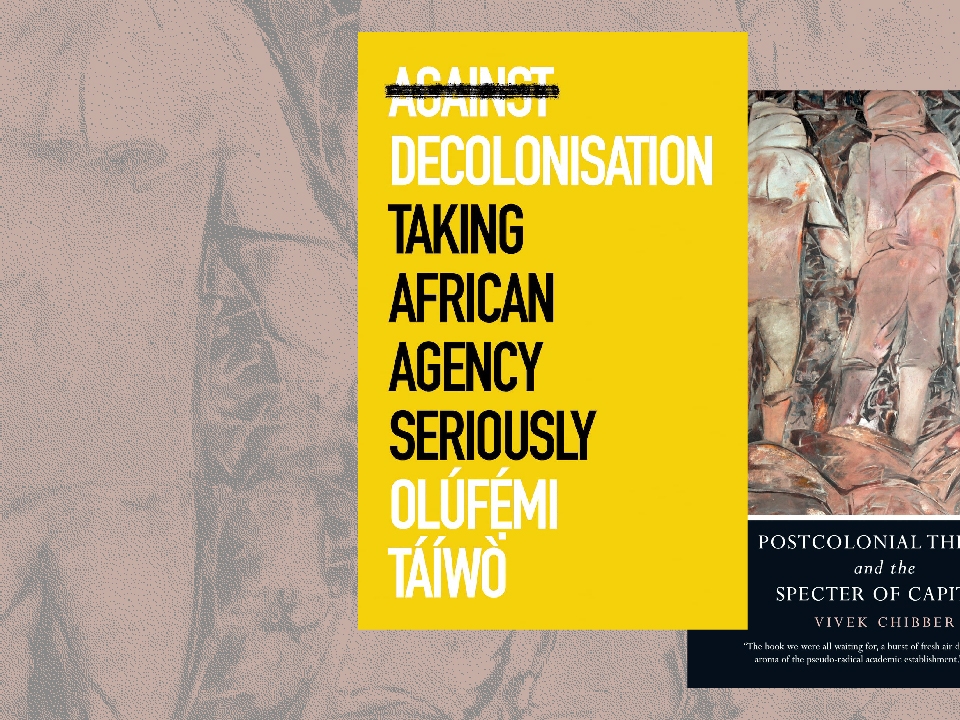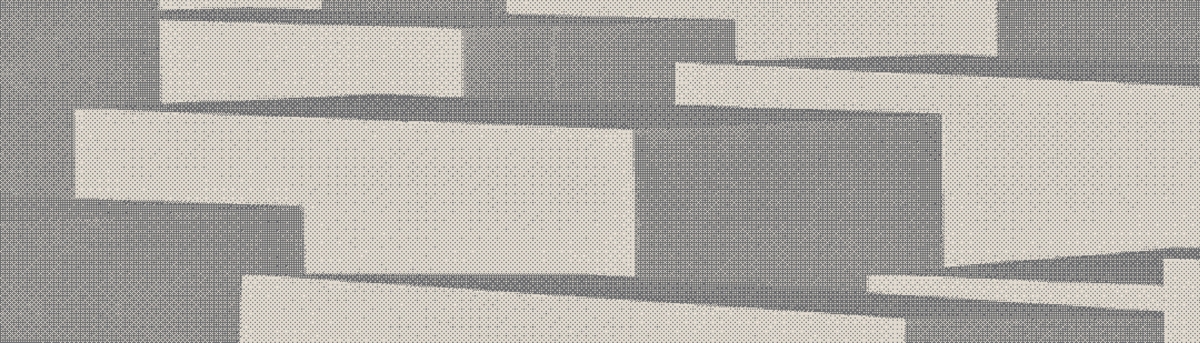
الصهيونية المُفرطة في الأكاديميا
مراجعة لكتاب إنغو إلبي «معاداة السامية والنظرية ما بعد الاستعمارية»، الذي يسعى إلى تفنيد بعض أطروحات الفكر ما بعد الاستعماري عبر اتهامه بإعادة إنتاج أنماط من العداء للسامية تحت ستار نقد إسرائيل. ومن خلال قراءة نقدية متأنية، تحاول هذه المراجعة تفكيك منطق الكتاب، مساءلة أدواته النظرية، والكشف عن التوتر القائم بين ادّعاءاته حول معاداة السامية وبين إسقاطه السياسي الذي يتماهى مع السردية الصهيونية الرسمية.
ينطلق هذا النقد من مقاربة راديكالية ما بعد استعمارية تناهض بشكلٍ مباشر مضمون كتاب المؤلّف. بدلاً من تقديم تحليل مفصّل لمحتوى الكتاب، يسعى هذا التعليق إلى كشف الافتراضات الضمنية والتشويهات والتغافلات التي تشكّل ركائز أساسية في البنية السردية. ننوّه إلى أن القرّاء الباحثين عن قراءة معمّقة للكتاب قد لا يجدون في هذا النص فائدةً تُذكر؛ فهو يتعامل مع الكتاب بوصفه جزءاً من هجومٍ أوسع على الكتّاب المناهضين للاستعمار، مبيّناً أن ما يُقال في تلك الصفحات يقدّم معلومات عن المؤلّف والمناخ الفكري في ألمانيا أكثر ممّا يقدّمه عن «الآخرين».
صدر كتاب إنغو إلبي «معاداة السامية والنظرية ما بعد الإستعمارية» في العام 2024، في سياق تصاعد الانتقادات العالمية لسياسات إسرائيل والإبادة الجارية في غزّة. يعمد إلبي في هذا الكتاب، الواقع في 400 صفحة، إلى تحريف الوقائع وإغفال جوانب حاسمة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بما يخدم تأطيراً أيديولوجياً يرمي إلى تقديم دراسات ما بعد الاستعمار على أنها معادية لليهود في جوهرها، متجاهلاً عن عمد الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين.
يعتمد هذا السرد على تحريفٍ متعمَّد قائم على إغفالٍ انتقائي يُصوَّر فيه الصراع في الشرق الأوسط بوصفه صراعاً عِرقياً ودينياً بالأساس. غير أنّ هذا التغاضي المقصود يبدو أقرب إلى تكتيك محوري، وإلى تأطير يُخفي السبب الفعلي للنزاع، أي الطابع الاستيطاني-الاستعماري للصراع، بوصفه صراعاً على الأرض. وضمن هذا الإطار، يتجاهل المؤلّف أنّ للفلسطينيين، بصفتهم شعباً واقعاً تحت الاحتلال، الحقّ في مقاومة استعمارهم، وهو حقّ أقرّته أيضاً إحدى قرارات الأمم المتحدة الصادرة في العام 1973. في ظل هذا المنطق المختلّ الذي يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، تصبح حملات التشكيك في المفكّرين ما بعد الاستعماريين أمراً مشروعاً، ويُسهِم طمس واقع الاحتلال الاستعماري في فتح المجال أمام حججٍ زائفة يروّج لها الكتاب. لننتقل الآن إلى مناقشة بعض النقاط الأساسية فيه.
أوّلاً: لا وجود للاستعمار
يعمد المؤلّف إلى اختيار وقائع وصور واستدلالات مجتزأة من نقاشات دارت بين مفكّري ما بعد الاستعمار في مناطق مختلفة، من أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا، سعياً منه لإضفاء طابع من الشرعية على اتّهامه الأساس. المقلق في الأمر هو تكرار نمطٍ بلاغيٍّ مألوف: كلّ نقد يُوجَّه إلى إسرائيل يُرفَض على الفور باعتباره معاداة للسامية. وغالباً ما يُستخدم هذا التكتيك من قبل المدافعين عن إسرائيل بلا شروط، إذ يُستخدم لتحييد النقد المشروع، إمّا عبر تجاهله، أو عبر تشويهه وتصويره كأنه هجومٌ تحرّكه كراهية «عميقة لليهود».
يدّعي إلبي أنّ كتابه إسهام نظريّ، لكن ميله إلى وسم مفكّري ما بعد الاستعمار والنشطاء المنتقدين للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية بمعاداة السامية يُقارب منطق حملات التشهير
يدّعي إلبي أنّ كتابه إسهام نظريّ، لكن ميله إلى وسم مفكّري ما بعد الاستعمار والنشطاء المنتقدين للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية بمعاداة السامية يُقارب منطق حملات التشهير. على الرغم من استناد إلبي إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية لتبرير نقده، فإنه يكتفي بالإشارة إلى تعريف إعلان القدس الأكثر دقّة وتفصيلاً من دون أن يعتمده كأساسٍ لتعريف معاداة السامية. وبهذا الخلط بين النقد المشروع والكراهية ضد اليهود، يمهّد إلبي الأرضية لحججه الزائفة.
كما يجادل موشيه تسوكرمان في كتابه «معادٍ للسامية!: اتّهام بوصفه أداة هيمنة»، فإن الخلط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لا ينطوي فقط على خداعٍ فكريّ، بل يحرّف أيضاً مواقف الأصوات اليهودية الناقدة لإسرائيل. طالما أكّدت شخصيات من قبيل تسوكرمان وجوديث بتلر ونعومي كلاين ونعوم تشومسكي على التمييز بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، إلا أنّ هذا لم يمنع جهات عدّة من وصمهم بـ«معاداة السامية» أو اعتبارهم «يهوداً يكرهون أنفسهم».
يقوم البناء الحجاجي في كتاب إلبي على تبنّي السردية السائدة في أوروبا وألمانيا، التي تُستخدَم لتبرير أفعال إسرائيل والدفاع عنها. يمكن اختزال هذا المنطق في سلسلةٍ استدلالية تقوم على إنكار الطبيعة الاستعمارية لإسرائيل:
• إذا لم تكن إسرائيل دولةً استعمارية، فهي لم ترتكب جرائم فصل عنصري أو تطهير عرقي.
• بالتالي، فإنّ أي اتّهام بارتكاب إبادة جماعية يُعَدّ معاداة للسامية يمكن استبعاده.
غير أنّ هذا المنطق ينهار حين يُواجَه بالكمّ الهائل من الأدلّة على الطابع الاستيطاني-الاستعماري لتاريخ إسرائيل، كما وثّقه مؤرّخون مثل إيلان بابيه ورشيد الخالدي وغيرهما كثيرون. كشف بابيه في أعماله عن سياسات التهجير المنهجي ومحو الوجود الفلسطيني، ما يناقض تماماً مزاعم إلبي القائلة إنّ هذه الاتهامات ليست سوى استمرار «للتقاليد المعادية لليهود». ويبدو أن الألمان، الذين أُتيحت لهم فرصة إعادة كتابة التاريخ، يفضّلون النأي بأنفسهم عن معاداة السامية التاريخية التي اقترفوها وإسقاطها على منتقدي إسرائيل وعلى اليسار وعلى المجتمعات العربية، وكأنّ معاداة السامية لم توجد يوماً في ألمانيا. كما قالت الكاتبة أسرا أوزيوريك مؤخراً في مقابلة:
«ترجع هذه التهمة إلى فكرة مفادها أنك تُقبَل في العقد الاجتماعي فقط إذا أثبتّ أنك قد تعلّمت الدروس من عهد النظام النازي. وكيف تُثبت ذلك؟ بأن تُظهر أنك «محبّ لليهود»، ما يعني، في السياق الألماني، إعلان الولاء لإسرائيل. وبحكم التعريف، فإنّ مَن لا يفعل ذلك لا يستحقّ أن يكون جزءاً من ألمانيا. أمّا فكرة أن المسلمين يحملون تصوّرات ثقافية مختلفة تجعلهم غير منسجمين مع الثقافة الألمانية، فقد كانت رائجة منذ زمن طويل. الجديد الآن هو التركيز على معاداة السامية. فثمّة شعور منتشر، لدى اليمين كما لدى اليسار، يقوم على أنّ المسلمين لا يستحقّون البقاء هنا لأنهم معادون للسامية».
في منطق «المعادين لمعاداة السامية»، يصبح الاعتراض على الإبادة الجماعية فعلاً معادياً لليهود. مجرّد التجرّؤ على قول «ثمة إبادة تجري» يُقابَل بتهمة التحريض المعادي للسامية. يصل إلبي بهذا المنطق إلى أقصاه، إذ يتّهم جنوب أفريقيا بمعاداة السامية لمجرّد لجوئها إلى محكمة العدل الدولية لاتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. يكتب قائلاً: «يُطرَح السؤال عمّا إذا لم يكن اتّهام الإبادة الجماعية امتداداً لأسطورة القتل الطقسي والكذبة الدموية المستمدّة من التقليد المعادي لليهود» (ص. 25–26). وعلى الرغم من تعمّده استخدام صيغة تساؤلية، إلا أنّ المعنى واضح: اتهام إسرائيل بالإبادة هو تكرار لمزاعم تاريخية عن معاداة السامية. بهذه الصيغة، يدمج إلبي بين الإنكار والاتهام لإسكات أي نقد موجَّه ضد إسرائيل.
ثانياً: ضد «التيار الأكاديمي السائد»
يقدّم إلبي نفسه بوصفه مدافعاً عن الأكاديمية، زاعماً أنّه يتحدّى «التيار السائد» الذي يُفترض أنّ دراسات ما بعد الاستعمار تهيمن عليه. غير أنّ تصوّر المعركة ضد «هيمنة أكاديمية» هو أبعد ما يكون عن الواقع، سواء في ألمانيا أو في غيرها، حيث تتعرّض دراسات ما بعد الاستعمار لهجمات مستمرّة. تشير ألانا لينتن في كتابها «لماذا لا تزال مسألة العرق مهمّة»، أنّ السردية التي تزعم أنّ هذه الدراسات استولت على الأكاديميا تُستخدم غالباً من قبل مثقّفين يمينيين لتقويض النقد الموجّه للإمبريالية الغربية. وتندرج عناوين أخرى ضمن هذا السياق، حيث تُصوَّر الريبة تجاه الغرب على أنّها «حرب ضد الغرب» أو حتى كراهية له، كما في أدبيات «صدام الحضارات». ويمكن أيضاً قراءة تموضع إلبي بوصفه ضحية كجزء من استراتيجية أيديولوجية أوسع، تُقحِم عمله في سياق الدفاع عن الإرث التاريخي الغربي.
لا تتعارض أفكاره مع السلطة، بل تتناغم مع خطابٍ سياسي مهيمن يُخوِّن كلّ نقد لإسرائيل، في حين أنّ التظلّم الذي يدّعيه لا يحمي حرّية الفكر بل يكرّس أنظمة السيطرة
في ألمانيا، يصعب أخذ ادّعاء إلبي بمواجهة هيمنة فكرية مأخذ الجدّ، في ظلّ واقعٍ تُقصى فيه الأصوات المناصرة لفلسطين بطرقٍ ممنهجة من الحقل الأكاديمي، كما تبرهن تجربتا غسّان الحاج ونانسي فريزر. لا تتعارض أفكاره مع السلطة، بل تتناغم مع خطابٍ سياسي مهيمن يُخوِّن كلّ نقد لإسرائيل، في حين أنّ التظلّم الذي يدّعيه لا يحمي حرّية الفكر بل يكرّس أنظمة السيطرة التي يسعى مفكّرو ما بعد الاستعمار إلى نقدها. الدلالة الأوضح على موقعه هذا تكمن في استناد سياسيّي حزب «البديل» اليميني المتطرّف إلى أطروحاته لمهاجمة الفكر ما بعد الاستعماري والتشكيك في برامج التنمية الألمانية وإنكار الاستعمارية الإسرائيلية. وكأنّ ألمانيا تشهد بدايات مراجعة تاريخية قد تتبلور في السنوات المقبلة.
ثالثاً: ضد رؤية «مانوية» للعالم
يتّهم إلبي باحثي ما بعد الاستعمار بتبنّي رؤية مانوية للعالم، تقوم على تقسيم حادّ بين الخير والشر. ورغم أنّ بعض الباحثين قد يبالغون في التركيز على جرائم الاستعمار الأوروبي، فإنّ نقده يتجاهل الغاية الأساسية من دراسات ما بعد الإستعمار: معالجة المظالم التاريخية والمستمرّة في آن. وكما يشير بانكاج ميشرا، فإنّ إرث الاستعمار لا يزال يؤثّر في توازنات القوّة العالمية ويتجلّى اليوم في الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل، ما يجعل المساهمة الفكرية والسياسية لهذه الدراسات ضرورية في فضح هذه التركات وكشف آليات استمرارها.
من المفارقة أنّ إلبي يمارس شكلاً من «المانوية المعكوسة»، إذ يهاجم بشكلٍ انتقائي باحثي ما بعد الاستعمار، متجاهلاً تماماً النقد الصادر عن مفكّرين يهود. فقد دأبت شخصيات مثل جوديث بتلر ونعومي كلاين ونورمان فينكلشتاين على انتقاد سياسات إسرائيل من موقعٍ يساريٍّ مناهض للصهيونية. غير أنّ تبسيط إلبي لمفهوم «الهويّة اليهودية» وما ينبغي أن يكون عليه سلوك اليهود تجاه إسرائيل، يكشف رفضه الاعتراف بتعدّد الرؤى داخل التقاليد اليسارية عموماً، وداخل دراسات ما بعد الاستعمار خصوصاً. ويُظهر ذلك انحيازه الأيديولوجي إلى أولئك الساعين إلى حماية موقع إسرائيل بوصفها حليفاً للغرب ووكيلاً للإمبراطورية.
رابعاً: الصهيونية الفائقة
يكشف كتاب إلبي عن قلق متجذّر لدى بعض المثقّفين الألمان إزاء ضرورة مواجهة ماضيهم القائم على العنف والنفاق، لا سيما حين يتعلّق الأمر بإرثهم الاستعماري. كما يوضّح روب نيكسون في «العنف البطيء وبيئية الفقراء»، فإنّ الغرب لطالما أخفى البُنى العنيفة التي أسّست إمبراطورياته. أما اليوم، فتنعكس تلك التركة الاستعمارية بوضوح في مشاهد الدمار في غزّة والقصف المتكرّر للبنان والحرب الأخيرة مع إيران.
تجسّد التصريحات الأخيرة للمستشار الألماني الجديد، ومن بينها قوله إنّ «إسرائيل تقوم بالعمل القذر بالنيابة عنّا جميعاً»، مثالاً صارخاً على هذا التحالف الإمبريالي القائم على نزع إنسانية الآخر باستمرار، سواء كان فلسطينياً أو يمنياً أو إيرانياً أو من المعارضين اليساريين. وتندرج سرديات مثل سردية إلبي ضمن توجّه أيديولوجي أوسع، يهدف إلى حماية المصالح الغربية من خلال توظيف الخطاب الفكري في خدمة استمرار الوضع القائم الاستعماري الجديد والإمبريالية الأميركية.
تبسيط إلبي لمفهوم «الهويّة اليهودية» وما ينبغي أن يكون عليه سلوك اليهود تجاه إسرائيل، يكشف رفضه الاعتراف بتعدّد الرؤى داخل التقاليد اليسارية ودراسات ما بعد الاستعمار
ليس من المستغرب أن تكون مثل هذه الرؤى شائعة داخل الأوساط الأكاديمية الألمانية، إذ تهدف إلى تشكيل وعي الأجيال الجديدة من الألمان على نحوٍ يُكرّس الدفاع عن الإرث الإمبريالي الغربي، عبر التحذير من «التهديدات الداخلية» و«الخارجية»، سواء تمثّلت في «جحافل المهاجرين» (القادمين من بلادٍ عربية دمّرتها الحروب ويسعون إلى دخول أوروبا)، أو في التهديد الخارجي المتمثّل بروسيا. ويبدو أنّ إسرائيل تضطلع بدور قيادي داخل هذا التحالف الإمبريالي الغربي في مواجهة «تهديداته»، وهو دور لا يرغب أشدّ السياسيين والمثقفين الألمان ميلاً للحرب بالتخلّي عنه، ويظهرون دعماً لإسرائيل يلامس حدود اللاعقلانية والتطرّف، لما ينطوي عليه من نفاق فجّ ومعايير مزدوجة مكشوفة.
يتغلغل هذا الشكل من الصهيونية الألمانية الفائقة، كما يصفه هانس كونتنانّي، حتى في الأوساط اليسارية وفي صفوف حزب الخضر الألماني. إنّه ميل قومي غريب ينظر إلى إسرائيل بوصفها نسخة مُحسّنة من الذات الألمانية، في تشويه فادح للتاريخ، لا سيّما لدى ما يُعرَف بتيّار «المعادين للألمان». ومن الصعب على أيّ مراقب خارجي أن يفهم هذا النوع الغريب من الإسقاط الفرويدي.
كلمة ختامية
في نهاية المطاف، لا ينبغي التعامل مع الكتاب بوصفه «مساهمة أكاديمية» جادّة، بل يجب النظر إليه كمادّة دعائية أيديولوجية تهدف إلى الدفاع عن السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، وترسيخ السردية الغربية المتمحورة حول تمجيد الذات، في وقت تواصل فيه «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» ارتكاب الإبادة بحق الفلسطينيين وقصف دول الجوار. ومع انكشاف واقع الاستعمار وتواصل الحملة الإبادية في غزّة، سيجد باحثون أمثال إلبي أنفسهم أكثر عزلة، مع تهاوي محاولاتهم لحماية إسرائيل والتستّر على جرائمها ضد الإنسانية تحت وطأة الأدلة التاريخية والوضوح الأخلاقي المتزايد. ومع ذلك، لا بدّ من القول بوضوح إنّ هذا المزيج من الصهيونية الفائقة وازدراء الوقائع التاريخية وحالة الذعر الأخلاقي، كما يصفه إيلان بابيه، لا يبدو ممكناً إلّا في أماكن مثل ألمانيا.
نُشر هذا المقال في 5 تموز/يوليو 2025 في The Left Berlin.