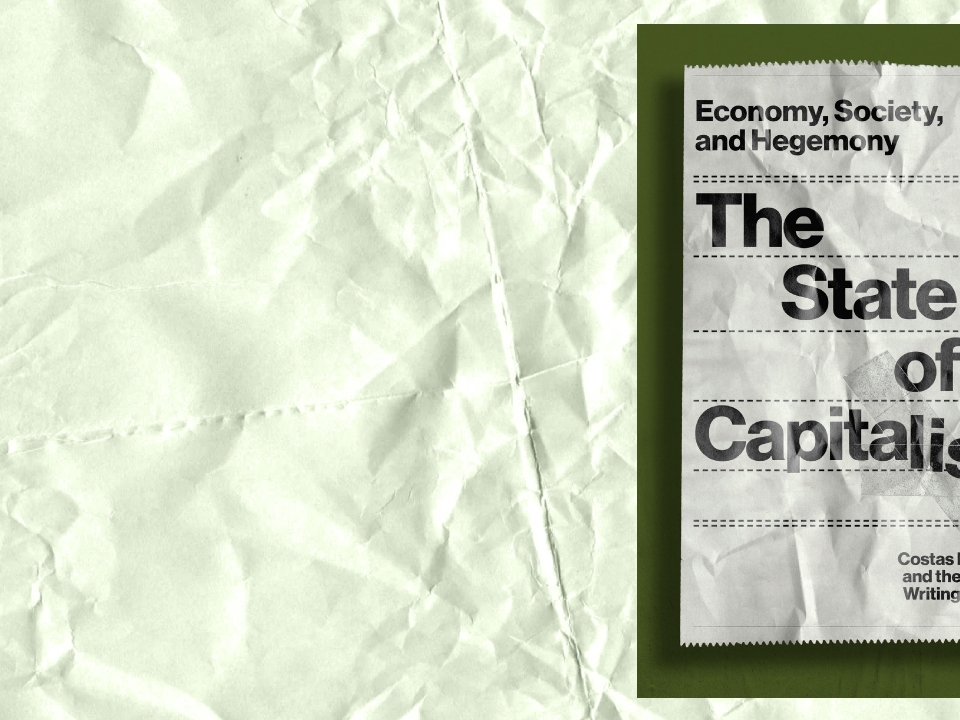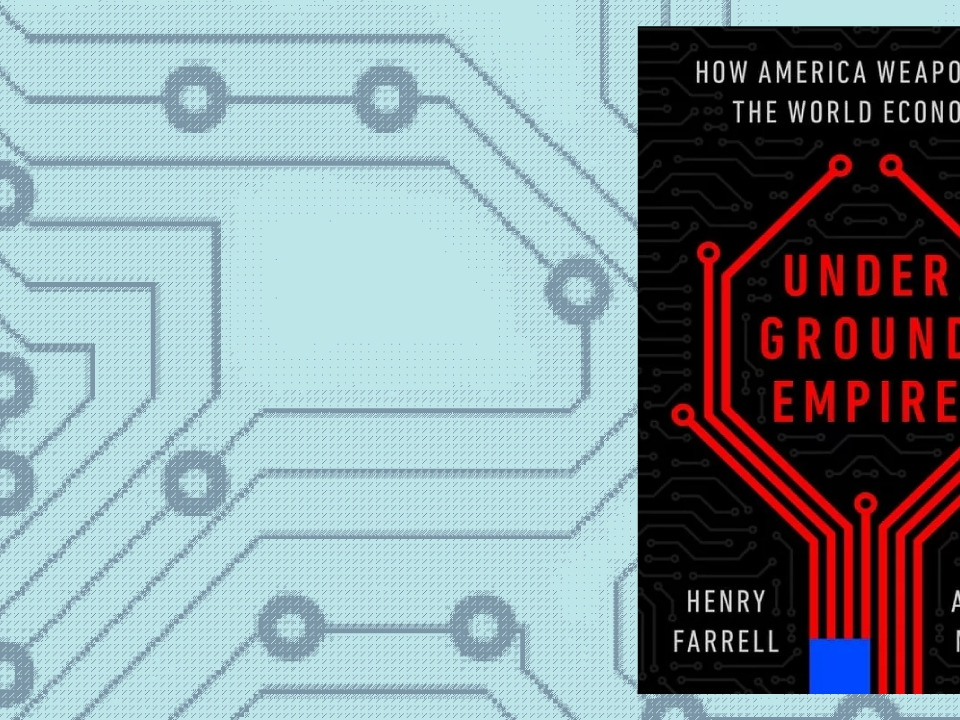اللاسوق
- مراجعة لكتاب برت كريستوفرز «السعر خاطئ: لماذا لن تنقذ الرأسمالية الكوكب»، الذي يمكن اعتباره الجزء الثالث من ثلاثية، بعد كتابيه الرأسمالية الريعية (2020) وحياتنا في محافظهم (2023). فما يربط بين هذه الكتب هو سعي إلى فهم الربح وآلياته، وتحدّي الشروط التي سُوّق من خلالها لكل من الخصخصة والخضوع لقواعد السوق.
كثيراً ما تُستخدم كلمتا «السوق» و«الرأسمالية» كأنهما مترادفتان، وحين يدافع أحدهم عن «السوق الحرّة» خصوصاً يُفهم عموماً أنه يدافع عن «الرأسمالية» أيضاً. لكن يمكن للمصطلحين أن يشيرا أيضاً إلى مجموعات مختلفة من العادات والأنظمة والمنطق. ووفقاً للتصنيف الذي وضعه المؤرّخ الاقتصادي فرنان بروديل، يمكن للمصطلحين أن يكونا معاكسين أحدهما للآخر.
بحسب تشبيه بروديل، تتكدّس مراحل طويلة من التاريخ الاقتصادي واحدة فوق الأخرى مثل طبقات المنزل. في الأسفل «الحياة المادية»، وهي عالم مُبهم من الاستهلاك الأساسي والإنتاج وإعادة الإنتاج. وفوقها «الحياة الاقتصادية»، عالم الأسواق، حيث يواجه البشر بعضهم بعضاً من الندّ إلى الندّ في علاقات التبادل، إنّما كمنافسين محتملين أيضاً. وتتميز الأسواق بالشفافية: الأسعار معلنة، وجميع الأنشطة ذات الصلة مرئية للجميع. وبسبب المنافسة، تكون الأرباح ضئيلة، تزيد قليلاً عن «أجر» البائع. وفوق «الحياة الاقتصادية» تأتي «الرأسمالية». وكما يراها بروديل، هي منطقة «اللاسوق»: عالم من الغموض، والاحتكار، والتركّز في السلطة والثروة، والأرباح الاستثنائية التي لا تتحقّق إلّا بالهروب من قواعد «الحياة الاقتصادية». يتفاعل تجّار السوق مع بعضهم بعضاً في زمان ومكان محدّدين، ملتزمين قواعد مشتركة (تخيّلوا ساحة بلدة في يوم السوق)؛ يستغل الرأسماليون سيطرتهم المتينة على الزمان والمكان كي يفرضوا قواعدهم على الجميع (تخيّلوا وول ستريت). الباعة والمشترين على موقع eBay مساهمون في سوق؛ وتساهم شركة eBay في الرأسمالية. والرأسمالية، بتعبير بروديل، هي «حيث تجول الحيوانات المفترسة ويطبّق قانون الغاب».
على هذا الأساس، وجِدت «الحياة الاقتصادية» بالفعل في المجتمعات الحديثة المبكرة، لكن «الرأسمالية» انتصرت لاحقاً، وأحكمت سيطرتها منذ القرن التاسع عشر، ما إن جنّدت الدولة حليفاً لها. وظهر طيف من البنى القانونية والمالية والإدارية لحماية الرأسماليين - وأرباحهم - من أنواع المساواة والمنافسة التي واصلت تقييد البرجوازية الصغيرة والتجار المحليين. أوجدت «الملكية الفكرية»، والمسؤولية المحدودة، و«مقرض الملاذ الأخير»، والتوسّع الاستعماري والتقنيات الجديدة لضبط الطبقة العاملة ظروفاً ملائمة للاستخراج والاستغلال، بدلاً من مجرد التبادل. وجاء العصر الرأسمالي في عهد روكفلر وفورد ليطغى على الفضائل الأخلاقية والسياسية للأسواق، كما بدت لأمثال آدم سميث.
لماذا إذاً تُخلط «الرأسمالية» و«الأسواق» في كثير من الأحيان؟ أحد التفسيرات هو أن الرأسمالية تحتاج إلى الأسواق بلا شك. لكنها تحتاج إلى أسواق محدّدة تخفي انعدام المساواة تحت غطاء التبادل الحرّ. وفقاً للماركسيين، إن السوق الوحيدة التي لا غنى عنها للرأسمالية هي سوق العمل، وهي المؤسسة التي تحوّل بشكل سحري القوى البشرية الفطرية إلى شيء يُشترى ويُباع كالتفاح والبرتقال. ويؤكد آخرون، أكثر تأثراً بكينز، على اعتماد الرأسمالية على الأسواق المالية، حيث يتم تبادل أوراق مالية (مثل السندات والأسهم والمشتقات المالية وما إلى ذلك) برهان على ارتفاع قيمتها أو انخفاضها في المستقبل. أي من هاتين السوقين عادية. وما تتيحه كل منهما هو تمكين طبقة من البشر - الرأسماليين - من تحقيق الثراء من دون جهد يُذكر، أولاً بتقليل أجور عمالهم، وثانياً بالتلاعب بميزانيات أعمالهم. قد تبدو أسواق العمل والأصول المالية مثل أسواق الخبز أو الجوارب، لكنها تنتمي بلا ريب إلى عالم «الرأسمالية» التراتبي المبهم، لا إلى فضاء «للحياة الاقتصادية» الشفاف والعادل.
ثمّة تفسير ثانٍ لهذا الخلط هو أن الرأسمالية، بخلاف وجود الأسواق، يصُعب تبريرها بشروطها الخاصة. تمتلك أي معاملة سوقية بسيطة قيمة اجتماعية تتمثل في جمع غرباء معاً لتحقيق منفعة متبادلة، من دون أن يكون لأحدهما تفوق على الآخر. و«التجارة العادلة» هي مناشدة معاصرة لهذا المبدأ. ولكن بأي منطق أخلاقي يصبح مالك أسهم في شركة أو مالك عقارات أو دار رعاية أكثر ثراء بنسبة 10% أو 15% في خلال عام، مع أنّه لم يبذل أي جهد أو براعة لزيادة «قيمة الأصول» المعنية؟ يجيب الاقتصاديون الليبراليون بالتمييز بين الأرباح التي تنعكس تحسينات في الإنتاجية (ما يجعلها أرباحاً جيّدة) وبين الأرباح التي تعكس قوّة السوق (ما يجعلها أرباحاً سيئة)، لكن هذا التمييز صعب للغاية في الممارسة، وضبطه أصعب. وعادة ما يقرّ أعتى المدافعين عن الرأسمالية بأنها احتكارية واستغلالية ومبهمة، إنما مع زعم بأن هذه الشروط مطلوبة حتى تتمكن أقلية بطولية، أي روّاد الأعمال، من الظهور والازدهار. وتبدو هذه السردية متماسكة عند الحديث عن حالات نادرة مثل ستيف جوبز، لكنها تتداعى حين تلامس الواقع العادي للمديرين التنفيذيين ومديري الأصول الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال ويكسبون 100 ضعف متوسط الأجر، ويعتبرون ذلك «تعويضات» لهم.
للرأسمالية، خلافاً للأسواق، مراكز قيادة. والرأسمالية، خلافاً للأسواق، تستتر بالتعقيد. أمّا المغزى الضمني لكتاب «السعر خاطئ» فهو أن نوعاً من رأسمالية الدولة، على النقيض من العنوان الفرعي للكتاب، قد تنقذ الكوكب، بل قد تكون أفضل أمل لنا
مالت الأيديولوجية الليبرالية إلى تجنّب مشكلة الرأسمالية تماماً، واختارت بدلاً من ذلك أن تتخيّل أنّ «الحياة الاقتصادية» (أي الأسواق التنافسية المتساوية) لا تزال تمسك بزمام الأمور. ويتجلّى قصر النظر هذا في المناهج الاقتصادية في الجامعات الكبرى التي واصلت إقصاء النظريات التي تؤكّد على القوة وانعدام اليقين والاحتكار وعدم الاستقرار، على الرغم من الجهود التي بذلتها مختلف الحملات ومعهد الفكر الاقتصادي الجديد الذي يموّله سوروس، كما واصلت التشبّث بمعتقدات تقليدية تحدّد فيها الأسعار والحوافز بصورة رئيسة النشاط الاقتصادي. وفي هذه الأثناء، يتمسّك الساسة بالحكايات الليبرالية الخرافية حول العمل المأجور والحراك الاجتماعي والملكية للجميع، وهو ما أصبح منفصلاً باضطراد عن واقع الفقر في العمل والثروة غير المكتسبة والإيجارات المتصاعدة. وتدّعي الخدمات المالية أنها مجرد «قطاع» آخر بين قطاعات كثيرة، فتبيع بضائعها في سوق شأنها شأن أصحاب المتاجر المتواضعين.
في كتابه «السعر خاطئ»، يضيف بريت كريستوفرز إلى هذه القائمة عارضاً أكثر خطورة ربما: فشل صناع السياسات في فهم تحوّل الطاقة الذي يتوقف عليه مستقبل الكوكب. على مرّ السنين، كان الافتراض السائد لدى اقتصاديي الطاقة أن العقبة الرئيسة أمام نمو الطاقة المتجدّدة هي كلفتها المرتفعة، ما يجعلها غير قادرة على منافسة الوقود الأحفوري في سوق الطاقة، وبالتالي اعتمادها على الدعم الحكومي. لذلك، كانت لحظة مثيرة في العام 2015، حين أشارت الوكالة الدولية للطاقة أخيراً إلى أن التقنيات المتجدّدة (بشكل أساسي مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) «لم تعد باهظة التكاليف»، بالمقارنة مع الغاز والفحم والنفط والطاقة النووية. وبحسب السياسة التقليدية، شكّل ذلك نقطة تحوّل. في تلك اللحظة كان بإمكان الحكومات أن تسحب دعمها لقطاع الطاقة المتجدّدة، وأن تتراجع بينما تمارس آلية الأسعار سحرها. فإذا أصبح الفحم والغاز والنفط الخيار الأقل تنافسية من حيث السعر، فإن قوانين العرض والطلب سرعان ما ستندثر. لكن أياً من هذا لم يحدث. لماذا؟
بكلمة واحدة، الربحية. وكما قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، في العام الماضي: «يستحق مساهمونا أن يرون سعينا وراء تحقيق عوائد مرتفعة». وفي حال لم نتمكّن من تحقيق عوائد من رقمين، علينا أن نسأل أنفسنا بجدية بالغة ما إذا كان علينا أن نواصل هذا العمل. لا شك أنّنا نريد تخفيض انبعاثات الكربون، لكن يجب أن يكون الأمر مربحاً. وتتوقع شركات مثل شل أن تحقّق عوائد لا تقل عن 15% على استثماراتها في الوقود الأحفوري، في مقابل عوائد لا تزيد عن 5% إلى 8% على استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة. تكمن جاذبية الوقود الأحفوري، من منظور «اللا سوق»، في مواصلته تقديم أنواع من الريع الاحتكاري لا توفره صناعة الطاقة المتجددة الأكثر تنافسية والأكثر ارتباطاً بالسوق. وهذه، كما يراها كريستوفرز، هي الحقيقة البشعة التي أخفاها نموذج اقتصاد السوق. وهو يبدي الخوف الذي عبّر عنه الرسم الكاريكاتوري لـ «نيويوركر» (New Yorker)، ويظهر فيه رجل وهو يوضح لثلاثة أطفال تحلّقوا حول نار مخيّم في المستقبل: «نعم، لقد دُمِّر الكوكب. ولكن في لحظة جميلة من الزمن، حقّقنا الكثير من القيمة للمساهمين».
ولا بد من إزالة الكربون على العديد من الجبهات، ويمكن القول إن توليد الكهرباء هو أهم هذه الجبهات. وفي العام 2019، نتج 37.5% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية عن توليد الكهرباء، والنسبة الباقية عن أنشطة مثل النقل والإنتاج الصناعي والتدفئة. وتتوقف إزالة الكربون من هذه الأنشطة على الوعد بالكهربة (السيارات، على سبيل المثال)، ولذلك فإن الحاجة إلى إحداث تغيير في توليد الكهرباء هو الأولوية الواضحة.
التحدي شاق. في العام 2022، نحو 61% من إمدادات الكهرباء العالمية أنتجت بالوقود الأحفوري، وبغالبية من الفحم، بالمقارنة مع نحو 12% فقط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين. ولمواكبة الطلب المتزايد، يجري طوال الوقت بناء محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم، إذ تتم الموافقة على إنشاء محطتين في المتوسط أسبوعياً في الصين وحدها. وتتضمّن خطة الوكالة الدولية للطاقة الرامية إلى بلوغ صفر انبعاثات بحلول العام 2050، زيادة مساهمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 68%، والتخلّص فعلياً من الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، على أن يتم تأمين النسبة الباقية من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى مثل الطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية وكذلك الطاقة النووية. وإذ يرجّح تضاعف الطلب العالمي على الكهرباء في خلال الفترة نفسها (بفضل كهربة تكنولوجيات أخرى على نحو خاص)، فإن المهمة تكاد تبدو مستحيلة. لكنه إذا كان هناك أمل في الحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين أو أكثر، فهو يتوقف على إقامة مزارع جديدة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بسرعة فائقة.
يتوقّف إمكان تحقيق ذلك أو عدمه على قدرة المؤسسات السياسية والاقتصادية القائمة على تيسيره. تعدّ اقتصاديات توليد الكهرباء وتنظيمها معقدة للغاية، لكن يمكن الإشارة إلى قلّة من العناصر وثيقة الصلة، ولكل منها أثره في آفاق التخلّص من الكربون بسرعة. أولاً، هناك البيئة التنظيمية التي أصبحت القاعدة في معظم بلدان الشمال منذ ثمانينيات القرن الماضي. وشرع صناع السياسات، متأثرين بإحياء الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة وأيديولوجيات السوق الحرة، في إعادة هيكلة قطاعات الطاقة لديهم على أمل أن تؤدي المنافسة في السوق إلى خفض الأسعار، وإفادة المستهلكين، وإجبار المنتجين على الاستثمار في التكنولوجيات والخدمات المتفوقة بهدف الحفاظ على حصتها في السوق وربحيتها. هذه رؤية مربحة «للحياة الاقتصادية»، حيث تتمتع الأسواق بالسيادة، وتسود الشفافية، ولا يستطيع أحد أن يستأسد بالآخر.
تعد أساطير «السوق الحرة» و«ريادة الأعمال» أشبه بهدية لأصحاب الريوع، حيث قدِّمت الأرباح المفرطة باعتبارها انعكاساً للابتكار والشجاعة، لا تسوية سياسية لا يجرؤ أحد على تحدّيها
سعياً لتحقيق هذا الحلم، بدأ المنظّمون تفكيك الأجزاء المختلفة من قطاع الطاقة (فصل الجملة عن التجزئة) بهدف الحد من قوة الاحتكار، وتثبيت آليات السوق في بقية القطاعات. وبالنتيجة أصبح توليد الكهرباء عملاً تجارياً في سوق شديدة التنافس والتقلب. و«العملاء» الرئيسون في هذا السوق هم تجار الكهرباء بالتجزئة. ويتأثر سعر الجملة للكهرباء بمجموعة من العوامل، بما في ذلك المضاربات المالية وصعوبات التنبؤ بمكان ووقت الحاجة إلى الكهرباء. ويأتي مزيد من التقلب من تأرجح أسعار الوقود الأحفوري (لا سيما منذ غزو أوكرانيا)، مع أن ذلك يمثّل تحوّطاً من مصادر الطاقة غير المتجددة: إذا انخفضت أسعار الكهرباء، فهذا يرجع جزئياً إلى انخفاض تكلفة الوقود أيضاً، ولذلك تبقى هوامش الربح ثابتة. مصادر الطاقة المتجددة لا تتمتع بهذه الميزة.
ثم هناك الخصوصيات المادية لكيفية توليد الكهرباء بالفعل. تتسم مزارع الرياح والطاقة الشمسية بتكاليف استثمار أولية مرتفعة نسبياً، في مقابل تكاليف تشغيلية منخفضة نسبياً، نظراً لأن مصدر طاقتها مجاني. وقد لا تُستردّ التكاليف الاستثمارية لعشر سنوات أو عشرين سنة. وهذا الجدول الزمني، بالإضافة إلى حقيقة أن مصادر الطاقة المتجددة لا تزال جديدة، يجعل مشاريع مماثلة هشّة أمام أهواء المستثمرين ومشاعرهم. يكتب كريستوفرز: «يمثل التمويل الحاجز الأخير، وهي النقطة التي غالباً ما يتوقف عندها تطوير مصادر الطاقة المتجددة على نحو دائم». ولا يختار المستثمرون بين توليد الكهرباء «النظيفة» و«غير النظيفة»، لكنهم يحكمون على الفرص المتاحة عبر طيف واسع من فئات الأصول. يكمن الاهتمام الوحيد للرأسماليين، كما رأى ماركس، في كيفية تحويل المال إلى مزيد من المال، وليس واضحاً ما إذا كانت مصادر الطاقة المتجددة وسيلة جيدة للقيام بذلك، بغض النظر عن رخص نفقاتها التشغيلية.
المشكلة، من وجهة نظر المستثمرين، هي الربحية. يريد المستثمرون التأكد من العوائد المستقبلية المتوقعة على استثماراتهم، وإلا سوف يشترطون الحصول على ضمانات عالية مقابل تحمّل المزيد من المخاطر. ويتمثل التحدي الذي يواجه قطاع الطاقة المتجددة في إقناع المستثمرين بأنهم قادرون على تحقيق عوائد مرتفعة في سوق تتسم بأسعار شديدة التقلب، وحواجز منخفضة أمام الدخول إليها، وعدم وجود ما يحقق استقرار الإيرادات. ولقد ساهمت السياسات التي حاولت خفض تكاليف الكهرباء - عبر ربطها بقواعد السوق والمنافسة - في جعل القطاع المالي حذراً. وكلما بدا أن مصادر الطاقة المتجددة تبلو بلاءاً حسناً، اندفع مقدمو خدمات جدد، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي الأرباح. فيشعر المستثمرون بالخوف من جديد.
ما يتوق إليه المستثمرون هو استقرار الأسعار، أو القدرة على التنبؤ بها على الأقل. فالمخاطرة شيء، وانعدام اليقين شيء آخر. إنّه لمن الأسهل أن ندمج في النماذج المالية تلك الصناعات المتّسمة بدرجة عالية من التركّز وقوة الاحتكار والدعم الحكومي المديدين، لأن تفاصيلها معروفة. وبالنظر من منظور إزالة الكربون، فإن السياسات الأكثر نجاحاً التي استعرضها كتاب «السعر خاطئ» ليست تلك التي تخفّض سعر الكهرباء لمصلحة المستهلكين، بل تلك التي تعمل على استقرار السعر لصالح المستثمرين. وفي الوقت نفسه، يظل استخراج الوقود الأحفوري وحرقه وسيلة أكثر موثوقية لتحقيق العائدات التي تتوقعها وول ستريت وسيتي. تضمّ هذه الصناعة لاعبين مسيطرين، وتتسم بحواجز أعلى تمنع دخول لاعبين جدد، وتأسّست (وموّلت) قبل فترة طويلة من فورة التسويق.
تمسك الاقتصاديون والنقاد الليبراليون بفكرة أن الرأسمالية الغربية تعاني من «ركود طويل الأمد»، لكن كريستوفرز يذهب إلى أبعد من ذلك في تحديد الطريقة التي تستخدمها الرأسمالية للازدهار على الرغم من غياب مكاسب الإنتاجية أو الرخاء
على الرغم من الغبطة الزائدة بانخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يشكّ كريستوفرز في «أن يكون هناك منشأة واحدة من الطاقة المتجدّدة الضخمة وغير المدعومة في مكان ما في العالم». والمزعج هو أنه بقدر ما تبقى الكهرباء المتجدّدة مرهونة بالدعم، فهي ليست أموالاً يتم توفيرها على المستهلكين، بل أرباح يحصدها المستثمرون ومحافظ مديري الأصول. ومن عجيب المفارقات هنا أن الإيديولوجية التي عزّزت الأسواق الحرة وثقافة المشروع (في مواجهة التكتل والاحتكار) فرضت اعتماد هذا القطاع على الدولة. والدرس الذي يستخلصه كريستوفرز هو أن الكهرباء «كانت ولا تزال غير مناسبة للتسويق وتوليد الأرباح في المقام الأول». أمّا من الناحية البيئية، فما كان بمقدور النيوليبرالية أن تأتي في وقت أسوأ.
ما العمل؟ من الواضح أن الأمل مقطوع في أن تقود أسواق الكهرباء عملية التحول في مجال الطاقة، في الوقت الذي نجد أنّ الأسواق المالية هي التي تتخذ القرارات. والخيار الذي برز إلى الواجهة في السنوات الأخيرة، وقادته إدارة بايدن، هو الخيار الذي يطلق عليه مجازاً «تخفيف المخاطر»، والذي يعني في الواقع زيادة العائدات التي يتوقّعها المستثمرون وضمانها باستخدام الإعفاءات الضريبية وغيرها من وسائل الدعم. وقانون خفض التضخم الذي وقعه بايدن في صيف العام 2022 يَعِدُ بمبلغ ضخم قدره 369 مليار دولار على شكل حوافز على مدى السنوات العشر المقبلة. وهذا على الأقل يواجه حقيقة مفادها أن قدراً كبيراً من القدرة على صوغ المستقبل يقع في أيدي مديري الأصول والمصارف، وحساباتهم (وليس حسابات العملاء) هي التي سوف تقرّر ما إذا كان الكوكب سوف يحترق أم لا. لا يوجد سبب اقتصادي لاعتبار عائد استثمار بنسبة 15% «طبيعياً»، كما لا يوجد سبب يشي بسوء مشروع يحقّق عوائد بنسبة 6%. المشكلة، كما يوضح كريستوفرز، هي أنّ على المستثمرين أن يختاروا العائد الذي يفضّلونه، ومن غير المرجح أن تجبر أي حكومة «بلاك روك» (BlackRock) على كسب أموال أقل في أي وقت قريب. ومع استمرار سياسة «تخفيف المخاطر» بالإخفاق في الانتقال من «الجزرة» إلى «العصا»، يوجد القليل من الشروط الثمينة المفروضة على المستفيدين من الإعفاءات الضريبية الخضراء، وأقل القليل من العقوبات الكافية لردع أولئك الذين يواصلون الاستثمار في الوقود الأحفوري.
يتمثّل الخيار الأكثر طموحاً، وإن لم يكن مستساغاً سياسياً، في صفقة خضراء جديدة حقّة، تتحمّل فيها الدولة قدراً هائلاً من التكاليف والمخاطر ضمن ميزانيتها العمومية. وما إن يصبح مقبولاً، فلن يتم التعامل مع الكهرباء كسلعة نمطية، وسوف تتجاوز الحاجة الملحة إلى إزالة الكربون كل حسابات التكلفة والعائد الضيقة، وعندها من المنطقي التخلّي عن الاعتماد على الأسواق تماماً. قد يحدث بعد ذلك شيء أشبه بالتعبئة في زمن الحرب، فتوسّع الدولة مصداقيتها المالية إلى أقصى حد للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بالوتيرة التي تتطلبها حالة الطوارئ المناخية. لكن أحداً لا يتوقع أن تعود هذه العملية بالمال على الدولة، كما قدّر لمشروع طاقة بريطانيا العظمى الذي اقترحه كير ستارمر.
يمكن اعتبار كتاب كريستوفرز «السعر خاطئ» الجزء الثالث من ثلاثية، إذ يأتي بعد كتابيه الرأسمالية الريعية (2020) وحياتنا في محافظهم (2023). وما يربط بين هذه الكتب هو سعي إلى فهم الربح في أعقاب تاتشر وريغان، وتحدّي الشروط التي سُوّق من خلالها لكل من الخصخصة والخضوع لقواعد السوق. وتشترك آليات قطاع الكهرباء في بعض الأمور مع حالات أخرى تناولها كريستوفرز في السنوات الأخيرة، من ضمنها الإسكان، والاعتماد على القطاع الخاص لتقديم الخدمات العامة وإدارة دور الرعاية والأرض والبنية التحتية.
عندما تكون الرأسمالية هي المشكلة، وليس الأسواق، فإن البديل الوحيد هو ما بعد الرأسمالية
في جميع هذه الحالات، خضعت السلع التي يعتمد عليها المجتمع للخصخصة باسم تشجيع المنافسة في السوق، إنّما مع نتائج لا تشبه على الإطلاق نتائج سوق «حرة»، ومع مستفيدين يمكن التنبؤ بهم. لم تخضع هذه السلع للخصخصة فحسب، بل «حوِّلت إلى أصول»، بمعنى أنها جُمّعت وكُمِّمت وأُديرت بطرق تناسب حسابات المموّلين ومصالحهم. (الفارق في حالة الطاقة المتجددة هو مدى خداع مشروع التحويل إلى أصول، إلى حد أثبت أنّه من المستحيل حتى بناء التوربينات والألواح الشمسية اللازمة). يتعامل القطاع المالي بلغة المخاطر، لكنه يسعى إلى أوضاع تكون فيها الربحية مضمونة فعلياً، ويتحقق فيها مستوى معين للعائد. والقطاعات التي تفي بهذا الغرض هي القطاعات ذات الحد الأدنى من المنافسة أو التي لا تستطيع الدولة التخلي عنها. المصطلح المهين الذي يُستخدم هنا هو «السعي وراء الربح السهل والمفرط» الذي يُفترض أن يكون أسلوباً غير عادي وغير مشروع للربح، لكن المغزى المقلق من عمل كريستوفرز الأخير هو أن الرأسمالية - في الأقل في حالها الراهن - تحب أن تعمل بموجب هذه الطريقة.
تظهر التأثيرات المترتبة على هذه التسوية الاقتصادية في كل مكان، في الثروات المتضخمة للنخب المالية، والقطاع العام المتهالك، والإسكان الذي لا يمكن تحمل تكاليفه، والاستثمار المستمر في التكنولوجيات المضرّة، مثل المولدات التي تعمل بالفحم. وأن نعزوِ ذلك كلّه إلى «السوق»، كأن أحداً لم يخطّط له، ولا مراكز قوة فيه، يطيل أمد الفشل في فهمه. للرأسمالية، خلافاً للأسواق، مراكز قيادة. والرأسمالية، خلافاً للأسواق، تستتر بالتعقيد. أمّا المغزى الضمني لكتاب «السعر خاطئ» فهو أن نوعاً من رأسمالية الدولة، على النقيض من العنوان الفرعي للكتاب، قد تنقذ الكوكب، بل قد تكون أفضل أمل لنا. لكن كثيراً من صناع السياسات لا يزالون يعانون من انغلاق ذهني حين يتعلق الأمر بالتخلي عن المثال الليبرالي الذي تقودنا إليه السوق من دون التخطيط له.
من المعروف أن كينز وضع أماله في «القتل الرحيم لأصحاب الريوع». كان ليبرالياً في المقام الأول، لكنه كان متيقظاً أيضاً للتهديد الذي فرضته الرأسمالية على المُثُل الليبرالية. يوضح كتاب «السعر خاطئ» مشكلة مركزية للرأسمالية من المنظور الكينزي، وهي أنها لا تتميز بنظام سعر واحد، بل بنظامين. هناك سعر السلع (مثل سعر ميغاوات من الكهرباء) الذي يحدّده العرض والطلب اليوم، وهناك سعر الأصول المالية (مثل الحق في تدفق إيرادات مزارع الرياح) الذي تُحدّده توقعات الغد. وتحدّد هذه التوقعات بالمشاعر والأعراف والسياسات والثقافة. وجميع هذه الأمور مرنة، لكن تعديلها يحتاج سلطات مركزية راغبة في تعزيزها وتشكيلها. تعد أساطير «السوق الحرة» و«ريادة الأعمال» أشبه بهدية لأصحاب الريوع، حيث قدِّمت الأرباح المفرطة باعتبارها انعكاساً للابتكار والشجاعة، لا تسوية سياسية لا يجرؤ أحد على تحدّيها. لا يوجد نقص في رأس المال المالي المتاح لدعم التحول في مجال الطاقة، بل مجرد إصرار مُنهَك على المكافآت التي يمكن تحصيلها للقيام بذلك.
لا يمكن تبرير الرأسمالية في هذا الشكل الصريح «اللاسوقي». لقد حاول قادة يساريون أن يشيروا إلى هذه الحقيقة في عديد من المرات منذ الأزمة المالية العالمية. استخدم جيريمي كوربين وبيرني ساندرز منصتيهما للتدليل على نظام ينتزع من دون أن يعد بأي شيء في المقابل، وإدانته. وفي خطابه الذي ألقاه في مؤتمر حزب العمّال في العام 2011، ألقى إد ميليباند باللائمة على التمييز البروديلي بين «المفترسين» و«المنتجين» الاقتصاديين، وقد ثبت أنه مزعج بالنسبة للصحف البريطانية المنحازة إلى المفترسين، وأدق من أن يمكث طويلاً في جلبة وستمنستر. ولا يزال إد ميليباند آخر حاملي هذا الفكر النقدي في حكومة الظل (بعد تراجع ستارمر عن التزامه بإنفاق 28 مليار جنيه إسترليني سنوياً للتخلّص من الكربون، وحوّله إلى مادة ساخرة على أحد المواقع التابعة لحزب المحافظين، بطرحه سؤال: «أين إد؟»)، وسياسي الصف الأول الوحيد الذي يقبل تحليلات مثل تحليلات كريستوفرز الموجهّة من مركز أبحاث الكومونويلث في مرحلة ما بعد كوربين.
ومن الأمور المثيرة للفضول في هذا النقد هو مدى ما يدين به لكينز، وضآلة ما يدين به لماركس. إن غياب الاستغلال الصناعي للعمالة، وغياب الابتكار التكنولوجي، هما على وجه التحديد ما يعتبران العيبان الجوهريان للرأسمالية المعاصرة. وبدلاً من ذلك، تبدو الرأسمالية كأنها محكومة بالخبرة المالية التي تكتسح كل شيء وتعيد تشكيله من بناء المنازل إلى الجامعات، والاستثمار في البنية التحتية إلى الرعاية الصحية. يعاني الاقتصاد المنتج من الركود، في حين تُنتزع الأرباح من جميع المرافق الاجتماعية والعامة المتاحة من خلال تحالفات بين شركات النخب للخدمات القانونية والمالية، ما يؤدي إلى استنزاف الأصول وتوسيع حقوق الملكية. لقد تمسك الاقتصاديون والنقاد الليبراليون بفكرة أن الرأسمالية الغربية تعاني من «ركود طويل الأمد»، لكن كريستوفرز يذهب إلى أبعد من ذلك في تحديد الطريقة التي تستخدمها الرأسمالية للازدهار على الرغم من غياب مكاسب الإنتاجية أو الرخاء.
الدولة وحدها هي من يمتلك القوة والمال والقدرة التنسيقية لتوجيه الاستثمار الرأسمالي على نطاق وبسرعة كافيين نحو قطاع الطاقة المتجددة
ربما يكون هناك بعض الأمل في براعة أولئك الذين يجدون أنّ اللاسوق لا تطاق، ويصوغون طرقاً للهروب خاصة بهم. النشر الأكاديمي، على سبيل المثال، هو واحد من أفظع عمليات انتزاع الريع. إذ يعمل باحثون ومحررون ومراجعون بالمجان، فيما تفرض التكتلات الكبرى المحمية بحقوق الطبع والنشر على المكتبات رسوماً بعدة آلاف من الجنيهات الاسترلينية سنوياً مقابل الوصول الرقمي إلى المجلات التي لا يمكنها الاستغناء عنها. وتصل هوامش ربح كبار الناشرين العلميين إلى 40%، وهي نسبة تكفي لجعل رئيس شركة شل يحمر خجلاً. ومن هنا يأتي الحماس لمشاريع مثل مكتبة العلوم الإنسانية المفتوحة غير الربحية، التي أنشأها أكاديميو بيركبيك في العام 2013، وتنشر الآن نحو 33 مجلة في السنة. عندما تكون الرأسمالية هي المشكلة، وليس الأسواق، فإن البديل الوحيد هو ما بعد الرأسمالية.
لكن الحقيقة الأساسية لأزمة المناخ هي أن ثمّة القليل من الوقت، بالتوازي مع زيادة حجم التحدي السياسي مع مرور كل يوم. وأهمية أن نتصرّف بأسرع ما يمكن تشوّش تنسيقاتنا السياسية والأخلاقية المعتادة، ما يجبرنا أن ننظر إلى ما هو أبعد من الحلول السياسية والاقتصادية التي قد نأمل فيها عادة، وأن ننظر على نحو أكثر إيجابية إلى الحلول التي تعتبر «واقعية». لا يكفي أن ننتظر مجيء الحلول من تحت سواء من الناشطين أو من الأسواق. الدولة وحدها هي من يمتلك القوة والمال والقدرة التنسيقية لتوجيه الاستثمار الرأسمالي على نطاق وبسرعة كافيين نحو قطاع الطاقة المتجددة. ومن الناحية العملية، فإن التمييز بين دولة «التخفيف من المخاطر» التي تعمل على زيادة أرباح القطاع الخاص، وصفقة خضراء جديدة تبني بنية تحتية عامة جديدة، قد يكون أقل وضوحاً مما يبدو على الورق. والأولوية، كما هي الآن ومنذ عقود، هي لتحقيق أكبر قدر ممكن وفي أسرع وقت ممكن.
نُشِر المقال في London Review of Books في 4 نيسان/أبريل 2024، وتُرجِم وأعيد نشره على موقع صفر بموافقة من الجهة الناشرة.