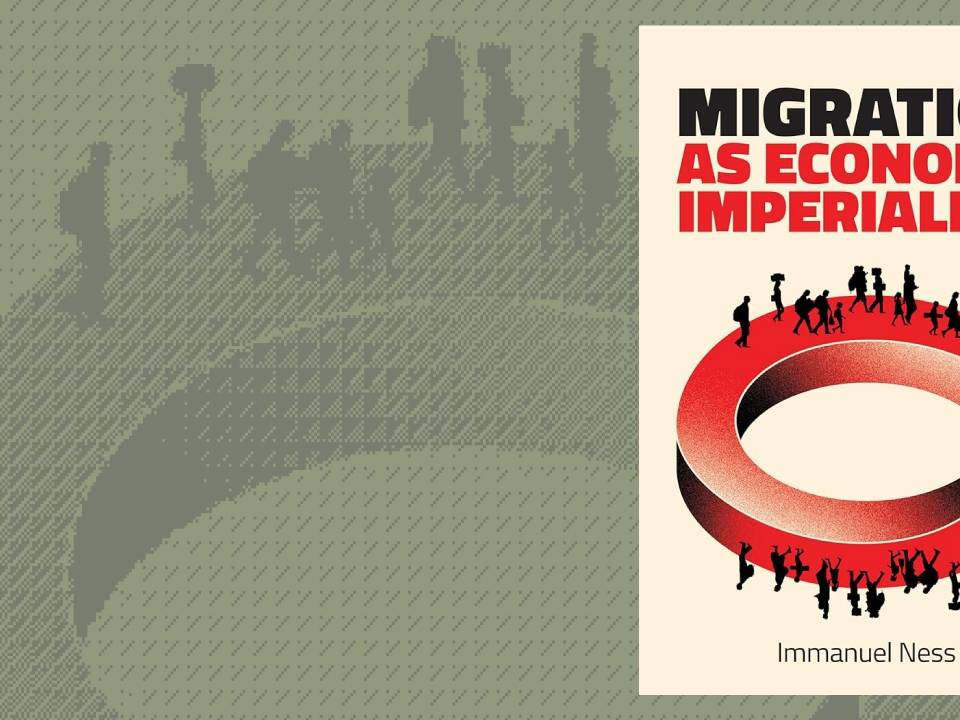الهجرة كاقتصاد عالمي للخوف
الهجرة ليست مجرّد حركة انتقال بين ضفتين، بل هي مسرح يُدار فيه الخوف كآلية ضبط وإنتاج في آنٍ واحد. عند الحدود، ينكشف أحد أكبر تناقضات العالم المعاصر: من جهة، عولمة تُبشّر بحرية السلع ورؤوس الأموال، ومن جهة أخرى، منظومات متشابكة تُشيّد الجدران وتُنصّب أجهزة مراقبة لتقييد البشر. المفارقة أن النظام نفسه الذي يروّج لحرية السوق هو من يضاعف الاستثمار في تكنولوجيات المنع، بحيث يتحوّل الخوف من المهاجر إلى مادة خام تُغذي صناعة كاملة من السياسات والأرباح.
لم تعد الحدود خطوطاً جغرافية تفصل بين الدول، بل فضاءات اختبار تُجرَّب فيها أحدث الأدوات: قواعد بيانات بيومترية، طائرات مسيّرة، أنظمة تصنيف خوارزمية. لا يُرى المهاجر كفرد له حياة ومسار، بل كإشارة في منظومة رصد، كتهديد يجب التعرّف إليه مبكراً واحتوائه. المفارقة أن خطاب الحماية والإنقاذ يتقاطع مع خطاب الأمن والردع: الجسد نفسه الذي يُقدَّم كضحية في صور الغرق هو نفسه الذي يُعاد تصنيفه كخطر ينبغي ردعه قبل الوصول إلى الشاطئ. تتجاور الإنسانية مع الأمن في حدود ضبابية، فتُمنح الحياة للبعض ويُترك آخرون للموت، وفق حسابات لا تخلو من منطق انتقائي بارد.
الخوف هنا ليس مجرد عرض جانبي، بل هو جوهر تشغيل هذه الآلة. يغذّي الخوف من «الغزو الديموغرافي» الحملات الانتخابية ويعزّز صعود التيارات اليمينية. يبرّر الخوف من «الهجرة غير الشرعية» العقود الضخمة لشركات الأمن والتكنولوجيا. يفتح الخوف من «أزمة اللاجئين» المجال أمام منظمات إنسانية تُعيد إنتاج منطق السيطرة وهي تُمارس أدوارها الإغاثية. المفارقة أن كل الأطراف، على الرغم من تناقض خطاباتها، تلتقي في تحويل الخوف إلى مورد قابل للتسويق السياسي والاقتصادي والإنساني، وحتى الإعلامي.
الحدود في هذا المعنى ليست جدراناً صلبة فقط، بل مختبرات رمزية للعنف. المخيمات، الطوابير، الانتظار اللانهائي، كلّها أدوات تُحوّل الزمن نفسه إلى وسيلة ردع. الجوع والبرد والألم ليسوا مصادفات، بل سياسات غير معلنة: تحويل العبور إلى تجربة مهينة كي يصبح الردع ذاتياً. المفارقة أن هذه القسوة لا تُقدَّم كلحظة عقاب، بل غالباً ما تُبرّر باعتبارها ضرورة إنسانية، حماية للضحايا أنفسهم من المخاطر الأكبر التي قد يواجهونها لو استمروا في الرحلة.
لكن الخوف لا يعمل في اتجاه واحد. فهو في الشمال خوف من الآخر، من المختلف، من القادم الذي يُهدّد الهوية والرفاه. وفي الجنوب، هو خوف من الانسداد، من الفقر، من العيش دون أفق. المهاجر الذي يركب البحر يحمل في جسده هذين الخوفين معاً: يهرب من خوفه الداخلي ليواجه خوفاً جديداً على العتبة الأوروبية. المفارقة أن النظام العالمي يحوّل هذا الازدواج إلى وسيلة لإعادة إنتاج تبعية دائمة: من يُستبعد من الاقتصاد الرسمي يُدمج في اقتصاد غير مرئي، يُستغل فيه كعامل هش بلا حماية، كجيش احتياطي يضمن مرونة الرأسمالية عند الأزمات.
في العمق، الخوف من الهجرة ليس سوى انعكاس لآليات النظام الرأسمالي الذي يحتاج إلى ضبط تدفق البشر بقدر حاجته إلى تحرير حركة الأموال. السياسات التي تدّعي حماية الحدود لا تسعى فقط إلى منع الدخول، بل إلى تشكيل سوق للعمل الهش، سوق يقوم على وفرة دائمة من الأجساد المستعدة للعمل في الظل. المفارقة أن ما يُقدَّم كسياسات ردع هو في الآن نفسه آلية إنتاج: إنتاج خوف يعيد تشكيل المخيال الجماعي، وإنتاج قوة عمل رخيصة تُغذي الاقتصاد الرسمي من خلف الستار.
هكذا يتضح أن الخوف ليس شعوراً عابراً ولا نتيجة جانبية، بل هو قلب آلية السيطرة في زمن العولمة. إنه وسيلة لإعادة ترسيم الحدود بين الداخل والخارج، بين المواطن والمهاجر، بين المستفيد والمُستغَل. وفي النهاية، المسألة ليست متعلقة بكيفية إيقاف الهجرة، بل بكشف السؤال الأعمق: من يربح من تحويل الخوف إلى نظام عالمي لإدارة البشر؟
الخوف كآلية أمنية: الحدود كمسارح للمراقبة
لم تعد الحدود في العالم المعاصر مجرد خطوط ترسم على الخرائط، بل تحوّلت إلى مسارح ضخمة تُمارس فيها طقوس المراقبة وتُدار عبرها صناعة الخوف. هنا يلتقي القانوني بالرمزي، الأمني بالإنساني، والتقني بالسياسي. وفي هذا التداخل، يتكشف أن الحدود لم تعد فقط أدوات سيادة، بل فضاءات حية لإنتاج الخوف وتدويره كآلية لضبط الأجساد وتوجيه الحركات.
عندما يُقدّم المهاجر كتهديد، لا يُقصد بذلك خطراً مادياً مباشراً، بل يُعاد تشكيله في المخيال السياسي كرمز متحرك يختزن الخوف الجماعي. لا ينبع هذا الخوف من وقائع بعينها، بل من سلسلة صور وخطابات تُغذي باستمرار فكرة أن الحدود مهدّدة وأن الداخل مهدّد بالاختراق. وهكذا يتحوّل المهاجر من إنسان يسعى إلى النجاة إلى إشارة داخل نظام مراقبة يختزل حياته في ملف رقمي، صورة التقطتها كاميرا حرارية، أو رقم في قاعدة بيانات بيومترية. لم تعد المسألة حماية المجال الوطني فقط، بل خلق فضاء مراقبة دائم تتداخل فيه الدولة والشركات الخاصة والمنظمات الدولية، حيث يُصبح الأمن بحد ذاته صناعة قائمة على الخوف.
بلغ حجم الإنفاق العالمي على تقنيات مراقبة الحدود نحو 50 مليار دولار سنوياً، مع توقعات أن يتجاوز 90 مليار دولار بحلول 2030
بهذا المعنى، تشبه الحدود مختبراً للتجارب الاجتماعية والتقنية. فالتكنولوجيات الجديدة لا تُطبق أولاً في المدن أو الفضاءات اليومية، بل تُختبر عند الحدود: تقنيات التعرف إلى الوجوه، تقييم المخاطر عبر الخوارزميات، وحتى أدوات التنبؤ بالحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ما يثير الانتباه هو أن هذه التجارب تُبرّر دائماً بخطاب الخوف: حماية المواطنين من الإرهاب، منع الجريمة العابرة، أو تفادي «الغزو الديموغرافي». لكن المفارقة أن هذه الأدوات، بعد أن تُرسّخ على الحدود، تنتقل تدريجياً إلى المجال المدني، لتصبح جزءاً من الرقابة الشاملة على الحياة اليومية. الحدود هنا ليست فقط أماكن للمنع، بل نقاط انطلاق لانتشار منطق المراقبة في المجتمع ككل.
الأكثر إثارة أن الخوف لم يعد محصوراً في لغة السياسة، بل أصبح مادة اقتصادية. فقد بلغ حجم الإنفاق العالمي على تقنيات مراقبة الحدود نحو 50 مليار دولار سنوياً، مع توقعات أن يتجاوز 90 مليار دولار بحلول 2030. في الولايات المتحدة مثلاً، رُصدت ميزانية تتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً لتكنولوجيا الحدود وحدها، بينما كلّف مشروع SBInet على الحدود مع المكسيك ما بين 2 و8 مليارات دولار من دون أن يكتمل كما كان مخططاً. في أوروبا، خصّص الاتحاد الأوروبي مئات الملايين لنظام Eurosur الذي يوظف الأقمار الصناعية والمسيّرات لمراقبة المتوسط، ومن المتوقع أن يتجاوز تمويله عتبة المليار يورو في السنوات القادمة. هذه الأرقام ليست محايدة: إنها دليل على أن صناعة الأمن باتت من أكثر القطاعات نمواً، وأن الخوف هو الوقود الذي يضمن استمرار هذا النمو. بقدر ما يُضخّم التهديد، بقدر ما تزداد ميزانيات الجيوش وحرس الحدود، وتُفتح الأسواق أمام شركات التكنولوجيا الأمنية. والمهاجر في هذا السياق يصبح «مادة أولية» لهذه السوق، حيث يُستخدم وجوده ذاته كحجة لتوسيع الرقابة وإنعاش الاقتصاد الأمني. المفارقة أن الفئات الأكثر هشاشة، التي تبحث عن ملاذ، هي نفسها التي تُحوّل إلى سلعة لتغذية دورة اقتصادية عالمية.
لا تقتصر المسارح الكبرى للمراقبة اليوم على المتوسط أو حدود أوروبا. على خط التماس بين الهند وباكستان، تنتشر الأسلاك الشائكة والكاميرات الحرارية في مسرح دائم للتوتر؛ وفي إسرائيل، تُحوّل الحدود مع غزة والضفّة إلى جدار ذكي تتخلّله الرادارات والدرونات؛ في الصين، الحدود والمطارات تعمل كغرف بيومترية عملاقة تصنّف الأجساد مسبقاً قبل عبورها. تكشف هذه الأمثلة أن الخوف ليس محلياً بل ظاهرة عالمية، وأن «حدود السيادة» صارت مختبرات كونية للمراقبة.
لكن مسارح المراقبة ليست فقط أنظمة تقنية، بل هي أيضاً فضاءات للعنف الرمزي والمادي. المخيمات الممتدة عند حدود أوروبا، مراكز الاحتجاز في الشمال والجنوب، الدوريات البحرية في المتوسط، كلها أدوات لا تسعى إلى منع العبور فقط بل إلى إنتاج تجربة خوف دائمة. الانتظار الطويل، البرد القارس، المعاملة المذلة، كلها عناصر تُحوّل الوجود عند الحدود إلى مسرحية ردع. الهدف ليس أن يتوقف هذا الجسد عن العبور فحسب، بل أن يُنقل الخوف إلى أجساد أخرى تفكر في المغادرة. بهذا المعنى، يصبح الألم نفسه سياسة: سياسة تهدف إلى جعل الخوف معدياً، إلى تحويل التجربة الفردية إلى رسالة جماعية.
المتوسط ليس مقبرة للمهاجرين فقط، بل أيضاً حلقة مركزية في سوق عالمية لإدارة التنقل، حيث تتحكّم أوروبا في حركة البشر بالطريقة نفسها التي تضبط بها حركة البضائع ورؤوس الأموال
المفارقة الصارخة هي أن الخطاب الإنساني لا ينفصل عن هذا المنطق الأمني، بل يتقاطع معه. عمليات الإنقاذ، التدخلات الطبية، برامج الإغاثة، كلها تُقدَّم كدليل على الرحمة، لكنها في الواقع تُستعمل كامتداد للمراقبة. الجسد الذي يُنتَشل من البحر لا يُستقبل بوصفه ناجياً، بل يُسجّل ويُحتجز ويُراقب. هنا يظهر كيف يتحوّل التعاطف نفسه إلى تقنية للضبط: تُمنح الحياة لبعض الأجساد وتُحرم أخرى منها، وفق معايير انتقائية تُخفيها لغة الإنسانية لكنها تكشفها ممارسة المراقبة. الخوف هنا ليس من «الآخر الغازي» فقط، بل أيضاً من «الضحية الزائدة» التي قد تتحول إلى عبء على الداخل.
يكشف هذا التداخل بين الأمني والإنساني عن بعد أعمق: الحدود ليست مجرد مؤسسات سياسية، بل هي أيضاً بنيات لإنتاج المعرفة والخيال. الصور المتداولة في الإعلام، خطاب السياسيين، وحتى تمثيلات السينما، كلها تساهم في صناعة خيال حدودي يختزن الخوف ويعيد إنتاجه. كل صورة لقارب مكتظ أو مخيم مزدحم تتحول إلى دليل إضافي على التهديد، وكل خطاب عن «التدفق غير المسبوق» يعزّز القناعة بأن الحدود مهدّدة دائماً. هكذا يصبح الخوف متوالية رمزية لا تحتاج إلى وقائع ملموسة كي تتغذّى، بل يكفيها إعادة تدوير الصور والخطابات.
لكن الأهم أن الخوف صار جزءاً من هندسة التبادل الاقتصادي بين الشمال والجنوب. الاتفاقيات التجارية الكبرى غالباً ما تتضمّن بنوداً صريحة أو ضمنية عن «إدارة الهجرة»، ما يعني أن حرية السلع ورؤوس الأموال تُشترط بضبط تدفقات البشر. يُصدّر الجنوب المواد الخام والأيدي العاملة الرخيصة، لكنه يُحاصر بسياسات تأشيرات مشددة واتفاقيات إعادة مهاجرين. هنا يظهر الخوف كعملة سياسية واقتصادية: كلما تضخمت صور «الغزو»، كلما شدّدت أوروبا أو أميركا قيودها على الهجرة، وكلما توسّعت الأسواق الأمنية وازداد التحكم في شروط التجارة.
وعلى الرغم من كل هذا، لا يمكن فهم الحدود كأدوات للردع فقط. فهي أيضاً فضاءات مقاومة، حيث تتشكل أشكال جديدة من التضامن والتحايل. ممرات سرية في الجبال، شبكات مساعدة محلية، أو حتى تحركات جماعية تطالب بفتح الحدود. المفارقة أن المسرح نفسه الذي يُدار فيه الخوف هو أيضاً مسرح لإنتاج الأمل والتمرّد. لكن هذا التمرد نفسه يُعاد إدماجه في خطاب الخوف، حيث يُصوَّر التضامن كتهديد للنظام، أو يُختزل في لغة «المساعدة غير القانونية».
في النهاية، يظهر أن الخوف ليس عرضاً جانبياً في إدارة الحدود، بل هو آليتها الجوهرية. الخوف هو الذي يبرر السياسات الاستثنائية، وهو الذي يغذي الصناعات الأمنية، وهو الذي يُعاد تدويره في المخيال الجماعي. الحدود بهذا المعنى هي مسارح تُعرض فيها يومياً مسرحية الخوف: أجساد تُراقَب، تقنيات تُجرَّب، خطابات تُعاد صياغتها، وأسواق تُنتعش.
البحر الأبيض المتوسط: مقبرة وخط إنتاج
البحر الأبيض المتوسط، الذي طالما قُدّم في المخيال الأوروبي كبحر الحضارات والتبادل والتلاقي، صار في العقود الأخيرة رمزاً مزدوجاً: مقبرة مفتوحة للأجساد الفارة، وخط إنتاج متواصل للخوف والسيطرة. المفارقة هنا أن البحر الذي يُسوّق كجسر ثقافي وسياحي هو ذاته الذي يتحوّل إلى مسرح موت جماعي وإلى مختبر للسياسات الأمنية والإنسانية في آن واحد.
تحوّل المتوسط إلى فضاء تتقاطع فيه تقنيات الردع وسياسات الإنقاذ. فمن جهة، تبحر الزوارق الحربية والطائرات المسيّرة لرصد «التدفقات غير النظامية»، وتنتشر شبكات الرادارات الممولة بمليارات اليوروهات لرصد أي تحرّك في المياه. ومن جهة أخرى، تُنشأ برامج إنسانية وتُطلق عمليات إنقاذ تُقدَّم في الإعلام كرمز للتعاطف والرحمة. لكن هذه الثنائية – الردع والإنقاذ – لا تعكس تضاداً بقدر ما تكشف عن تكامل وظيفي: فالإنقاذ ذاته يصبح جزءاً من إدارة الحدود، حيث تُنقذ الأرواح لتُعاد إلى مراكز الاحتجاز أو لتُستعمل كبرهان على «إنسانية» النظام. النتيجة أن المتوسط لم يعد بحراً للتبادل، بل مسرحاً يُمارَس فيه العنف المزدوج: العنف الصلب المتمثل في المنع والقمع، والعنف الناعم المتخفي في خطاب الرحمة.
تكفي الأرقام وحدها لإظهار عمق هذه المفارقة: منذ مطلع الألفية، غرق أو فُقد عشرات الآلاف من المهاجرين في المتوسط، ما جعله أكثر الحدود دموية في العالم. لكن في المقابل، استثمر الاتحاد الأوروبي مئات الملايين في مشاريع مثل Eurosur، ومول عقوداً ضخمة مع شركات الطيران والدرون والأمن السيبراني. كل غريق هنا لا يُفهم فقط كمأساة إنسانية، بل كحجة لتكثيف الاستثمار الأمني، وكل عملية إنقاذ تتحول إلى مادة لتبرير المزيد من الرقابة. بهذا المعنى، البحر ليس فقط مقبرة بل أيضاً خط إنتاج مستمر للخوف: كل جثة تولّد خطاباً جديداً عن الخطر، وكل قارب يُرصد يغذي صناعة المراقبة.
ما يميز المتوسط عن حدود أخرى في العالم هو طابعه الرمزي. إنه ليس مجرد خط عسكري أو جدار مادي، بل فضاء مفتوح يستعصي على السيطرة الكاملة، ما يجعله أكثر خصوبة لإنتاج الخيال السياسي. الصور التي تنشرها وسائل الإعلام – قوارب مكتظة، أطفال غرقى، مخيمات مؤقتة على الجزر – تصبح أدوات لإعادة إنتاج الخوف الجماعي في الشمال. لا تخلق هذه الصور تعاطفاً متقطعاً فقط، بل تُستعمل لبناء إجماع حول «ضرورة» تعزيز الحراسة، بل وأحياناً لتشريع اتفاقيات مع دول الجنوب لوقف المهاجرين قبل أن يصلوا إلى السواحل الأوروبية. بذلك يصبح المتوسط مرآة تعكس ليس مأساة المهاجرين فقط، بل أيضاً هشاشة المشروع الأوروبي ذاته، الذي يوازن بين صورة «قلعة الإنسانية» وصورة «حصن الردع».
يكشف المتوسط لنا طبيعة النظام العالمي الراهن: حدود مفتوحة للسلع والأموال، مغلقة على الأجساد؛ بحر يُباع كمنتج سياحي للأوروبيين، ويُمارس فيه الموت كعقاب جماعي للمهاجرين
إلى جانب دوره كفضاء موت، يعمل المتوسط كمحرك اقتصادي عالمي. حركة المهاجرين التي يُفترض أنها «غير نظامية» تُنظَّم في الواقع عبر شبكات تهريب معقدة غالباً ما تتقاطع مع أجهزة رسمية أو مع اقتصاديات محلية. في تونس وليبيا مثلاً، الهجرة تُستعمل كورقة تفاوض مع الاتحاد الأوروبي: مزيد من المساعدات المالية في مقابل مزيد من الرقابة على الحدود. تخلق هذه الترتيبات اقتصاداً سياسياً قائماً على إدارة الخوف: يتحصّل الجنوب على موارد مالية في مقابل تأدية دور «الشرطي»، ويطمئن الشمال رأيه العام عبر إظهار أنه يسيطر على التدفقات. النتيجة أن المتوسط ليس مقبرة للمهاجرين فقط، بل أيضاً حلقة مركزية في سوق عالمية لإدارة التنقل، حيث تتحكّم أوروبا في حركة البشر بالطريقة نفسها التي تضبط بها حركة البضائع ورؤوس الأموال.
البعد الآخر الذي يكشفه المتوسط هو الانتقائية. ليس كل من يعبر البحر يُعتبر تهديداً؛ بعض الفئات – المستثمرون، الطلبة، السياح – يُفتح أمامها المجال بسهولة، بينما تُغلق الأبواب أمام الفئات الفقيرة أو الفارة من الحروب. هكذا تُحوَّل التأشيرة إلى أداة فرز طبقي، والبحر إلى غربال هائل يقرر من يستحق العبور ومن يُترك للموت. هنا يتضح أن الخوف ليس شعوراً عاماً، بل آلية تشتغل بدقة اقتصادية: تُستبعد الأجساد غير المرغوبة من الاقتصاد الرسمي، لكنها تُدمج في اقتصاد الظل عبر العمل غير المصرّح به أو التهريب.
وعلى الرغم من هذه الآلة الجهنمية، يظل المتوسط أيضاً فضاء مقاومة. فالمهاجرون الذين يصرّون على العبور على الرغم من المخاطر، وشبكات التضامن التي تتشكل على الجزر أو في المدن الساحلية، والمنظمات التي تواصل عمليات الإنقاذ على الرغم منم المضايقات، كلهم يعيدون تعريف البحر كساحة صراع. هنا المفارقة العميقة: البحر الذي يُراد له أن يكون مقبرة هو نفسه الذي يولّد ممارسات تضامن وتمرّد. لكن هذه المقاومة بدورها تُستوعب أحياناً في خطاب الخوف: يُتهم المتضامنون بأنهم «مهربون» أو «مهددون للنظام»، وتُختزل أفعالهم في لغة القانون الجنائي.
في النهاية، يكشف المتوسط لنا طبيعة النظام العالمي الراهن: حدود مفتوحة للسلع والأموال، مغلقة على الأجساد؛ بحر يُباع كمنتج سياحي للأوروبيين، ويُمارس فيه الموت كعقاب جماعي للمهاجرين. الخوف هنا ليس نتاجاً عرضياً، بل هو منتَج مقصود: يُستعمل لشرعنة السياسات الأمنية، لإدارة التوازنات الاقتصادية مع الجنوب، ولإعادة إنتاج الصور النمطية عن «الغزو» و«الضحية». إن البحر الأبيض المتوسط ليس مقبرة للآلاف فقط، بل أيضاً خط إنتاج مستمر لاقتصاد عالمي يقوم على الخوف، حيث تتحوّل حركة البشر إلى مورد مربح للسياسة والأمن والتجارة في آن واحد.
فيزا شنغن: الخوف كبنية اقتصادية للفرز
في تحقيق لموقع الكتيبة التونسي، تظهر شهادات حيّة تفضح منطق الاعتباط الذي يحكم نظام التأشيرات الأوروبية. سيرين، فنّية الأسنان التي أُعفي زوجها من الرفض فيما جوبه ملفّها بالحرمان على الرغم من تشابه الوثائق والمبالغ، تصف التجربة وكأنها «قرعة». شهادات أخرى لأكاديميين، أطباء ومهندسين، واجهوا الرفض بدورهم، تبيّن أن التأشيرة لم تعد مجرّد إجراء إداري بل أداة سياسية واقتصادية، تُدار عبرها علاقة غير متكافئة بين الشمال والجنوب.
يعكس هذا الواقع الملموس ما يمكن تسميته باقتصاد الإقصاء. فبدلاً من أن يقوم النظام على استغلال العمال كفئة اجتماعية واضحة، كما في منطق الصراع الطبقي الكلاسيكي، انتقل الخطاب إلى الحديث عن «المقصيين» و«المرفوضين». التأشيرة هنا ليست مجرد وثيقة عبور، بل اختبار انتماء للشبكة العالمية: من يُمنح الفيزا يُعترف به كجزء من شبكة الحركة والتنقل، أما من يُرفض فيُدفع إلى الهامش، حيث يفقد إمكانية المشاركة في الدورة العالمية للمعرفة والعمل.
كما لاحظ لوك بولتانسكي، الرأسمالية الجديدة لا تُعرّف ذاتها بلغة الاستغلال الطبقي، بل بلغة الشبكات. من هو متصل، متحرك، خفيف، سريع في خلق الروابط، يصبح مستفيداً من النظام؛ أما من يبقى ثابتاً، عالقاً في مكانه، فيُقصى. هنا تبرز المفارقة: في عالم يُحتفى فيه بحرية الحركة كقيمة عليا، يتحوّل الثبات إلى لعنة. المواطن التونسي، مهما كان موقعه الاجتماعي أو الأكاديمي، يصبح «ثقيلاً» في نظر النظام الأوروبي ما لم يدخل في خانة «المواهب المختارة». هذا ما يفسّر كيف يسهل استقطاب الكفاءات العلمية أو التقنية عبر مسارات خاصة، فيما يُترك باقي طالبي الفيزا لامتحان بيروقراطي مهين.
لكن الاعتباطية التي يكشفها تحقيق الكتيبة ليست خللاً في النظام، بل جزء من وظيفته الأساسية. فالقرار الذي يأتي بلا تعليل، أو التعليل الذي يتناقض مع ملفات مشابهة، يُحوّل طلب الفيزا إلى تجربة خوف. يضبط هذا الخوف الأجساد قبل أن تدخل الشمال: يُدرك طالب التأشيرة مسبقاً أن مجهولية القرار قد تطيح بجهوده، وأن كرامته قد تُسحق في الطوابير. الاعتباطية هنا أداة سياسية، تُنتج خضوعاً داخلياً، وتحوّل الحقّ في التنقل إلى امتياز توزعه القنصليات بجرعات صغيرة.
ما يزيد الطابع البنيوي لهذه السياسة هو ارتباطها بالاقتصاد السياسي للعلاقات بين الضفتين. يمنح الاتحاد الأوروبي أو يمنع التأشيرات وفق منطق تفاوضي: مزيد من التعاون الأمني في ملف الترحيل يقابله انفتاح أكبر على التنقل؛ أي تراخي في إعادة قبول «مهاجري الجنوب» يقابله تضييق على التأشيرات. هنا تتحول حرية الحركة إلى أداة ضغط دولي، تُدار بها التوازنات الاقتصادية والدبلوماسية. المفارقة أن أوروبا التي تتباهى بحرية السلع والخدمات والاستثمارات، تُحكم قبضتها على حرية البشر.
أفكار الباحثين في الهجرة والحدود تساعد على تعرية هذه المفارقة. فالحدود الحديثة ليست مجرد جدران، بل أجهزة مراقبة متحركة: مراكز فرز في المطارات، أنظمة بيومترية، مكاتب خاصة تدير المواعيد وتجني الأرباح من رسوم باهظة. التأشيرة صارت صناعة مربحة في حد ذاتها: شركات وسيطة كـTLS Contact تحقق أرباحاً من إدارة ملفات آلاف التونسيين، بينما النتيجة النهائية قد تكون رفضاً «اعتباطياً». هذا يبيّن أن الإقصاء ليس مجرد أداة سياسية، بل مصدر ربح اقتصادي يغذّي شركات خاصة ودولاً تستثمر في الخوف.
يُستبعد من الاقتصاد الرسمي يُدمج في اقتصاد غير مرئي، يُستغل فيه كعامل هش بلا حماية، كجيش احتياطي يضمن مرونة الرأسمالية عند الأزمات
إذا نظرنا إلى البحر الأبيض المتوسط كـ«خط إنتاج للخوف»، نجد أن التأشيرة هي «المعمل البيروقراطي» لهذا الخوف. في البحر، يُنتج الخوف عبر مشهد الغرق والموت؛ في القنصليات، يُنتج الخوف عبر الرفض والإذلال. في الحالتين، الغاية واحدة: التحكم في التدفقات البشرية بما يخدم مصالح اقتصادية وسياسية. الفارق أن الموت في البحر يحوّل الأجساد إلى تحذير رمزي، بينما الرفض في القنصلية يحوّل الأجساد إلى «ملفات غير مرغوبة».
أشار التحقيق أيضاً إلى أن من يُمنحون التأشيرات عادة هم «المتنقلون» الذين يحتاجهم الشمال: كفاءات علمية، طلاب مرموقون، أو مستثمرون. أما «الثابتون» الذين لا يملكون ما يُقدَّم للشبكة إلا وجودهم المحلي، فهم الأكثر عرضة للإقصاء. وهذا يتوافق مع تحليل بولتانسكي: المتنقلون يستغلون ثبات الآخرين ليتمكنوا من الحركة. يصبح الجنوب بمثابة «قاعدة ثابتة» تسمح للشمال بالمزيد من الحركة والربح. فالتونسي الذي يُمنع من الفيزا ليس مجرد فرد محروم، بل جزء من سياسة تجعل من الجنوب مخزناً للموارد والكفاءات المنتقاة، ومكبّاً لليد العاملة «غير المرغوبة».
النتيجة أن فيزا شنغن تعمل كبنية خوف وإقصاء. فهي تنتج تراتبية جديدة لا تقوم فقط على الثروة أو الطبقة، بل على القدرة على الحركة. من يحمل جوازاً أوروبياً أو فيزا صالحة يُعتبر «مواطناً عالمياً»؛ من يُرفض ملفه يصبح عالقاً خارج الشبكة، مُقصى حتى لو كان أكاديمياً أو طبيباً. الخوف هنا ليس عرضياً بل هو قلب المنظومة: الخوف من الرفض يردع، الخوف من الترحيل يضبط، والخوف من المجهول يعيد إنتاج التبعية.
وبينما تختفي لغة الاستغلال الطبقي من الخطاب العام، تحلّ محلها لغة «الإقصاء». لكن، كما يذكّرنا بولتانسكي، هذا الإقصاء ليس نقيض الاستغلال بل شكله الجديد: استغلال «ثبات» المستبعدين لتمكين «حركة» المهيمنين. من هنا، فإن التأشيرة ليست مجرد ورقة، بل أداة حكم، تجعل من حرية التنقل سلعة نادرة تُباع وتُشترى، وتحوّل الخوف ذاته إلى مورد سياسي واقتصادي.
المراجع
Andersson, R. (2014). Illegality, Inc.: Clandestine migration and the business of bordering Europe. Oakland, CA: University of California Press.
Pallister-Wilkins, P. (2022). Humanitarian borders: Unequal mobility and saving lives. London, UK: Verso.
Tazzioli, M. (2020). Governing migrant mobility through mobility: The EU hotspots approach. Environment and Planning C: Politics and Space, 38(7–8), 1311–1329. https://doi.org/10.1177/2399654420924408
Walters, W. (2011). Foucault and frontiers: Notes on the birth of the humanitarian border. In U. Bröckling, S. Krasmann, & T. Lemke (Eds.), Governmentality: Current issues and future challenges (pp. 138–164). New York, NY: Routledge.
Salter, M. B. (2003). Rights of passage: The passport in international relations. Millennium: Journal of International Studies, 31(2), 345–368. https://doi.org/10.1177/03058298030310020501
Bigo, D. (2007). Sécurité et immigration: Vers une gouvernementalité par la peur. Paris: L’Harmattan.
Spire, A. (2008). Accueillir ou reconduire: Enquête sur les guichets de l’immigration. Paris: Raisons d’Agir.
Fassin, D. (2010). La raison humanitaire: Une histoire morale du temps présent. Paris: Hautes Études/Gallimard/Seuil.
Agier, M. (2018). L’étranger qui vient: Repenser l’hospitalité. Paris: Seuil.
Boltanski, L., & Chiapello, È. (1999). Inégaux face à la mobilité. Vacarme, 10, 97–105.
الباهي، رحمة. (2022). "تأشيرة شنغن: سياسة الإقصاء والمهانة في معاملة التونسين". موقع الكتيبة – قسم التحقيقات الدولية. تونس.