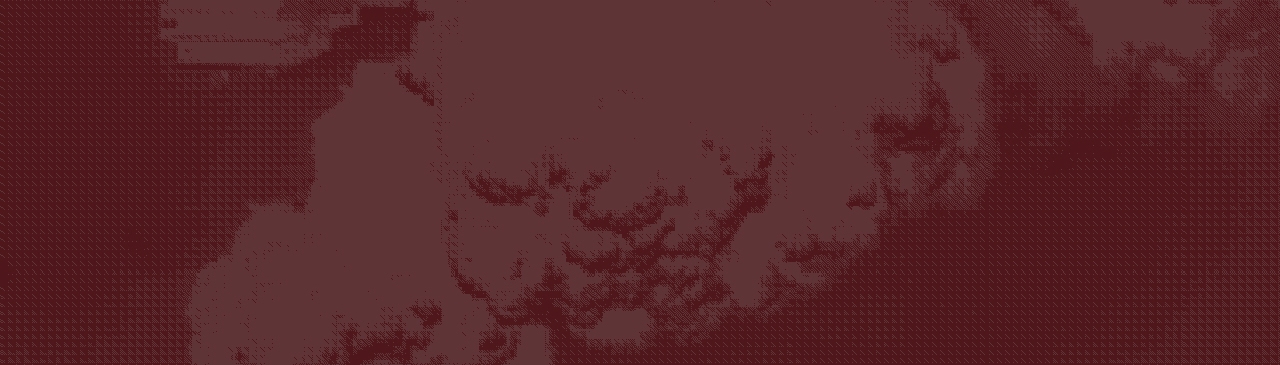
كتابة تاريخ غزّة من تحت القصف
- مراجعة لكتاب «غزة: حرب استعمارية» الذي يضم 16 فصلاً لعدد من الباحثين في التاريخ والعلوم السياسية والأنثروبولوجيا والقانون، ويرى أن الحرب على غزة ليست حدثاً منفصلاً بدأ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بل امتدادٌ لمشروعٍ استعماري طويل يسعى إلى محو الفلسطينيين جسدياً وثقافياً وزمنياً.
صدر كتاب «غزة: حرب استعمارية» عن منشورات La Découverte بباريس في العام 2024، في حوالي 430 صفحة، تحت إشراف جوليان سالتنر وربا صالح وستيفاني لاتّي عبدالله ليجمع في بنيته 16 فصلاً موزّعة على 4 محاور كبرى. يشارك فيه باحثون وباحثات من تخصّصات متعددة، في التاريخ والعلوم السياسية والسوسيولوجيا والأنثروبولوجيا والدراسات القانونية، مثل ليلى سورات، أنطوان شلحاط، ماهر الشريف، أباهر السقا، ستيفاني لاتّي عبدالله، ماريون سلتين، إرمينيا كيّارا كالابريزي، كريستين جونغن، ديمة السجدية، فاطمة دازي-هيني، توماس فاسكوفي، جوني عاصي، يوهان صوفي وغيرهم. لا يهدف هذا التعدد إلى جمع نصوص متفرقة، بل إلى إنتاج مقاربة جماعية تسعى إلى تفكيك الحرب على غزة بوصفها حدثاً معاصراً ممتدّ الجذور، لا يمكن فهمه إلا عبر تضافر زوايا النظر المختلفة.
منذ صفحاته الأولى، يقيم الكتاب مع قارئه صدمة تأويلية: ما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وما تلاه من عدوان واسع ليس بداية الحكاية، بل امتداد لمسار استعماري طويل. العبارة المفتاحية التي ترد في النص التأسيسي - «التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر» - تزيح مركزية اللحظة الصادمة وتعيد إدراجها ضمن استمرارية منطق استيطاني يقوم على السيطرة الشاملة ونفي الوجود الفلسطيني. بهذا ينقل الكتاب النقاش من دائرة الطارئ إلى فضاء البنية: من حدث يُعرض إعلامياً باعتباره استثناءً دموياً إلى سياق استعماري طويل يعيد إنتاج نفسه بأشكال متجددة.
لا يكتفي المدخل الافتتاحي باستعراض الأرقام المروعة للضحايا ولا المشاهد المأسوية للخراب، بل يذهب أبعد ليبيّن أن الدمار لم يكن نتيجة عارضة، بل استراتيجية مقصودة. فالمستشفيات والمدارس والبنية التحتية وشبكات الماء والكهرباء لم تُدمّر عرضاً بل استُهدفت بشكل منهجي، بحيث تحوّلت غزة إلى ما يسميه النص «حقل من الخراب»، حيث تُجرد الحياة من شروطها الأولية. يتقاطع هذا التحليل مع مقاربات سوسيولوجية وأنثروبولوجية ترى في الاستعمار الاستيطاني مشروعاً للسيطرة على الحياة ذاتها، لا على الأرض فقط.
الاستعمار لا يكتفي بفرض الهيمنة المادية، بل يحتكر أيضاً السردية ويصوغ صورة الفلسطيني في ثنائية مقيِّدة: «إرهابي» يهدد الأمن أو «ضحية» صامتة بلا صوت سياسي
لكن قيمة النص الافتتاحي لا تكمن في التوصيف المأساوي فحسب، بل في طرحه لسؤال تأويلي مفتوح: ما الذي تمثله هذه الحرب في عمقها؟ هل نحن أمام ذروة مشروع الإبادة، أم أمام فصل آخر في تاريخ طويل من العنف الاستعماري المتجدد؟ طرح السؤال بهذا الشكل لا يقدّم إجابة نهائية، بل يفتح أفقاً للتفكير في جدلية الاستمرارية والقطيعة في آنٍ واحد. فثمة استمرارية في الأدوات والخطابات، وثمة قطيعة في مستوى التصعيد وآليات التدمير التي بلغت مستويات غير مسبوقة، سواء في شدة القصف أو في شمولية الحصار أو في استهداف المستقبل ذاته عبر ما تسميه بعض المساهمات «الفيوتوريسايد»، أي قتل الأفق وإلغاء إمكانية تخيّل الغد.
ويبرز الكتاب منذ البداية أن الحرب لا تُخاض بالسلاح وحده، بل أيضاً في ساحة المعرفة والرموز. الاستعمار لا يكتفي بفرض الهيمنة المادية، بل يحتكر أيضاً السردية ويصوغ صورة الفلسطيني في ثنائية مقيِّدة: «إرهابي» يهدد الأمن أو «ضحية» صامتة بلا صوت سياسي. هنا يصبح الفعل الكتابي نفسه جزءاً من المقاومة، إذ يهدف العمل إلى إعادة تعريف ما يجري في غزة باعتباره حرباً استعمارية تهدف إلى محو مجتمع كامل. وفي هذا السياق، تستعاد مقولة الباحثة ربا صالح: «الشعوب المضطهدة والمستعمَرة كانت، وما زالت، خاضعة لعنف معرفي يجعلها غير مسموعة أو لا تُعرض إلا في إطار رؤى محدّدة مسبقاً». إدراج هذه المقولة في المدخل يوضّح أن المعركة اليوم مزدوجة: معركة بقاء على الأرض، ومعركة تمثيل في الفضاء الرمزي.
تكشف بنية الكتاب عن مشروع متكامل. ففي محوره الأول، تنطلق الفصول من تحليل سياق 7 تشرين الأول/أكتوبر وما تلاه، مع تركيز على التحوّلات الداخلية في حركة حماس، وعلى المجتمع الإسرائيلي، وعلى موقع الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ثم على أزمة الشرعية السياسية الفلسطينية. في المحور الثاني، يتحوّل التحليل إلى تفكيك أشكال المحو: من تدمير المستقبل واستهداف التعليم والذاكرة إلى الإبادة الحضرية والديموغرافية والوجودية، حيث يُظهر أباهر السقا كيف أن ضرب المدن والتهجير الجماعي ليسا عَرَضين، بل جزء من إستراتيجية منهجية لإلغاء المجتمع الفلسطيني. أما المحور الثالث فيقدّم اليوميات الصغيرة كعدسة تحليلية: كيف تُبنى الحياة تحت القصف في غزة، وكيف تنعكس صورها في بيروت التي عرفت حروباً مشابهة، أو في عمّان حيث يتجلّى «التعاطف عن بُعد» كقوة سياسية في البيوت والصالونات العائلية. وأخيراً، يتوسع الكتاب في محوره الرابع نحو الإقليم والعالم: من إدارة مصر للحدود وسياسات الخليج المزدوجة بين التضامن الشعبي والالتزامات الدولية، إلى دور الإعلام الفرنسي في إعادة إنتاج السردية الاستعمارية أو في كسرها عبر أصوات بديلة، وصولاً إلى محكمة العدل الدولية والعدالة الجنائية الدولية وما تكشفه من حدود النظام القانوني العالمي وإمكاناته.
تقديم هذه الفصول بإيجاز لا يقلل من قيمتها، بل يكشف أن العمل بُني بعناية ليغطي مستويات متعددة: من الوقائع الميدانية إلى الخطابات الرمزية، ومن السياسة المحلية إلى التوازنات الإقليمية والدولية. ما يجمعها جميعاً هو الفكرة التأسيسية التي يضعها النص الافتتاحي: الحرب على غزة ليست حدثاً استثنائياً، بل تجلٍ راهن لمسار استعماري يسعى إلى محو الفلسطينيين جسدياً ومعرفياً وزمنياً.
إن قراءة هذا الكتاب تمنح القارئ أداة لفهم ما يتجاوز ضجيج الأخبار اليومية. فهي تضع الحرب في أفق أوسع، يكشف أن العنف الاستعماري يتغذّى من تكرار نفسه ومن احتكار الرواية، لكنه في الوقت ذاته يواجه مقاومة متواصلة، سواء عبر الصمود الميداني أو عبر إعادة إنتاج سردية مضادة. بهذا يصبح الكتاب نفسه جزءاً من هذه المقاومة المعرفية، يكتب في مواجهة المحو، ويعيد الاعتبار للحق الفلسطيني في أن يُرى ويُسمع ويُفكَّر فيه كفاعل لا كموضوع لخطابات الآخرين.
هجوم 7 أكتوبر بين تحوّلات غزة وانكشاف الداخل الإسرائيلي
حين نقرأ الفصلين الأول والثاني من الكتاب، ندرك أن ما وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم يكن مجرد «بداية» أو «صدمة مفاجئة»، بل تتويجاً لمسار طويل من التحوّلات المتشابكة في غزة، وفي الوقت نفسه لحظة انكشاف داخلي للمجتمع الإسرائيلي. بهذا المعنى، لم يكن الحدث لحظة منفصلة، بل «نتيجة مسار طويل من إعادة التكيّف والتجذّر داخل المجتمع الغزّي» كما تقول ليلى سورات، مؤكدة أن القراءة التي تفصل العملية عن سياقها التاريخي والاجتماعي لا تفضي إلا إلى تبسيط مخل.
توضح سورات أن حركة حماس عاشت في خلال العقد الأخير ضغطين متناقضين: من جهة «استمرار الحصار الإسرائيلي وتكرار الاعتداءات»، ومن جهة أخرى «الحاجة إلى الحفاظ على قاعدة اجتماعية تمنحها الشرعية كسلطة أمر واقع». فرض عليها هذا الوضع البحث عن معادلة صعبة تجمع بين إدارة الحياة اليومية لمليوني إنسان في قطاع محاصر وتجديد شرعيتها كمقاومة في مواجهة الاحتلال. وتضيف الباحثة أن هذه المعادلة لم تكن ثابتة: «كان على الحركة أن تجد صيغة تضمن استمرارها كسلطة محلّية، وفي الوقت نفسه ألا تفقد صورتها كمقاومة»؛ وهو ما جعلها تنخرط في عملية مستمرة من إعادة التنظيم والتكيّف مع المتغيرات الإقليمية.
غير أن السياق لا يقتصر على خيارات حماس فحسب. فقد أنتجت سنوات طويلة من الحرمان والتجويع حالة من الانسداد الاجتماعي، جعلت المجتمع الغزّي نفسه أكثر تقبّلاً لخيار المواجهة الشاملة باعتباره المخرج الوحيد. في هذا السياق، تقول سورات: «ما جرى في 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يكن قراراً تنظيمياً فقط، بل كان أيضاً انعكاساً لحالة اجتماعية ممتدة»؛ أي أنه كان صرخة مجتمع بأكمله في وجه الحصار.
من الجهة المقابلة، تأتي دراسة أميلي فيري لتضعنا أمام أثر الحدث على الداخل الإسرائيلي. المجتمع الذي طالما قدّم نفسه ككيان متماسك تحميه قوة عسكرية لا تقهر، وجد نفسه فجأة أمام صدمة وجودية. تصف فيري ما حدث بالقول: «لقد فجّرت العملية شعوراً جماعياً بالهشاشة، وأعادت طرح سؤال جوهري عن العقد الاجتماعي الذي يجمع الدولة بمواطنيها». فالهجوم لم يكن مجرّد خرق أمني، بل فضح عجز المنظومة الأمنية بكاملها عن توفير الحماية التي بُنيت عليها شرعية الدولة منذ نشأتها.
تكشف فيري أن الحرب لم تُلغِ الانقسامات التي سبقت 7 تشرين الأول/أكتوبر بل عمّقتها. فالمجتمع الإسرائيلي كان يعيش على وقع احتجاجات حاشدة ضد سياسات حكومة نتنياهو، وخلافات عميقة على إصلاح القضاء. ومع اندلاع الحرب، «لم تختف هذه التصدّعات بل أخذت أشكالاً جديدة»، إذ تحوّل الخطاب الأمني إلى أداة مؤقتة لتوحيد الصفوف، لكنه في العمق كشف الصراعات الكامنة على طبيعة الدولة ومشروعها.
الحدث لم يكن بداية حرب جديدة فقط، بل كشفاً عن استحالة استمرار الوضع القائم، وولادة طور جديد من الصراع ستتردد أصداؤه طويلاً في المنطقة بأسرها
إلى جانب ذلك، غذّت الحرب نزعة قومية متطرفة، إذ ارتفعت أصوات تطالب بـ«توسيع العمليات حتى لو كان الثمن إبادة جماعية». تشير فيري هنا إلى أن هذا الخطاب ليس جديداً، بل «امتداد لسردية استعمارية متجذّرة»، لكن الحرب منحته مشروعية متجدّدة وجعلته خطاباً مهيمناً في المجال العام. النتيجة أن الفلسطيني لم يعد يُقدَّم كخصم سياسي أو عسكري، بل كتهديد وجودي يبرّر كل أشكال العنف.
وتضيف فيري أن أثر الحرب امتد إلى الحياة اليومية ذاتها: «حالة الطوارئ تغلغلت في تفاصيل البيت والعمل والمدرسة، حتى أصبح الخوف جزءاً من الروتين اليومي». هذا التحول جعل الجيش ليس مجرد مؤسسة عسكرية، بل منظماً للزمن الاجتماعي، حاضراً في كل تفاصيل الحياة.
الجمع بين هذين المنظورين يقدّم صورة بانورامية: في غزة، تتويج لعقد من التحولات الداخلية والانسداد الاجتماعي انتهى إلى انفجار مقاوم؛ وفي إسرائيل، صدمة وجودية فجّرت تناقضات داخلية ووضعت المشروع الاستعماري أمام مرآة هشاشته. كلا المجتمعين عاش لحظة مفصلية، لكن بمعنيين متعاكسين: الفلسطينيون أعلنوا عبرها رفض الاستسلام، فيما الإسرائيليون اكتشفوا أن تفوقهم العسكري لا يحميهم من الانكشاف.
الأهم أن هذه اللحظة دشّنت طوراً جديداً من الصراع. فهي من ناحية امتداد لمسار طويل من المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، ومن ناحية أخرى دشّنت نمطاً جديداً من الحرب يتميز بشموليته واتساع رقعته الجغرافية. وكما تقول سورات: «إنها ليست محطة عابرة، بل نقطة انعطاف ستعيد تشكيل مسارات الصراع لسنوات قادمة».
أما بالنسبة إلى إسرائيل، فلم تعد الحرب اختباراً للآلة العسكرية فقط، بل أيضاً «اختباراً للتماسك الاجتماعي والقدرة على الاستمرار في مشروع استعماري يزداد كلفة وتعقيداً» على حد تعبير فيري. فإذا كان الخطاب الأمني يوحّد في الظاهر، يكشف الواقع هشاشة عميقة تجعل أي ترميم هشّاً ومؤقتاً.
في النهاية، ما يقدّمه هذان الفصلان ليس مجرد تحليل سياسي أو عسكري، بل رؤية مركّبة تعيد تعريف 7 تشرين الأول/أكتوبر كلحظة تاريخية مزدوجة: لحظة تأكيد على استمرارية المقاومة وتجذّرها في غزة، ولحظة انكشاف داخلي لمجتمع استعماري يواجه أزماته الخاصة. ومن هذا المنظور، يمكن القول إن الحدث لم يكن بداية حرب جديدة فقط، بل كشفاً عن استحالة استمرار الوضع القائم، وولادة طور جديد من الصراع ستتردد أصداؤه طويلاً في المنطقة بأسرها.
الفلسطينيون بين طوفان الأقصى وأزمة الشرعية: هوية ممزقة ومشهد سياسي مأزوم
تبدو لحظة 7 تشرين الأول/أكتوبر وما تلاها من حرب شاملة على غزة نقطة انكسار حقيقية للفلسطينيين أينما وُجدوا، لكن أثرها كان بالغاً بوجه خاص على مكوّنين مترابطين: الفلسطينيون في الداخل (أراضي 48) الذين وجدوا أنفسهم مجدداً أمام حدود مواطنتهم المنقوصة، والطبقة السياسية الفلسطينية التي انكشفت أزمتها البنيوية في مشهد من الانقسام والضعف. يكشف الجمع بين هذين البعدين أن الحدث لم يكن مجرد مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل، بل لحظة أعادت إنتاج سؤال الهوية والشرعية في آن واحد.
يقرأ أنطوان شلحاط موقع الفلسطينيين في الداخل في ضوء هذه اللحظة المفصلية. هؤلاء الذين يعيشون في دولة تُعرّف نفسها كيهودية، وفي الوقت ذاته ينتمون إلى شعب يرزح تحت الاحتلال، وجدوا أنفسهم بعد «طوفان الأقصى» في قلب التوتر بين الولاء المفروض والانتماء الطبيعي. فقد تلقوا الحدث بتعاطف عميق مع غزة، بوصفها جزءاً من ذاكرتهم الجماعية وتجربتهم التاريخية مع التمييز والإقصاء. غير أن هذا الموقف وُجِه برد فعل إسرائيلي عنيف: أي تعبير عن التضامن جرى اعتباره «تهديداً أمنياً»، وأي نقد للجيش صُوِّر كخيانة. والنتيجة كانت موجة من الاعتقالات والملاحقات، خصوصاً في المدن المختلطة، أعادت إلى السطح هشاشة «المواطنة» التي لا تحمي أصحابها متى عبّروا عن انتمائهم الحقيقي.
بهذا المعنى، أكدت الحرب أن الفلسطينيين في الداخل يعيشون فضاء سياسياً مأزوماً، حيث تُفرض عليهم معادلة مستحيلة: إما صمت يضمن بقاءهم ضمن حدود «المقبول»، أو تضامن يعرّضهم للملاحقة والنبذ. والأخطر أن الخطاب الإسرائيلي الرسمي، مدعوماً بالإعلام، وضعهم في خانة «المشتبه بهم الدائمين»، فصار كل فلسطيني داخل الخط الأخضر متهماً محتملاً بمجرد إظهار التعاطف مع غزة. هكذا تُستعاد آليات الإقصاء الاستعماري القديمة معزّزة بمفردات «الأمن القومي» و«مكافحة الإرهاب».
لكن ما تكشفه هذه اللحظة أيضاً هو أن الهوية الفلسطينية في الداخل لم تُمحَ على الرغم من الضغوط. فقد استمرت أشكال التضامن، ولو في دوائر صغيرة أو سرية، وظهرت محاولات لربط مأساة غزة بقضايا محلية مثل الأرض والمسكن والتعليم والعمل. يؤكد هذا التوازي أن الانتماء الوطني لا يزال أقوى من سياسات التفكيك، وأن الفلسطينيين في الداخل – على الرغم من تمزّقهم بين مواطنة شكلية وانتماء جوهري – لا يزالون جزءاً حياً من القضية الأم.
القضية الفلسطينية برمتها في لحظة حرجة تستدعي إعادة التفكير في أشكال المقاومة والمعنى العميق للشرعية
من زاوية أخرى، يسلّط ماهر الشريف الضوء على انعكاسات هذه اللحظة على البنية السياسية الفلسطينية الأوسع. فقبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، كان المشهد السياسي في حالة ركود: سلطة وطنية محدودة الصلاحيات في الضفة الغربية، حركة حماس محاصرة لكنها مسيطرة في غزة، وانقسام جغرافي وسياسي أفقد الفلسطينيين مشروعهم الوطني الجامع. المفاوضات مجمدة منذ سنوات، شرعية المؤسسات الرسمية متآكلة، والجمهور الفلسطيني فقد ثقته بقيادة لم تستطع مواجهة الاستيطان أو العدوان.
جاءت عملية «طوفان الأقصى» لتقلب الطاولة على هذا المشهد. فهي من جهة أكدت قدرة المقاومة المسلحة على قلب المعادلات وإعادة فرض القضية على جدول الأعمال العالمي، لكنها من جهة أخرى كشفت هشاشة الخيارات الأخرى. طرحت الحرب سؤالاً وجودياً: من يمثل الفلسطينيين اليوم؟ السلطة الوطنية التي فقدت وزنها السياسي وأصبحت رهينة لاتفاقيات أوسلو التي فقدت صلاحيتها؟ أم حماس التي برزت كفاعل رئيس ميدانياً لكنها تبقى مثيرة للجدل داخلياً وإقليمياً؟
يرى الشريف أن هذه الحرب أعادت إحياء خطاب المقاومة على حساب خطاب التسوية، وأضعفت أكثر من أي وقت مضى حجج الواقعية السياسية التي تراهن على المفاوضات. لكن في الوقت ذاته، عمّقت الانقسامات: بين الضفة الغربية وغزة، بين الفصائل، وبين من يراهن على البعد الدولي ومن يصرّ على المقاومة الميدانية. النتيجة أن الفلسطينيين دخلوا لحظة اختبار مزدوج: اختبار الصمود العسكري والاجتماعي، واختبار القدرة على إنتاج مشروع سياسي جامع يعيد بناء الشرعية على أسس جديدة.
وإذا كان الفلسطينيون في الداخل يواجهون خطر المحو الرمزي عبر تحويلهم إلى «مواطنين مشتبه بهم»، يواجه الفلسطينيين في النظام السياسي خطر المحو السياسي عبر تآكل الشرعية وانعدام البديل. ويكشف كلاهما وجهاً من وجوه الاستعمار: نزع الاعتراف بالهوية، أو نزع الاعتراف بالتمثيل. وبين الاثنين، يظهر أن القضية الفلسطينية برمتها في لحظة حرجة تستدعي إعادة التفكير في أشكال المقاومة والمعنى العميق للشرعية.
يقدّم الجمع بين تحليل شلحاط والشريف لوحة متكاملة: من جهة، جماعة فلسطينية داخل إسرائيل تعيش تمزّق الهوية ومحدودية المواطنة؛ ومن جهة أخرى، مشهد سياسي فلسطيني أوسع يعاني أزمة شرعية وغياب مشروع جامع. وفي العمق، كلاهما يواجه الوجه نفسه للمشروع الاستعماري الذي يسعى إلى إضعاف الفلسطيني في كل مكان: بالحصار والقتل في غزة، بالإقصاء الرمزي في الداخل، وبالتفكك السياسي في الساحة الوطنية.
تبيّن هذه القراءة أن 7 تشرين الأول/أكتوبر لم يكن مجرد شرارة حرب جديدة، بل مرآة كشفت التصدعات في البنية السياسية والاجتماعية على الجانبين: مجتمع استعماري مأزوم يرد بعنف شامل، ومجتمع فلسطيني ممزق يبحث عن أدوات جديدة للبقاء والمقاومة. إنها لحظة تاريخية تعيد طرح السؤال المؤجل: كيف يمكن لشعب يعيش بين الحصار والتمييز والانقسام أن يعيد بناء مشروعه الوطني ويصوغ هويته الجماعية في مواجهة مشروع استعماري لم يتوقف يوماً عن محاولات محوه؟
غزة بين قتل المستقبل والإبادات المركبة
يضيء الكتاب من خلال مساهمتي ستيفاني لاتّي عبدالله وأباهر السقا على الأبعاد الأعمق للحرب على غزة، بما يتجاوز توصيفها كعدوان عسكري دموي، ليكشف عن استراتيجيات استعمارية تهدف إلى محو المجتمع الفلسطيني في أبعاده المختلفة: الزمن، المكان، السكان، والوجود ذاته. الجمع بين مفهوم «قتل المستقبل» (futuricide) وتحليل «الإبادات المتعددة» يمنحنا رؤية شاملة لفهم كيف تتحوّل الحرب إلى أداة لإلغاء أفق جماعي بأكمله.
تبدأ لاتّي عبدالله من زاوية الزمن. فالحرب، كما تقول، لا تستهدف الحاضر فقط بل «تسعى إلى تدمير إمكانية المستقبل للفلسطينيين»؛ إنها لا تقتل الجسد وحده، بل تقتل القدرة على التخيل. تشير الباحثة إلى أن الاستعمار الإسرائيلي لم يعد يكتفي بالسيطرة على الأرض والسكان، بل أصبح يوجّه حربه نحو الزمن ذاته: «حين تُدمَّر المدارس والجامعات وتُمحى فضاءات الإبداع، يصبح الهدف تجريد المجتمع من حقه في أن يحلم بمستقبل» (ص. 112).
الاستعمار الإسرائيلي لم يعد يكتفي بالسيطرة على الأرض والسكان، بل أصبح يوجّه حربه نحو الزمن ذاته: «حين تُدمَّر المدارس والجامعات وتُمحى فضاءات الإبداع، يصبح الهدف تجريد المجتمع من حقه في أن يحلم بمستقبل»
الأمثلة التي تستحضرها صارخة: استهداف المؤسسات التعليمية، تدمير المشاريع الصغيرة، تهجير مئات الآلاف من العائلات، وتحويل المخيمات المؤقتة إلى فضاءات انتظار للموت أكثر منها للحياة. وبذلك، يصبح «الدمار ليس نتيجة جانبية للحرب بل جزءاً من استراتيجيتها» (ص. 118). فالطفل الذي يُحرم من التعليم، والشاب الذي يُقصى من العمل، والفنان الذي يُحرم من فضاء للتعبير، جميعهم يتحولون إلى أسرى حاضر دائم بلا أفق. هذا ما تسميه الكاتبة «الفيوتوريسايد»: قتل المستقبل بوصفه سياسة استعمارية.
لكن في المقابل، تلاحظ لاتّي عبدالله أن المقاومة هنا تأخذ شكلاً معرفياً ورمزياً: مبادرات تعليمية بديلة، محاولات للحفاظ على الذاكرة، والإصرار على الاستمرار اليومي على الرغم من الخراب. «إن الدفاع عن المستقبل حق أساسي، تماماً كالدفاع عن الأرض» (ص. 125).
من جهته، يقدّم أباهر السقا قراءة مكمّلة، لكنه ينطلق من المكان والسكان. فهو يرى أن ما يحدث في غزة هو مشروع إبادة مركّب يتوزع على 3 مستويات: إبادة حضرية، إبادة ديموغرافية، وإبادة جماعية.
أولاً، «الإبادة الحضرية» (urbicide): تدمير المدينة بما هي فضاء للذاكرة الجماعية والهوية. حين تتحول أحياء كاملة إلى أنقاض، فإن ما يُمحى ليس الحجر فقط، بل أيضاً «النسيج الاجتماعي الذي يجعل من المكان فضاءً للانتماء» (ص. 147). استهداف البنية التحتية للمدن – من الأحياء السكنية إلى المراكز الاقتصادية والثقافية – ليس عرضياً، بل جزء من إستراتيجية تهدف إلى محو إمكانية إعادة البناء الوطني.
ثانياً، «الإبادة الديموغرافية» (démocide): التهجير الجماعي للسكان وقتل المدنيين بشكل ممنهج. الحرب الأخيرة، كما يوضح السقا، أدّت إلى نزوح ملايين الفلسطينيين في غزة، كثير منهم اضطروا للتنقل أكثر من مرة في بضعة أشهر. «إنها إعادة إنتاج للنكبة بوسائل جديدة» (ص. 155). هذا التهجير ليس مجرد نتيجة للحرب بل سياسة مقصودة ترى في الوجود الفلسطيني «خطراً ديموغرافياً» يجب تفكيكه.
ثالثاً، «الإبادة الجماعية» (génocide): الاستهداف المباشر والواسع للمدنيين عبر القصف العشوائي، منع الغذاء والدواء، وضرب المستشفيات والمراكز الصحية. هذه الأفعال، بحسب السقا، ترقى إلى سياسة «تهدف إلى القضاء على جماعة وطنية بأكملها» (ص. 163). فالقتل لا يستهدف المقاتلين وحدهم، بل كل المجتمع: النساء، الأطفال، كبار السن، وحتى المرضى في المستشفيات.
يضيف الباحث بعداً آخر بالغ الأهمية: الخطاب. فقبل أن يُمارَس العنف المادي، يُنتَج خطاب يُجرّد الفلسطيني من إنسانيته. «حين يُصوَّر الفلسطيني كحيوان أو كخطر وجودي، يصبح قتله أمراً مقبولاً في المخيال العام» (ص. 169). هذا العنف الرمزي هو الذي يشرعن العنف المادي، ويجعله ممكناً أمام جمهور داخلي ودولي.
وعلى الرغم من كل ذلك، يلاحظ السقا أن المجتمع الفلسطيني يواصل ممارسة أشكال المقاومة اليومية: من إعادة بناء البيوت المهدّمة إلى تنظيم مبادرات مجتمعية في ظروف الحصار. «إن التمسك بالحياة في ظل الموت هو بحد ذاته فعل مقاومة» (ص. 175).
إذا جمعنا بين القراءتين، ندرك أن المشروع الاستعماري يعمل في اتجاهين متوازيين: محو المستقبل عبر تعطيل إمكانيات الأمل (لاتّي عبدالله)، ومحو الحاضر عبر تدمير المدينة والسكان (السقا). لكن في مواجهة ذلك، ينهض الفلسطيني بمقاومتين متكاملتين: مقاومة البقاء الجسدي على الرغم من محاولات الإبادة، ومقاومة الحفاظ على الأمل والمعنى على الرغم من محاولة قتل المستقبل.
بهذا، يصبح الصراع في غزة أكثر من حرب عسكرية: إنه صراع على الزمن والمكان، على الذاكرة والأفق، على الحق في أن يكون للفلسطينيين مستقبل. تسعى الحرب إلى تحويل غزة إلى فضاء بلا مدينة، بلا سكان، وبلا حلم، لكن الفلسطينيين يواجهونها بإصرار على البقاء وعلى إعادة إنتاج الحياة والمعنى.
الاقتصاد الفلسطيني بين الاستعمار والإبادة: من الهيمنة البنيوية إلى التدمير الشامل
ينطلق طاهر لبدي في تحليله من فكرة محورية مفادها أن الاقتصاد الفلسطيني لم يكن يوماً معزولاً عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي، بل كان دوماً ساحة رئيسة للهيمنة والسيطرة. غير أن ما جرى في غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر أظهر انتقال هذه السيطرة من شكلها البنيوي – القائم على التحكم في الموارد والمعابر وحركة التجارة – إلى منطق إبادة اقتصادية شامل يهدف إلى شلّ كل إمكانية لنشوء حياة اقتصادية مستقلة.
يبيّن الكاتب أن الاقتصاد الفلسطيني قبل الحرب كان خاضعاً لشبكة معقّدة من التبعية: فإسرائيل تتحكم في المعابر والحدود، وتفرض شروطاً خانقة على الاستيراد والتصدير، وتحتكر عوائد الضرائب والجمارك. وبهذا تحوّل الاقتصاد الفلسطيني إلى «اقتصاد مقيد» لا يستطيع النمو إلا ضمن الحدود التي يرسمها الاحتلال. هذا الوضع جعل المجتمع الفلسطيني هشاً أمام أي صدمة، وهو ما استُغلّ بعد الحرب لتحويل الهشاشة إلى انهيار.
إذا كانت الحرب العسكرية تهدف إلى محو الأجساد والمكان، فإن الحرب الاقتصادية تهدف إلى محو القدرة على الحياة المستقلة
يصف لبدي ما حصل في غزة بأنه عملية «إبادة اقتصادية». فقد استُهدفت المصانع والمنشآت التجارية، ودُمّرت البنية التحتية التي تسمح بالعمل والإنتاج، من كهرباء ومياه واتصالات. حتى المشاريع الصغيرة، التي كانت تمثل مصدر رزق لعائلات كثيرة، لم تسلم من الدمار. هذا التدمير الشامل حوّل غزة إلى فضاء معطّل اقتصادياً، حيث لم يعد ممكناً الحديث عن دورة إنتاج طبيعية، بل عن صراع يومي من أجل البقاء.
لكن الأهم أن الباحث يربط هذا التدمير بمنطق استعماري ممتد. فالمشروع الاستيطاني، كما يرى، لم يكتف تاريخياً بنزع الأرض والسيطرة على الموارد، بل سعى أيضاً إلى خلق تبعية اقتصادية تجعل الفلسطينيين عاجزين عن الاستقلال. مثّلت الحرب الأخيرة، في نظره، المرحلة القصوى من هذا المنطق: من اقتصاد تابع إلى اقتصاد مدمَّر، بحيث يصبح المجتمع الفلسطيني مرتهناً بالكامل للمساعدات الإنسانية والهيمنة الإسرائيلية.
ويشير لبدي كذلك إلى البعد الرمزي لهذا التدمير. فالاقتصاد ليس مجرد أرقام أو مؤسسات، بل هو أيضاً تعبير عن القدرة على التنظيم الذاتي والإبداع الاجتماعي. عندما يُدمَّر الاقتصاد، يُرسَل أيضاً خطاب ضمني: أن الفلسطينيين غير قادرين على بناء حياة مستقلة. هذا الخطاب يعزز منطق الاستعمار الذي يسعى إلى نزع الشرعية عن الوجود الوطني.
مع ذلك، يلاحظ الكاتب أن الفلسطينيين يواصلون أشكالاً متعددة من المقاومة الاقتصادية. فحتى في أصعب الظروف، ظهرت مبادرات لإعادة تدوير الموارد، ولخلق شبكات تضامن محلية، وللاستمرار في بعض أشكال التجارة على الرغم من الحصار. هذه المبادرات، على الرغم من محدوديتها، تعبّر عن إرادة الصمود، وعن رفض الانصياع لمنطق الإبادة الذي يسعى إلى تحويل المجتمع إلى مجرد متلقٍ سلبي للمساعدات.
بهذا يقدّم لبدي قراءة تجعل من الاقتصاد مرآة للصراع الأوسع. فإذا كانت الحرب العسكرية تهدف إلى محو الأجساد والمكان، فإن الحرب الاقتصادية تهدف إلى محو القدرة على الحياة المستقلة. لكن كما في الأبعاد الأخرى، يظل المجتمع الفلسطيني يقاوم، مثبتاً أن الاقتصاد، حتى في لحظات الانهيار، يمكن أن يكون مجالاً لإعادة إنتاج الصمود.
الإبادة الثقافية في غزة: حين تستهدف الحرب المخيلة والذاكرة
تذهب ماريون سلتين في هذا الفصل إلى بُعد آخر للحرب، غالباً ما يُهمَّش أمام صور الدمار المادي والضحايا: البعد الثقافي. فهي ترى أن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بأنه تدمير للبنى التحتية أو استهداف للأجساد فقط، بل هو أيضاً عملية «إبادة ثقافية» تسعى إلى محو المخيلة الجمعية للفلسطينيين وتدمير إمكانياتهم في إنتاج الفن والتعبير والإبداع.
تشير الكاتبة إلى أن استهداف المراكز الثقافية والفنية، ودور النشر، وحتى المسارح الصغيرة، ليس أمراً عرضياً. فالثقافة في غزة كانت دوماً فضاءً للمقاومة الرمزية، حيث يجد الفنانون والمبدعون طرقاً لتحويل المعاناة إلى لغة جمالية تحمل رسالة سياسية. وعندما تُدمَّر هذه الفضاءات، يُوجَّه ضرب مباشر إلى قدرة المجتمع على صياغة روايته الخاصة. فالاستعمار لا يريد السيطرة على الأرض فقط، بل أيضاً على السردية، أي على الحق في رواية التاريخ.
الحرب أداة لتجفيف المخيلة، ولإبقاء الفلسطيني محصوراً في صورة الضحية التي ينتجها الآخر، بدل أن يكون فاعلاً في إنتاج معناه
تلفت سلتين الانتباه إلى شهادات فنانين غزيين فقدوا أعمالهم أو اضطروا إلى ترك أدواتهم تحت الركام. هؤلاء يرون في الدمار رسالة واضحة: أن الفن، بما يحمله من إمكانات لتخيل مستقبل مختلف، يُعتبر خطراً يجب محوه. تقول الكاتبة إن «ما يفعله القصف ليس إسكات الأجساد فقط، بل إسكات الأصوات التي تحلم وتبدع». وبذلك، تصبح الحرب أداة لتجفيف المخيلة، ولإبقاء الفلسطيني محصوراً في صورة الضحية التي ينتجها الآخر، بدل أن يكون فاعلاً في إنتاج معناه.
غير أن النص لا يقف عند حدود التشخيص. فهو يُظهر أيضاً أن الفلسطينيين، على الرغم من هذا التدمير، يواصلون المقاومة عبر الثقافة. فهناك مبادرات لإقامة معارض فنية في المخيمات المؤقتة، ومحاولات لتوثيق التجربة عبر الرسم والموسيقى والأدب. هذه الأفعال، وإن بدت صغيرة أمام هول المأساة، تحمل قيمة كبرى: إنها تؤكد أن المخيلة لا يمكن محوها بالقصف، وأن الفن يظل مساحة للكرامة الإنسانية.
تربط سلتين هذا البعد بقراءات أنثروبولوجية عن «الحق في الثقافة» كجزء لا يتجزأ من الحق في الوجود. فالإبادة الثقافية، كما ترى، ليست فقط تدميراً للرموز، بل نفياً لحق جماعة بشرية في أن تحلم وأن تروي قصتها. في هذا المعنى، يصبح استهداف الفنانين والمثقفين في غزة جزءاً من مشروع أشمل لإلغاء المجتمع الفلسطيني من الخريطة السياسية والرمزية معاً.
بهذا يقدم الفصل صورة مكمّلة لما سبقه: إذا كان الحديث عن الإبادة الحضرية والديموغرافية والاقتصادية قد أظهر كيف يُستهدف الجسد والمكان، تكشف الإبادة الثقافية استهداف الذاكرة والمخيلة. فهي بُعد لا يقل خطورة، لأن من دون ذاكرة ولا فن ولا سردية، يصبح من السهل إعادة كتابة التاريخ من قبل المستعمِر وحده.
إيكولوجيا الحصار: زراعة الحياة تحت النكبة
يركز هذا الفصل على جانب قد يبدو ثانوياً وسط أصوات القصف والدمار، لكنه في الحقيقة يكشف بعمق معنى الصمود الفلسطيني: الحياة اليومية وكيفية إنتاجها على الرغم من الاستهداف المستمر. ينظر منى دجاني وعمر جباري سلامنكا إلى الحصار لا باعتباره أداة عسكرية لإخضاع غزة فقط، بل بيئة كاملة تعيد تشكيل علاقة الناس بالطبيعة وبأشكال العيش في ما يشبه «إيكولوجيا الحصار».
يشير الباحثان إلى أن الحياة في غزة منذ سنوات طويلة تُبنى على اقتصاد البقاء. فالمزارعون الذين حُرموا من الوصول إلى أراضيهم الواسعة القريبة من الحدود، لجؤوا إلى ابتكار طرق جديدة للزراعة في مساحات ضيقة، وحتى على أسطح البيوت. النساء في الأحياء المحاصرة طورن أساليب لإعادة تدوير الموارد المحدودة وتحويلها إلى غذاء. بهذه الممارسات الصغيرة، يصبح الحصار مجالاً لإنتاج أشكال جديدة من المعرفة البيئية والمجتمعية.
الحياة في غزة منذ سنوات طويلة تُبنى على اقتصاد البقاء
يذهب النص إلى أن هذه الممارسات ليست مجرد تكيّف مع الوضع، بل هي شكل من أشكال المقاومة. فالاستعمار يريد أن يحصر الفلسطيني في صورة «الضحية التي تنتظر المساعدة الإنسانية»، لكن الفلسطيني يقلب المعادلة عبر الاستمرار في الزراعة، الطهي، التعليم، وإعادة الإنتاج اليومي للحياة. يقول الكاتبان بوضوح: «كل عمل يومي ينجز في غزة – زرع نبتة، خبز رغيف، تدريس درس – هو فعل سياسي بامتياز». إنه إعلان أن الحياة لا يمكن محوها حتى في ظروف الموت.
تتوقف الدراسة عند أمثلة ملموسة: مشاريع الزراعة المجتمعية في المخيمات، المبادرات النسائية لإنتاج الغذاء المحلي، محاولات الشباب لإيجاد بدائل للطاقة. تكشف هذه الأمثلة عن قدرة الفلسطينيين على إعادة ابتكار الحياة في ظروف يائسة، وهي تؤكد أن «المقاومة ليست في الميدان العسكري فقط، بل أيضاً في تفاصيل اليومي التي تحافظ على الوجود».
كما يربط الباحثان هذه الظواهر بمفهوم «النكبة المستمرة». فالحصار والحروب المتكررة أعادت إنتاج التهجير والاقتلاع بشكل دائم، لكن الفلسطينيين طوروا في المقابل أشكالاً من التعايش مع الكارثة، أو بالأحرى، أشكالاً من إعادة زرع الحياة وسط الركام. إنهم لا يعيشون النكبة كذكرى ماضية فقط، بل كواقع يومي، وفي مواجهة ذلك يُصرّون على إبقاء جذورهم في الأرض وعلى حماية بذور المستقبل.
بهذا، يضيف الفصل بعداً جديداً للكتاب: الحرب ليست مجرد مشهد دمار، بل هي أيضاً سياق تُصنع فيه الحياة بوسائل بديلة. والحديث عن «إيكولوجيا الحصار» يذكّر القارئ أن غزة ليست فقط فضاءً للموت، بل أيضاً مختبراً للإبداع الاجتماعي والبيئي، حيث يتحول البقاء نفسه إلى شكل من أشكال المقاومة.
غزة كمرآةٍ إقليمية: تداخل الذاكرة والسياسة والقانون
يُظهر تتبّع صدى حرب غزة في محيطها القريب والبعيد أنّ ما يجري ليس حدثاً محلياً معزولاً، بل ظاهرة إقليمية وعالمية تتقاطع فيها الذاكرة والمعيش اليومي، وحسابات الحدود والطاقة، والمعركة على السردية والشرعية القانونية. فمن بيروت إلى عمّان، ومن القاهرة إلى عواصم الخليج، وصولاً إلى غرف الأخبار في باريس ومنابر القضاء الدولي، تتشكّل شبكة كثيفة من الاستجابات تكشف طبيعة العنف الاستعماري وقدرته على إعادة ترتيب السياسات والوجدانات معاً. في بيروت، تقرأ إرمينيا كيّارا كالابريزي صور غزة بوصفها استعادة لخبرة لبنانية طويلة مع الاجتياحات والحصارات: ذاكرة حرب تموز 2006 وأطياف حصار بيروت تتسرّب إلى الوعي الحاضر، فيولد تعاطف يتجاوز حدود «النصرة» الأخلاقية إلى إدراك بنيوي بأن الاستعمار الاستيطاني ليس مشكلة فلسطينية فحسب، بل تهديد لبنية المشرق برمّته. ومع هذا التعاطف تظهر تباينات سياسية داخل لبنان عن معنى المقاومة وموقعها من توازنات الداخل والإقليم، فتغدو غزة مُحدِّداً جديداً لاصطفافات محلية: فريق يرى في دعمها واجباً وامتداداً لسيادة وطنية مقاومة، وآخر يخشى تداعيات إقليمية تخلّ بالتوازن الداخلي. هكذا تتحوّل غزة إلى مرآةٍ لبيروت: تكثّف ذاكرة الحرب، وتعيد توزيع الخريطة السياسية، وتضع المجتمع أمام سؤال القدرة على تحمّل كلفة التضامن حين يغدو خياراً سياسياً لا شعوراً وجدانياً فحسب.
وعلى مسافة جغرافية قريبة، تبرهن ملاحظة كريستين جونغن لظاهرة «التعاطف عن بُعد» في عمّان أن الحرب لا تقع في الميدان فقط، بل أيضاً في صالونات البيوت. المتابعة اليومية عبر الشاشات لا تُنتج معرفة فحسب، بل تُبلور وجداناً متوتّراً يراوح بين العجز والواجب، يتحوّل إلى سلوك سياسي ملموس: تبرعات، مظاهرات، وإعادة إنتاج للسردية على المنصّات. هنا يتجاوز التضامن منطق الحدث إلى تشكيل هوية جماعية؛ فغزة تُرى كجزء من الذات العربية، لا «خبراً خارجياً». وهذه الوساطة الوجدانية – الإعلام الاجتماعي كقناة تواصل مباشر مع الألم – تخلخل قدرة الإعلام التقليدي على احتكار المعنى، وتدفع نحو تعميم قصص الضحايا ونقلها من هامش «الإنساني» إلى مركز «السياسي».
من بوابة الحدود، تكشف ديمة السجدية كيف تُدار غزة من القاهرة ببراغماتية دقيقة تجمع الاحتواء والردع. فمصر، بحكم الجغرافيا وسيناريوهات الانفجار الإنساني والأمني، تمارس «إدارة وقائية»: فتحٌ محسوب لمعبر رفح، ووساطة لا غنى عنها، وضبط يوازن بين ضغط الرأي العام العربي والالتزامات الأمنية مع واشنطن ومقتضيات العلاقة المعقّدة مع تل أبيب. تصبح الحدود أداة سيادية وسياسية في آنٍ: قناة مرور للمساعدات، ورافعة نفوذ إقليمي، ووسيلة ضغط قابلة للترجمة في ملفات أخرى (سيناء، الغاز، الإعمار). يقرأ الفلسطينيون في غزة هذا الدور بعينين: نافذة الأمل الوحيدة إلى العالم، ورمزاً مستمراً لتكريس الإغلاق. والنتيجة أن معادلة غزة-مصر تبقى محكومة بمعنى الحدود: ليست خطاً جغرافياً، بل جهازاً لإدارة الخطر وتسييل رأس مال سياسي.
في الخليج، كما توضّح فاطمة دازي-هيني، تُظهر الحرب حدود الجمع بين 3 معادلات: تضامن شعبي مرتفع وحساسيات دبلوماسية مع الحليف الأميركي، ومصالح طاقة تتأثر بأي اتساع للصراع شمالاً أو على خطوط الملاحة جنوباً، ومشاريع تطبيع لم تعد «تكلفة صفرية» أمام الرأي العام. تتحرّك العواصم الخليجية على حبل مشدود: خطاب رسمي نحو التهدئة وحلّ الدولتين، مع الحفاظ على قنوات التطبيع في بعض الحالات؛ وتريّثٌ محسوب في ظل تنافس سعودي–إيراني يتخذ من غزة مرآةً لا ساحة مواجهة مباشرة. هنا تؤكد غزة أنها «مؤشّر نظامي»: فاهتزازها الصغير ينعكس على تسعير النفط، وعلى مزاج الأسواق، وعلى اشتباك السرديات داخل الفضاء العام الخليجي.
أما في باريس، فيكشف توماس فاسكوفي كيف يشتغل الإعلام كآلة تعريف وتبرير. الانطلاق من صدمة 7 تشرين الأول/أكتوبر أنتج انحيازاً أولياً لصورة إسرائيل الضحية، وجرى تجريد المقاومة من سياقها الاستعماري. لكن «هوامش» إعلامية ومنصّات رقمية دؤوبة نجحت في كسر احتكار الرواية، مظهرة التفاوت بين صورة «الأمن ضد الإرهاب» وواقع الإبادة الممنهجة. المعركة هنا ليست على الوقائع بل على لغتها: هل غزة «حرباً» أم «مجزرة»، هل الفلسطيني «فاعلاً سياسياً» أم «موضوعاً أمنياً»؟ كل توصيف يفتح ويغلق إمكانات الفعل: الاحتجاج في الشارع، المقاطعة الأكاديمية، أو حتى مجرد حقّ الكلام في فضاء يتضخّم فيه الاتهام الجاهز بـ«معاداة السامية» لتكميم أي مساءلة للسياسات الإسرائيلية.
في هذا التقاطع الكثيف، تتحدد إمكانات ما بعد الحرب: ليس بوقف النار وحده، بل بقدرة المنطقة والعالم على إعادة تعريف معنى العدالة والسيادة والذاكرة في وجه مشروعٍ يريد تحويل فلسطين إلى هامشٍ أبدي
ولأن السردية تشتبك بالقانون، يعيد جوني عاصي ويوهان صوفي وضع العدالة الدولية تحت المجهر. لجوء جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية أعاد تسمية ما يجري: من «حرب على الإرهاب» إلى شبهة «إبادة جماعية». هذا التحوّل اللغوي ليس تفصيلاً؛ إنه يبدّل خرائط التضامن ويمدّ الحركات المدنية بأداة رمزية صلبة. غير أنّ فجوة المبدأ والتطبيق تظل واسعة: اختصاصات المحكمة الجنائية قائمة نظرياً، لكن إرادة التنفيذ رهينة قوة الدول الكبرى وعدم اعتراف إسرائيل. لذا تنعطف الوظيفة القانونية نحو تراكمٍ توثيقي بطيء: تقارير أممية، لجان تحقيق، قرارات رمزية تشكّل أرشيفاً أخلاقياً يُقوّض شرعية الاحتلال على المدى الطويل حتى إن عجز عن وقف القصف غداً. العدالة هنا «بطيئة»، لكنها تُنتج أثراً تراكمياً: مقاطعات، محاكم رأي، ومساءلة تاريخية تكتب سردية مضادة لتبييض الاستعمار.
ما الذي يجمع هذه الخيوط؟ أولاً، تعميم التجربة: غزة لا تُفهم إلا كحدث عابر للحدود يحرّك ذاكرة بيروت، ويعيد صياغة انفعالات عمّان، ويختبر سياسات القاهرة والخليج، ويعري الإعلام الفرنسي، ويمتحن جدوى المنظومة القانونية الدولية. ثانياً، وحدة الحقول: العسكري والإنساني والاقتصادي والرمزي والقانوني ليست مسارح منفصلة، بل دوائر متداخلة؛ فمن معبر رفح إلى أسعار النفط، ومن هاشتاغات عمّان إلى قاعات لاهاي، يشتغل «النظام الغزّاوي» كمصفاة تكشف أين تقف الدول والمجتمعات والإعلام من سؤال الاستعمار. ثالثاً، مركزية اللغة: من يملك حق التسمية يمتلك إمكان الفعل؛ ولذلك تدور المعركة على الكلمات بقدر ما تدور على الأرض.
بهذا المنظور، تخرج القراءة بتحويلٍ في زاوية النظر: ليست غزة مجرد مأساة تُستدعى للتعاطف، بل مختبرٌ لفهم زمننا السياسي، حيث تُقاس مصداقية الخطاب الغربي عن حقوق الإنسان، وتُختبر صلابة الدول العربية بين حدودها ومجتمعاتها، وتتعلم الحركات المدنية كيف تَصنع من العاطفة فعلاً ومن الأرشفة القانونيّة سلاحاً بطيئاً لكنه حاسم. إن تضايف بيروت وعمّان والقاهرة والخليج وباريس ولاهاي حول غزة لا يقدّم جغرافياً جديداً فحسب، بل يكشف أن المقاومة اليوم متعددة الطبقات: وجدانٌ يُحوِّل المشاهدة إلى التزام، وسياسة حدود تضبط من دون خنق، واقتصادٌ يعي هشاشته، وإعلامٌ يُنتَزع من هيمنته، وقانونٌ يراكم سردية المساءلة. هناك، في هذا التقاطع الكثيف، تتحدد إمكانات ما بعد الحرب: ليس بوقف النار وحده، بل بقدرة المنطقة والعالم على إعادة تعريف معنى العدالة والسيادة والذاكرة في وجه مشروعٍ يريد تحويل فلسطين إلى هامشٍ أبدي.


