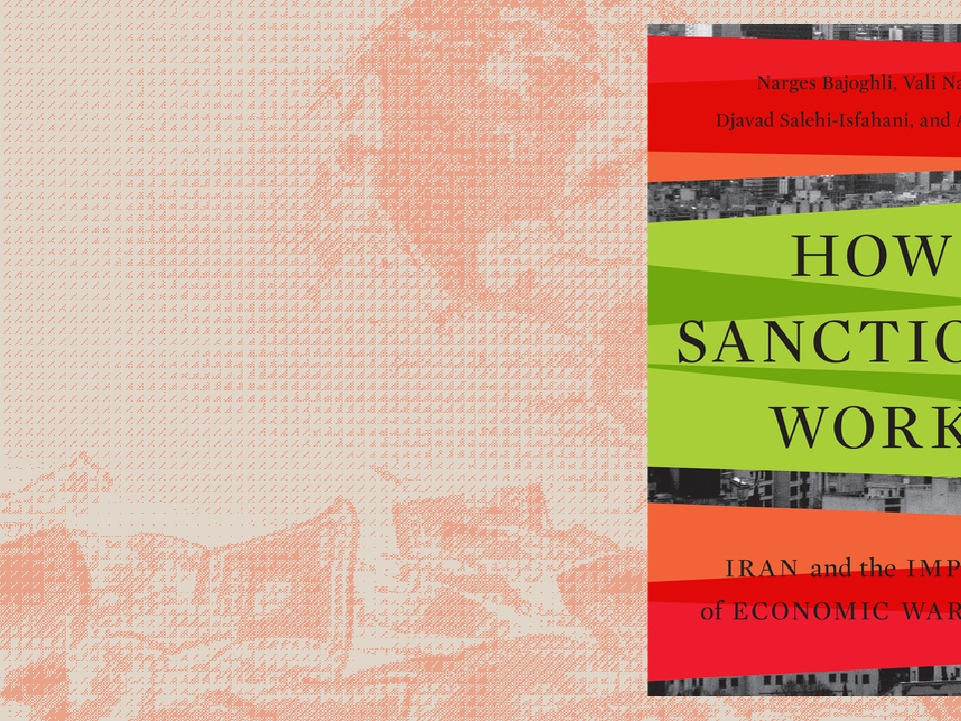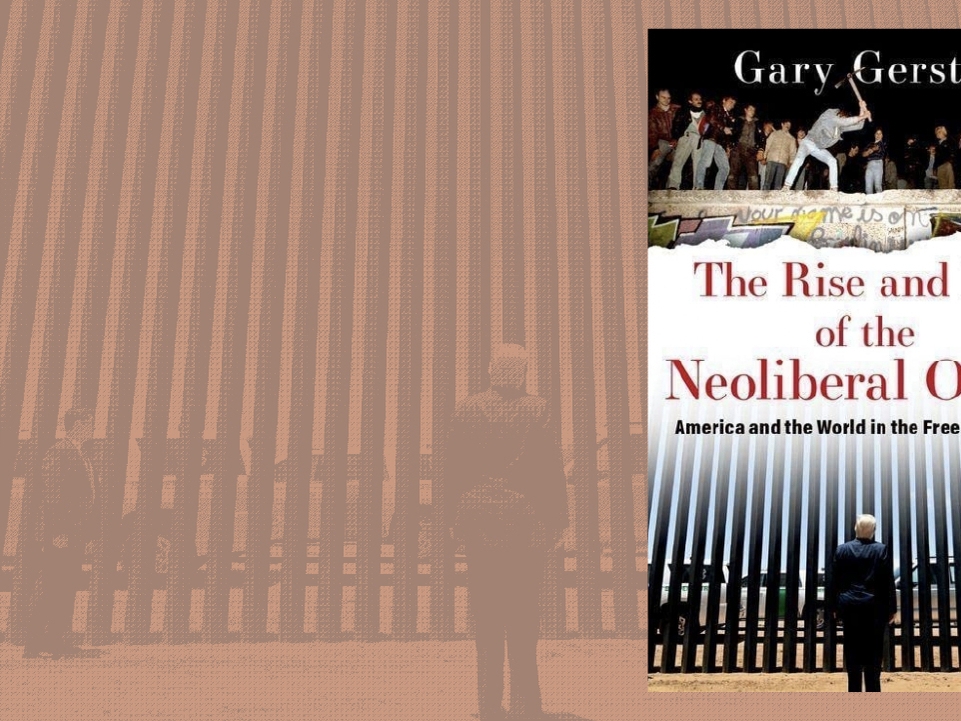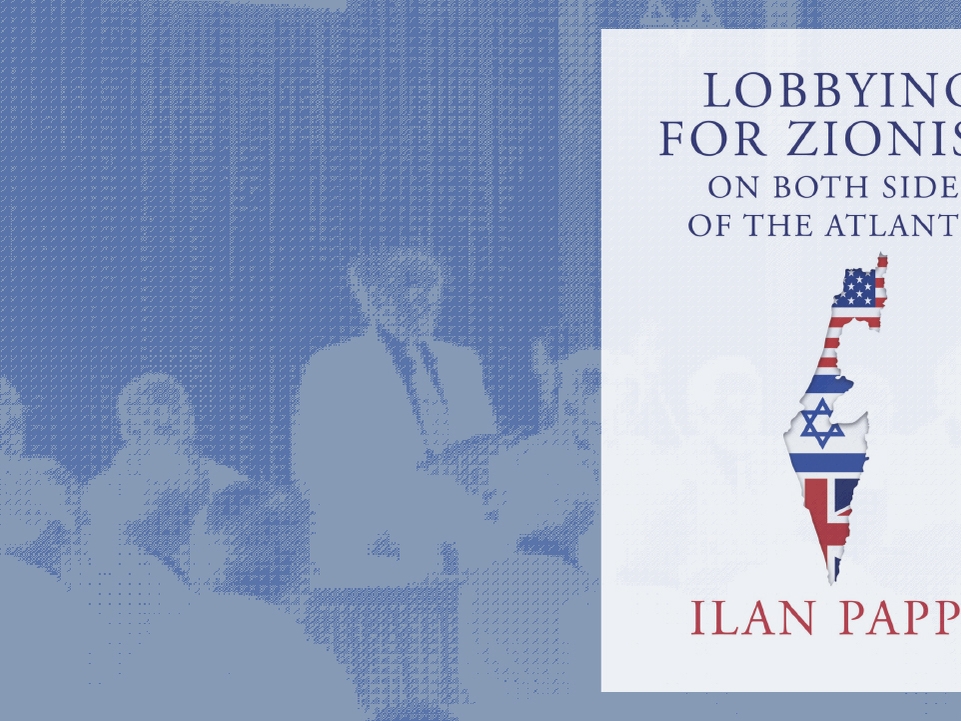عَرَق البرنوس
- مراجعة كتاب «عَرَق البرنوس» من تأليف بول فينياي دوكتون، الذي أراده وثيقة احتجاج ضدّ الاستعمار الفرنسي ولكن من داخله. إذ تعمّد نقل صورة تونسيين منسحقين في سياق صراع طبقي، وكأن الاستعمار مجرد تفصيل في صراع اقتصادي أعمّ: صراع البروليتاريا ضدّ البرجوازية.
في العام 1907، أرسل مجلس النواب الفرنسي، الطبيب والنائب الإشتراكي بول فينياي دوكتون في مهمّة تحقيق واستقصاء بشأن سير عمل الإدارة الفرنسية في مستعمراتها في المغرب الكبير، أي المغرب والجزائر وتونس. وعلى امتداد ثلاث سنوات أمضاها في الشمال الأفريقي، تعلّم اللغة العربية، وارتدى البرنوس زيّ المغاربة العتيق، وكتب تقريره المطوّل. وعلى غير المتوقّع، جاء التقرير سلبياً وعنيفاً وفاضحاً لانتهاكات من أصناف شتّى. ونتيجة لذلك، هُمِّش التقرير ونُسِي. لكن المؤلف لم يرضَ الأمر، فعمد إلى نشر قسم منه في طبعة يتيمة في العام 1911، وهو القسم المُخصّص لجرائم المستعمرة التونسية. وبيد خفيّة ما، تسرّبت نسخة من تلك الطبعة إلى رفوف مكتبة شركة فسفاط قفصة في الحوض المنجمي التونسي. رحل المستعمر، وحلّت الدولة الوطنية وأمِّمت شركة الفسفاط، وبقي الكتاب منسياً على أحد الرفوف.
في ثمانينيات القرن الماضي، تعرّض أستاذ التاريخ الأزهر الماجري لنقلة تعسّفية نحو الحوض المنجمي بسبب نشاطه النقابي. وبنقلته اكتشف النسخة اليتيمة وباشر مشروع ترجمتها. ولكن لم ترَ الترجمة النور سوى في العام 2008، وأعيد نشرها في طبعة مُحيّنة في العام 2021. وبذلك أتاح وثيقة فريدة عن الاستعمار وجرائمه.
في تراتبية الاستغلال
قبل الخوض في التجاوزات التي عاينها، انطلق دوكتون من سؤال إشكالي مُحدّد: من المسؤول عن كلّ هذا؟ وفي حقيقة الأمر، هو لم يطرح السؤال بقدر ما وجّه الاتهام مباشرة إلى الهيكل الإداري القائم بشقّيه: المخزني المحلّي والموروث عن نظام البايات، أي ملوك تونس القدامى الذين تواصل حكمهم صورياً مع انتصاب الحماية الفرنسية، وموظّفي الحماية الفرنسية.
ومن صفحات الكتاب الأولى، وضع قائمة حصرية لمن أسماهم «الكوارث الآدمية» المتسبّبة في كلّ مآسي التقرير، ولم يتوانَ عن ترتيبها تصاعدياً كالآتي: الآغاوات باعتبارهم العناصر المجنّدة المكوّنة لقوّات الصبايحية، أي أدوات التنفيذ لكل عمليات المصادرة والابتزاز والاعتقال. ثمّ القيّاد، أو مجموعة الولاة المشرفين على إدارة المحافظات بعبارات اليوم. ويليهم في الخطورة، المراقبون المدنيون الفرنسيون باعتبارهم ماسكي زمام السلطة الحقيقية وإن وقع التسويق لغير ذلك دعائياً. وفي هذه المرحلة بالذات، تأخذ القائمة منحى مختلفاً، فيعود أعوان القيّاد، من مشائخ وخلفاوات، الذين على الرغم من مكانتهم الإدارية المتدنيّة، اعتبروا أخطر عنصر مباشر في المجموعة، ولا يليهم في الخطورة سوى كبّار المرابين من اليهود وكبّار المعمّرين - في الأدبيات التاريخية التونسية، اعتُمِد مصطلح المعمِّرين لوصف المستوطنين الفرنسيين - باعتبارهم المحرّك الخفي للعملية الاستعمارية.
تبدو هذه القائمة أقرب إلى لائحة اتهام انطباعية، أملتها المشاهد المأساوية لمصادرة قرى كاملة واعتقال سكّانها وحشدهم في المعتقلات، وهي عمليّات أشرفت عليها ميدانياً مؤسّستان: الشيخ الذي يعادل عمدة القرية اليوم، والخليفة مساعد القايد الأول.
تبدو هذه القائمة أقرب إلى لائحة اتهام انطباعية، أملتها المشاهد المأساوية لمصادرة قرى كاملة واعتقال سكّانها وحشدهم في المعتقلات
ولم يكن مشهد الخليفة فوق حصانه المذهّب أثناء اقتحام القرى لينسى سريعاً من ذاكرة صاحب التقرير، وبذلك نالت هذه الهياكل الإدارية المتدنية الحيز الأكبر من سهام النقد.
صحيح أن دوكتون، هاجم الدعاية الرائجة في الأوساط الفرنسية، عن اقتصار دور المسؤولين الاستعماريين على ضمان حدّ أدنى من الإشراف على نشاط الهياكل الإدارية المحلّية، لكن بقي هذا الهجوم في مستواه الأدنى المقتصر على التنديد بالسلوك «المنحرف» لموظّفي الحماية الذين يقع انتدابهم من بين أصحاب السوابق والفضائح في الميتروبول الفرنسي. وبالتالي لا يمكن تفسير الانحراف المدوي للإدارة المحلّية إلا بتجذّر الفساد الإداري، وتوطد شبكة استغلال قوامها التحالف بين العناصر الإدارية الفاسدة من الوافدين والعناصر المحلّية الفاسدة أصلاً، لا في الظاهرة الاستعمارية نفسها.
وُجِد البرنوس لكي يعتصر
هناك اتفاق عام بين مختلف الدارسين - بقطع النظر عن خلفياتهم - بشأن النموذج الاقتصادي المُعتمد في البلاد التونسية من القرن السادس عشر، والقائم أساساً على الجباية كمورد ومحدّد لعلاقة الأفراد بالسلطة، إذ يعكس الإعفاء من الضرائب - وتحديداً ضريبة المجبى أشهر الضرائب وأثقلها على الأفراد - الانتماء الحضري والأرستقراطي للمعني بالأمر. في حين يمثل دفعها أو التهرّب منها محدِّداً للتمييز بين القبائل المطيعة أو قبائل «المجبى» والقبائل المتمرّدة أو «قبائل المغنم». هذا من دون العودة إلى أشكال الضرائب الأخرى المختلفة على كلّ الأنشطة التجارية والفلاحية، مثل القانون على النخيل والعشر على الزيتون والإعانة وغيرها.
على امتداد ثلاث قرون، تزامن تضخم العبء الجبائي باضطراد مع تدهور وانهيار الموارد الاقتصادية الكلاسيكية بداية من انقطاع التجارة الصحراوية في القرن السادس عشر، ثم انتهاء نشاط القرصنة البحرية - المورد المالي البديل على امتداد القرن الموالي- في العام 1827، وصولاً إلى تدهور آخر نشاط حرفي ضخم ومهيكل، أي صناعة الشاشية أمام منافسة السلع الفرنسية الواردة. وأمام نزيف الميزانية، تقرّر مضاعفة ضريبة المجبى من 36 إلى 72 ريال دفعة واحدة في العام 1864، ما تسبّب في أعنف ثورة في تاريخ البلاد، أدّى قمعها الوحشي إلى قيام مجاعة وأزمة لم يقطعها - شكلياً - سوى دخول المستعمر الفرنسي في العام 1881.
في هذه النقطة، يأتي عمل دوكتون لتتبع مفارقة «الرسالة التمدينية» الفرنسية مع الممارسة الجبائية القروسطية المتمثلة في ضريبة المجبى، التي لا يمكن أن تتسق إلا مع نظام القنانة - بل هي أسوأ حسب قوله - في النموذج الاقتصادي الإقطاعي.
ويمكن ردّ استمرار هذا النزيف إلى سببين أساسيين، الأول هو تشعّب شبكة الاستغلال والابتزاز، إذ عوض الخضوع القديم لابتزاز القيّاد والخلفاوات دون سواهم، وجد البدو والقرويون أنفسهم أمام فاعل جديد، هو الموظّف المدني أو العسكري الفرنسي، الذي أصبح بدوره يطالب بنصيب من عائدات المجبى، والذي لم يكن على حساب مناب القايد أو خليفته، بل على حساب الرعية. وبذلك تضخّمت سياسة الغزو، وهي العبارة التي اعتمدها المؤلّف لحملات انتزاع الضرائب، وتضخّمت عمليات التحيّل والمطالبة بالدفع لمرّتين وأكثر.
السبب الآخر لتدهور الوضعية الجبائية هو مصادرة الأملاك والأراضي المتسارع لصالح المعمرين، إذ دشنّت الجمهورية الثالثة عهدها بالاستحواذ على أحد أكبر وأخصب الحقول التونسية، أي هنشير النفيضة قبل دخولها الفعلي إلى تونس بثلاث سنوات، لتليه بعدها مصادرات شاسعة في كامل المجال الريفي، وذلك على حساب المكوّن السكاني الأساسي فيه أي الفلاحين والبدو، الذين وجدوا أنفسهم في أفضل الأحوال خمّاسة في أراضيهم القديمة - وهو الصنف الأدنى من العملة الفلاحيين في تونس وقتها، والذين شكلوا حالة خاصّة من القنانة في شمال أفريقيا - أو مطرودين منها نحو مجالات أكثر قفراً. وعلى الرغم من فقدانهم لمورد الرزق الأخير في منظومة اقتصادية متهالكة، إلا أن هذا لم يعفهم من إلزام دفع ضريبة المجبى، ومع عدم قدرة جزء كبير منهم، أصبح السجن الجماعي إجراءً معتاداً وعبثياً في الآن نفسه.
عوض الخضوع القديم لابتزاز القيّاد والخلفاوات دون سواهم، وجد البدو والقرويون أنفسهم أمام فاعل جديد، هو الموظّف المدني أو العسكري الفرنسي
من أبة كسور في الشمال الغربي، مروراً بقفصة ووصولاً إلى بلاد الجريد بأقصى الجنوب الغربي، عاين دوكتون جحافل شبه يومية للبدو وهم في طريقهم نحو السجون. وتعتبر هذه هبة الاستعمار الكبرى للتونسيين، الذين لم يألفوا منظومة السجن كمؤسّسة أصلاً، ولم يعرفوا منها إلا أسماء قليلة، لم تستخدم إلا كفضاءات نادرة للإيواء انتظاراً لتسليط العقوبة الأصلية.
لقد كان السجن كعقوبة دائمة ومتواصلة أمراً غريباً وصادماً، وشرخاً قاسياً، سبّبته حداثة الاستعمار، في منظومة حياة جماعات لم تعرف غير البادية وانطلاقها، ولا حتى قسوة السلطة التي على الرغم من كل أشكال الإيلام الجسدي الذي من الممكن أن تسبّبه لها، لم تحاول مطلقاً مصادرة آخر الحريات: الحياة خارج المعتقل.
وعن أولئك المحشورين بسبب العوز والعجز في معتقلات المستعمر الممتدة، كتب دوكتون في واحدة من أكثر فقرات الكتاب عاطفية: «إن الجوع ونقص الغذاء لا يمثل مشكلاً بالنسبة إلى البدوي. أما حرمانه من استنشاق هواء الصحراء النقي ملء رئتيه، أو منعه من السجود ... على حبات الرمال الرطبة لمّا ينشر عليها الفجر أنواره الأولى فذلك مرفوض لديه... هذا العالم الرحب هو مجال تنفّسه وفضاء سعادته. أمّا أن يقبع بين الجدران المظلمة مكبّل اليدين والرجلين فهذا هو الموت المحقق بالنسبة له».
مسيو موجو: نموذج للتوحّش الاستعماري
شغلت قضية «مسيو غورو» حيزاً هاماً من تقرير دوكتون، وأفرد له صفحات عدة. ويعود هذا الاشتغال لا لتشعب القضية وضخامة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية على ريف منطقة صفاقس فقط، وإنما أساساً لأن دوكتون رأى فيها مثالاً جليّاً عن هيمنة البرجوازية الفرنسية على المستعمرة التونسية وخصوصاً على قدرتها على توظيف كل المقدرات السياسية والإدارية والأمنية والدعائية في سبيل توطيد هذه الهيمنة، وهنا نفهم لما، اعتبر كبّار المعمرين، أخطر عنصر في تراتبية الاستغلال الاستعماري.
تعود نواة هذه القضية إلى ملف «أراضي السيالين»، وهي المجال الريفي الممتدّ على شعاع 80 كيلومتراً حول مدينة صفاقس، والذي كان مجالاً رعوياً لثلاث قبائل كبرى استقرّت فيه منذ قرون. وقبل بدايات القرن العشرين، منح التاج لزمة استغلال هذه الأراضي إلى أسرة سيالة وهي من ارستقراطية صفاقس، فأشرفت على جباية القبائل المستقرة بتلك المساحات لصالح التاج. في العام 1871، سُحبت «لزمة» التصرف في تلك الأراضي من أسرة سيالة وألحقت ملكيتها بأراضي البايليك - أي أراضي التاج - من دون أن يترتب على ذلك أي تأثير في حياة السكان. غير أن دخول المستعمر، أعاد خلط الأوراق، إذ ركّزت الصحافة الفرنسية المحلية في فرنسا على خصوبة المنطقة وضرورة استغلالها من أجل إعادة إحياء غابة الزيتون الرومانية القديمة، التي خرّبها البدو العرب.
وإعادة الإحياء هذه لا يمكن أن تتم إلا من خلال مصادرة تلك الأراضي وطرد البدو منها. وهنا جاء الفصل المخصّص للسيد موجو، المحامي الذي ولج عالم السياسة بر الانتماء إلى الحزب الراديكالي الفرنسي ذي التوجهات الاشتراكية المعلنة، ومنه إلى وزارة التلغراف والهاتف ثم مجلس الشيوخ مطلع القرن العشرين.
لم يبق للبدو من وسيلة للاستمرار سوى العمالة في أراضيهم السابقة تحت سلطة مسيو موجو في علاقة شبه قنانة، وصفها المؤلف بكونها «نظاماً قروسطياً بغيضاً»، وحالة مثالية لسياسة النهب المنظّم والرسمي
تزامن صعود الرجل مع افتتاح عصر المصادرات الكبرى للأراضي التونسية، وعن طريق وسطاء عقاريين نجح رفقة عصابة من الوزراء في افتتاك أراضي شاسعة، كان نصيبه منها أراضي السيالين. كانت العملية بسيطة وقانونية، فأراضي السيالين مسجّلة في النهاية باسم التاج، وبالتالي اعتبر البدو المستقرون فوقها منذ قرون حائزون غير شرعيون لها. وبضغط بسيط بيعت الأرض بأثمان بخسة لم تتجاوز عشرة فرنكات فرنسية للهكتار الواحد. فيما بعد أثبت أبحاث دوكتون أن القيمة الحقيقية للهكتار الواحد تبلغ 300 فرنك. وكان نصيب البدو الطرد نحو المناطق القاحلة وتحديداً منطقة هنشير واد اللبن.
لم يكتف الوزير السابق بتلك المصادرات الشاسعة، ولكنه أراد توسيع نشاطه ليشمل تربية الماشية، وهو آخر مورد رزق بقي للبدو المهجرين في هنشير واد اللبن. وبتواطؤ من الأجهزة الأمنية والقضائية الاستعمارية، فبرك الأخير محاولة اغتيال له. وبعد حملة دعائية، صادرت السلطات لصالحه ما بقي من مجال للبدو بحجة حماية أمنه الشخصي وحماية النشاط الفلاحي الاستعماري من «الهمج المخربين»، ولم يبق للبدو من وسيلة للاستمرار سوى العمالة في أراضيهم السابقة تحت سلطة مسيو موجو في علاقة شبه قنانة، وصفها المؤلف بكونها «نظاماً قروسطياً بغيضاً»، وحالة مثالية لسياسة النهب المنظّم والرسمي، الذي لم يقتصر على الفلاحة، بل اتخذ في مناجم جنوب غرب البلاد شكلاً أكثر دموية وقسوة.
صدمة الفسفاط
بقرار مبكر في العام 1881، صادرت السلطات الاستعمارية الأراضي الغابية بشمال البلاد ووسطها من ساكنيها «الجبّالية»، بتعلة حماية الغطاء النباتي فيها من الاندثار، في حين سلّمت ثرواتها في إطار وكالات للمعمرين. وفي السنوات القليلة الموالية توسعّت هذه المصادرة لتشمل حتى أراض غير غابية بموجب الأساس نفسه، ولكن عن طريق هيكل قضائي تم إحداثه إثر معاهدة المرسى هو «المحكمة المختلطة»، التي أستحدثت خصيصاً وفق المؤلف «للسيادة على الثروات التونسية»، وعن طريقها صادرت كلّ الأراضي التي اكتشفت فيها مواد منجمية كقلعة سنان والجريصة وغيرها. غير أن الاكتشاف الأكبر، تمّ عن طريق البيطري الفرنسي فيليب توماس، في إحدى رحلاته إلى الجنوب الغربي، عندما اكتشف في جهة «الثالجة» ثروات ضخمة من الفوسفات - أو الفسفاط وفق الاستخدام التونسي - أعلن عنها في العام 1887. وعلى إثر إعلانه سارعت السلطات في مسيرها المحموم لبعث أكبر وأقوى شركات الفترة الاستعمارية، والمستمرّة لليوم، وهي شركة الفسفاط والسكك الحديدية بقفصة في العام 1897. ومن أجل ذلك، خاضت واحدة من أقسى عمليات التهجير.
ومرة أخرى لم يحل الشكل القانوني للمستعمرة التونسية باعتبارها نظام حماية، من قدرة الإدارة الاستعمارية على التلاعب بالنصوص والقوانين. إذ صدر في البداية القرار باعتبار أراضي «أولاد بويحيى» وغيرها من القبائل القاطنة بمجال اكتشاف الفسفاط، أراض جماعية تعود ملكيتها إلى الدولة، تماماً كأراضي السيالين، وعلى ضوء ذلك تمت مصادرتها وتشريد أكثر من 100 ألف بدوي من مجالهم التاريخي من دون أي مقابل، سواء لهم أو لخزينة الدولة. ومثلت النقطة الأخيرة بالذات واحدة من أكبر عمليات التحيل خلال تلك الفترة.
يصف دوكتون، اكتشاف الفسفاط بكونه صدمة، بالنسبة إلى النخب الاستعمارية الرأسمالية في البلاد التونسية، إذ من الممكن لهذا الاكتشاف أن «يضيع» من بين أيديهم للصالح العام. وهنا لعب المهندس جورج بافيلياي، ذي الماضي المشبوه في السنغال والجزائر يحسب المؤلف، دوراً محورياً في مؤامرة بعث شركة فسفاط قفصة. ومن خلال منصبه كمدير عام للأشغال العمومية في تونس (1893-1903)، تمكّن من إحباط أي محاولة للاستثمار في قطاع الفسفاط وفق شروط طبيعية. وأسّس بافيلياي في السرّ مع خلية من الموظفين والنوّاب وكبار المعمّرين، بل وحتى أفراد أسرته، شركة مالية مُنِحت امتياز استغلال فسفاط قفصة بشروط صادمة: امتياز حصري لاستغلال الفسفاط والتنقيب عنه وعن غيره من الثروات في مجال تجاوزت مساحته مليوني هكتار لمدة 60 سنة. وعدم تقديم أي تعويض مالي للدولة أو للقبائل المهجرين عن مئات الالاف من هكتارات الأراضي المصادرة. والإعفاء من دفع الضرائب غير المباشرة. إضافة إلى تخفيض ضريبي ضخم في علاقة بالضرائب المباشرة. وبذلك كانت حصيلة عملية التحيل، التي وقف عليها دوكتون بالأرقام كالآتي: لم تتجاوز قيمة الأداءات الموظّفة على 150 ألف طن من الفسفاط، 150 ألف فرنك فرنسي، في حين وظّفت على الكمية نفسها المستخرجة على الشطر الآخر من الحدود، أي الجزائر، ما قيمته 375 ألف فرنك، أي أكثر من الضعف.
بهذا التحيل على الميزانية العامّة، وبالقسوة المفرطة التي زامنت عملية التهجير وعمليات التنقيب المأساوية التي راح ضحيتها مئات من العمّال المحلّيين، دشّنت شركة الفسفاط مرحلة جديدة من حياة أهالي الجنوب الغربي. صحيح أن المؤلف، لم يعاين أثناء وضع تقريره مستقبل عملية إنتاج الفسفاط في الجهة، إذ سرعان ما تشكلت قرى استعمارية كاملة وأصبحت بلدات للعملة الاوربيين، وإلى جوارها قامت الأحياء البدائية والمختلطة للبروليتاريا من تونس والمغرب والجزائر، ولكنه تنبأ مبكراً بأن الشركة لن تقدّم للتونسيين ولغيرهم سوى البؤس والفقر.
أسّس بافيلياي في السرّ مع خلية من الموظفين والنوّاب وكبار المعمّرين، بل وحتى أفراد أسرته، شركة مالية مُنِحت امتياز استغلال فسفاط قفصة بشروط صادمة
جمهورية البرجوازية
يوجّه دوكتون في كتابه الخطاب لوزراء عدة وفاعلين في السياسة الفرنسية، غير أن اسماً واحداً لا ينفك يتردّد وهو اسم الوزير ستيفان بيشون، الصحافي القديم والوزير الإشتراكي القادم من الحزب الراديكالي، والمقيم العام الفرنسي وهو أعلى سلطة استعمارية في الحماية الفرنسية على تونس والمغرب. جنباً إلى جنب مع كليمنصو، شارك بيشون في الدفاع عن مقاربة إشتراكية لفرنسا أكثر عدالة للفرنسيين وللمستعمرات على حد السواء. وهي الدعاية نفسها التي انضم إليها صاحب الكتاب، بل إنه ألف تحت رعاية كليمنصو وبتشجيع منه «مجد السيف»، وهو أقدم كتبه المندّدة بالجرائم الاستعمارية في السودان ومدغشقر، وساهمت أصدائه في «أنسنة» الاستعمار في الربوع الأفريقية لبعض الوقت، بفضل دعاية إشتراكية سرعان ما انتهت بوصول الإشتراكيين الراديكاليين إلى السلطة بداية من العام 1902. يصف دوكتون هذه المرحلة بـ«الفجر وقد تحوّل، للأسف الشديد، إلى غروب»، إذ عادت الممارسات الاستعمارية الوحشية في أفريقيا لسابق عهدها. وفي تونس، عيّن ستيفان بيشون مقيماً عاماً ليسرّع من عمليات المصادرة للأراضي الفلاحية والمنجمية على حد السواء، ما تسبّب في نهاية عهده في اندلاع أول انتفاضة فلاّحين بعد الاستعمار، هي انتفاضة تالة لسنة 1906، التي قمعها بكل عنف وقسوة، قبل أن يغادر تونس وتتم مكافأته بمنصب وزير المستعمرات في حكومة كليمنصو الأولى.
وبهذا التكرار المستمر لذكر بيشون، وتذكيره بذلك البلد الوادع والمسالم، الذين أمضى فيه سنوات، لعب دوكتون على وترين مختلفين. الوتر الأول هو وتر شخصي، غازل به رفيقه القديم المناهض للاستعمار في شبابه والشعارات المثالية التي طالما رفعها، حتى أنه كتب: «لا شك سيدي الوزير بيشون أن الصحافي الذي كنت بالأمس سينتفض أمام هذه الفظاعات على الوزير الذي أنت عليه اليوم». أما الوتر الآخر، فهو وتر المعركة السياسية، وتموقع دوكتون نفسه فيها، إذ انتمى إلى تحالف نواب عرف باسم كتلة الإشتراكيين الراديكاليين مثّلت امتداداً للحزب الراديكالي، حزب الوزير بيشون، الذي أمام تنامي انتقادات سياسته الاستعمارية، اضطر إلى فتح تحقيقات برلمانية عن هذه الجرائم في شمال أفريقيا. هنا اختار الوزير بيشون صديقه القديم لهذه المهمة، في محاولة للتحكّم في أبعادها، ولو أن التقرير جاء على غير المأمول.
لا يبدو أن التقرير نجح في تحقيق هدفه السياسي، أي إحراج الحكومة الفرنسية، أو تأليف كتلة مناهضة للاستعمار في مجلس النواب، بل لم ينشر إلّا بعد سعي شخصي من المؤلف. أما في البرلمان، فقد بقي دوكتون ممثلاً لصوت اليسار ناشزاً ووحيداً، قبل أن يضطر إلى مغادرته، مع بلوغ النزعة الاستعمارية أوجها في السنوات الأخيرة لمرحلة ما قبل الحرب الكبرى. وفي فوران الغضب ذلك، نشر التقرير للعلن، عن طريق مطبعة حملت اسم «الحرب الاجتماعية» لصاحبها الإشتراكي غوستاف هارفي في العام 1911. وفي أحد فصوله، وبيأس مطلق من عجز اليسار الفرنسي على تحقيق ما وعد به المستعمرات، كتب: «اللعنة على الجمهورية البرجوازية التي باسمها ينهب المعدمون وتهتك أعراضهم». وبذلك أمست الجمهورية الثالثة، بكل أطيافها من اليمين الاستعماري المعلن، إلى إشتراكيها القدامى، توليفة واحدة من اليمين.
ولسخرية القدر، زادت خيبة أخرى دوكتون عندما علم أن ناشره «مسيو هارفي» تحوّل نحو أقصى اليمين بعد 5 سنوات فقط وغيّر اسم مطبعته إلى «النصر» بعد أن حوّلها إلى بوق دعاية مساند للحرب.
أمست الجمهورية الثالثة، بكل أطيافها من اليمين الاستعماري المعلن، إلى إشتراكيها القدامى، توليفة واحدة من اليمين
متضامن، ولكن مع من؟
هل تضامن دوكتون مع التونسيين باعتبارهم مستعمرين أم باعتبارهم بروليتاريا مستغلة؟ تصعب الإجابة على هذا السؤال لشواهد عدة يطرحها على امتداد كتابه. وبالنسبة إلى نقده للاستعمار كظاهرة، وإن كان نقداً حاداً بمعايير عصره، إلا أنه بقي محدوداً ولم يبلغ حد الدعوة لاستقلال المستعمرات الصريح. وبذلك بقيت محاولته في إطار انتقاد «وحشية» الاستعمار، وتسهيل هذه الظاهرة التاريخية لتغوّل البرجوازية ودوائر النفوذ القريبة منها لا فقط داخل المستعمرات، بل وداخل المركز نفسه. وعليه فإن أنسنة التجربة الفرنسية وفرض رقابة صارمة ومكافحة الفساد داخل الدوائر البيروقراطية والسياسية فيها، ينصّب في النهاية في صالح المُستعمَرين.
لم يخل هذا المنهج في النهاية من الوصول إلى نتائج لا تخدم سوى استمرار الظاهرة الاستعمارية نفسها، مثلاً التعاطف الكبير الذي أبداه الكاتب مع شريحة من المستوطنين الفرنسيين، هم صغار المعمرين وصغار الموظّفين والعملة، الذين عجزوا عن تحسين وضعهم المالي من خلال القدوم إلى تونس، بسبب هيمنة كبار البرجوازيين. يتناسى هذا التعاطف حقيقة أن هؤلاء، تمتعوا بدورهم بامتيازات جبائية عالية مقارنة بالمحليين، وحتى الأراضي الصغرى التي حصلوا عليها، كانت كلّها حصيلة لعملية افتكاك ومصادرة لأملاك التونسيين. وهو ما يجعل التعاطف - المبني على الصراع الطبقي الفرنسي الداخلي - مع هذه الفئة لا يخدم في النهاية سوى الظاهرة الاستعمارية نفسها، إذ على خلاف كبار المعمرين والذين لم تزر غالبيتهم تونس إلا مرّات قليلة، كان صغار المعمرين العنصر الدائم في عملية التوطين وفي عمل الأجهزة الاستعمارية المحلية.
إن موقف دوكتون نفسه من التونسيين هو شاهد آخر، إذ خصّص صفحات مطوّلة من الكتاب لمهاجمة النخب التونسية الوطنية، وتحديداً حركة الشباب التونسي - النواة الأولى للحركة الوطنية - معتبراً إياها حركة أرستقراطية رجعية، بل وعلى القدر نفسه من التحالف أو التواطئ مع الإدارة الاستعمارية. ولهذا الموقف وجاهته، إذ تجاهل أحد أبرز روادها وهو البشير صفر - أحد أكبر الملاّك العقاريين وقتها - ثورة الفلاحين والخمّاسة في منطقة تالة سنة 1906، رافضاً دعمها أو التنديد بالانتهاكات المرتبطة بها. وهو ما فسّره دوكتون بانتمائه الطبقي وتهديد مثل هذه الثورات لمصالحه الشخصية تماماً مثل مصالح كبار المعمّرين. ومع ذلك، يبدو أن النقد الموجّه إلى دوكتون هنا لا يخلُ من صوابية، خصوصاً أنه أغفل هشاشة الحركة الوليدة، مقابل قوة استعمارية ناشئة. وحتى المطالب الوطنية الإصلاحية لهذه الحركة، يبدو أنها لم تنل الكثير من اهتمامات المؤلف، أو تعاطفه معها كمطالب تونسية مستقلة.
إن أنسنة التجربة الفرنسية وفرض رقابة صارمة ومكافحة الفساد داخل الدوائر البيروقراطية والسياسية فيها، ينصّب في النهاية في صالح المُستعمَرين
هنا تتوضح بعض ملامح دوافعه وأهدافه من وراء هذا التقرير: أراد دوكتون من عمله أن يكون وثيقة احتجاج ضد الاستعمار، ولكن من داخله، أراد نقل صورة تونسيين منسحقين في سياق صراع طبقي، وكأن الاستعمار في النهاية لا يعدو سوى أن يكون تفصيلاً في صراع اقتصادي أعم: صراع البروليتاريا ضدّ البرجوازية. وبمثل هذه التوليفة، لم يرض من وراء كتابه أي طرف: لا أصدقائه الإشتراكيين القدامى ممن دافعوا عن مبدأ المركز أولاً ثم المستعمرات، ولا النخب التونسية التي هاجمها ورفض مساندتها، وبطبيعة الحال الإدارة الاستعمارية والمتحالفين معها. أمّا المسحوقون أي السجناء والخمّاسة والفلاحين وعمّال المناجم والرعاة البدوو ممن لقيهم أثناء رحلته التونسية، فقد نسيته غالبيتهم غداة رحيله، وربما مات كثيرون منهم قبل أن يصدر كتابه أصلاً.