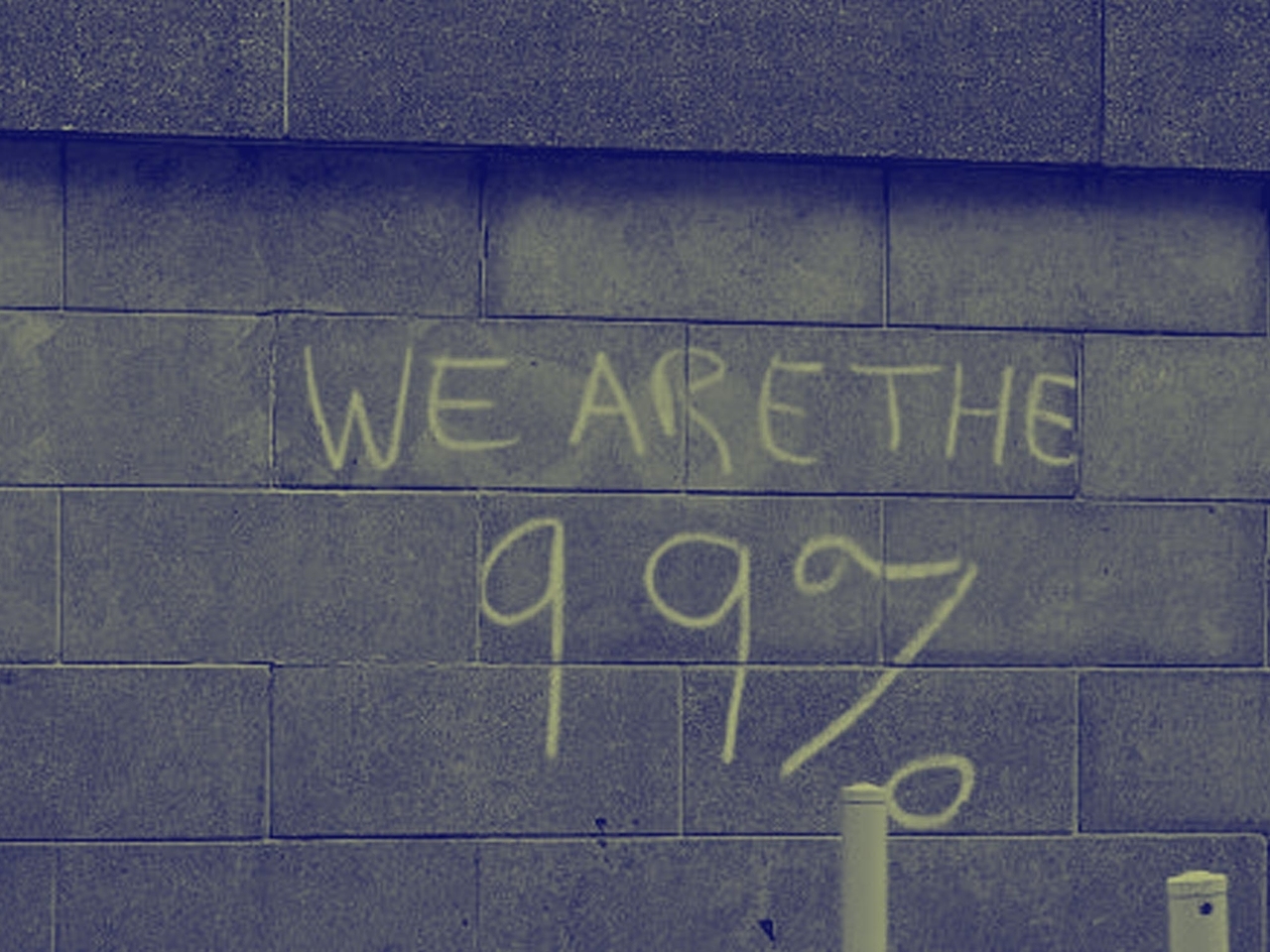66 دولاراً في مقابل 4 سنتات: التفاوت العالمي في الصحّة النفسية
تتوضّح أقصى درجات اللامساواة في الصحة العالمية في معالجة الصحة النفسية. فوفقاً لـ أطلس الصحة النفسية لعام 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية، تنفق الحكومات في الدول المرتفعة الدخل نحو 66 دولاراً للفرد سنوياً على خدمات الصحة النفسية، بينما ينخفض هذا المبلغ في الدول المنخفضة الدخل إلى 0.04 دولار فقط.
دلالة هذا التفاوت شاسعة، إذ تتعدّى قيمته الإحصائية لتصبح تشخيصاً للخلل البنيوي في الاقتصاد العالمي. لطالما جرى التعامل مع الصحة النفسية كهامش من النظام الصحي، لكنها ترسم اليوم الحدّ الأكثر وضوحاً بين من تُعتبَر معاناتهم شأناً عاماً ومن يُترَك وجعهم عبئاً خاصاً يلقى على عاتق العائلة أو الأصدقاء أو الفرد.
تكشف الأرقام التالية البنية المادية لهذا الانقسام، إذ تتركز الخبرة والرعاية والحقوق في الدول التي تتراكم فيها الثروة، بينما يسود في سائر أنحاء العالم مزيج من الندرة والصمت والاعتماد القسري على الذات. وتمتدّ خلف كل فجوة بنية سياسية اقتصادية تستنزف القدرات من الجنوب لتكدّسها في الشمال، ثم تُعيد إنتاج خريطة اللامساواة بوصفها ظاهرة طبيعيّة أو خللاً أخلاقياً. فمن خلال الموازنات، والقوى العاملة، والتشريعات، وأنظمة الحماية الاجتماعية، تعمل المنظومة العالمية للصحة النفسية كمرآةٍ دقيقةٍ لنمط التنمية غير المتكافئ، وتساهم في استدامته.
تنفق البلدان الغنية 65.89 دولاراً للفرد على الصحة النفسية في مقابل 0.04 دولار فقط في البلدان الفقيرة
تبقى موازنات الصحة النفسية رمزية في اقتصادات الجنوب العالمي وتُظهر أن المعاناة النفسية ما زالت في أدنى سلّم أولويات الإنفاق العام. ينتج عن ذلك منظومة تعمل بالحد الأدنى من الموارد البشرية والمادية، وتعتمد بشكل عضوي على المنظمات غير الحكومية ذات التمويل الهش، وتتحمّل فيها الأسر عبء الرعاية مدى الحياة في غياب أي دعم مؤسسي. هذا التفاوت بين الشمال والجنوب هو حصيلة عقود من سياسات التكيّف الهيكلي والخصخصة وخدمة الدين العام والاعتماد على المانحين، التي فرّغت أنظمة الصحة العامة من كوادرها وبنيتها.
تضم البلدان الغنية 67.2 عاملاً في مجال الصحة النفسية لكل 100 ألف شخص بينما لا يتجاوز العدد 1.1 في البلدان الفقيرة
يفوق عدد المعالجين التقليديين عدد الأطباء النفسيين في معظم البلدان المنخفضة الدخل، ويزيد عدد رجال شرطة عن عدد العاملين الاجتماعيين المؤهّلين للتعامل مع حالات الضيق النفسي. ينتج عن ذلك نقصٌ حاد في الكوادر وسلسلة توريد أحادية الاتجاه: الجنوب يُدرّب، والشمال يُجنّد. تُهاجر الخبرات نحو الأمان والموارد، وتُترك المجتمعات الأكثر هشاشة بلا خبرات. بهذه الآلية، تتحوّل الرعاية إلى سلعة تُصدَّر، تُستنزف فيها المعرفة والقدرة من القاعدة لتتكدّس عند القمّة، في مقابل تحويلات ماليّة زهيدة إلى البلاد الفقيرة لا تعوّض الخسائر الفعليّة.
يحصل الأطفال في البلدان الفقيرة على 4 زيارات فقط في عيادات الصحة النفسية لكل 100 ألف شخص في مقابل 974 في البلدان الغنية
تبدأ اللامساواة منذ الطفولة. يترك غياب خدمات الأطفال والمراهقين في البلدان الفقيرة الصدمات والاضطرابات النمائية بلا علاج، ويُكرّس دوائر الفقر والإقصاء حتى سنّ الرشد. وفيما ينشأ الطفل في بلد غنيّ في منظومة تتوافر فيها برامج التدخّل المبكر والإرشاد المدرسي والوقاية، ينشأ نظيره في بلد فقير في فراغٍ مؤسسي. لا تكمن الفجوة في العلاج فقط، بل في التصوّر السياسي ذاته، في من يُعتبَر ألمه جديراً بالاعتراف والمعالجة. فلا يرث أطفال العالم تفاوتاً في الثروة فحسب، بل في الحقّ بأن يُؤخَذ وجعهم على محمل الجدّ.
2/3 البلدان الغنية تعتمد قوانين للصحة النفسية قائمة على الحقوق في مقابل أقل من 1/3 في البلدان الفقيرة
تُصان حقوق المرضى في الدول الأكثر ثراءً عبر هيئات رقابية ومسارات قانونية تضمن الكرامة والاستقلالية، أما في البلدان الأفقر، فيبقى الإكراه والوصم والحجز الإجباري ملامح أساسية للرعاية. لا تكفي التشريعات وحدها، بل تحتاج إلى جهاز إداري وتمويل عام لتنفيذها، وهو ما يغيب في الأنظمة الهشّة. هكذا يتشكّل نظام مزدوج يكرّسه القانون: عالم تُعتبر فيه الكرامة حقاً قانونياً، وفي آخر تُختزل إلى امتيازٍ اجتماعي.
3/4 البلدان الغنية تمتلك برامج للوقاية من الانتحار بينما لا يمتلك أيّ من أفقر البلدان مثل هذه البرامج
أصبح امتلاك القدرة على الوقاية من اليأس نفسه امتيازاً. ففي حيث تتوافر الموارد، تُنشأ خطوط المساعدة، وتُنظَّم حملات التوعية، ويُدرَّب المتخصّصون، وحيث تغيب، يُترك الانتحار بلا بيانات أو معالجة، كأنه قدرٌ مأساوي. تكشف هذه الفجوة أن السياسات تحدّد فعلياً من تُعتبر وفاته قابلة للمنع، ومن تُقبل وفاته كتحصيل حاصل للمعاناة. تتطلب الوقاية استثماراً طويل الأمد في الوقت والبيانات والبنية التحتية، وهي عناصر يقوّضها التقشف والتمويل القصير الأجل الذي يحكم الصحة العامة في الجنوب العالمي. لا يمكن اختزال الصمت المحيط بالانتحار بالآفات الثقافيّة بحت كونه سياسي أيضاً، فهو التعبير الأكثر وضوحاً عن قرارٍ بعدم الإنقاذ.
74% من البلدان الغنية توفّر دعماً سكنياً وإعانات للمصابين بأمراض نفسية حادّة في مقابل 11% فقط في البلدان الفقيرة
في نهاية سلسلة اللامساواة، يظهر السؤال بسيط: كيف يعيش الناس بعد العلاج، إن بدأ أصلاً؟ في الدول الغنية، تُؤمّن أنظمة الحماية الاجتماعية دخلاً وسكناً ومسارات لإعادة الاندماج، بينما في الدول الفقيرة يؤدّي «الشفاء» غالباً إلى الوقوع في العوز. فحين يغيب المأوى والرعاية الاجتماعية، يصبح العلاج بلا معنى، وتتحوّل المعاناة النفسية إلى اختفاء اجتماعي بطيء. تكشف هذه الفجوة أن التعافي المدعوم مؤسسياً ليس خياراً متاحاً في الجنوب، بل ترفاً لقلّة ميسورة. فإذا كان يُترك المرضى بلا شروط حياة لائقة، فكيف يُتوقع من الأصحاء أن يحافظوا على صحتهم النفسية أصلاً؟
تظهر بيانات منظمة الصحة العالمية خللاً بنيويّاً عالميّاً في الصحة النفسية يحاكي اللامساواة في النظام الاقتصادي العالمي. ويرسم كل رقم، من الموازنات إلى السكن، خريطة واحدة للقيمة: الثروة والرعاية في الشمال، والحرمان والعوز في الجنوب. تكشف هذه المنظومة أن المعاناة لا تُقسَّم بالتساوي، بل تُدار وتُرتّب وفق القدرة على تحمّل كلفتها. لا يعكس الفرق بين 66 دولاراً و0.04 دولار تفاوتاً في السخاء، بل هو تعبير عن نظامٍ واحدٍ يُنتج الألم في مكانٍ ويعالجه في آخر. ولن يُردم هذا الانقسام ببرامج تمويل جزئية، ما دامت البنى المالية التي تستنزف أنظمة الجنوب بالديون والتقشف هي نفسها التي تحدّد من يستحق العناية، ومن يُترَك ليواجه معاناة الجسد والعقل معاً.