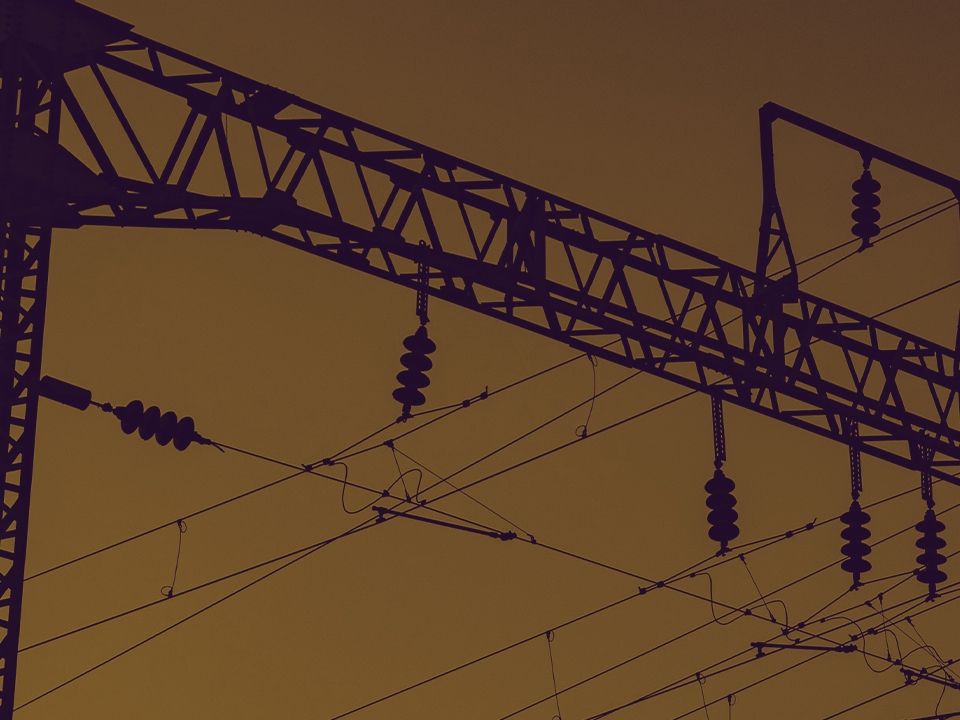الترقيع والإهمال في مواجهة شحّ المياه في لبنان
في ظل أزمة المياه غير المسبوقة التي يواجهها لبنان، بات من الضروري أن تتخذ الدولة خطوات جذرية لصون الأمن المائي للبلاد، بدلاً من الحلول الترقيعية والاعتماد المتكرر على إجراءات الطوارئ في كل مرة تتفاقم فيها الأزمة. وفي هذا التقرير، يشرح خبراء وعاملون في قطاع المياه مجموعة من السياسات التي يمكن تبنيها لتحسين وضع القطاع على المديين المتوسط والطويل، وتفادي وقوع البلاد رهينة لأزمات الجفاف المستقبلية.
ما حجم الأزمة الحالية؟
نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن معدلات الأمطار في عامي 2024-2025 تُعد «الأسوأ منذ 80 عاماً» في سجلات لبنان. وأوضح الخبير في شؤون البيئة نديم فرج الله لمجلة «صفر» أن مستوى الشح في الشتاء الأخير كان استثنائياً، فعلى الرغم من أنّ لبنان شهد وضعاً مشابهاً في العام 2014، إلا أنّ ما حصل في موسم الأمطار الأخير كان أشد قسوة.
يمتد فصل الشتاء في لبنان من تشرين الأول/أكتوبر حتى آذار/مارس من كل سنة، بينما يبقى نحو 6 إلى 7 أشهر من دون أمطار، ما يفرض الاعتماد على المياه المخزنة. وتتمثل المشكلة في أن القدرة التخزينية لمياه الشتاء أو مياه الوديان والأنهار ضعيفة جداً ومحدودة للغاية، فيتم اللجوء إلى المياه الجوفية بشكل عشوائي وفوضوي لتعويض النقص، ما أدّى إلى تفاقم الأزمة وزيادة مخاطر التلوث والملوحة.
ووفق تصريحات وزير الطاقة والمياه اللبناني جو صدّي، يشهد لبنان «نقصاً غير مسبوق في المياه». ويشير إلى أن معدل هطول الأمطار السنوي انخفض في الموسم الماضي بنسبة 50% بالمقارنة مع متوسط السنوات الماضية الذي تراوح بين 700 و1000 ملم. وفي بيروت بشكل خاص، لم يتجاوز معدّل هطول الأمطار في الموسم الماضي 382.1 ملم، بالمقارنة مع 1,051.3 ملم في الموسم الأسبق، ومتوسط 822 ملم في خلال الثلاثين عاماً الماضية. ومرّ لبنان خلال شهر كانون الثاني/يناير 2025 بأكمله من دون هطول أمطار يُذكر، علماً أن نحو 20% إلى 30% من تساقط الأمطار في البلاد حدث في السنوات الماضية في هذا الشهر وحده، وقد بلغ متوسط هطول الأمطار في كانون الثاني/يناير 2024 نحو 191 ملم.
انخفض معدل هطول الأمطار السنوي في الموسم الماضي بنسبة 50% بالمقارنة مع متوسط السنوات الماضية الذي تراوح بين 700 و1000 ملم مع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض مفاجئاً تماماً، فبحسب المجلس الوطني للبحوث العلمية، انخفض معدل الهطول السنوي إلى 600 ملم في السنوات 2014 و2018 و2021، بعد أن كان يبلغ 800 ملم سنوياً، كما تقلّصت فترة تغطية الجبال بالثلوج لتصل إلى 30 يوماً بدلاً من 120 يوماً سابقاً، ما أدّى إلى ذوبان سريع للثلوج وحرمان المياه من الوقت الكافي لتغذية الطبقات الجوفية والينابيع.
أصبح تأثير الجفاف على المياه السطحية واضحاً للغاية، فقد انخفض الإنتاج اليومي لنبع جعيتا من 90,000 متر مكعب في العام 2024 إلى 40,000 متر مكعب في العام 2025، في حين تراجع إنتاج نبع العسل من 25,000 متر مكعب إلى 10,000 متر مكعب. وبالمثل، انخفض الإنتاج اليومي لسد القيسماني بشكل حاد من 1,000,000 متر مكعب إلى 150,000 متر مكعب. وأشار المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية إلى أننا نشهد أزمة شحّ غير مسبوق إطلاقاً في تاريخ سد القرعون، وهي البحيرة الأكبر في البلاد، ويضيف «منذ تسعينيات القرن الماضي ونحن نرصد تراجعاً في كميات المياه في الينابيع المختلفة، وقد تجاوزت نسبة الانخفاض في تصريف مياه الينابيع والمياه السطحية 80% في بعض المواقع في هذا العام».
وأشار الباحث في شؤون المياه والبيئة، أحمد الحاج، في مقال نشرته جريدة «النهار»، إلى وجود عجز كبير في المخزون الجوفي للمياه، بمعنى أننا نستخرج منه كميات أكبر بكثير مما تعوضه الأمطار. وقدّر الحاج هذا العجز بحوالي 947 مليون متر مكعب في العام 2024، ما يعني أنه حتى لو توقفت عمليات السحب من الآبار بشكل كامل الآن، فإن العجز في المياه الجوفية سيستمر لسنوات عدّة، ومن الطبيعي أن يكون قد ازداد هذا العجز في العام 2025 مع تراجع هطول الأمطار.
ووفق تقديرات المرصد اللبناني للمياه لعام 2023، أصبحت حصة الفرد السنوية من المياه في لبنان أقل من 500 متر مكعب، أي إلى ما دون نصف خط الفقر المائي المحدد بنحو 1000 متر مكعب، وما دون خط الندرة المائية المحدد بنحو 500 متر مكعب. وهذا يعني أن لبنان دخل في مرحلة الفقر المائي المدقع. وأشار تقرير صادر عن «يونيسف» و«واش كلاستر» عن قطاع المياه في لبنان الى أن «تأثير الجفاف في لبنان أصبح بالفعل مدمراً، إذ يعيش 1.85 مليون شخص في مناطق شديدة التأثر بالجفاف، ويعتمد أكثر من 44% من السكان على خدمات صهاريج المياه المكلفة وغالباً غير الآمنة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل». فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة على السكان بسبب تأثر قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والصحة وغيرها.
استجابة الحكومة
لا تستجيب الحكومة لأزمة المياه كما يجب، إذ لم تضع خطّة ولا برامج ولم ترصد الاعتمادات اللازمة لتخفيف المخاطر والخسائر والحد من التداعيات، واكتفى وزير الطاقة والمياه بالطلب إلى مؤسسات المياه وضع خطة منسّقة للاستجابة لأزمة الجفاف. ونظراً للإمكانيات المحدودة جدّاً لمؤسّسات المياه، لم تتضمن الخطة سوى بعض الخطوات المدفوعة بالأوضاع الطارئة، مثل تزويد المجتمعات المحرومة بالمياه عبر صهاريج الطوارئ، وإعادة تأهيل الآبار غير العاملة لاستعادة توفر المياه بسرعة، وإجراء إصلاحات سريعة للتسريبات. مع ذلك، أشار تقرير «واش كلاستر» إلى أن «محدودية القدرة التشغيلية، والبنية التحتية المتقادمة، والاعتماد على الوقود، ونقص التمويل، تشكّل عقبات أمام التنفيذ الكامل لهذه الخطة».
حتى لو توقفت عمليات السحب من الآبار بشكل كامل الآن، فإن العجز في المياه الجوفية سيستمر لسنوات عدّة
وأوضح المدير العام لمصلحة الليطاني أن وزارة الطاقة طالبت المؤسّسات باتخاذ القرارات اللازمة وفق ما ينص عليه قانون المياه، الذي يفرض تقييد بعض الاستخدامات عند حدوث أزمة مائية، «فلا يجوز أن يكون هناك أشخاص بحاجة إلى المياه، فيما تُمنَح كميات هائلة منها، تصل إلى آلاف الأمتار المكعبة، للمسابح ومغاسل السيارات». وأشار مدير وحدة الإعلام والاتصال في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي جمال شعيب الى أن الأولوية اليوم هي للقطاع السكني والمراكز الخدمية الأساسية، مثل المستشفيات، ومراكز الجيش، والصليب الأحمر وسواها من المرافق الحيوية، التي يجب تأمين المياه لها نظراً لدورها في ظل الوضع اللبناني الحالي. وأوضح شعيب أن مؤسسات المياه بدأت برامج تقنين المياه منذ العام الماضي، وباشرت ببعض الإجراءات الإدارية التي تهدف إلى فصل الاستخدامات السكنية عن الاستخدامات التجارية والسياحية والصناعية، بعدما كانت المؤسّسات تحصل على المياه عبر الاشتراكات بالشروط والأسعار نفسها، مثلها مثل أي مواطن. وقال أن مؤسسات المياه قامت بتوجيه كتب إلى جميع المؤسسات لتصنيفها، وتم توجيه إنذارات لها بوجوب الاشتراك كجهات تجارية».
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن نيّتها الاستثمار في أنظمة قياس الأمطار على مستوى البلاد، وتحديث محطّات الضخ القديمة وتوسيع قدراتها، ووضع خطط محلية لإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة. إلا أن الدولة اللبنانية تتجاهل الحاجة إلى اعتماد سياسات طويلة الأمد لإصلاح الأعطاب البنيوية في قطاع المياه. وفي هذا السياق، من الجدير ذكره أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجّه إنذاراً عن المخاطر التي تهدّد قطاع المياه في لبنان منذ 10 سنوات، ولم تفعل الحكومة شيئا يُذكر إزاء هذه المخاطر المتعاظمة.
أشار التقرير حينها الى أن «هناك اعتقاد شائع بأن لبنان يتمتع بمعدل أمطار معتدل، ويمتلك إمدادات وفيرة من الموارد المائية المتجددة. إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ، إذ أن ممارسات إدارة الموارد المائية غير المستدامة المتبعة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب ضعف الحوكمة المائية، وضعت ضغطاً كبيراً على موارد البلاد المائية، وخصوصاً المياه الجوفية».
الحد من حفر الآبار عشوائياً ونقل المياه بالصهاريج
أصبحت صهاريج المياه الخاصة المصدر الرئيس، وليس الاستثناء، لتوفير المياه لعدد كبير من سكان لبنان، بما في ذلك في بيروت وضواحيها، في ظل عدم ضمان الدولة تزويد الناس بالمياه بشكل مستدام، وتعمل هذه الصهاريج المتنقلة من دون أي رقابة حكومية، فضلاً عن كون خدماتها أغلى من تلك التي تقدّمها شركات المياه الحكومية، ما يؤدي إلى زيادة فاتورة المياه على السكان.
وأوضح فرج الله أن أصحاب الصهاريج يستخرجون المياه من الآبار، والتي غالباً ما تكون قد حفرت بشكل غير قانوني. لا يوجد إحصاءات رسمية دقيقة عن هذه الآبار نتيجة انتشارها الكبير والعشوائي، إلا أن تقارير البنك الدولي لعام 2022 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023 تشير إلى وجود حوالي 100 ألف بئر غير مرخصة، في مقابل 15 ألف بئر مرخصة، و4 آلاف بئر تابعة للدولة، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه بين 2020 و2023، كما يشرح أحمد الحاج.
يوجد حوالي 100 ألف بئر غير مرخصة، في مقابل 15 ألف بئر مرخصة، و4 آلاف بئر تابعة للدولة
بحسب فرج الله، عادةً يمكن التقدم إلى وزارة الطاقة والمياه للحصول على رخصة لحفر بئر بعمق يصل إلى 150 متراً، أما إذا تجاوز العمق هذا الحد، فالأمر يصبح أكثر جدية ويتطلّب الحصول على مرسوم جمهوري موقع من رئيس الجمهورية، علماً أن معظم الآبار اليوم تتجاوز عمق 150 متراً، ويتم ضخ كميات هائلة منها. لذلك، فإن مخزون الآبار والمياه الجوفية أصبح مالحاً، خصوصاً في المناطق الساحلية، حيث يقوم أصحاب الصهاريج بحفر الآبار إلى أعماق كبيرة تحت مستوى سطح البحر، ثم يبدأون بسحب المياه. وعندما تصبح المياه مالحة نتيجة طول مدة الضخّ وعمق البئر، يتوقفون عن السحب ويتركون البئر. لذا نجد أن آبار الدامور مثلاً، التي أنشأتها الدولة لتزويد الضاحية الجنوبية وجزء من بشامون ودوحة عرمون وعين الرمانة وفرن الشباك بالمياه، تشهد زيادة مستمرة في ملوحة المياه عاماً بعد عام.
وأشار فرج الله إلى أن بعض بائعي المياه يبيعون مياهاً مأخوذة من آبار ملوثة بمياه الصرف الصحي، ما يجعل من الضروري فحص المياه قبل توزيعها، وإلا فقد تتسبّب الصهاريج التي تنقل هذه المياه بتلويث خزانات المنازل بجميع أنواع الملوّثات والمخاطر المحتملة.
تطوير البنية التحتية لإيقاف الهدر المائي
أشار فرج الله إلى ضرورة الحد من التسريب والهدر في شبكة المياه والاستعمال الجائر لمياه الآبار، من أجل الحفاظ على المخزون، وبدلاً من أن يُفقد 50% أو 60% من المياه في بعض المناطق يمكن خفض نسبة الهدر إلى ما بين 10 و15%، وهي نسبة مقبولة. ويعتقد فرج الله أن بناء السدود يمكن أن يساهم بزيادة القدرة التخزينية، لكنه أوضح أنه في حال جرى تقليص الهدر، فإن حجم السدود المطلوبة سيكون أقل، وكذلك الأكلاف البيئية المترتبة عليها.
وأشارت الأستاذة في قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة البلمند ياسمين جبلي إلى أن تجديد البنية التحتية يعد ضرورة قصوى للحفاظ على مخزون المياه، إذ تُظهر أحدث التقارير أن التسريبات تؤدي إلى فقدان ما بين 40% و48% من المياه، ويشمل تأهيل البنية التحتية تحديث الشبكات وترميم الشعب وتركيب العدّادات لتمكين حساب الاستهلاك بدقة، بالإضافة إلى بناء خزانات لتخزين مياه الأمطار في خلال موسم الشتاء، إلا أن هذه الخطوات تتطلب تمويلاً كبيراً.
تكرير مياه الصرف الصحي
لفتت الدكتورة جبلي إلى أن إحدى الطرق لتوفير المياه تكمن في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وأوضحت أن لبنان ينتج حالياً نحو 600 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي، وإذا تمت معالجة ربع هذه الكمية فقط، سيكون لذلك تأثير إيجابي كبير على تخفيف الضغط على الموارد المائية المستخدمة في قطاع الزراعة.
وأشار المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية إلى أنه لو كانت محطات التكرير - وهي من مسؤولية مؤسسات المياه الأربع - تعمل بشكل كامل لانخفض الضغط على الموارد المائية بنسبة تصل إلى 50%، لأن أكثر من 60% من المياه الصالحة للشرب تُستخدم حالياً في ريّ المزروعات.
ينتج لبنان حالياً نحو 600 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الصرف الصحي، وإذا تمت معالجة ربع هذه الكمية فقط، سيخفف ذلك الضغط على الموارد المائية المستخدمة في قطاع الزراعة
وبحسب جبلي، يجب أن يتم استخدام مياه الصرف الصحي وفق المعايير المطلوبة، التي سبق وضعها بالتعاون بين منظمات مثل «فاو» ووزارة الطاقة والمياه. وتشير منظمة «فاو» الى أن الاستخدام الآمن للمياه المعالجة من الصرف الصحي يتطلب ألا يؤثر على صحة الإنسان، وأن يتم الحفاظ على جودة البيئة على المدى القصير والطويل بمستوى مقبول، وقد أصبحت بالفعل المصدر الرئيس للمياه في الزراعة في الكثير من الدول، مع تراجع مصادر المياه التقليدية عالية الجودة أو تحويلها لاستخدامات أخرى.
إعادة دراسة خريطة لبنان المائية
يعاني لبنان من نقص حقيقي في فهم مصادر مياهه، بما في ذلك المياه الجوفية الكامنة تحت الأرض. يعود آخر تقييم وطني للمياه الجوفية إلى العام 2016، وقد نفّذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالشراكة مع وزارة الطاقة والمياه وبالنيابة عنها، وبتمويل من حكومة إيطاليا. قبل ذلك، كان هناك دراسة وطنية شاملة وحيدة لتقييم المياه الجوفية أُنجزت في العام 1970 بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى برنامج النقطة الرابعة التابع لمكتب الريّ الأميركي في أوائل الثلاثينيات.
وبحسب الدكتورة جبلي، فإن الدراسة الأخيرة بحاجة إلى تحديث، ويمكن الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للقيام بعدد كبير من الدراسات، لاسيما لتحديد المناطق التي تخضع لإعادة شحن المكامن الجوفية المدارة أو Managed aquifer Recharge، المعروفة أيضًا باسم «إعادة تغذية المياه الجوفية» أو «الشحن الاصطناعي»، وتعتمد على الهياكل الصناعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الطبيعية من أجل ضخ المياه إلى المكامن الجوفية بشكل متعمد لاسترجاعها لاحقاً أو لتحقيق فوائد بيئية.
حل أزمة الطاقة
تواجه جميع مؤسسات المياه تحدياً رئيساً يتمثل في تأمين مصادر الطاقة. إذ يعتبر المسؤولين في هذه المؤسسات أن الكثير من خططها غير قابلة للتنفيذ بسبب نقص الكهرباء وفترات الانقطاع الطويلة. فأزمة الكهرباء في لبنان تفرض على مؤسّسات المياه الاعتماد على المولّدات ما يفرض تكاليف إضافية نتيجة استهلاك المحروقات.
في دول أخرى، قد لا يشكّل حل مشكلة الكهرباء تحدياً رئيساً لمعالجة أزمة المياه، بل مجرد حل لمشكلة ظرفية، لكن في لبنان، الذي يعاني من أزمة كهرباء بنيوية، يصبح الوضع مختلفاً تماماً، ما يستدعي من الدولة وضع خطة متكاملة لتوفير الطاقة بشكل مستدام وبتكلفة رخيصة لمؤسسات المياه. وأشارت جبلي إلى أهمية اعتماد محطات الضخّ على مصادر كهرباء غير تقليدية، مثل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. وأفاد جمال شعيب من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن المؤسسة شرعت فعلياً في خطوات للتحوّل إلى الطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد على المولدات، إلا أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير عدد كبير من أنظمة الطاقة الشمسية.
توفير التمويل للمؤسسات
أشارت جبلي إلى «ضرورة تفعيل الإدارات بما في ذلك تفعيل البلديات ومؤسسات المياه، وتمكينها وتحديد المسؤوليات بشكل واضح وتزويد كل مؤسسة بالمعارف اللازمة ليتمكنوا من إدارة خططهم بفعالية، ولكن تحتاج جميع هذه الأمور إلى تمويل»، وهو ما يشكّل أحد المشكلات الرئيسة، إذ أن مؤسسات المياه هي عامة مستقلة، يجري تمويل ميزانياتها من الجباية وليس من الموازنة العامة، فكيف يمكن لهذه المؤسسات تنفيذ الخطط المطلوبة من دون توفير الأموال اللازمة؟ ولماذا لا تقوم الدولة بتمويل الخطط الاستثنائية لضمان وصول الجميع إلى المياه النظيفة والآمنة بأسعار تتناسب مع المداخيل؟