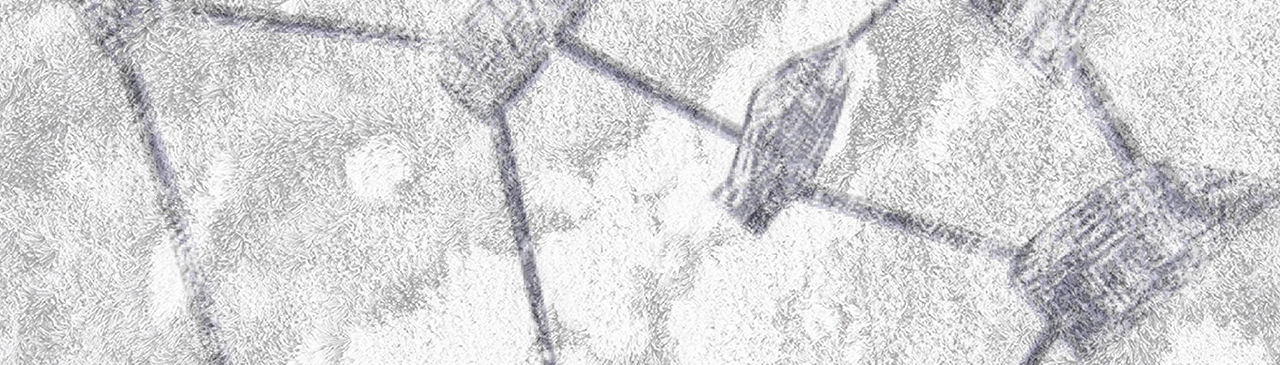
الديمقراطية الجريحة ومسار ترامب نحو الحكم
- مراجعة لكتاب «الكبرياء المسروق» لأرلي راسل هوكشيلد، التي تشرح كيف تحوّل شعور واسع بـ«فقدان الاحترام» بين الأميركيين إلى قوة سياسية غذّت صعود ترامب. فالأزمة، برأيها، ليست اقتصادية فقط بل أزمة كرامة وهوية، إذ جرى تحويل الإحباط الفردي إلى غضب جماعي وولاء لزعيم يجسّد «الكرامة المستعادة».
يواصل كتاب «الكبرياء المسروق» (Stolen Pride) لعالمة الاجتماع الأميركية أرلي راسل هوكشيلد، الصادر عن دار The New Press في العام 2024، مشروعاً بحثياً بدأته الكاتبة منذ ثمانينيات القرن الماضي في تفكيك العلاقة بين العاطفة والسياسة والعمل داخل المجتمع الأميركي. موقع هوكشيلد في علم الاجتماع الأميركي ليس هامشياً، فهي من أبرز من أدخل مفهوم «إدارة العاطفة» إلى النقاش الأكاديمي، وحوّلته إلى أداة لفهم التحولات الاجتماعية. وفي هذا العمل الجديد، لا تكتفي هوكشيلد، بإعادة طرح سؤال الانقسام الاجتماعي، بل تذهب أبعد من ذلك لتكشف كيف أصبحت المشاعر الجريحة، أي شعور الخذلان والغضب وفقدان الاحترام، محرّكاً أساسياً للسياسة في الولايات المتحدة، وكيف مهّد هذا المناخ النفسي لصعود دونالد ترامب إلى السلطة.
ينطلق الكتاب من أطروحة مفادها أن الأزمة الأميركية المعاصرة لا تختزل في فقدان الوظائف أو تفكّك الطبقة الوسطى فحسب، بل في إحساس قطاعات واسعة من السكان بأن كرامتهم سُرقت. لا يرى هؤلاء أنفسهم ضحايا سياسات اقتصادية فقط، بل ثقافية ورمزية أيضاً، ويشعرون أن النخبة الأكاديمية والإعلامية تسخر منهم، وأن القيم التي حملوها جيلاً بعد جيل لم تعد محل اعتبار. هنا تبرز أهمية الهوية والانتماء أكثر من الأجر أو المردود الاقتصادي، فالجرح الأعمق هو جرح الاعتراف. تنقل هذه الرؤية النقاش من مستوى الاقتصاد السياسي إلى مستوى أعمق يتصل بتجارب الحياة اليومية والتمثلات العاطفية ما يمنح الكتاب قوة تفسيرية تتجاوز المقاربات التقنية المعتادة.
ما نراه من انقسامات حادة اليوم ليس وليد اللحظة، بل نتاج تراكم طويل من الإحباطات التي تحوّلت إلى شعور جمعي بالخذلان، وإلى مطالبة صريحة باستعادة الكبرياء المسروق
في هذا السياق، تقدّم هوكشيلد قراءة في ديناميات الغضب الجماعي: وكيف يتحوّل شعور فردي بالازدراء إلى قوة سياسية جماعية. فالطبقات الشعبية التي طالما رأت نفسها عماد الأمة وجدت ذاتها، مع تسارع العولمة والتغير الثقافي، على الهامش. ومع كل تحوّل اقتصادي أو ثقافي ــ من إغلاق المصانع إلى توسع الحقوق المدنية للأقليات ــ ترسخ الإحساس بأنها تُدفع خارج المشهد. لم تبقَ هذه المشاعر مشتتة، بل صيغت في خطاب سياسي قادر على تحويلها إلى مشروع جماعي. ولم يكن ترامب، في هذه المعادلة، مجرد مرشح، بل تجسيد رمزي لجرح جمعي، وقدّم ذاته كمن يستعيد الكبرياء المسلوب.
يبرز تحليل هوكشيلد أن الديمقراطية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث لم يعد الصراع على من يقدّم برنامجاً اقتصادياً أفضل، بل على من يمنح جمهوراً واسعاً شعوراً بالاحترام. وفي هذا المعنى، تصبح الانتخابات منافسة على «من يستعيد الكرامة» لا على «من يدير الاقتصاد». وهو تحول خطير لأن الاعتراف بفئة قد يستلزم نفي الاعتراف بأخرى. فاستعادة الكبرياء الشعبي الأبيض، في خطاب ترامب، ارتبط بتهميش الأقليات والمهاجرين وتصويرهم كسبب الانحدار. وهنا يلتقي التحليل العاطفي مع تحليل السلطة: فالجرح العاطفي لا ينفصل عن آليات الإقصاء وإعادة ترسيم المواطنة.
يتّضح من مسار الكتاب أن هوكشيلد تقسم معالجتها إلى محاور مترابطة: بداية بدراسة الإحباطات الشعبية وتحوّلها إلى إحساس بالخذلان، ثم تحليل كيفية تحويل هذا الإحساس إلى طاقة سياسية عبر الرموز والشعارات، وصولاً إلى لحظة تشكّل علاقة استثنائية بين القاعدة والزعيم. هذه العلاقة قائمة على التماهي الوجداني أكثر مما هي قائمة على العقلانية أو المصلحة المباشرة. قدّم ترامب نفسه بوصفه من يجرؤ على قول ما يعتبرونه «المسكوت عنه»، ومن يتبنى خطاباً غاضباً يشبه غضبهم. ومن هنا نفهم أن صعوده ليس مجرد مصادفة انتخابية، بل نتيجة بنية شعورية تراكمت لعقود.
وفي التحليل الأوسع، يرى الكتاب أن ما يحدث في الولايات المتحدة ليس معزولاً عن موجة عالمية من الشعبويات اليمينية. فالشعور بالكرامة المسروقة نجده في أوروبا أيضاً حيث تشتد الحركات المعادية للهجرة، وفي بلدان أخرى حيث يصوَّر الماضي الذهبي باعتباره مفقوداً ينبغي استعادته. توظف هوكشيلد هذه المقارنة لتبين أن الديمقراطية الليبرالية تواجه أزمة عميقة: كيف يمكنها أن تصمد إذا كانت تُختزل في إدارة الجروح العاطفية بدل إدارة المصالح والسياسات العامة؟
تكمن القيمة الفكرية للكتاب بأنه يدمج بين الإثنوغرافيا العميقة والتحليل النظري. تُظهر المقابلات والقصص الفردية التي تستعرضها الكاتبة أن السياسة ليست بعيدة من تفاصيل الحياة اليومية: الإهانات الصغيرة، الشعور بأن صوتك غير مسموع، أو أن قيمك موضع سخرية. وتتحوّل هذه التفاصيل، التي قد تبدو تافهة، إلى أساس لبناء تحالفات سياسية كبرى. وهنا تكمن براعة هوكشيلد: قدرتها على تحويل العاطفي والشخصي إلى مادة لفهم التحولات التاريخية.
في المحصلة، يقدّم «الكبرياء المسروق» تفسيراً مغايراً لصعود ترامب: ليس مجرد نتاج أزمة اقتصادية أو تلاعب إعلامي، بل نتيجة جرح جمعي في كبرياء قطاعات واسعة من الأميركيين. هذا الجرح، كما تحلل الكاتبة، لم يُلتئم، بل استُثمر سياسياً ليمنح زعيماً مثل ترامب شرعية عاطفية غير مسبوقة. وهو ما يضع الديمقراطية الأميركية أمام سؤال صعب: كيف يمكن أن تُبنى على أساس من الاعتراف المتبادل، في مجتمع يتنازع حول من يستحق الاحترام ومن لا يستحقه؟
الجرح الخفي: من الإحباط الفردي إلى شعور جماعي بالخذلان
يفتتح الفصل الأول من كتاب «الكبرياء المسروق» لعالمة الاجتماع الأميركية أرلي راسل هوكشيلد بمقاربة دقيقة لواحدة من أكثر الديناميات تعقيداً في المجتمع الأميركي المعاصر: كيف يتحوّل الإحباط الفردي، الناتج عن التحولات الاقتصادية والثقافية، إلى شعور جمعي بالخذلان يطال فئات واسعة من المواطنين. ومن هذا المدخل، تكشف هوكشيلد أن ما يبدو مجرد استياء عابر أو حنين إلى الماضي ليس سوى أحد تعبيرات جرح عاطفي عميق يرتبط بفقدان المكانة والاعتراف. هذا الجرح لا يقتصر على فقدان وظائف أو انهيار صناعات، بل يتجلى في الإحساس بأن النظام السياسي والثقافي لم يعد يُنصت لصوتهم ولا يعترف بوجودهم.
في هذا الفصل، تعيد الكاتبة طرح سؤال طالما شغل السوسيولوجيا الأميركية: لماذا يصوّت المهمَّشون ضد مصالحهم الاقتصادية المباشرة؟ الجواب الذي تلمّح إليه هوكشيلد لا ينحصر في الاقتصاد، بل يكمن في السياسات العاطفية للكرامة. فالمسألة عند هؤلاء الناخبين لا ترتبط بالراتب أو الضمان الاجتماعي فحسب، بل بالكرامة التي يشعرون أنها سُرقت منهم. هنا تبرز أطروحة مركزية: الاقتصاد قد يفسر بعض الغضب، لكن فقدان الاحترام والاعتراف يفسر لماذا يتحول هذا الغضب إلى دعم لشخصية مثل دونالد ترامب.
الغضب، حين يُؤطَّر سياسياً، يصبح أداة لتعريف الهوية. فالفرد الذي يشعر أنه غير مرئي يجد في الغضب المشترك وسيلة لتعزيز انتمائه لجماعة جديدة
تستخدم هوكشيلد في عرضها لغة قريبة من الإثنوغرافيا، إذ تستحضر قصصاً ومواقف تعكس كيف يشعر الأفراد في حياتهم اليومية بأنهم مهمَّشون أو موضع سخرية. فالمزارع الذي يرى قريته تُختزل في الخطاب الإعلامي باعتبارها متخلفة، أو العامل الصناعي الذي يُقال له إن مهاراته لم تعد تناسب العصر، لا يعيش خسارة اقتصادية فقط، بل يعيش إهانة رمزية. وتتراكم هذه التجارب اليومية لتشكّل ما يمكن تسميته بنية شعورية، وهي بنية تتجاوز الأفراد لتصبح نمطاً جماعياً. وهنا تلتقي المقاربة العاطفية مع التحليل السياسي: فالإحباط الذي لا يجد منفذاً في السياسات العمومية يتحوّل إلى مادة خام للخطاب الشعبوي.
من الناحية النظرية، يربط الفصل الأول بين فقدان المكانة وصعود السياسات الهوياتية. فالأميركي الأبيض المنتمي إلى الطبقة العاملة، الذي كان يرى نفسه في قلب المشروع الوطني، أصبح يشعر بأن موقعه تراجع أمام صعود أقليات جديدة، نساء مهاجرين وأفارقة وأميركيين من أصول لاتينية. هذا الشعور بالتراجع لا يُقرأ كفقدان للامتيازات فحسب، بل كإقصاء رمزي. قدّم ترامب، بخطابه المبني على «إعادة أميركا إلى عظمتها»، وعداً بإعادة الاعتراف لهؤلاء. وهكذا يتضح أن الشعور بالخذلان لم يكن مجرد استجابة للوضع الاقتصادي، بل كان تربة خصبة لخطاب يستثمر في الجرح العاطفي.
يعالج الفصل أيضاً مسألة التناقض بين الواقع والتمثلات. فالكثير ممن يشعرون بالتهميش لا يعيشون بالضرورة في أسوأ الظروف الاقتصادية، لكنهم يقيسون أوضاعهم مقارنة بما يعتقدون أنهم يستحقونه. هذا البُعد المقارن هو ما يضخّم الإحساس بالظلم: ليس لأن وضعهم كارثي، بل لأنهم يشعرون بأن آخرين يتقدمون عليهم في سلم الاعتراف. وهنا تبرز أهمية التحليل العاطفي، لأن السياسة لم تعد مجرد لعبة مصالح مادية، بل أصبحت أيضاً مسرحاً للتنافس على الرمزية والاحترام.
من زاوية أخرى، يُظهر الفصل كيف أن هذا الشعور بالخذلان يقترن بميل إلى إعادة تأويل التاريخ الشخصي والجماعي. يرى كثيرون في ماضيهم زمناً ذهبياً ضائعاً، سواء كان ذلك الماضي فترة ازدهار المصانع في الخمسينيات أو قوة القيم العائلية التقليدية. وتؤدّي الذاكرة الانتقائية وظيفة مزدوجة: تمنح الأفراد إحساساً بأنهم كانوا يوماً في موقع مركزي، وتغذي فيهم رغبة في استعادة ما فُقد. وهكذا، يتحول الحنين إلى الماضي إلى مطلب سياسي يجد في ترامب ترجمة عملية.
يذهب التحليل أبعد من ذلك حين يبرز أن هذه المشاعر ليست عفوية تماماً، بل يتم تضخيمها وصياغتها عبر وسائل الإعلام وخطاب النخب الشعبوية. على سبيل المثال، أدّى الإعلام المحافظ دوراً أساسياً في إقناع هذه الفئات بأن خسائرها ليست طبيعية، بل نتيجة «سرقة» متعمدة من قبل النخب الليبرالية والمهاجرين. وبهذا يصبح الغضب موجّهاً نحو «الآخر» لا نحو البنية الاقتصادية أو السياسات النيوليبرالية التي أضعفتهم. هذه النقلة في التوجيه السياسي هي التي جعلت من الإحباط قوة انتخابية لصالح ترامب.
ما يميز قراءة هوكشيلد أنها لا تكتفي بالوصف، بل تقدم تفسيراً سوسيولوجياً لآليات التحول من شعور فردي إلى قوة جماعية. فالفرد الذي يشعر بأنه غير مرئي يجد صدى لمشاعره في خطاب سياسي يَعِده بالاعتراف، وحين يرى أن آخرين يشاركونه هذا الإحساس، يتولد لديه شعور بالانتماء إلى جماعة جديدة قائمة على الجرح المشترك. هذا ما يمكن وصفه بـ«الجماعة العاطفية»، أي تلك التي تتأسس على تجارب وجدانية مشتركة أكثر مما تتأسس على مصلحة اقتصادية محددة.
يهيئ هذا الفصل القارئ لفهم الفصول التالية من الكتاب، فهو يقدم البنية الشعورية التي ستتم إعادة تفعيلها لاحقاً في تحليل الخطاب الشعبوي وفي العلاقة الاستثنائية بين ترامب وقاعدته. إذا كان الفصل الأول قد رسم خريطة الجرح العاطفي، ستُظهر الفصول القادمة كيف يتم تحويل هذا الجرح إلى طاقة سياسية، وكيف يُعاد إنتاجه عبر مؤسسات الإعلام والثقافة والسياسة. وبهذا المعنى، يشكّل الفصل الأول أساساً لا غنى عنه: إنه يبيّن أن ما نراه من انقسامات حادة اليوم ليس وليد اللحظة، بل نتاج تراكم طويل من الإحباطات التي تحوّلت إلى شعور جمعي بالخذلان، وإلى مطالبة صريحة باستعادة الكبرياء المسروق.
من الغضب الكامن إلى القوة السياسية: صناعة خطاب الكبرياء
ينتقل الفصل الثاني من كتاب «الكبرياء المسروق» من تشخيص الجرح العاطفي الذي يعيشه جزء واسع من المجتمع الأميركي إلى تحليل كيفية تحويل هذا الجرح إلى خطاب سياسي جماعي. فإذا كان الفصل الأول قد ركّز على الإحساس بالخذلان وفقدان الاحترام، يوضح هذا الفصل الكيفية التي يصبح بها الغضب الكامن مادة خام لصناعة سياسة هوية جديدة، حيث تتقاطع العاطفة مع الرمزية لتنتج قوة انتخابية هائلة.
ترى هوكشيلد أن الغضب الشعبي لا يتحول تلقائياً إلى حركة سياسية، بل يحتاج إلى وسطاء قادرين على صياغة المشاعر في شكل سردية جامعة. وهنا يظهر دور الزعيم الشعبوي، ووسائل الإعلام، والشبكات الاجتماعية في تحويل الإحباطات الفردية إلى قصة كبرى عن الظلم والسرقة. الخطاب الذي يعلن أن «أمريكا سُرقت» أو أن «المواطن العادي أُقصي عمداً» يعمل كإطار تأويلي يوحّد مشاعر متفرقة تحت لافتة سياسية واحدة. وهكذا، يوضح الفصل أن قوة ترامب لم تكن في وعوده الاقتصادية فقط، بل في قدرته على ترجمة مشاعر الخذلان إلى لغة جماعية تمنح أتباعه إحساساً بأنهم جزء من حركة تستعيد الاعتراف.
من الناحية التحليلية، يشدّد هذا الفصل على أن الغضب ليس عاطفة محضة، بل هو إنتاج اجتماعي. فهو يولد من مقارنات مستمرة: لماذا نحصل على أقل بينما يحصل الآخرون على أكثر؟ لماذا يتم السخرية منا بينما يُحتفى بغيرنا؟ هذه المقارنات لا تُصاغ في فراغ، بل تُبنى عبر رسائل متكررة في الإعلام والسياسة. فالقنوات المحافظة، مثل فوكس نيوز، كرّست سردية مفادها أن الطبقة العاملة البيضاء تُدفع خارج مسرح التاريخ، وأن النخب الليبرالية والمهاجرين والأقليات هم المستفيدون على حسابها. هذا التضخيم المستمر لمشاعر الإقصاء حوّل الغضب من تجربة شخصية إلى موقف أيديولوجي، يتميز بالعداء الصريح تجاه النخب والمؤسسات.
إحدى الأفكار الجوهرية التي يعالجها الفصل الثاني هي أن الغضب، حين يُؤطَّر سياسياً، يصبح أداة لتعريف الهوية. فالفرد الذي يشعر أنه غير مرئي يجد في الغضب المشترك وسيلة لتعزيز انتمائه لجماعة جديدة. تشير هوكشيلد هنا إلى أن الغضب ليس رد فعل على خسارة فقط، بل هو وسيلة لإعادة تعريف الذات: «نحن من تم استبعادهم، ونحن من سيستعيد كبرياءه». بهذا المعنى، يصبح الغضب رابطاً اجتماعياً، ويؤدي وظيفة شبيهة بالديناميات التي درسها دوركهايم عن الطقوس الجمعية، حيث الشعور المشترك يخلق هوية جمعية متماسكة.
إضافة إلى ذلك، يوضح الفصل كيف يتم إعادة توجيه الغضب بعيداً عن البنى الاقتصادية المسؤولة عن التهميش (كالعولمة والنيوليبرالية)، ليُسقط على «أعداء» أقرب: المهاجرون، النخب الثقافية، الصحافة، وحتى جيران من خلفيات مختلفة. هذه الآلية، التي يسميها بعض المنظّرين «تحويل اللوم»، تعمل على إعادة ترتيب الحقل السياسي بحيث يصبح الصراع قائماً ليس بين الطبقات الاجتماعية التقليدية، بل بين «الشعب الحقيقي» و«أعدائه». نجح ترامب في تجسيد هذا الانقسام حين صاغ نفسه بوصفه صوت «الأميركي الصادق» في مواجهة «المؤسسة الفاسدة». وهكذا، تُحوَّل الغضبة الفردية إلى مشروع سياسي يَعِد بإعادة الكرامة عبر مواجهة رمزية مع خصوم محددين.
السياسة ليست مجرد صراع على الموارد أو المؤسسات، بل أيضاً على الحواس والمعايير الثقافية: ما نعتبره لائقاً أو مبتذلاً، راقياً أو رديئاً، وما نشعر حياله بالاعتزاز أو بالاشمئزاز
يتوقف الفصل أيضاً عند الجانب المسرحي للغضب السياسي. فالغضب لا يُعاش داخلياً فقط، بل يُعرض ويُؤدى في تجمعات انتخابية وخطابات عامة. هذه العروض الجماعية، حيث يصرخ الجمهور بشعارات مثل «أعيدوا لنا بلدنا» أو «اطردوا النخب الفاسدة»، ليست مجرد مظاهر سطحية، بل لحظات تكثيف للهوية الجمعية. تبيّن هوكشيلد أن هذه الطقوس الجماهيرية تمنح المشاركين إحساساً بالتحرر من التهميش، وتجعلهم يختبرون القوة في الفعل الجماعي. بهذا، يصبح الغضب ممارسة سياسية بحد ذاته، لا مجرد إحساس سلبي.
من زاوية نقدية، يشير الفصل إلى المخاطر الكامنة في هذا التحول: فحين يصبح الغضب هو الرابط الأساسي للجماعة، يتم إقصاء كل من لا يشارك فيه. هذا يعني أن الديمقراطية، التي تقوم على التعددية والاعتراف المتبادل، تتحول إلى ساحة استقطاب حاد، حيث لا مكان للتسويات. وهنا يكمن ما تسميه هوكشيلد أزمة الديمقراطية العاطفية: حين تتحول المشاعر إلى معيار للشرعية السياسية، يصبح الحوار مستحيلاً، لأن الآخر يُختزل في كونه سبباً للغضب.
يهيئ هذا الفصل القارئ لفهم كيف ستتطور هذه الديناميات في الفصول اللاحقة. فإذا كان الفصل الأول قد كشف الجرح العاطفي، فإن الفصل الثاني يوضح آلية تضخيمه وتحويله إلى سردية سياسية. أما الفصول التالية فستتعمّق في كيفية تجسيد ترامب لهذه السردية، وكيف بنى علاقة وجدانية مع قاعدته، ثم كيف أعادت هذه العلاقة تشكيل المشهد الديمقراطي الأميركي بأسره. وبذلك، يشكّل الفصل الثاني حلقة وسيطة أساسية: إنه يرسم المسار من الجرح الفردي إلى الهوية الجمعية الغاضبة، ويضع الأساس لفهم كيف يمكن لزعيم واحد أن يركب موجة المشاعر ليصل إلى سدة الحكم.
الذوق والاشمئزاز: حين تتحوّل الحواس إلى حدود سياسية
في الفصل الثالث من الكتاب، تذهب أرلي راسل هوكشيلد خطوة أبعد في تحليلها، لتُبيّن أن الانقسام الأميركي المعاصر لا يتغذى من الجراح الاقتصادية أو من الغضب الجماعي فقط، بل يجد جذوره أيضاً في تفاصيل تبدو «بريئة» مثل الذوق واللغة والأشكال الجمالية للحياة اليومية. الفكرة الجوهرية في هذا الفصل أن السياسة ليست مجرد صراع على الموارد أو المؤسسات، بل أيضاً على الحواس والمعايير الثقافية: ما نعتبره لائقاً أو مبتذلاً، راقياً أو رديئاً، وما نشعر حياله بالاعتزاز أو بالاشمئزاز.
تستند هوكشيلد هنا إلى تقليد سوسيولوجي يعود إلى بيير بورديو وكتابه La Distinction، لكنها تضيف إليه بعداً عاطفياً وحسّياً لم يُمنح في الدراسات الكلاسيكية الاهتمام الكافي. فبينما ركّز بورديو على الذوق باعتباره أداة لإعادة إنتاج الطبقات الاجتماعية، تكشف هوكشيلد أن الاشمئزاز (disgust) يؤدّي دوراً محورياً في ترسيم الحدود السياسية في أميركا اليوم. فالطبقة العاملة البيضاء، التي طالما كانت موضع سخرية من النخب الثقافية، لم تعد ترى في الاستهزاء بموسيقاها أو مأكولاتها أو لهجتها مجرد نكتة عابرة، بل إهانة تمس كرامتها. ويخلق هذا الاشمئزاز المتبادل هوة ثقافية تتحوّل بسرعة إلى هوة سياسية.
يوضح الفصل أن الشعور بالازدراء لا يسير في اتجاه واحد. فكما تشعر الطبقات الشعبية بأن النخبة تحتقرها، ترى النخبة أن سلوكيات هذه الطبقات ومواقفها السياسية تثير اشمئزازها أيضاً. فأسلوب ترامب المباشر والفجّ، الذي قد يبدو مبتذلاً لليبراليين، اعتبره أنصاره صادقاً و«غير متكلّف». هنا تتجسد سياسات الذوق: ما يُعد دليلاً على الفجاجة عند فئة، يُقرأ كدليل على الأصالة عند فئة أخرى. وهكذا تتحوّل اللغة الجسدية، طريقة الأكل واللباس، وحتى الذوق الموسيقي، إلى رموز تحدّد الانتماء السياسي.
أحد أهم محاور الفصل هو أن هذه الانقسامات الحسية ليست سطحية، بل تعمل كآليات لإعادة إنتاج اللامساواة. فحين تُقدَّم الطبقة العاملة البيضاء في الإعلام بوصفها «جاهلة» أو «بذيئة»، يعمّق ذلك شعورها بأنها غير معترف بها، ويجعلها تبحث عن قائد يعكس أسلوبها في الكلام والتصرف. ترامب، في هذا السياق، لم يكن سياسياً فقط بل أداءً جمالياً: نبرة صوته العالية، عباراته البسيطة، سخريته من الخصوم، كلها شكلت مسرحية جمالية تُعيد الاعتبار لجمهوره. وهكذا يصبح الذوق السياسي متشابكاً مع الذوق الثقافي، وتتحوّل الحواس إلى ساحة صراع اجتماعي.
من الناحية التحليلية، يربط الفصل بين العاطفة والحسّ الجمالي. فالاشمئزاز ليس شعوراً فردياً بريئاً، بل هو أداة قوية لترسيم من ينتمي ومن يُقصى. حين يقول مواطن من القاعدة الشعبية إن «الليبراليين يثيرون اشمئزازي» أو حين يعبّر ليبرالي عن امتعاضه من «بدائية» خطاب ترامب، فإن ذلك لا يصف إحساساً ذاتياً فقط، بل يرسم خطاً فاصلاً بين «نحن» و«هم». وتخلق هذه الخطوط الحسية، التي تبدو غير سياسية، واقعاً سياسياً متشدداً، حيث يصبح الحوار بين الطرفين شبه مستحيل.
يتوقف الفصل أيضاً عند دور الإعلام والثقافة الشعبية في تضخيم هذه الفواصل. فبرامج السخرية السياسية التي تستهزئ بلهجة الريف الأميركي أو بأسلوب حياة العمال، تسهم من حيث لا تدري في تعزيز سردية «الاحتقار». وعلى الجانب الآخر، يرد الإعلام المحافظ بتضخيم كل مظهر من مظاهر «التحلل الثقافي» لدى الليبراليين بوصفه دليلاً على فساد النخبة. وبهذا، تتحوّل الشاشة إلى مرآة مزدوجة تعكس الاشمئزاز المتبادل وتعمّقه، فتزيد الهوة بين المجموعتين.
إحدى المساهمات المهمة لهذا الفصل هي إبراز أن الاشمئزاز ليس شعوراً سلبياً فقط، بل هو شعور منتج سياسياً. فهو لا يعبّر عن رفض الآخر فقط، بل يخلق هوية صلبة للجماعة التي تشترك في هذا الرفض. أنصار ترامب، على سبيل المثال، لم يجدوا في ازدراء النخبة لهم سبباً للانسحاب، بل سبباً للتماسك. لقد حوّلوا الشعور بالاشمئزاز من الآخر إلى مصدر فخر: «إذا كانوا يسخرون منا، فهذا لأننا نحن الشعب الحقيقي وهم أقلية متعالية». وهذه الآلية، التي تحوّل الإهانة إلى قوة، هي ما تفسّر جزئياً صلابة القاعدة الانتخابية لترامب على الرغم من كل الفضائح السياسية.
من منظور أوسع، يشير الفصل إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة ليس فريداً، بل يعكس ظاهرة عالمية حيث الذوق والاشمئزاز يتحوّلان إلى أدوات سياسية. ففي أوروبا، كثيراً ما تُستخدم الصور النمطية حول طعام المهاجرين أو لباسهم لإعادة إنتاج خطاب قومي شعبوي. وفي بلدان أخرى، نجد أن الاشمئزاز من ممارسات ثقافية معينة توظَّف لترسيم الهوية الوطنية. بهذا، يضع الكتاب الحالة الأميركية في إطار مقارن يكشف عن أن الحواس ليست بريئة، بل هي جزء من بنية السلطة.
يمهّد هذا الفصل لما سيأتي لاحقاً في الكتاب، حيث تتضح كيفية تجسيد ترامب لهذه «السياسات الحسية» بشكل ممنهج. فإذا كان الفصل الأول قد كشف الجرح العاطفي، والفصل الثاني قد شرح ديناميات الغضب السياسي، فإن الفصل الثالث يبين أن الصراع على الكبرياء المسروق يمر أيضاً عبر الحواس والذوق. وهو ما يجعل السياسة المعاصرة أكثر تجذّراً في الحياة اليومية، وأكثر صعوبة على التحليل الذي يقتصر على الأرقام أو المصالح الاقتصادية. إننا أمام عالم تُدار فيه السلطة عبر ما نشعر به، وما نعتبره لائقاً أو مقيتاً، حيث يتحوّل الاشمئزاز إلى سلاح انتخابي، والذوق إلى بطاقة هوية سياسية.
الزعيم كمرآة للجراح: تشكّل العلاقة الوجدانية بين ترامب وقاعدته
في الفصل الرابع من كتاب «الكبرياء المسروق»، تنتقل أرلي راسل هوكشيلد إلى تحليل العلاقة الخاصة التي نشأت بين دونالد ترامب وقاعدته الشعبية، باعتبارها علاقة وجدانية قبل أن تكون سياسية أو أيديولوجية. إذا كان الكتاب قد أوضح في فصوله السابقة أن الجرح العاطفي والاشمئزاز والذوق يشكّلون خلفية صلبة لفهم الانقسامات الأميركية، يبيّن هذا الفصل كيف تحوّل ترامب من مجرد مرشح سياسي إلى رمز عاطفي، يوفّر لجمهوره ما يفتقدونه: الاعتراف، الاحترام، والإحساس بالكرامة المستعادة.
العلاقة بين ترامب وقاعدته لم تكن قائمة على الثقة العقلانية، بل على الولاء العاطفي. كثيرون كانوا يعلمون أن وعوده قد لا تتحقق، لكنهم ظلوا مخلصين له لأنه جسّد مشاعرهم
ترى هوكشيلد أن قوة ترامب لا تكمن في برامجه أو وعوده فقط، بل في قدرته على تجسيد مشاعر الغضب والخذلان التي تعتمل في قلوب أنصاره. فقد كان يتحدث بلغة قريبة منهم، لا من حيث المعجم فقط، بل من حيث الأداء الجسدي والنبرة والإيقاع. كل إهانة يوجهها لخصومه كانت تُستقبل على أنها إهانة باسمهم، وكل سخريته من النخب الليبرالية كانت تُقرأ كتعبير عن سخريتهم المكبوتة. هكذا تحوّل ترامب إلى مرآة جماعية، تعكس مشاعر أنصاره وتضخّمها، بحيث وجد كل فرد في القاعدة نفسه حاضراً في شخصية الزعيم.
يسلّط الفصل الضوء على التبادل العاطفي بين القاعدة والزعيم. لم يكتفِ ترامب بتلقّي مشاعر الغضب، بل أعاد إنتاجها في خطابه وصاغها بلغة أكثر كثافة. مثّلت التجمعات الانتخابية مسرحاً لهذا التبادل: تأتي الحشود محمّلة بالاستياء، ويُعيد الزعيم صياغته كقوة هجومية ضد الخصوم. جعل هذا التفاعل العلاقة أشبه بعلاقة وجدانية متبادلة: يغذي الزعيم جمهوره بمشاعر القوة، والجمهور ويمنح الزعيم شرعية عاطفية متجددة. وهكذا، تشكّل ما يمكن تسميته باقتصاد العاطفة السياسية، حيث التداول ليس للسلع أو الأصوات فقط، بل للمشاعر.
من الناحية السوسيولوجية، يُبرز هذا الفصل أن القاعدة لم تعد ترى ترامب سياسياً تقليدياً، بل مُجسِّداً للذات الجمعية. لقد قدّم نفسه بوصفه من يتعرّض للازدراء نفسه الذي يعانونه: عندما هاجمته الصحافة أو المؤسسات، رأى أنصاره في ذلك هجوماً عليهم. وعندما سخرت النخب من أسلوبه، شعروا أن السخرية موجّهة إليهم. هذه العلاقة القائمة على التماهي الوجداني جعلت من الدفاع عن ترامب دفاعاً عن النفس، ومن كل نقد له دليلاً إضافياً على «المؤامرة» ضد القاعدة الشعبية.
يذهب الفصل أيضاً إلى تحليل الرمزية الجمالية لشخصية ترامب: مظهره، لغته المباشرة، أسلوبه المسرحي، كلها عناصر عززت صورته كزعيم «خارج النظام» وغير خاضع لقواعد النخب. حتى تصرفاته التي اعتبرها خصومه فضائح أو تجاوزات، تحوّلت لدى أنصاره إلى علامات على صدقه وعفويته. وبهذا، لم يكن ترامب سياسياً يقول ما يريدون سماعه فقط، بل كان أيضاً يؤدي شخصيته بطريقة تُشعرهم أن الكرامة المستعادة ليست وعداً مجرداً، بل تجربة حية يعيشونها معه في كل ظهور علني.
أحد الأبعاد المهمة التي يتوقف عندها هذا الفصل هو أن العلاقة بين ترامب وقاعدته لم تكن قائمة على الثقة العقلانية، بل على الولاء العاطفي. كثيرون كانوا يعلمون أن وعوده قد لا تتحقق، لكنهم ظلوا مخلصين له لأنه جسّد مشاعرهم. هنا تستحضر هوكشيلد مفاهيم من علم الاجتماع السياسي عن «الكاريزما» (في التقليد الفيبري)، لكنها تضيف إليها بعداً عاطفياً: الكاريزما ليست فقط قدرة الزعيم على الإقناع، بل هي أيضاً قدرة على تمثيل الجرح العاطفي لجماعة بأكملها.
يبيّن الفصل كذلك أن هذه العلاقة الوجدانية ساهمت في إعادة تعريف الديمقراطية. لم تعد المسألة منافسة بين برامج سياسية، بل بين زعيم يجسّد مشاعر جماعة واسعة وخصوم يُنظر إليهم كرموز للاحتقار. جعل هذا التغيير الديمقراطية الأميركية تنزلق نحو ما يمكن وصفه بـ«ديمقراطية التماهي العاطفي»، حيث الشرعية تُبنى على الشعور بالانتماء إلى القائد أكثر مما تُبنى على النقاش العقلاني أو المؤسسات.
من زاوية نقدية، تحذر هوكشيلد من المخاطر الكامنة في هذه الصيغة: فعندما تصبح السياسة قائمة على علاقة وجدانية شبه شخصية بين القاعدة والزعيم، تُضعف المؤسسات، ويصبح كل خلاف مع الزعيم خيانة للجماعة. وهذا ما يفسر لماذا ظل أنصار ترامب متمسكين به حتى في أحلك اللحظات السياسية، معتبرين أن أي هجوم عليه هو في جوهره هجوم عليهم. العلاقة إذن ليست انتخابية ظرفية، بل عقد عاطفي طويل المدى.
يمهّد هذا الفصل للفصول اللاحقة التي ستحاول الإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: ما الذي يحدث للديمقراطية عندما تُبنى على جراح الكرامة وعواطف الاشمئزاز والولاء الوجداني؟ إذا كان الفصل الأول قد كشف الجرح، والثاني قد شرح ديناميات الغضب، والثالث قد أبرز دور الحواس والذوق في ترسيم الحدود، فإن الفصل الرابع يوضح كيف أن هذه العناصر جميعاً وجدت في ترامب نقطة تركيز، فصار الزعيم نفسه الترجمة المجسدة للكبرياء المسروق. وبذلك، يرسم الكتاب لوحة متكاملة عن التحولات الخطيرة التي تمس صميم الديمقراطية الأميركية.
الديمقراطية على محك الجراح: آفاق السياسة الأميركية بعد الكبرياء المسروق
في الفصل الخامس من كتاب «الكبرياء المسروق»، تبلغ أرلي راسل هوكشيلد ذروة تحليلها حين تطرح السؤال الأكثر إلحاحاً: ما الذي يحدث للديمقراطية الأميركية عندما تُبنى على جراح الكرامة أكثر مما تُبنى على النقاش العقلاني أو البرامج السياسية؟ بعد أن تتبّعت الكاتبة مسار تشكّل الجرح العاطفي (الفصل الأول)، وتحويله إلى غضب سياسي (الفصل الثاني)، وتغذيته عبر الذوق والاشمئزاز (الفصل الثالث)، وتجسده في علاقة وجدانية بين القاعدة وزعيمها (الفصل الرابع)، يجيء هذا الفصل ليُظهر أن النتيجة ليست صعود ترامب فقط، بل إعادة تعريف الديمقراطية ذاتها على أسس عاطفية وهوياتية جديدة.
الفكرة المركزية هي أن السياسة الأميركية تحوّلت من كونها منافسة بين مشاريع إلى كونها منافسة على من يمنح الاعتراف والاحترام لجماعة بعينها. الديمقراطية، في معناها التقليدي، تقوم على التعددية والتسويات؛ لكن حين تصبح المشاعر الجريحة هي المحرك الأساسي، يذوب منطق التفاوض لصالح منطق الاستقطاب. كل طرف يرى في الطرف الآخر ليس مجرد خصم سياسي، بل تهديداً لكرامته ووجوده. بهذا، تتحول الديمقراطية إلى ساحة معارك رمزية حيث الاعتراف الممنوح لفئة يعني بالضرورة نفي الاعتراف عن أخرى.
توضح هوكشيلد أن هذه الصيغة من الديمقراطية العاطفية تجعل النظام السياسي هشاً على مستويين. من جهة أولى، تُضعف الثقة في المؤسسات، لأن القاعدة ترى أن الشرعية تأتي من الزعيم لا من القواعد الديمقراطية. ومن جهة ثانية، تفتح الباب أمام تآكل العقد الاجتماعي، إذ يصبح الانتماء الوطني مشروطاً بالموقف من جماعة بعينها. فأنصار ترامب لا يرون أنفسهم مجرد ناخبين، بل «الأميركيين الحقيقيين»، مقابل آخرين يُصوَّرون كدخلاء أو فاسدين أو غير مستحقين. هذه الثنائية تهدد مفهوم المواطنة الشاملة، وتحول الديمقراطية إلى لعبة صفرية لا رابحين فيها على المدى البعيد.
يبرز الفصل الخامس أيضاً أن هذا التحول ليس عابراً، بل يمثل نموذجاً سياسياً جديداً قد يستمر حتى بعد ترامب. لقد نجحت الشعبوية اليمينية في بناء سردية متماسكة عن الكرامة المسروقة، وهي سردية قادرة على إعادة إنتاج نفسها عبر وسائل الإعلام والسياسة المحلية والانتخابات القادمة. وهكذا، لا ينتهي الكتاب عند تفسير ظاهرة ترامب، بل يفتح النقاش حول مستقبل الديمقراطية الأميركية في ظل «تأميم» الجرح العاطفي وتحويله إلى أيديولوجيا.
إحدى النقاط القوية في تحليل هوكشيلد هي تأكيدها على أن الديمقراطية لا تفقد فقط فعاليتها المؤسسية، بل تفقد أيضاً قدرتها على إنتاج الثقة بين المواطنين. فعندما تُختزل السياسة في منطق «نحن ضد هم»، يتراجع التضامن الوطني، ويصبح العيش المشترك أكثر هشاشة. هذا ما تسميه هوكشيلد بـ«أزمة الاعتراف المتبادل»، حيث كل جماعة تشعر أن الأخرى تزدريها أو تهدّد مكانتها. هنا يتضح أن الكرامة ليست مجرد إحساس فردي، بل شرط لبقاء الديمقراطية نفسها.
حين تصبح المشاعر الجريحة هي المحرك الأساسي، يذوب منطق التفاوض لصالح منطق الاستقطاب. كل طرف يرى في الطرف الآخر ليس مجرد خصم سياسي، بل تهديداً لكرامته ووجوده
يتناول الفصل الخامس كذلك المخاطر المترتبة على تدويل هذه الصيغة. فالشعبويات في أوروبا وأميركا اللاتينية وأماكن أخرى تستلهم الديناميات نفسها: تحويل الإحباط إلى غضب، والغضب إلى خطاب هوية، ثم بناء زعيم كاريزمي يجسد الكبرياء المستعاد. هذا يجعل من التجربة الأميركية مختبراً عالمياً لفهم كيف يمكن للديمقراطية أن تنقلب إلى ضدها حين تُختزل في إدارة الجراح العاطفية.
لكن هوكشيلد لا تكتفي بالتشخيص، بل تطرح أسئلة مفتوحة: هل يمكن إعادة بناء الديمقراطية على أساس من الاعتراف المتبادل بدل الاعتراف الانتقائي؟ هل يمكن للسياسات العامة أن تعالج الجروح بدل أن تستثمر فيها؟ هل يكفي الاقتصاد وحده لردم الهوة إذا ظل الشعور بالازدراء الثقافي قائماً؟ هذه الأسئلة تجعل من الكتاب ليس فقط قراءة في الماضي القريب، بل دعوة إلى التفكير في مستقبل يتجاوز ترامب.
من الناحية السوسيولوجية، يُظهر هذا الفصل بوضوح أن المشاعر ليست هامشية، بل هي بنية تحتية للديمقراطية المعاصرة. فقدرة النظام على الاستمرار لا تتوقف فقط على الانتخابات أو فصل السلطات، بل أيضاً على ما إذا كان المواطنون يشعرون أن أصواتهم محترمة وأن حياتهم معترف بها. وإذا غاب هذا الشعور، فإن الديمقراطية تُفرغ من مضمونها حتى وإن بقيت آلياتها الشكلية قائمة.
بهذا، يختتم الفصل الخامس مسار الكتاب بتأكيد أن ما هو على المحك ليس مصير زعيم واحد ولا حزب بعينه، بل مستقبل الديمقراطية الأميركية. فالكرامة المسروقة التي حللتها هوكشيلد ليست مجرد استعارة، بل حقيقة اجتماعية وسياسية تهدد أسس النظام برمته. إنها كناية عن أزمة عميقة حيث يصبح الاعتراف ندرةً، والاحترام عملةً سياسية، والجرح العاطفي مورداً يُستثمر انتخابياً. هذه اللوحة المقلقة تمهّد للنقاشات الأوسع حول الحاجة إلى إعادة تصور الديمقراطية بحيث تُبنى على الاعتراف الشامل لا على إقصاء الآخر.
وبذلك، لا يُغلق الكتاب على خلاصة مريحة، بل على دعوة إلى مواجهة صعبة: إما أن تتعلم الديمقراطية كيف تعالج جراح الكبرياء وتمنح الاعتراف للجميع، أو أن تستمر في الانقسام حتى الانهيار. وهنا تكمن القيمة الحقيقية لـ «الكبرياء المسروق»: إنه ليس فقط تحليلاً لصعود ترامب، بل إنذاراً مبكراً لما يمكن أن يحدث إذا تُركت الجروح العاطفية من دون التئام.


