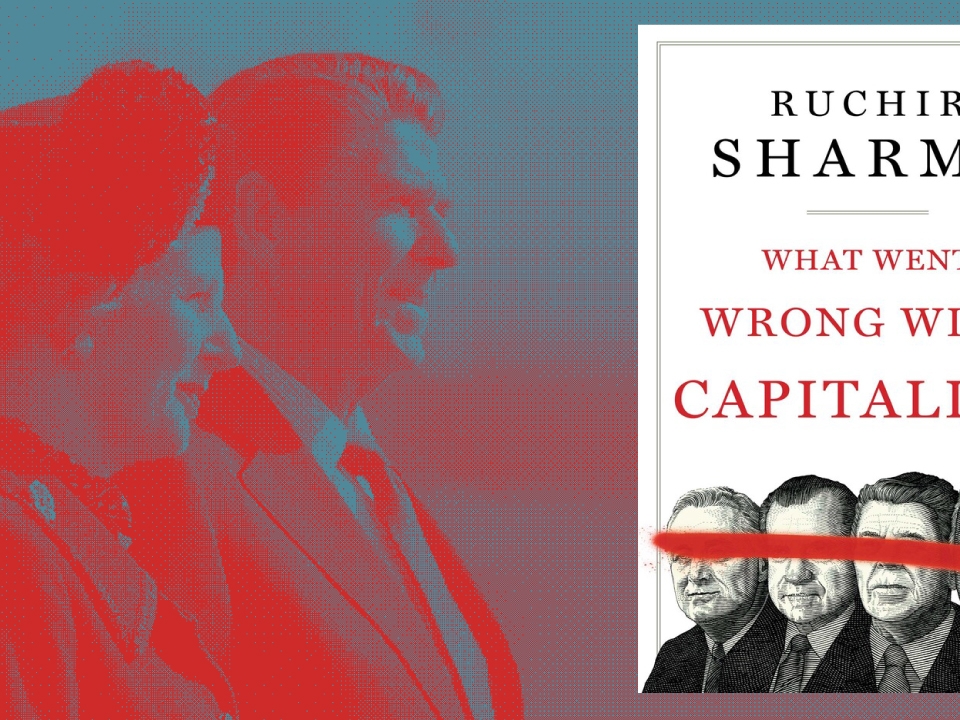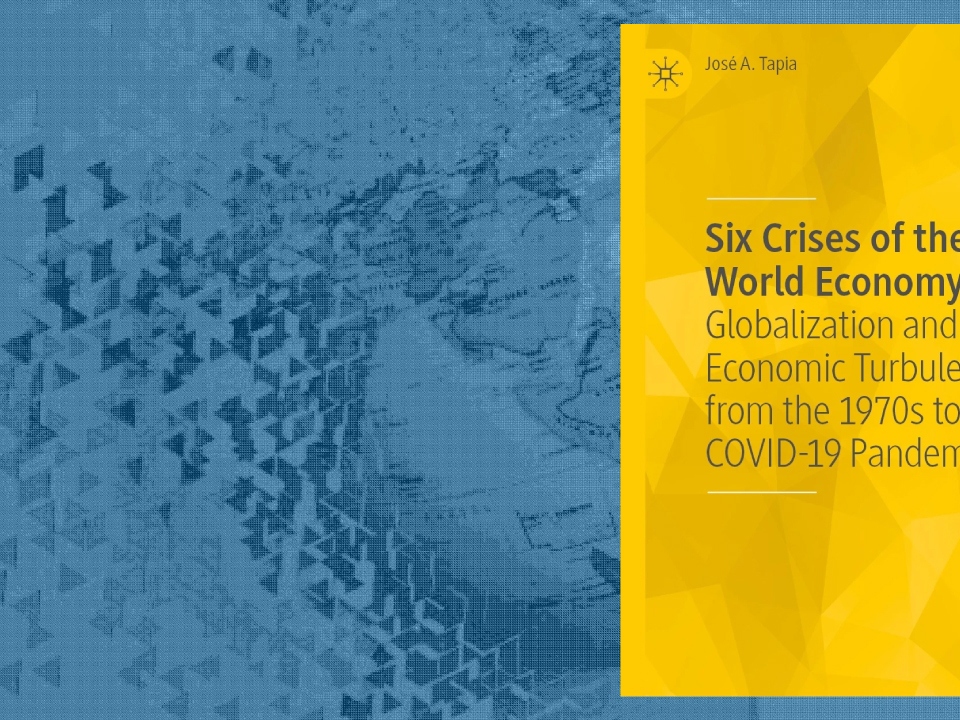الاقتصاد السياسي للحب في ظل الرأسمالية
- يمثل التدفق المتبادل مكوّناً رئيساً للحب، لكن الرأسمالية تقضي عليه. ويلاحظ حتى أغنى أعضاء مجتمعنا خفوته. يشتري الأغنياء قدراً لا ينتهي من انتباه الآخرين وعاطفتهم، لكنّ المال مهما بلغ يعجز عن شراء تجربة الانغماس الكامل في دورة طبيعية من العطاء والأخذ غير النفعي، لكونها في جوهرها غير نفعية.
- يغدو الكادحون في ظل نظام تعلو فيه القيم التبادلية على القيم الاستعمالية «سجناء أنانيتهم من دون علْم؛ فيشعرون بانعدام الأمان والوحدة والحرمان من الاستمتاع البريء والبسيط وغير المتكلف بالحياة».
أبتاع كوباً كلما استقرّ بي المقام في ألمانيا. يقتضي هذا عادة التوجّه إلى أقرب متجر تي كي ماكس، فأشتري كوباً ضخماً بـ4 يوروهات يكفي شاي الأعشاب الخاصّ بي. تعجز الأكواب الأوروبية المنمقة الموجودة في مسكني المفروش عن استيعاب كمياتي المرغوبة من المشروبات. معاييري بسيطة: الحجم والمتانة. لا أبالي بشكل الوعاء ولا بمصنّعه. وبمصطلحات ماركس، لا تعنيني سوى قيمته الاستعمالية.
أما لو شئت الظهور بمظهر الأناقة أو مواكبة الموضة، فبإمكاني شراء كوب هيرميس من طراز «H Déco Rouge No. 1» بسعر 125 يورو. قد يرفع احتساء منقوع الزنجبيل في هذه القطعة الخزفية الفاتنة قيمتي الاجتماعية في عيون خبراء أدوات المائدة، غير أنّ قيمته الاستعمالية تبقى ثابتة: احتواء الشاي. وبالعودة إلى المصطلحات الماركسية، تمثّل الـ121 يورو الإضافية لقاء كوب هيرميس الفارق في قيمتهما التبادلية بصفتهما سلعتين.
حين يناقش كارل ماركس الفارق بين القيمتيْن الاستعمالية والتبادلية، يحيل إلى الأشياء المادية الملبّية لرغبات الإنسان واحتياجاته، وهذه لا تصير سلعاً إلّا عبر تداولها في السوق. في العام 1857، ضرب مثلاً بالقمح، إذ يمتلك القيمة الاستعمالية ذاتها سواء زرعه العبيد أو الأقنان أو الأحرار. ولن يفقد قيمته الاستعمالية ولو هطل من السماء كالثلج. فكيف تنقلب القيمة الاستعمالية سلعة؟ [حين تغدو] وعاءً للقيمة التبادلية.
ومن صميم الرأسمالية، بصفتها نظاماً اقتصادياً، تحويلُ الأشياء ذات القيمة الاستعمالية (وهذه في الغالب وفيرةً ومجانية) إلى أشياء ذات قيمة تبادلية؛ أي سلع شحيحة يجب على الناس الدفع لقاءها.
والحبّ يمتلك بالمثل، على الرغم من كونه شيئاً غير مادي، قيمة استعمالية توجد خارج علاقات التبادل الاجتماعية الحاكمة للمجتمعات الرأسمالية. بذل معظمنا - إنْ لم نكن كلنا - الحبّ وتلقاه، وغالباً ما بدأ ذلك من الطفولة في كنف عائلاتنا، نشعر بالرعاية والاعتراف ممّن حولنا. منح هذه المشاعر الأهمّ واستقبالها ضرورة للازدهار البشري، كالحاجة للغذاء والماء والمأوى. ومن هنا ينبثق لزوم حضوره البارز في أي برنامج سياسي للتحول الاشتراكي. لكن إذا أردنا صياغة تحليل اشتراكي للحب وسياسة له، فيجب فهْم كيف يسلبنا نظامنا الاقتصادي الحالي الوقت والطاقة اللازمين لبذل الحب وتلقيه.
ارتبط تجاهل الزملاء للشخص «ارتباطاً سلبياً بصحته الجسدية ومواقفه المتعلقة بالعمل ومعدل تركه للوظيفة، فاق ارتباط التحرش بها»
ولتبيان الفارق بين القيمة الاستعمالية والتبادلية للحب، أقترح انطواء «الحب» على 3 أركان متمايزة على الأقل: الانتباه، والعاطفة، والتدفق المتبادل. تشتمل صور الحب كافّة - رومانسياً كان أم أفلاطونياً أم فطريّاً أم روحياً أم غير ذلك - على مزيج من هذه الثلاثة. تمتلك جميعها قيماً استعمالية تقع خارج السوق، غير أنّ اثنتين منها تقبلان التسليع المباشر، أما الثالث - التدفق المتبادل – فبعيد بالضرورة عن حقل التبادل السوقي. يتوقف فهْم كيفية إضعاف الرأسمالية قدرتنا على بذل الحبّ وتلقيه على فهْمنا لغبنها واستغلالها القيمة الاستعمالية الوحيدة المستعصية على التحويل إلى قيمة تبادلية.
الانتباه والدفع لقاءه
يمثل الانتباه المكوّن الأول للحب، ويُقصَد به التركيز الحصري تقريباً للملكات الإدراكية لكائن ما على موضوع أو كائن آخر. يتوق البشر لانتباه الآخرين، فإحساسنا الجوهري بالانتماء يتوقف على الوصول إلى الموارد الانتباهية، ويبلغ توقنا إليها حداً يدفع معظم الناس إلى تفضيل الانتباه السلبي على انعدام الانتباه. فمثلاً، وجدت دراسة صدرت في العام 2015 أنّ التجاهل في مكان العمل يفوق في أثره النفسي السلبي «سلوكيات التحرّش المهينة للشخص مباشرة أو الحاطّة من قدره أو المذلّة إيّاه». وارتبط تجاهل الزملاء للشخص «ارتباطاً سلبياً بصحته الجسدية ومواقفه المتعلقة بالعمل ومعدل تركه للوظيفة، فاق ارتباط التحرش بها».
يمتلك الانتباه قيمة استعمالية واضحة نظراً لمركزيته في الازدهار البشري. فرؤية الآخرين لنا واعترافهم بنا حاجةٌ نفسيةٌ جوهرية، تماماً كالاستماع إلينا وتصديق أفكارنا وآرائنا. ووجدت دراسةٌ صدرت في العام 2010 أنّ مجرد إشاحة شريك الحوار ببصره ولّد شعوراً عميقاً بالتجاهل قلّل من «تقدير الذات الظاهر والكامن». وأظهر بحثٌ منشور في العام 2021 أن مشاعر الإقصاء الاجتماعي غيّرت حتى الإدراك السمعي؛ إذ يختبر من ناله التجاهل العالم كمكان أهدأ.
يبرز الانتباه - من بين مكوّنات الحبّ الثلاثة - بوصفه الأدعى إلى التسليع. فالمال يشتري الانتباه، وبيع المرء لانتباهه وسيلة مشروعة لكسب العيش. يبيع الثيرابيست واللايف كوتش ومدربو اللياقة مقادير معينة من انتباههم الكامل. يتقاضى قرّاء التاروت والعرافون أجورهم بالجلسة أيضاً. يدفع الآباء لمربي الأطفال للعناية بصغارهم، وفي الولايات المتحدة، الطليعية دائماً في مضمار التسليع، تسمح شركةٌ تدعى (rentafriend.com) للمستخدمين بشراء وبيع ساعات من الانتباه الأفلاطوني. بل إنّنا نستأجر الروبوتات لتمنحنا انتباهها؛ فسجلات الدردشة لبرامج الذكاء الاصطناعي الشهيرة كشات جي بي تي تعجّ بالكتابات الاعترافية.
وفي غضون ذلك، تلتهم الشركات والخوارزميات وضرورات الحياة الحديثة مقادير هائلة من مواردنا الانتباهية، ولا تترك لنا إلا القليل لنتصرف فيه بمحض إرادتنا. تتطلب وظائفنا انتباهنا الكامل لغالبية ساعات يقظتنا. وتقتنص منصات التواصل الاجتماعي الباقي من انتباهنا ثم تبيعه للمعلنين، ما يتركنا في حالة استنزاف. ومع استنزاف نظامنا الاقتصادي قدرتنا على تركيز انتباهنا، تزداد ندرته، وبالتالي ترتفع قيمته التبادلية. وفي نهاية يوم مضن من السعي الرأسمالي المتأخر، قد يتجاهل حتى أسخى الوالدين أطفالهم بعض الشيء. يترك الأصدقاء رسائل أصدقائهم بلا رد. ينقطع العشاق فجأة عن بعضهم البعض.
عاني واحدٌ من كلّ 6 أشخاص حول العالم من الوحدة، ويتسبب غياب الروابط الاجتماعية في زيادة الوفيات بقرابة 900 ألف شخص سنوياً
وإذا اعتدنا التفكير في الانتباه كشيء نشتريه، فسنغدو أقلّ ميلاً للمشاركة المجانية لما تبقى لدينا من موارد انتباهية هزيلة. يشير باحثون في جامعة هارفارد إلى ظاهرة «ركود الصداقة»، بعدما أجبرت أكلاف المعيشة المرتفعة الناس على قضاء وقت أطول في العمل وساعات أقلّ في التواصل الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تُحجِم نسبةٌ كبيرةٌ من النساء الأميركيات (26% بحسب دراسة حديثة) عن مواعدة رجال لا يخضعون للعلاج النفسي؛ وهي طريقةٌ أخرى للقول إنّ النساء يرغبن في تقاسم عبء الانتباه المتأتي من العلاقات العاطفية مع رجال تنكمش عوالمهم الاجتماعية بتوجيه أصدقائهم لانتباههم نحو مشاغل أخرى.
وبشراء الأثرياء موارد الآخرين الانتباهية - سواءٌ بتوظيفهم عمالاً أو تصميم ملهيات مربحة لهم كمستهلكين - نشهد نموّ طبقة دنيا من الناس لا تنال إلا النزر اليسير من الانتباه أو لا تناله أبداً، ما يغذي وباء العزلة الاجتماعية العالمي. ووفقاً لتقرير من منظمة الصحة العالمية صدر هذه السنة، يعاني واحدٌ من كلّ 6 أشخاص حول العالم من الوحدة، ويتسبب غياب الروابط الاجتماعية في زيادة الوفيات بقرابة 900 ألف شخص سنوياً.
العاطفة والتدفق
تمثل العاطفة مكوناً رئيساً آخراً للحب، وهي فئةٌ واسعةٌ تشمل الجنس واللمس والمواساة والكلمات الطيبة والثناء، وأيّ فعل يعبر عن الحنان أو الشغف أو الاهتمام أو التفاني. وفي دراسته الشهيرة المنشورة في العام 1958 بعنوان «طبيعة الحب»، لاحظ عالم النفس الأميركي هاري هارلو سلوك صغار قرود الريسوس مع أمّين بديلتين غير حيّتيْن؛ صنعت الأولى من الأسلاك وتقدّم الحليب، وغطّيت الثانية بقماش ناعم من دون تقديم الحليب. وجد هارلو رغبة صغار القرود في «لمسة الطمأنة» أكثر من رغبتها في الطعام. ومؤخراً، يقترح علماء الأنثروبولوجيا الحيوية أنّ اللمسة البشرية البسيطة قد تخفف الضغط الفسيولوجي المرتبط بالبيئات القاسية، كالجاذبية المنخفضة أو المرتفعات الشاهقة أو البرودة والحرارة المفرطتين. ومع تفاقم أزمة المناخ وتحدّيها لحدود البيولوجيا البشرية، ستزداد العاطفة قيمةً استعمالية.
ولكن، وكما هو الحال مع الانتباه، تنقلب وحدات العاطفة سلعاً بسهولة. ففي المجتمعات التي تتجاوز فيها أكلاف المعيشة متوسط الراتب، يترك الإرهاق في العمل والقلق الناس فقراء في الوقت ومستنزفين، فيكنزون عاطفتهم لفترات الرعاية الذاتية الضرورية. إذا أردنا طبخ الطعام المفضل لشخص ما، فلنكن نحن هذا الشخص. يستنزفنا التنافس الضاري والاضطراب الاقتصادي. ومع ندرة العاطفة، ترتفع قيمتها التبادلية، ويختار المزيد من العمال عقلانياً بيع عاطفتهم كشكل من أشكال قوة العمل، ولا سيما عند انخفاض الأجور.
يبرز العمل الجنسيّ كمثال جلي هنا. ظهر هذا العمل قبل ظهور الرأسمالية لكنه يتخذ اليوم صوراً أكثر إبداعاً، من «بث المحتوى الإباحي عبر الإنترنت» إلى «الهيمنة المالية الجنسية». لكن المال يشتري أنواعاً أخرى من العاطفة. يدفع رجال الأعمال اليابانيون للنساء في نوادي المضيفات ليمنحنهم شعوراً بالمرغوبية والتقدير عبر الثناء والإطراء الشخصيَيْن. ويشتري الثراء أيضاً إمداداً مستمراً من الأشكال المهنية للمسة البشرية: تدليك الجسد والقدمين والمنتجعات الصحية وخدمات التجميل وما شابه. ومع ملء طبقة الواحد بالمئة جداولها بأشكال التدليل المشتراة، تنقلب العاطفة نفسها سلعة فاخرة؛ تُكنَز وتُتداول وتُعرض بوصفها رمزاً للنجاح الشخصي في نظام اقتصادي لكل شيء فيه ثمن.
في علاقات الحب، يرتبط تقاسم الانتباه والعاطفة بمكون ثالث أسميه «التدفق المتبادل»، وهو دورة طبيعية من العطاء والأخذ. ديناميّة مولّدة ومنتجة: كلما زاد ما نتلقاه من انتباه وعاطفة، زاد إلهامنا للعطاء، والعكس صحيح. نجد هذا في كلّ مكان في الطبيعة، كما وصفت روبن وول كيميرير بجمال في كتاباتها. تغذي الأرض الأشجار، فتُسقِط الأخيرة أوراقها وثمارها لتغذية الأرض. يجمع النحل الرحيق من النباتات المزهرة، فيلقّحها ويكفل بقاءها. يستنشق البشر الأكسجين ويزفرون ثاني أكسيد الكربون، وتتنفس النباتات ثاني أكسيد الكربون وتطرح الأكسجين. تعتمد أنظمةٌ بيئيةٌ كاملةٌ على دورات العطاء والأخذ المستمرة والمتبادلة هذه.
تنبع القيمة الاستعمالية للتدفق المتبادل من توجيهه الطبيعي لهذه الأنظمة البيئية الدقيقة، وسماحه بالتعاون داخل النوع الواحد وبين الأنواع المختلفة والحفاظ على توازن النظام كله. ذهل الجغرافي الروسي بيوتر كروبوتكين في رحلاته في سيبيريا من تعاون الحيوانات المختلفة لضمان بقائها المتبادل في المناخ القاسي. وبالمثل، وجد الباحثون ممارسة الأطفال سلوكاً إيثارياً عابراً للأنواع؛ إذ يساعدون الكلاب بغض النظر عن المعاملة بالمثل.
في المجتمعات الرأسمالية الضارية ذات مستويات اللامساواة المرتفعة، نتعلم حماية أنفسنا ممّن يأخذون ولا يعطون إلا نادراً. نُشجّع بسرعة على الانسحاب من الصداقات «السامة» وقطع العلاقات مع الشركاء «المحتاجين»
ينبع الكثير من الحبّ الذي شعرت به تجاه رفاقي من الكلاب عبر السنين من التدفق المتبادل للعاطفة والانتباه الجاري بيننا. وجدت دراسةٌ من العام 2024 أنّ قدامى المحاربين في الجيش الأميركي تحدثوا عن «انخفاض ملحوظ في شدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب» عند مرافقة كلاب الخدمة. تجلب جامعتي كلاباً علاجية إلى الحرم الجامعي أيام الامتحانات لتخفيف توتر الطلاب. تُظهِر الدراسات أن التربيت على الكلب يمنح المربّت لذة تعادل لذة المربّت عليه. لن يربّت الكلب عليك بالمقابل، لكنّ الفعل يخلق طاقةً من العاطفة المتبادلة، وهالةً من الحب.
نحن معاً في هذا
لا يتطابق التدفق المتبادل مع المعاملة بالمثل؛ إذ توحي المعاملة بالمثل بوجود كشف حساب يُسجّل فيه كلّ طرف ميزانية العطاء والأخذ. يسمح التدفق المتبادل بوجود اختلالات قصيرة المدى لكونه يحدث ضمْن علاقات تستمرّ بمرور الوقت وفي حيّز قريب. تشاركت وكلابي تدفقاً متبادلاً بحكم عيشنا معاً ضمْن الروتين اليومي ذاته لسنوات طوال؛ فنمت ألفتنا بالتوازي مع كثافة اتصالنا وطوله.
وبالمثل، تتطلب الأبوة والأمومة نوعاً من القبول الضمني لحالة التدفق المتبادل هذه. يتطلب الصغار قدراً استثنائياً من الانتباه والعاطفة، غير أنّ الكثير من الوالدين يشعرون أيضاً بمعنىً عميق للهدف والرضا من المشاركة المجانية لهذه الموارد (وإلا لما نجا جنسنا). تستمرّ حالة التدفق المتبادل هذه بفضل التوقعات المشتركة باستمرار العلاقات بين الأجيال لعقود.
تمثل المحادثة الرائعة عالماً مصغراً للتدفق المتبادل، فتتضمن أفعالاً تلقائية من التفكير والحديث والاستماع والاستجابة في أخذ وعطاء سهل لا يهيمن فيه شخصٌ واحد. نتقاسم القصص والمستجدات والأفكار والملاحظات، ونطلب التعاطف والاستبصار والنصيحة أو نقدمها من دون اكتراث بقيمتها التبادلية المحتملة.
وفي المجالات الإبداعية، تعتمد جلسات الارتجال في الجاز ورقص الصالات للهواة على البهجة المشتركة من التدفق المتبادل. في أشْهر الصيف الكثيرة لي في فرايبورغ، أتوقف دائماً لأتعجب من هؤلاء عند النافورة الراقصة قرب مقصف الجامعة. فبالقرب من حوض مفتوح دمّره الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، يجتمع الأزواج من مختلف الأعمار في الأمسيات الدافئة ليتمايلوا معاً تحت النجوم لمجرد التسلية. وبالمثل، في رحلة لي إلى اسكتلندا مؤخراً، اختبرت أول كاي-لي، حيث يجلب مجموعةٌ من الناس آلاتهم ليعزفوا معاً بلا نوتات موسيقية أو قائمة مقطوعات معدة سلفاً. مزيج صاخب ومبهج من الأغاني والأصوات، يرتجل الموسيقيون معاً لمحض لذة عزف الألحان الاسكتلندية التقليدية.
وحتى عند الأطفال، أرقى مراحل اللعب وأهمّها هي «اللعب التعاوني» أو «اللعب المتبادل». تذكر تلك الأيام الطويلة في الطفولة حين شاركت زملاء لعبك عوالم خيالية، غافلاً عن مرور الوقت في مساحات التخيل المبنية بالاشتراك. يعتمد تقمّص الأدوار والتنكر والسرد التشاركي للقصص على حالات طبيعية من التدفق المتبادل بين أخيلة الصغار. تُعلِّم هذه الأنشطة الأطفالَ قراءة الإشارات العاطفية للآخرين وكيفية الاستجابة العفوية. يدرك علماء نفس الطفل أنّ الانخراط في فترات ممتدة من اللعب المتبادل ضروري لتطوّرنا المعرفي. فنسياننا أنفسنا في حالات التدفق المتبادل المشتركة هو السبيل لتعلم السلوكيات الاجتماعية الإيجابية التي تبنى عليها مجتمعاتنا.
ذهب ألبرت أينشتاين بهذا الطرح إلى مدًى أبعد في مقاله الشهير «لماذا الاشتراكية؟»، فاقترح وجود الأفراد والمجتمع في حالة مستمرة من التدفق المتبادل: «يستطيع الفرد التفكير والشعور والسعي والعمل بمفرده، لكنه يعتمد على المجتمع اعتماداً شديداً - في وجوده الجسدي والفكري والعاطفي - لدرجة استحالة التفكير فيه أو فهْمه خارج إطار المجتمع. فالمجتمع يوفر للفرد الغذاء والملبس والمسكن وأدوات العمل واللغة وصور التفكير ومعظم موضوعات التفكير؛ وتغدو حياته ممكنةً بفضل عمل وإنجازات ملايين الأشخاص في الماضي والحاضر ممّن يتوارون خلف كلمة «مجتمع» الصغيرة».
يفقد التدفق المتبادل قيمته الاستعمالية بمجرد جرّه إلى السوق. فهو يقوم على السّخاء، وتقاسم الموارد العاطفية بدافع الرعاية لا المصلحة الذاتية. إنّ مجرد محاولة تسليع التدفق المتبادل تقضي عليه
حين يتعلق الأمر بالصداقة والحب الرومانسي، ندخل تلقائياً في حالات تدفق متبادل مع الآخرين نتيجة طول العشرة والقرب. قد تختلف أسباب دخول هذا التدفق (كالانجذاب الجسدي أو الالتزامات السياسية المتشابهة أو الاهتمامات الفكرية المشتركة وغيرها)، لكنّ تدفق الانتباه والعاطفة هذا يتجاوز الدافع الأولي. وبخلاف الحيوانات الأليفة ومعظم الأطفال، تبدو هذه العلاقات بين البالغين أكثر هشاشة بحكم إمكانية انسحاب أحد الطرفين فجأة من التدفق.
وحين تتعثر هذه العلاقات، فقد يكون السبب تخلي طرف واحد على الأقل عن حالة التدفق المتبادل لصالح شكل من أشكال التبادل مدروس أكثر. وقد تعيق النرجسية أو الجشع أو الاستياء أو الصدمة أو الارتياب أو أيّ حالات نفسية أخرى قدرة المرء على مواصلة إيقاع طبيعي من العطاء والأخذ. وبعض الناس مجرد حقراء.
الحبّ ليس للبيع
تبرهن صور الحبّ الكثيرة في الموسيقى والفن والأدب والسينما على أهمية التدفق المتبادل لتجربتنا. حبكة كلّ كوميديا رومانسية تقريباً تتمحور حول عثور الأفراد على رفقاء روحهم؛ أولئك الذين ينغمسون معهم بكل سلاسة في حالة التدفق هذه. قد يَظهُر خُطابٌ آخرون، أكثر ثراءً أو جاذبية، لكنّ «الحبّ الحقيقي» يدور دوماً حول رابطة خاصة لا تُعوَّض. يمكن تسليع مظاهر التدفق المتبادل أيضاً، حين يأمل المتفرجون المتحمسون مشاهدة التدفق المتبادل في وقته الفعلي. والكوميديا الارتجالية مثال ممتاز، وكذا الرياضات التي ينتصر فيها الرياضيون الأفراد بالعمل الجماعي مع زملائهم. وعلى الرغم من مجانية حضور ومشاهدة كاي-لي في إنڨيرنيس، فقد يشتري الجمهور البيرة للموسيقيين أو يلقي عملات في سلة الإكراميات.
لكنّ التدفق المتبادل، وبخلاف الانتباه والعاطفة، لا يمكن تسليعه. فإعطاء التدفق المتبادل قيمةً تبادليةً ينفي جوهره كدورة طبيعية متناغمة من العطاء والأخذ من دون توقع فوريّ لعائد الاستثمار. يشبه الأمر رؤية شخص يحمل لافتة مكتوب عليها «عناق مجاني» في يد، ويهزّ علبة تبرعات في اليد الأخرى. فلم يعد «مجانياً» حال التماس أي شكل من أشكال الدفع.
وإذ تبقى القيم الاستعمالية للعاطفة والانتباه سليمة إلى حدّ ما سواءٌ شوركت بحرية أو بيعت أو هطلت من السماء كالثلج، يفقد التدفق المتبادل قيمته الاستعمالية بمجرد جرّه إلى السوق. فهو يقوم على السّخاء، وتقاسم الموارد العاطفية بدافع الرعاية لا المصلحة الذاتية. إنّ مجرد محاولة تسليع التدفق المتبادل تقضي عليه.
تُغرِق الرأسمالية كلّ عاطفة إنسانية حقيقية في «حساباتٍ أنانية» وتحول «القيمة الشخصية قيمةً تبادلية». وبالتبعية، «كلّ مقدس يدنّس»؛ فتساق أكثر تجاربنا حميمية وقيمة إلى السوق ويحدد لها ثمن
يمثّل هذا مشكلةً للرأسمالية. يرغب الرأسماليون في الاعتراف بقيمة التدفق المتبادل وقد يتفقون حتى على استحالة تعيين قيمة تبادلية له. فمثلاً، يدرك المحافظون العائليون وأتباع الأيديولوجيا اليمينية (من معظّمي الأسواق الخاصة في ميادين أخرى) حاجة الأطفال الصغار لتجربة الكثير من العاطفة والانتباه والتدفق المتبادل لتطوير مهاراتهم الاجتماعية والمعرفية. لكنّ التقليديين يؤكدون وجوب حصْر تقديم الانتباه والعاطفة للأطفال الصغار عبر حالة التدفق المتبادل وحدها، وأنّ تيسير هذه الحالة مسؤولية أصيلة للوالدين، ولا سيما الأمهات اللواتي يتعين عليهنّ فعل ذلك بدافع حبّ «طبيعي» متجذر بهن بيولوجياً. وعلى الرغم من وجود أدلة وافرة تكشف عن إمكانية ترعرع الرُضّع والأطفال الصغار وارتباطهم الآمن بمجموعة واسعة من البالغين الرّاعين (سواءٌ تقاضوا أجوراً أم لا)، فإن التقديس واسع الانتشار لـ«الرابطة الخاصة» بين الأمّ وطفلها يستبعد عمل الرعاية النسائي من الاقتصاد الإنتاجي. تحوم الريبة، في مجتمع سعّر كل شيء، حول بقاء أمور «لا تقدّر بثمن»؛ وهذه بالذات لا يستفيد منها إلا النخب.
لكن من جهة أخرى، يبرز دافع تحت وطأة الرأسمالية لتقليل القيمة الاستعمالية لكل ما يقاوم التسليع. فمع نضجنا، تعلِّمنا المجتمعات شديدة الفردانية الخشية من مخاطر الانغماس في حالات التدفق المتبادل فقد يستغلنا الآخرون. سوف يُفسّر لطفك ضعفاً. تُظهِر الدراسات الدولية مستويات متباينة بشدة من الثقة الاجتماعية. ترتبط دول الرفاه الأكبر والأسخى بمستويات أدنى من الريبة. فمثلاً، ورد في الموجة السابعة من مسح القيم العالمية (2017-2022) سؤال مفاده: «بوجه عام، هل تقول إنّ غالبية الناس جديرون بالثقة أم أنّ عليك الحذر الشديد في التعامل مع الناس؟». ردت غالبية الألمان والأميركيين بوجوب «الحذر الشديد»: 54.5% في ألمانيا و62.5% في الولايات المتحدة، مقارنةً بـ25.8% من المشاركين في الدنمارك و26.9% في النرويج.
في المجتمعات الرأسمالية الضارية ذات مستويات اللامساواة المرتفعة، نتعلم حماية أنفسنا ممّن يأخذون ولا يعطون إلا نادراً. نُشجّع بسرعة على الانسحاب من الصداقات «السامة» وقطع العلاقات مع الشركاء «المحتاجين». وفي عالم يحمل فيه الانتباه والعاطفة أثماناً باهظة، يبدو من الحماقة تقاسمهما بالمجان.
حبّ يتجاوز الرأسمالية
تخلق المجتمعات الأكثر عدلاً ومساواةً، والمولية رعاية المواطنين الأولوية، الممهدات اللازمة للتدفق المتبادل. يتطلب الأمر وقتاً وقرباً للانغماس في التدفق المتبادل مع الآخرين، والتخلي عن العقلية الحسابية التي تعلّمناها، والعودة لدورة العطاء والأخذ من دون كشف حساب الكلفة والعائد. ولهذا نتشارك غالباً المحادثات الرائعة مع عائلاتنا وأصدقائنا القدامى. لم نعد نسأل: «ماذا يمكن لهذا الشخص أن يقدّم لي؟» أو «ماذا قدّم لي مؤخراً؟». نثق في توازن التدفق بمرور الوقت. غير أن الوقت نادر، وتحت الضغط المستمر لأسواق متقلبة، قد تغذي طول العشرة التوتر أكثر من الترابط.
يمثل التدفق المتبادل مكوّناً رئيساً للحب، لكن الرأسمالية تقضي عليه. ويلاحظ حتى أغنى أعضاء مجتمعنا خفوته. يشتري الأغنياء قدراً لا ينتهي من انتباه الآخرين وعاطفتهم، لكنّ المال مهما بلغ يعجز عن شراء تجربة الانغماس الكامل في دورة طبيعية من العطاء والأخذ غير النفعي، لكونها في جوهرها غير نفعية. أدرك الاشتراكيون هذا منذ البداية.
كتب ماركس وفريدريك إنجلز في البيان الشيوعي أنّ النظام البورجوازي يخلق مجتمعاً لا يوجد فيه «أي رابط بين الإنسان والإنسان سوى المصلحة الذاتية العارية، سوى دفع الثمن النقدي الفظ». تُغرِق الرأسمالية كلّ عاطفة إنسانية حقيقية في «حساباتٍ أنانية» وتحول «القيمة الشخصية قيمةً تبادلية». وبالتبعية، «كلّ مقدس يدنّس»؛ فتساق أكثر تجاربنا حميمية وقيمة إلى السوق ويحدد لها ثمن. كتبت ألكساندرا كولونتاي في العام 1923 عن «صقيع الوحدة الداخلية» الساري في نفوس الناس ضمن اقتصادات تُشوّه فيها الملكية الخاصة مُثُلنا الجماعية عن الحب. لقد تخيلَتْ مستقبلاً اشتراكياً يتمتع فيه الناس بوفرة من التدفق المتبادل لدرجة تتضاؤل معها فداحة فقدان أي تدفق بعينه.
مع ملء طبقة الواحد بالمئة جداولها بأشكال التدليل المشتراة، تنقلب العاطفة نفسها سلعة فاخرة؛ تُكنَز وتُتداول وتُعرض بوصفها رمزاً للنجاح الشخصي في نظام اقتصادي لكل شيء فيه ثمن
وكان ألبرت أينشتاين يعي أيضاً احتمال ارتياب الناس في التدفق المتبادل الطبيعي بين الأفراد والمجتمع. واقترح أنّ الشخص قد يرى في هذا «تهديداً لحقوقه الطبيعية، أو حتى لوجوده الاقتصادي، وليس أصلاً إيجابياً، أو رباطاً عضوياً، أو قوةً حامية». وبدلاً من ذلك، يغدو الكادحون في ظل نظام تعلو فيه القيم التبادلية على القيم الاستعمالية «سجناء أنانيتهم من دون علْم؛ فيشعرون بانعدام الأمان والوحدة والحرمان من الاستمتاع البريء والبسيط وغير المتكلف بالحياة».
لو عشنا في مجتمع أكثر إنصافاً مع مستويات أعلى من الأمان الاجتماعي ووقت للفراغ، لاكتسبنا قدرةً أكبر على التدفق المتبادل الحقيقي، ولضاقت الفجوة بين القيمة الاستعمالية والتبادلية للانتباه والعاطفة. لا يعني هذا وجوب عدم تسليعهما بالمرة - على الأقل حالياً، فالكثيرون يعتمدون على بيعهما لتأمين قوتهم الأساسي، ويتعين على هؤلاء العمال التنظيم لتحسين ظروف عملهم كأيّ عمال آخرين.
لكننا نحتاج أيضاً للتفكير بإطار أوسع. فمن شأن وجود دولة رفاه أقوى وحماية أفضل للعمال تيسير التدفق المتبادل، لكن هذه وحدها لن تتجاوز القيود الصارمة التي فرضتها قرونٌ من الرأسمالية على كيفية حبّنا لأنفسنا ولبعضنا البعض. نحتاج إلى سياسة جديدة للحب؛ سياسة تقاوم منطق التراكم والربح عبر اعتناق متجدد للفرح والرحمة والترابط والتضامن. لن يتحقق هذا النوع من الحبّ اللامحدود وغير المغترب إلا بعد زوال الرأسمالية؛ ذلك النظام القائم على الندرة والمولد للريبة، والمتعارض جوهرياً مع السّخاء الذي يقوم عليه الحب. يتعين علينا النضال من أجل عالم جديد نمتلك فيه جميعاً الموارد لتقاسم الوقت والعِشرة اللازمين للاستمتاع باللذات البريئة والبسيطة وغير المتكلفة للدورة الطبيعية من العطاء والأخذ.
نُشِر هذا المقال في 12 آب/أغسطس 2025 في Jacobin، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة من الجهة الناشرة.