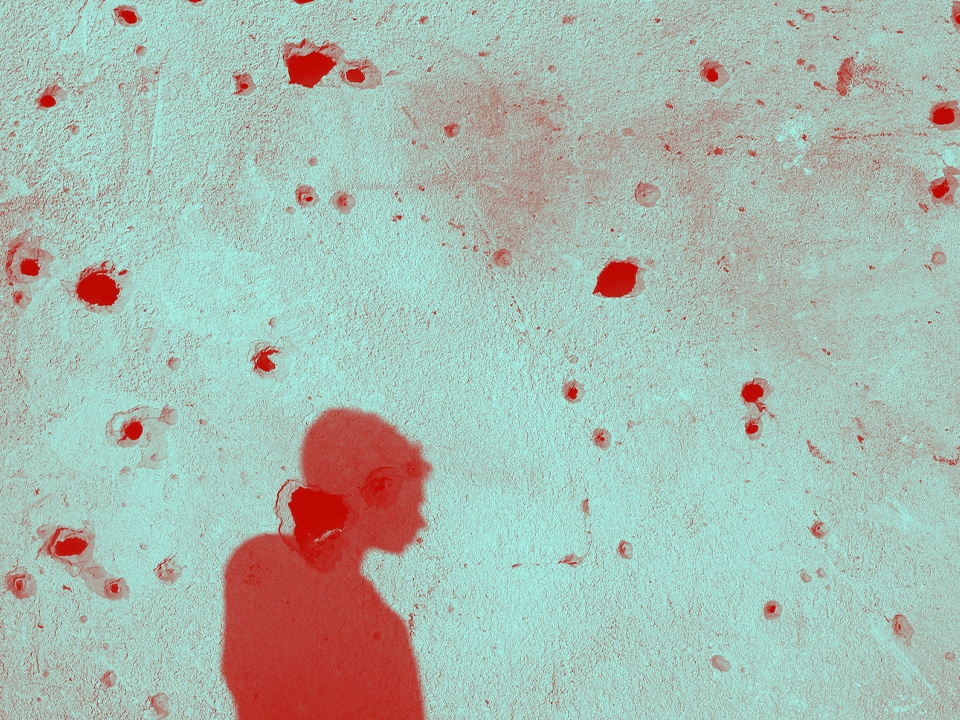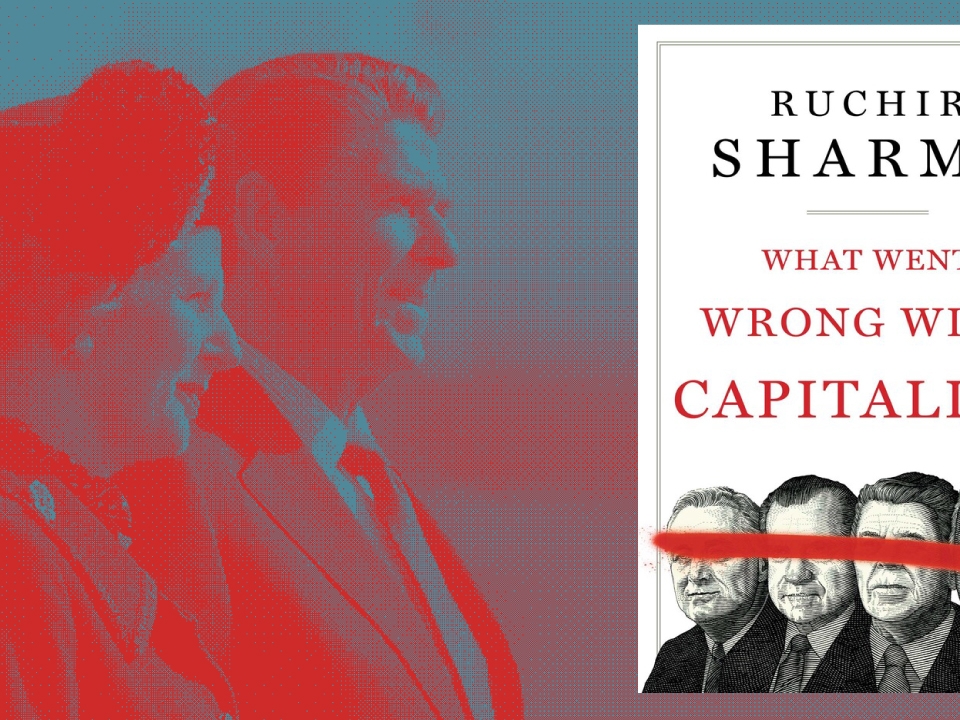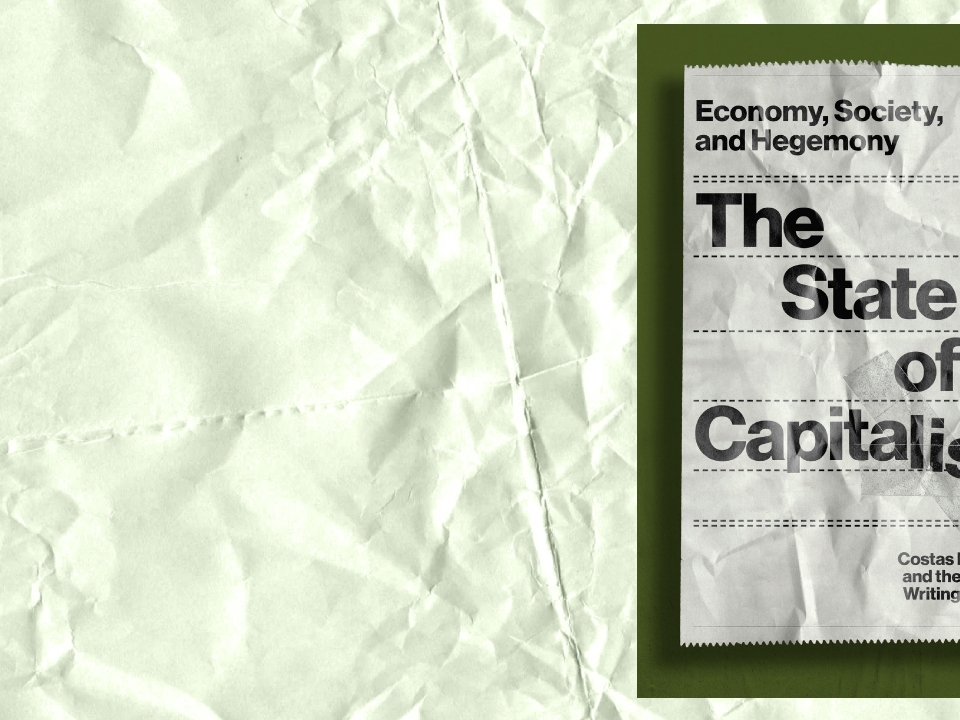الرأسمالية الجديدة
بدلاً من مجتمع طبقي كما في الرأسمالية الكلاسيكية، صار لدينا اليوم مجتمع تحكمه نخبة. هؤلاء الأفراد يتجاوزون التناقض بين رأس المال والعمل، لكنهم لا يفعلون ذلك إلا عبر التميّز عن بقيّة السكان، أي عبر تكوين نخبة تتربّع على قمة المجتمع.
في ما يخصّ ملكيّة رأس المال، لم تنجح الرأسمالية الجديدة، بأي شكل فعلي، في تخطّي العائق البنيوي الذي أرسته الرأسمالية التقليدية: فالدخل من الملكية لا يزال حكراً على قلّة، وداخل هذه القلّة بالذات، تتوزّع الامتيازات بشكل غير متوازن.
أغنى الرأسماليين وأعلى الأجور باتوا في ازدياد من الفئة نفسها
في كتابي «الرأسمالية، وحدها» الصادر في العام 2019، أطلقت عليها اسم «الرأسمالية الجديدة». فما الذي يجعلها جديدة؟ بحسب الرؤية الكلاسيكية التي تبنّاها اقتصاديّو أوروبا في القرن التاسع عشر، انقسمت المجتمعات الرأسمالية إلى فئتين: فئة تملك رأس المال (أو وسائل الإنتاج كما يسميها ماركس)، وأخرى لا تملك ولا خيار أمامها سوى بيع قوّتها العاملة للرأسماليين كي تعيش. لم يكن هذا الوصف دقيقاً تماماً، لكنه عبّر بشكل عام عن طبيعة المجتمعات الصناعية المتقدّمة آنذاك. في المقابل، لعبت ملكية الأرض وما اقترن بها من نفوذ سياسي دوراً أبرز في الاقتصادات الأقل تطوراً.
عرفت الرأسمالية تحوّلاً في القرن العشرين مع ظهور ما بات يُعرف بـ«الطبقة الإدارية»، وهي طبقة من المديرين لا تملك وسائل الإنتاج ولا تنتمي إلى طبقة العمّال، لكنها تدير وسائل الإنتاج نيابة عن رأسماليين غائبين ينعمون بوقتهم في ملاعب الغولف في فلوريدا. كان كتاب جيمس برنهام الكلاسيكي الصادر في العام 1941 هو من أعلن ولادة هذا التحوّل، قبل أن يطوّره لاحقاً مفكرون مثل جوزيف شومبيتر وريمون آرون وجون كينيث غالبريث ودانيال بيل، في خلال الستينيات والسبعينيات. وعلى هذا المسار، صدر مؤخراً كتاب «الرأسمالية الإدارية: الملكية والإدارة وتحوّلات نمط الإنتاج المقبل» لجيرار دومينيل ودومينيك ليفي، ويمكن الاطّلاع على مقاربة نقدية لهذا العمل في مقالة نيكول أشوف في جاكوبن.
استندت الفكرة التي ترى الرأسمالية مجتمعاً من ثلاث طبقات، مع صعود المديرين إلى موقع الطبقة الحاكمة الجديدة، إلى المفارقة التي لاحظها ماركس، وإن لم يبتّها بالكامل، بين وظيفتين أدّاهما الرأسمالي: تمويل وسائل الإنتاج، وتنظيم استخدامها. أو أو بلغة فالراس: بين الرأسمالي ورائد الأعمال. يمكن التفريق بين الوظيفتين من الناحية المنطقية، وهذا ما حصل فعلياً. ووفقاً للكتّاب الذين ذكرتهم آنفاً، أدّى هذا الفصل إلى ولادة طبقة ثالثة: طبقة المديرون. تناول ألكسندر شيرا هذه الظاهرة في دراسة حديثة محكمة من زاوية التحليل الماركسي.
في الحقيقة، كانت الثورة الإدارية وَهْماً مبالغاً فيه؛ لم تحدث قط ولا يبدو أنها بصدد التحقّق. لم يتمكّن المديرون، بوصفهم فئة مستقلة، من أن يُشكّلوا طبقة ثالثة. ما حدث، كما بيّنت في كتابي في العام 2019 وأكّدته أوراق بحثية حديثة، هو بروز نخبة هوموبلوتية في الولايات المتحدة خصوصاً، وفي اقتصادات رأسمالية غنيّة أخرى. وهوموبلوثيا، كما في حالات مماثلة، مصطلح جديد صيغ من مفردتين يونانيّتين تعنيان «الثروة نفسها»، أي من يتمتّعون بثروتين معاً: رأس المال البشري الذي يدرّ دخلاً عالياً من العمل، ورأس المال المالي والإنتاجي الذي يوفّر دخلاً من الملكية. يحتلّ أفراد هذه النخبة مواقعهم في آنٍ معاً بين أصحاب أعلى الأجور وبين أثرى الرأسماليين: رؤساء شركات مالية ومهندسون وأطباء ومبرمجون. يجمعون بين رواتب مرتفعة وثروات مالية ضخمة تضمن لهم عوائد رأسمالية كافية لوضعهم في قمّة الهرم. قد تكون تلك الثروات موروثة، أو حصيلة مدّخرة من الرواتب العالية. لكنّنا لا نعرف بعد مدى تأثير كلّ من المسارين، لأنّ هذا الحقل البحثي لا يزال في بداياته، ولم تُستخدم فيه بعد بيانات طولية تتيح معرفة دقيقة.
نرصد ظاهرة هوموبلوثيا عملياً على النحو الآتي: نأخذ الشريحة الأعلى دخلاً بعد الضريبة في الولايات المتحدة، أي العُشر الأغنى من السكان، ونحسب عدد من يندرجون منهم في الوقت نفسه ضمن العُشر الأعلى من حيث دخل العمل، وأيضاً ضمن العُشر الأعلى من حيث دخل رأس المال. ومن المهم الإشارة إلى أنه، في ظلّ الرأسمالية الكلاسيكية، كنا نتوقّع أن الغالبية الساحقة من الذين ينتمون إلى هذا العُشر من حيث مجموع الدخل يحصلون على معظم دخلهم من ملكية رأس المال، بينما لا يكون أيّ منهم تقريباً من بين الأعلى أجراً كعمال، أي أن الغنى والرأسمالية كانا مترادفين. والحقيقة أن هذا هو ما نراه ولا يزال قائماً حتى اليوم في الاقتصادات الرأسمالية الأقل تطوّراً مثل البرازيل أو المكسيك.
نجد في الاقتصادات الرأسمالية الأكثر تقدّماً مثل الولايات المتحدة أن نحو ثلث الأفراد ذوي الدخل المرتفع يندرجون في الوقت ذاته ضمن العُشر الأعلى من حيث دخل العمل (أي عند تصنيف الأفراد وفق دخلهم من العمل فقط) وضمن العُشر الأعلى من حيث دخل رأس المال (أي عند تصنيفهم وفق دخلهم من الملكية فقط). فضلاً عن ذلك، تُظهر البيانات أنّ أهمية ظاهرة هوموبلوثيا ظلّت في ارتفاع مستمرّ طوال الأربعين سنة الماضية.
يوثّق الرسم البياني أدناه، المأخوذ من ورقة بحثية أعددتُها بالاشتراك مع يوناتان بيرمان، هذا الاتجاه باستخدام ثلاث مجموعات بيانات مختلفة: أوّلاً، المسح السكاني الجاري في الولايات المتحدة، وهو المسح الأساسي للدخل هناك، كما تمّت مواءمته وفق معايير دراسة لوكسمبورغ للدخل؛ ثانياً، مسح الشؤون المالية للأسر، الذي يركّز على توزيعَي الثروة والدخل معاً؛ وثالثاً، بيانات الحسابات الوطنية التوزيعية التي طوّرها في الأصل توماس بيكيتي وإيمانويل سايز وغابرييل زوكمان، وتجمع بين بيانات الضرائب والاستبيانات والحسابات القومية. تروي جميع هذه المصادر القصة نفسها: نسبة الأفراد الهوموبلوتيين ضمن العُشر الأعلى دخلاً ارتفعت من خُمس هذه الشريحة في ثمانينيات القرن الماضي إلى نحو ثلثها اليوم. علاوة على ذلك، قدّرنا، بيرمان وأنا، أن حوالي 20% من ارتفاع اللامساواة في الدخل في الولايات المتحدة بين العام 1980 واليوم يمكن تفسيره تحديداً بارتفاع هوموبلوثيا، وذلك بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، والاكتفاء بزيادة الترابط بين دخل العمل ودخل رأس المال داخل الشخص نفسه. ويتجاوز أثر هوموبلوثيا حتى أثر ارتفاع حصة رأس المال من الدخل القومي. وبصيغة مبسّطة: لم ترتفع حصة رأس المال في الاقتصاد الأميركي فقط، بل الأهم أنّ هذه الحصة الإضافية ذهبت إلى جيوب أشخاص كانت رواتبهم مرتفعة أصلاً. ولم يعد بالإمكان تجاهل هذا التحوّل عند الحديث عن تصاعد اللامساواة في الدخل.
لماذا تُعدّ الهوموبلوثيا أمراً مهمّاً؟ قد تبدو للوهلة الأولى تطوّراً إيجابياً، لأنها تزيل الحدود الطبقية بين رأس المال والعمل. أمامنا هنا أفراد يُلغون، في ذواتهم، ذلك التمييز الجوهري الذي مثّل مصدراً لصراع الطبقات والثورات. فما المشكلة إذاً؟ ألا ينبغي الترحيب بهذا التحوّل والاحتفاء به؟ قد يصحّ ذلك من جهة، لكنه لا يصمد أمام اعتبارات أخرى كثيرة. تُنتج هوموبلوثيا أيضاً نخبة جديدة، محصّنة ضد الصدمات في سوقَي العمل ورأس المال، وقادرة بالتالي على الحفاظ على موقعها حتى في حال تراجع عائدات رؤوس الأموال الكبيرة التي تملكها، أو انخفاض الأجور في الوظائف المتقدّمة التي تشغلها. إنّها نخبة لا تتأثّر بالهزّات الاقتصادية الكبرى، تتكوّن من أفراد ذوي مهارات عالية، تلقّوا تعليمهم في أرقى الجامعات، ويرون غالباً أنهم يستحقّون المكانة التي يشغلونها. بخلاف الرأسماليين التقليديين، يشعر أفراد النخبة الهوموبلوتية أنهم كسبوا دخولهم العالية عن جدارة: إذ يركّزون على الدخل الناتج عن العمل، ويغفلون عمداً أو عن غير قصد، الدخل الآتي من رأس المال. ما يربط بين هؤلاء هو 3 عناصر: امتلاك كميات كبيرة من رأس المال، وتعليم رفيع المستوى، ووظيفة ذات أجر مرتفع. وبدلاً من مجتمع طبقي كما في الرأسمالية الكلاسيكية، صار لدينا اليوم مجتمع تحكمه نخبة. هؤلاء الأفراد يتجاوزون، في ذواتهم، التناقض بين رأس المال والعمل، لكنهم لا يفعلون ذلك إلا عبر التميّز عن بقيّة السكان، أي عبر تكوين نخبة تتربّع على قمة المجتمع.
تتجلّى معالم الرأسمالية الجديدة في جميع البلدان الرأسمالية المتقدمة. يبيّن الشكل أدناه، المستند إلى بيانات دراسة لوكسمبورغ للدخل، نسبة الأفراد في العُشر الأعلى دخلاً الذين يُعدّون هوموبلوتيين. وتتراوح هذه النسبة بين نحو 30% في الولايات المتحدة وإيطاليا، و16% في كل من اليابان وكوريا الجنوبية. أما في الاقتصادات الرأسمالية الأقل تطوّراً، مثل هنغاريا والبرازيل والمكسيك، فهي تقلّ عن 10%. وعلى نحو لافت، وربما بالغ الأهمية، تُظهر بيانات الصين للعام 2013 أن نسبة هوموبلوثيا فيها تجاوزت نظيرتها في أي بلد آخر، إذ بلغت 32%.
سوف تكتمل النخبة وتصبح منيعة حين يتحوّل 80% أو حتى 90% من العُشر الأغنى إلى نخبة هوموبلوتية. عندها، يطوي المجتمع الطبقي القديم صفحته ليُفسح المجال أمام نمط جديد من الحكم، تُحكم فيه المجتمعات من أعلى، ويغدو تحليل الهيمنة النخبوية، اقتصادياً وسياسياً، أكثر راهنية من أدوات الصراع الطبقي كما صاغها ماركس.
التفاوت التركيبي في مقابل التفاوت في الدخل: هل جميع المجتمعات الطبقية غير متساوية؟
كما ناقشتُ في كتاب «الرأسمالية، وحدها»، وفي الكتاب المرتقب «التحول العالمي الكبير»، لا تشبه هذه النخبة البتّة ما يُسمّى بالطبقة الوسطى المهنية، أو «الطبقة الإدارية المهنية». فهي من الناحية الأيديولوجية شديدة التمسّك بالرأسمالية وبالملكية الخاصة، لأنها في ذاتها تُجسّد اندماج العمل ورأس المال. لذا تدافع هذه النخبة بقوّة عن حقوق رأس المال، وتطالب بضرائب منخفضة على دخول الملكية والثروة، وسائر السياسات النيوليبرالية المتصلة بذلك. ولا ينبغي التغاضي عن هذا الجانب الأيديولوجي النيوليبرالي للنخبة الرأسمالية الجديدة.
لكن يمكن التساؤل: ماذا يحدث لو تمّ تجاوز التناقض بين رأس المال والعمل ليس فقط لدى الأغنياء، بل على مستوى كامل التوزيع الطبقي؟ ماذا لو كان للجميع دخل مزدوج من العمل ورأس المال بالنسبة نفسها؟ على سبيل المثال، يتلقّى الغني 100 دولار من العمل و50 من رأس المال، ويماثله في النسبة شخص من الطبقة الوسطى يتلقّى 40 و20، وشخص فقير يتلقّى 2 و1. في كل حالة، نسبة دخل العمل إلى دخل رأس المال هي 2 إلى 1. ما تشير إليه المساواة في التركيب أنّ أي زيادة في دخل رأس المال الناتجة عن تحوّلات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، لن تغيّر مستوى اللامساواة، لأن الجميع سيستفيدون بنسبة متساوية. مثلاً، بدلاً من أن يكون التوزيع (150، 60، 3)، سيصبح (200، 80، 4)، وتبقى نسب الدخول ثابتة: 2.5 بين الأعلى والثاني، 50 بين الأعلى والأدنى، و20 بين الثاني والثالث.
كان ماركو رينالدي في الفترة التي طرحتُ فيها مفهوم الهوموبلوثيا، يعالج السؤال نفسه في أطروحته للدكتوراه في مدرسة باريس للاقتصاد: كيف يمكننا فهم وقياس اللامساواة في تركيب الدخل؟ وكما يبيّن مثالي، فإن هذه اللامساواة تختلف تماماً عن اللامساواة في إجمالي الدخل؛ إذ يمكن أن يسود التوازن التركيبي بين العمل ورأس المال، من دون أن يتقلّص التفاوت في حجم الدخل. لمقاربة هذه المسألة، ابتكر رينالدي منهجية جديدة بالكامل مستوحاة من منهجية جيني. عوضاً عن اعتبار التساوي في الدخل بين جميع الأفراد هو دالة الهدف (كما في مؤشر جيني)، وضع رانالدي دالة هدف تقوم على التساوي في الحصص العاملية (بين العمل ورأس المال) لجميع الأفراد، واحتسب اللامساواة على أساس مجموع الانحرافات عن هذا التساوي التركيبي. وقد ابتكر مؤشراً خاصاً أطلق عليه اسم مؤشر تركيب مصادر الدخل (IFC)، تتراوح قيمته بين صفر – عندما يمتلك الجميع التركيب نفسه في مصادر دخلهم – وبين 1، عندما تبلغ اللامساواة التركيبية حدها الأقصى: أي عندما يحصل النسبة العليا x من السكان على دخلهم كاملاً من رأس المال (إلى أن يُستنفد كامل الدخل الرأسمالي)، في حين يحصل ما تبقّى من السكان (1 – x) على دخلهم كاملاً من العمل فقط.
أفسحت مقاربة رينالدي المجال لدراسة نماذج رأسمالية مختلفة ضمن إطار جديد يستند إلى ملاحظتين تجريبيتين: مستوى اللامساواة في الدخل (مثل معامل جيني)، ومدى اللامساواة في التركيب، التي تُستخدم كمؤشّر على وجود مجتمع طبقي. بذلك، نجمع بين عنصرين أساسيين: البُعد السوسيولوجي أو السياسي (وجود بنية طبقية)، والبُعد الاقتصادي (مدى التفاوت). في ورقة مشتركة، استخدمنا، ماركو رينالدي وأنا، بيانات دقيقة من دراسة لوكسمبورغ للدخل، وتوصّلنا إلى الرسم البياني التالي.
إذا رسمنا خطاً مستقيماً من الزاوية الشمالية الشرقية إلى الزاوية الجنوبية الغربية في الرسم البياني، نلاحظ، وهذا ليس مفاجئاً، أن اللامساواة في الدخل تميل إلى الانخفاض كلما انخفضت اللامساواة في تركيب الدخل. لنأخذ مثلاً أميركا اللاتينية في الزاوية الشمالية الشرقية: تُعرف بلدان أميركا اللاتينية بارتفاع اللامساواة في الدخل، لكن ما يتبيّن أيضاً هو أنّ لديها مستويات مرتفعة جداً من اللامساواة التركيبية، أي إنّ الأغنياء يحصلون على معظم دخلهم من رأس المال، فيما يحصل أبناء الطبقة الوسطى والفقراء على دخلهم من العمل. مجتمع طبقي نموذجي، قد يُقال. بل يبدو «طبيعياً»، وفق منطق الرأسمالية الكلاسيكية، أن يتحرّك الشكلان من اللامساواة معاً. كلما نزلنا على هذا الخط، نصل إلى كتلة من البلدان الغنيّة التي تسجّل مستويات متوسّطة من اللامساواة في الدخل (معامل جيني بين 35 و40)، ومستويات متوسّطة أيضاً من اللامساواة التركيبية. ومن المهم الإشارة إلى أن كثيراً من هذه الدول تضمّ نخبة هوموبلوتية، وهو ما يساهم في تخفيض مؤشر اللامساواة التركيبية. وفي الزاوية السفلى اليسرى، نجد بلداناً ذات لامساواة منخفضة (جيني بين 30 و35) ومستويات منخفضة نسبياً من اللامساواة التركيبية. تبرز تايوان وسلوفاكيا هنا في كلا المؤشّرين. أما الصين، فتميّزت بمستوى مرتفع نسبياً من اللامساواة في الدخل، على الرغم من انخفاض اللامساواة في التركيب. فهل يمكن أن تمثّل الصين نموذجاً استباقياً لمجتمع لا يقوم على التراتب الطبقي، لكنه مع ذلك شديد اللامساواة؟
تبدو الأمور واضحة حتى الآن. لكن ثمة نقطتين مهمتين يجب الإشارة إليهما. لننظر إلى الظاهرة غير المألوفة في الزاوية اليمنى السفلى من الرسم البياني: هذه تشمل بمعظمها دول الشمال الأوروبي (فنلندا وآيسلندا والنرويج والدنمارك) التي تتميّز بانخفاض التفاوت في الدخل، لكنها في الوقت نفسه تسجّل مستويات عالية من التفاوت التركيبي! من أين يأتي هذا التفاوت؟ الجواب أنه ناجم بشكل رئيس عن دخل التقاعد الخاص، والذي يُصنّف (عن حق) على أنه دخل رأسمالي. فالكثير من كبار السن، الذين يسحبون معاشاتهم من هذه الصناديق، يحصلون على معظم دخلهم من الملكية، في حين أن معظم السكان في سنّ العمل يعتمدون على دخلهم من العمل. وهذا يخلق تفاوتاً تركيبياً واضحاً. (مع الإشارة إلى أن العاملين اليوم قد يكونون في طور الادخار من أجل تقاعدهم، عبر الإسهام في صناديق خاصة، كما يفعل العاملون في الولايات المتحدة من خلال نظام «401k»، لكنهم لا يزالون حتى الآن لا يجنون دخلاً رأسمالياً منها). هكذا، نواجه مفارقة واضحة: تعاني دول الشمال وأميركا اللاتينية من تفاوت تركيبي، لكن التفاوت في الدخل منخفض في المجموعة الأولى ومرتفع في الثانية.
ثمّة ملاحظة أخرى: إذا نظرنا إلى الزاوية العليا اليسرى، فلن نجد أي بلد فيها. في ورقة أخرى لرانالدي (سأعود إليها لاحقاً)، يرى في ذلك «لا-نتيجة» لها دلالتها. ما يبدو جلياً هو أنّ البلدان المتساوية من حيث تركيب الدخل لا تُظهر مستويات عالية من اللامساواة. وهذا أمرٌ ليس حتمياً من الناحية النظرية، كما يوضح المثال أعلاه: في حال كانت مكوّنات الدخل متساوية بين الأفراد (نسبة رأس المال إلى العمل واحدة)، يمكن لمعامل جيني أن يصل إلى مستويات مرتفعة جداً. في مثالي، كان جيني 46، ولو زدت دخل الأول إلى 1,000,000 من العمل و500,000 من رأس المال، والثاني إلى 100,000 و50,000، والثالث إلى 2 و1 دولار، فمؤشر IFC يبقى صفراً، بينما يرتفع جيني إلى 61.
مع ذلك، تُظهر المعطيات الواقعية أن انخفاض اللامساواة التركيبية يترافق غالباً مع انخفاض في اللامساواة في الدخل. وهذا ما يتيح، كما تفعل ورقتنا البحثية، فتح نقاش معمّق عن الأشكال المختلفة للرأسمالية الحديثة (ولنا أن نتذكّر المفارقة بين الصين وتايوان المذكورة سابقاً). بهذا الانتقال، يمكن تجاوز النقاشات المتكرّرة والمحدودة التي هيمنت على أدبيات «تنويعات الرأسمالية»، والتي انشغلت طويلاً بقضايا مثل إجازات الوالدين في النرويج مقارنة بالولايات المتحدة، في حين كانت مظاهر متمايزة من الرأسمالية تتبلور فعلياً في بلدان مثل إندونيسيا والبرازيل ونيجيريا وكينيا وروسيا وتايلاند. والمطلوب هو تصنيف قائم على معطيات تجريبية، يدمج بين العناصر السياسية والاقتصادية في تحليل الرأسماليات المعاصرة.
لكن الأمر لا ينتهي هنا. ففي ورقتين صدرتا مؤخراً، إحداهما في مجلة Review of Political Economy (أيار/مايو 2025)، والثانية ضمن سلسلة PIAS Working Papers، يسعى ماركو رينالدي إلى بلورة إطار تحليلي، بل معرفي أيضاً، تكون فيه مسألة اللامساواة التركيبية (بين رأس المال والعمل) في صلب التفكير. يسأل: ماذا يعني أن نعيش في مجتمع تسوده مساواة تركيبية أكبر بكثير؟ وما انعكاسات ذلك على التناقض الطبقي، أو الدخل الأساسي الشامل، أو انتشار الذكاء الاصطناعي، أو تغيّر المناخ، أو حتى فلسفة أنماط الإنتاج؟ أنصح بشدّة بقراءة هذه الأوراق لمن يهتم بهذه الإشكاليات. (وبصراحة، أظنّ أنك ينبغي أن تهتم).
لماذا يتركّز رأس المال بهذا الشكل ولماذا لا يملكه سوى قلّة؟
أصل هنا إلى الدخل الناتج عن ملكيّة الأصول الإنتاجية والمالية، والذي سأطلق عليه اختصاراً «دخل رأس المال». هناك ثلاث نقاط أساسية يجب فهمها عن دخل رأس المال في ظل الرأسمالية الجديدة.
أولاً، دخل رأس المال ليس هو دخل العمل. قد يبدو هذا الأمر بديهياً، وهو كذلك فعلاً. فدخل العمل لا يأتي من فراغ؛ إنه يتطلّب الحضور والتركيز والتفكير وبذل الجهد الجسدي، جرّب فقط أن تقوم بوظيفة سائق توصيل في أمازون، ولن نُطالبك بتجربة العمل في منجم فحم. في المقابل، لا يستلزم دخل رأس المال شيئاً من ذلك. كلّ ما يحتاجه الأمر أن تفتح حقيبة مليئة بالمال وتضعها في المصرف، أو أن تطلب من مدير حسابك أن ينقل أموالك من حساب توفير إلى صندوق استثمار. لا أكثر.
يحمل هذا الفارق الجذري دلالات يتجاهلها عمداً الاقتصاديون النيوكلاسيكيون. فالـ100 دولار التي يتقاضاها العامل ليست صافي أجر، بل أجر إجمالي، لأن العمل ينطوي على «كُلفة» نفسية وجسدية. (ومن المفارقات أن نُذكّر الاقتصاديين النيوكلاسيكيين بهذه الحقيقة، في حين أن منظومتهم كلّها، من منحنى عرض العمل إلى مفاهيم الحوافز، قائمة على فكرة المنفعة؛ لكنهم فجأة ينسون كل ذلك). وعليه، فإنّ ما يتوجّب فعلياً هو خصم ما يُعادل الجهد المبذول ذهنياً وجسدياً، واعتبار الباقي فقط قيمة مضافة صافية في الحسابات القومية. تماماً كما لا نُدرج اهتلاك رأس المال ضمن القيمة المضافة الصافية. ومع ذلك، يبدو أن اقتصاديّي العمل قد تجاهلوا هذه النقطة كلياً.
لا يقتصر الأمر على أثره في كيفية احتساب القيمة المضافة وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، بل يطال أيضاً تعريف الدخل الخاضع للضريبة. خذ مثلاً عاملاً بأجر منخفض جداً: يُفرض على دخله بالكامل ضريبة، بينما في الواقع لا يمثّل هذا الأجر بكامله دخلاً صافياً، بل إن جزءاً كبيراً منه يُستهلك ببساطة لتعويض «اهتراء» قوّة العمل. لذلك، يكون الدخل الصافي للعمال ذوي الأجور المنخفضة ضئيلاً للغاية، وربما لا يتجاوز 50%، بل قد يهبط إلى 20% فقط، فيما يُستخدم الباقي لإعادة سائق توصيل في أمازون أو عامل في منجم فحم إلى حال الشبع والراحة التي كان عليها قبل بداية يومه. أما العمال الأعلى أجراً، فالجزء «المُستهلَك» من دخلهم أقلّ نسبياً، ما يعني أنّ التفاوت الحقيقي بين الأجور الصافية أعظم بكثير ممّا توحي به الأرقام الإجمالية. وإلى جانب هذا التفاوت، ينحاز النظام الضريبي بوضوح ضد العمال منخفضي الأجور. ولا تظهر هذه المعضلات مع دخل رأس المال، لأنه يُحتسب بعد خصم الاستهلاك، أي كأرباح صافية تُوزَّع منها الفوائد والعائدات.
ثانيا، يتميّز الدخل من رأس المال بتركّزه الشديد مقارنة بدخل العمل. يبيّن الشكل أدناه ما يمكن اعتباره نتيجة نموذجية عند قياس التفاوت (بمؤشر جيني) في توزيع دخل العمل ورأس المال في الاقتصادات الرأسمالية المتقدّمة. فعند ترتيب السكّان بحسب أجورهم، من الصفر حتى الأعلى، غالباً ما نلاحظ أنّ معامل جيني يتراوح بين 0.55 و0.6 (الخط الأحمر). الولايات المتحدة وألمانيا، مثلاً، لا تختلفان كثيراً على هذا الصعيد. (أعرض هنا هاتين الدولتين فقط، لكن الاتجاه نفسه يسري على أغلب البلدان الغنية). أمّا حين نرتّب الأفراد بحسب دخلهم من رأس المال، من الأدنى إلى الأعلى، فنجد أنّ معامل جيني يقفز إلى ضعف هذا الرقم تقريباً (الخط الأزرق). فما السبب؟
السبب الأوّل، والأكثر جوهرية، هو أنّ معظم الناس (وبالتالي معظم الأسر) لا يملكون أي دخل من رأس المال. نعم، هذه حقيقة: كما سيتّضح لاحقاً، فإنّ أكثر من نصف الأسر في الاقتصادات الغربية المتقدّمة لا تحصل على أي دخل من الأصول المالية. أمّا السبب الثاني، فهو أنّ الشريحة العليا من سلّم العوائد الرأسمالية تجني دخولاً ضخمة، ما يساهم في رفع معامل جيني بشكل كبير. لندقّق مثلاً في أحدث بيانات الولايات المتحدة للعام 2022، من «المسح السكاني الحالي» كما عُدّلت لتتلاءم مع بيانات LIS. عند عرض توزيع دخل رأس المال من أدناه إلى أعلاه، نُفاجأ بمنحنى لا لبس فيه: أشبه بمضرب هوكي بكل وضوح!
تشير الأرقام إلى أنّ 28% من الأسر الأميركية لا تتلقّى إطلاقاً أي دخل من رأس المال. أما 59%، فدَخلها الرأسمالي يُعدّ معدوماً أو شبه معدوم، أي تافهاً بالمعنى الاقتصادي. (وأفترض هنا أنّ الدخل التافه من الأصول المالية هو ذاك الذي يقلّ عن 100 دولار سنوياً للفرد، أي أقل من 8.33 دولارات شهرياً). وكملاحظة طريفة، فإنّ الوسيط السنوي لدخل الفرد من الأصول المالية والإنتاجية في الولايات المتحدة لا يتعدّى 21.89 دولاراً، ما يكفي بالكاد لكأس من الشاردونيه في مانهاتن، أو 3 عبوات بيرة في آيوا. الخلاصة؟ نحو 60% من الأسر الأميركية يمكن وصفها، في ما يخص دخل رأس المال، بأنّها «لا شيء».
من تلك النقطة فصاعداً، يبدأ دخل رأس المال بالظهور بشكل ملموس، ثم يقفز بوتيرة أُسّية عند الاقتراب من القمّة، كما هو واضح في الرسم، ليصل إلى حوالي 122,000 دولار للفرد ضمن أعلى شريحة مئوية. وحتى هذا الرقم يُعدّ متواضعاً مقارنةً بالواقع، نظراً إلى أنّ الأثرياء جدّاً من حيث رأس المال نادراً ما تُلتقطهم المسوح الإحصائية (لضآلة عددهم وصعوبة الوصول إليهم)، فضلاً عن ميل الأشخاص عموماً إلى التقليل من تقدير ثرواتهم ومداخيلهم الرأسمالية. مع ذلك، فهذا يعادل نحو 500 ألف دولار سنوياً لأسرة من 4 أفراد تقع في المئوية الأعلى من دخل رأس المال في الولايات المتحدة، وكلّ ذلك من الملكية المالية وحدها.
ثالثا، كم عدد الأشخاص حول العالم الذين يتلقّون دخلاً من ملكية رأس المال؟ لقد رأينا أنّ 60% من الأسر في الولايات المتحدة لا تحصّل أي دخل أو تحصّله بشكل هامشي من الأصول. الوضع ليس أفضل في بقيّة الاقتصادات المتقدّمة: في ألمانيا تصل النسبة إلى 64%، في الدنمارك 69%، في بريطانيا 79%، في إيطاليا 83%، وفي اليونان 87%. أكثر الاقتصادات التي يمكن وصفها بـ«الرأسمالية الشعبية» — أي التي يتلقّى فيها عدد أكبر من الناس دخلاً من رأس المال، هي النرويج وكوريا الجنوبية وفرنسا، والصين.
في بعض الدول مثل النرويج وبريطانيا، تُحدث المعاشات التقاعدية الخاصة (المدرجة في الرسم البياني أدناه) فارقاً ملحوظاً: فمثلاً، تنخفض نسبة الأسر «الصفرية» في بريطانيا من 84% إلى 79% عند احتساب المعاشات الخاصة. تُشكّل تشيلي حالة مثيرة ولافتة. 20% من الأسر هناك فقط لا تتلقّى أي دخل من الملكية. لكن، في المقابل، 79% من الأسر تحصل على مبالغ تافهة (أقل من 100 دولار سنوياً للفرد) من نظام التقاعد المموَّل في تشيلي. ما يعني أنّ 1% فقط من الأسر التشيلية تستحوذ فعلياً على مجمل الدخل الرأسمالي في البلاد! وفي معظم الدول الأخرى، لا تُحدث المعاشات الخاصة فارقاً يُذكر، إما لأنّها تذهب إلى أشخاص لديهم دخل رأسمالي أساساً، أو لأنّ أنظمتها التقاعدية صغيرة الحجم أو غير موجودة أصلاً.
كلّما ابتعدنا عن الدول الغنية، ارتفعت النسبة بشكل لافت ومقلق: في بلدان مثل البرازيل والبيرو وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك وتشيلي، تفوق نسبة من لا يتلقّون أي دخل من رأس المال 95% من السكان. نعم، هذه النسبة ليست خطأ مطبعياً. أكثر من 95%! ما يعني أن أقل من 5% من الناس هم وحدهم من يحصلون على كامل العائدات من الأصول المالية في تلك البلدان.
تشمل البيانات التي جمعتها من قاعدة LIS ما يقارب 4.6 مليار إنسان حول العالم، كلّهم من دول غنيّة أو من الشريحة العليا من البلدان المتوسّطة الدخل. وبالنظر إلى الوزن السكاني، يتّضح أنّ 77% من هؤلاء لا يتلقّون أي دخل رأسمالي. أمّا القسم المتبقّي من البشرية، الذي يبلغ 3.6 مليار نسمة، والذين لم تُجمَع بياناتهم بعد، فهم يقطنون دولاً أشدّ فقراً، في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، وبالأخصّ في أفريقيا. ومن شبه المؤكّد أنّ أقل من 5% من سكّان هذه المناطق يحصلون على دخل من القطاع المالي. بدمج الرقمين، نصل إلى نتيجة مذهلة: نحو 85% من سكان العالم محرومون تماماً من أي دخل ناتج عن الملكية الرأسمالية.
بعبارة أخرى، إنّ 15% فقط من سكّان العالم (أو من الأسر) يمتلكون الأصول المالية والإنتاجية على هذا الكوكب.
رابعاً، ماذا يعني كل هذا؟ فشلت «الرأسمالية الجديدة»، حتى في الدول الغنيّة، في تحقيق ما سمّته مارغريت تاتشر، وقبلها فريدريش هايك، بـ«مجتمع المالكين»، أي المجتمع الذي يمتلك أفراده الأصول الإنتاجية والمالية. (وكانت تاتشر قد أضافت إليه، من باب التجميل، كلمة «الديمقراطية»). حتى عند احتساب الدخل الناتج عن الادّخار القسري الذي يتحوّل لاحقاً إلى صناديق تقاعد، يبقى ما بين نصف السكان إلى ما يقارب 90% من الناس في الدول الغنية محرومين من الملكية المالية. وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90%، بل وتتجاوز 95%، في البلدان الأقل نموّاً.
تقدّم الهند والصين، أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان، مثالاً جديراً بالتأمّل. فالهند الرأسمالية، بالاسم على الأقل، لا يملك 97% من سكانها أي دخل رأسمالي. بينما شهدت الصين، التي لا تزال تُصنَّف رسمياً كدولة شيوعية، في خلال الأربعين سنة الماضية مستويات غير مسبوقة من «الرسملة»، بحيث بات نصف سكانها تقريباً يتلقّون دخلاً من رأس المال، وهي نسبة تتجاوز ما هو موجود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
الخلاصة: في ما يخصّ ملكيّة رأس المال، لم تنجح الرأسمالية الجديدة، بأي شكل فعلي، في تخطّي العائق البنيوي الذي أرسته الرأسمالية التقليدية: فالدخل من الملكية لا يزال حكراً على قلّة، وداخل هذه القلّة بالذات، تتوزّع الامتيازات بشكل غير متوازن على الإطلاق.
لم تتحوّل الرأسمالية في نسختها الجديدة إلى «رأسمالية الشعب» كما تمنّى بعضهم، بل أصبحت رأسمالية الهوموبلوتيا. لم يكن هناك توزيع أوسع لدخل رأس المال نحو الطبقات الدنيا، بل صعد دخل العمل نفسه إلى الأعلى، ليندمج مع الثروات الكبرى، الموروثة أو المُراكمة، ويُنتج في القمّة طبقة جديدة يستند غناها إلى مصدرَين معاً: العمل ورأس المال.
الهوموبلوتيا؟ هذه هي الأرستقراطية الجديدة بكل وضوح، يا صاح!