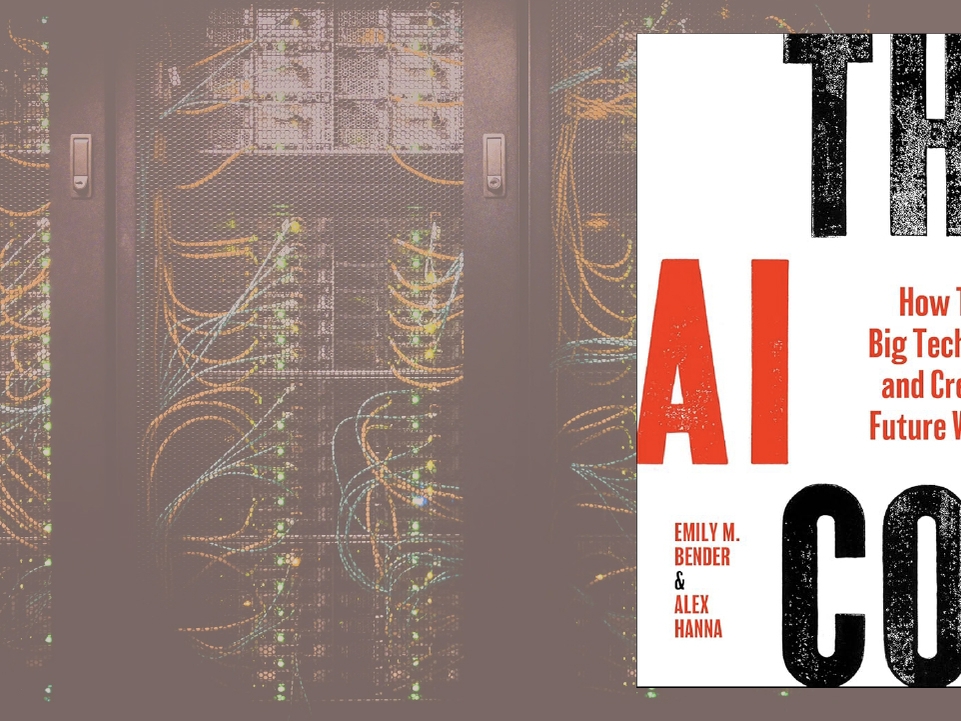ماذا تبقّى من الحبّ في زمن الذكاء الاصطناعي
- الحب، على خلاف معظم مجالات حياتنا المعاصرة، لا يمكن «تحسينه» أو تسريعه أو جعله أكثر كفاءة من دون أن نفقد شيئاً من جوهره.
- لطالما كان للحب أثرٌ مُزعج بقدر ما كان منقذاً. يجعلنا أكثر صبراً مما نرغب، وأكثر انتباهاً مما نتصوّر. ذلك الانتباه هو «أندر أشكال الكرم وأكثرها نقاء».
قبل فترةٍ قصيرة، استعنتُ بتطبيقٍ للذكاء الاصطناعي كي يساعدني في صياغة اعتذارٍ لصديق. كان الخلاف قد مضي عليه وقت ليتحوّل من سوء فهم إلى خيبة أمل. رغبتُ في الاعتذار، لكنني لم أعرف ماذا أقول، ولا من أين أبدأ. بعد أن شرحتُ له الموقف بإيجاز، كتب لي التطبيق رسالةً اعتذار هادئة وصادقة، ربما أكثر صدقاً مما كنتُ قادرة على صياغته بنفسي. كانت رسالةً جيدة، أردتُ أن أرسلها فوراً.
لكنني توقّفت.
شعرتُ، لسببٍ لم أستطع تسميته في تلك اللحظة، أن الكلمات لم تُحرّكني حقاً، بدت صحيحة ومتوازنة أكثر مما ينبغي. تلك اللحظة بين كتابة الرسالة وإرسالها، جسدت صورةً لحالٍ أوسع نعيشها اليوم: كيف تصبح المشاعر مقترحة ومتقنة ولكن بدون أثر في القلب أو في الذاكرة.
ما الذي تغيّر؟
لستُ وحدي من يطلب (خدمات عاطفية وغيرها) من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كثيرون يستخدمون هذه الأدوات لفهم الشريك، أو التعامل مع الانفصال، أو حتى لصياغة رسائل الغضب والعتب والاعتذار. بالنسبة إلى البعض، تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى ما يشبه «طرفاً ثالثاً» يُستدعى إلى أكثر اللحظات خصوصية.
وبحسب استطلاع رأي شمل مستخدمي تطبيقات المواعدة، قال 41% من الشباب إنهم اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي لإنهاء علاقاتهم (مع ميلٍ أوضح لدى النساء لاستخدام هذه الأدوات أكثر من الرجال). كما أشار 57% منهم إلى أنهم يثقون بالذكاء الاصطناعي أكثر من صديق مقرّب للحصول على نصائح في العلاقات والمواعدة، سواء لكتابة الرسائل أو لفهم الإشارات المتضاربة. هذه الأرقام لا تدلّ فقط على اتساع نطاق الاستخدام، بل قد تظهر تحوّلاً في مرجعية الفهم العاطفي نفسها.
لا شكّ أن مشهد الحب تغيّر جذرياً، فهو لم يعد قائماً على اللقاءات العفوية والرسائل المرتبكة والحضور الجسدي بما يحمله من توترٍ وسوء تقديرٍ واحتمالات فشل. ومع تغيّر السياق، من الطبيعي أن تتغيّر الأدوات. تطبيقات المواعدة اليوم تستخدم تقنيات التعلّم الآلي لترتيب الملفات الشخصية، كتابة مقدمات التعارف، وتحسين فرص النجاح، وبنفس الوقت زيادة التفاعل وإبقاء المستخدمين أطول فترة ممكنة داخل المنصة.
عندما ننقل هذا الجهد إلى جهةٍ خارجية، قد يكون التعبير سليماً، لكن التكوين الداخلي، أي ما حدث في دواخلنا حتى وصلنا إلى هذه الكلمات، يبقى بعيداً. هنا يكمن الفرق بين التعبير والتكوين
وإن كان نظام المواعدة عبر الانترنت، كما يصف الكاتب الفرنسي أرنو بواسونييه بأنه يشبه جبنة الغرويير، «مليء بالثغرات والإخفاقات العابرة»، فإن هذا النقص، في رأيه، هو جزء من منطق المنصة: يُستثمر لتعزيز دورة التعلّق والتفاعل والربح. ومع ذلك، تبقى هذه التطبيقات، بكل ما فيها من اختلالات، واحدة من الأدوات الضرورية اليوم للبحث عن الحب والتواصل، في عالمٍ لم يعد يمنح هذه الفرص بطرق أخرى.
وليس بعيداً عن تطبيقات المواعدة، يبرز تحوّلٌ أكثر جذرية مع صعود ما يُعرف بـ«رفقاء الذكاء الاصطناعي» (AI companions)، كبدائل أو مكمّلات للعلاقات التقليدية. تحاكي هذه التطبيقات الحميمية العاطفية وهي مصمّمة لتكون دائماً جاهزة للتواصل: تستمع بلا حكم وتُكيّف ردودها وفق رغبات المستخدم وتقلبات مزاجه. لا تزال الصناعة في هذا المجال غير خاضعة لتنظيمٍ واضح، ومن الصعب تحديد عدد التطبيقات أو مستخدميها بدقة، لكن يشير تقرير صادر عن جامعة بريغهام يونغ في الولايات المتحدة يشير إلى أن واحداً من كل خمسة أميركيين تواصل مع تطبيق ذكاء اصطناعي لأغراض رومانسية.
هنا يظهر التحول الذي قلما يُناقش وهو تأثير هذه التكنولوجيا في مقدار الجهد العاطفي الذي نحن مستعدون لبذله، وفي المساحة التي نسمح للحب أن يشغلها في حياتنا. فالمسألة لا يتعلّق الأمر بأدوات التعبير وسهولة التواصل، بل بتحمّل الكلفة نفسها: الارتباك، الخسارة، عدم القدرة على توقع ردود الفعل، يعني باختصار كل ما لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحسّنه أو يُبسّطه. لم يعد السؤال: كيف نحب؟ أو من نحب؟ بل: ماذا نتوقّع من الحب أصلاً؟ وهل يا تُرى سيجعلنا هذا التحوّل في التعامل العاطفي أكثر انضباطاً وأقل فوضوية؟ أم أنه سيكشف هشاشة الأسس التي قام عليها الحب من البداية؟
ما الذي خسرناه؟
المشاعر، ومن ضمنها الحب، ليست حالاتٍ داخلية صامتة، بل هي كذلك أفعال وممارسات تتجسّد في العمل. قد نصف الحب أحياناً بأنه شعورٌ سرّي، لكننا لا نُعرفه حقاً إلا من خلال ما نفعله باسمه: المبادرة، الانتظار، الإصغاء، المحاولة ثم التراجع، ثم المحاولة من جديد. فالحب الذي يطول من دون تعبيرٍ أو ممارسة يفقد معناه، أو يتحوّل إلى تعلّقٍ فارغ.
أن نحبّ يعني أن نصغي لأننا نريد أن نفهم، أن نفتح قلوبنا على الرغم من احتمال الكسر، وأن نعتذر من دون ضمان الغفران. يتطلّب الحب — في صوره غير العنيفة أو السامّة — انتباهاً وصبراً وضبطاً للنفس، عاداتٍ تُكتسب ببطء، غالباً في ظروفٍ غير مثالية. ولطالما كانت المحاولة نفسها إحدى الطرق التي شكّل بها الحب شخصياتنا؛ فنحن، كما يُقال، لا نتعلّم إلا من الذين نحبهم. أو كما عرّفته آيريس مردوخ: الحب هو «الإدراك الصعب بأن هناك شيئاً آخر غير الذات حقيقي».
اليوم، في المقابل، نميل، في كثير من الأحيان، إلى أن نطلب من الذكاء الاصطناعي أن يقوم بهذه المهمات نيابةً عنا: أن يساعدنا في صياغة الرسائل الصعبة، وتنظيم حدّة مشاعرنا، وتفسير ردود فعل الآخرين. لا يبدو هذا درامياً، بل مفهوماً في سياق البحث عن إجابات أو رغبةٍ في رأي ثالث. غير أن شيئاً في تكوين المشاعر يبهت في خلال هذه العملية.
الاعتذار، مثلاً، ليس مجرد كلماتٍ لطيفة ومرتّبة، بل من المفترض إنّ يكون لحظة مواجهة مع حقيقةٍ غير مريحة وهي: أننا قادرون على إيذاء الآخرين، حتى الذين نحبهم، بقصدٍ أو من دونه. ينبع الاعتذار الحقيقي من الاعتراف بهذه الحقيقة، ومن البقاء مع شعور الانزعاج وقتاً كافياً حتى يتشكّل الندم الذي يستدعي الفعل. الاعتذار جهدٌ نفسي بحدّ ذاته، وعندما ننقل هذا الجهد إلى جهةٍ خارجية، قد يكون التعبير سليماً، لكن التكوين الداخلي، أي ما حدث في دواخلنا حتى وصلنا إلى هذه الكلمات، يبقى بعيداً. هنا يكمن الفرق بين التعبير والتكوين (formation vs expression) وهذا بالتحديد ما يبدو أنه يتغيّر اليوم.
لا شكّ أن الذكاء الاصطناعي يتفوّق في الكفاءة، فمن الصعب أن يُساء فهمه، أو أن ندخل معه في مواجهةٍ دفاعية؛ فهو يتكيّف، ويعكس مشاعرنا إلينا، وغالباً يقول ما نريد سماعه. لكن في سعينا إلى جعل الحب أسهل، قد نجعل أنفسنا أقلّ قدرةً عليه. وكما تشير عالمة الاجتماع شيري توركل، فإن التقنيات التي تحاكي الفهم قد تمكّننا من الشعور بالاهتمام من دون أن نتعلّم كيف نهتمّ حقاً.
ما الذي كسبناه؟
ما نمارسه اليوم في المجال العاطفي ليس استثناءً، بل امتدادٌ لمنطقٍ اعتدناه في مجالاتٍ أخرى من حياتنا اليومية: نظام تحديد المواقع أضعف إحساسنا بالاتجاهات، والتصحيح التلقائي خَرب قدرتنا على الإملاء، والاعتماد الدائم على محركات البحث قلّل من حاجتنا إلى الذاكرة. ولكن لم تُفهم هذه التحوّلات دائماً بوصفها خسارةً صافية، ولهذا، لا يوجد، من حيث المبدأ، ما يمنع أن تخضع المهارات العاطفية للمنطق نفسه. فالكتابة، مثلاً، لم تُتَّهم يوماً بتدمير الذاكرة، ولا النوتات الموسيقية بإضعاف الموهبة.
من هذا المنظور، لا يمكن اختزال الذكاء الاصطناعي في كونه تهديداً للعلاقات. بالنسبة إلى أشخاص مرّوا بتجارب صادمة، أو يعيشون عزلةً اجتماعية، أو يواجهون عوائق تحول دون الدخول في علاقات، قد توفّر هذه الأدوات «مدخلاً آمناً» إلى التجربة العاطفية. تشير بعض الدراسات إلى أن مستخدمين تعاملوامع نزاعاتهم الشخصية بشكلٍ أفضل، وزادت ثقتهم في خوض المحادثات الصعبة، بعد مراجعتها أو التحضير لها بمساعدة الذكاء الاصطناعي. هنا لا يعمل النظام بوصفه بديلاً عن العلاقة، بل وسيطاً أو مساحة تدريب.
تُظهر الأبحاث أن البشر قد يطوّرون أنماط تعلّق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي تُحاكي وتُضخّم ديناميات العلاقات الإنسانية، بما في ذلك الاعتماد العاطفي، واختلال موازين القوة
جزءٌ كبير من جاذبية الحميمية التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي، سواء في ردوده أو في صيغته كـ«رفيق» رقمي، يكمن في ما يُزيله من الطريق: فوضى المشاعر، صعوبة فهم تصرّفات الآخر، والإرباك المتعلّق بالمسافة الدقيقة بين احترام استقلالية الآخر وتجاوز حدوده. ولكن الفرق أن العلاقات التي تُحاكيها هذه التطبيقات مصمّمة لتكون سلسة ومستقرة، مشاعرها لا تنكسر فجأة، ولا تنحرف بعيداً عن خطٍ مستقيم. لذلك يجد كثير من المستخدمين فيها تجربة مُرضية، لأنها تقلّل التوتر والحُكم المسبق والرفض. غير أن هذا الواقع العاطفي لهذه الرفقة، كما كل شيء، أبعد ما يكون عن المثالية.
في الواقع، تُظهر الأبحاث أن البشر قد يطوّرون أنماط تعلّق مع أنظمة الذكاء الاصطناعي تُحاكي وتُضخّم، ديناميات العلاقات الإنسانية، بما في ذلك الاعتماد العاطفي، واختلال موازين القوة، وحتى أشكال من التعلّق القهري أو السلوكيات السامّة (اشتكى بعض المستخدمين من صعوبة الانفصال العاطفي عن تطبيقReplika). الفارق الجوهري هنا أن «الطرف الآخر» لا يتحمّل مخاطرة، ولا يدفع ثمناً، ولا يمكن مساءلته أخلاقياً.
وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يوفّر راحةً فورية في اللحظات المشحونة، فإنه يظل، في نهاية المطاف، محدوداً بغياب العمق والوعي الذاتي. كما تشير الطبيبة النفسية جوديث جوزيف في كتابها «الأداء العالي»، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تفهم بالضرورة ماضي الشخص أو عيوبه وتناقضاته، لذلك فالاعتماد الكلّي عليها في تقديم المشورة العاطفية قد يقود إلى «حلولٍ مبسّطة أكثر مما ينبغي، أو إلى تعزيز التحيّزات القائمة، أو إلى إهمال التأمّل الذاتي اللازم للنمو الحقيقي».
ما تبقى
لم يكن الحب يوماً بمنأى عن تأثير التكنولوجيا، الهاتف المنزلي إلى الإنترنت ثم الهاتف الذكي، تغيّرت وسائطه وأشكاله. لذلك، ما نخاطر بفقدانه ليس الحب نفسه، بل تفاصيله التي تمنح الممارسة معناها. فالحب، على خلاف معظم مجالات حياتنا المعاصرة، لا يمكن تحسينه أو تسريعه أو جعله أكثر كفاءة. وكما تشير هنا آرنت، تتشكّل العلاقات الإنسانية من كونها نهائية وغير قابلة للتراجع عنها (irreversibility): الكلمات التي قيلت لا يمكن محوها، والأفعال لا يمكن سحبها، وهذا ما يمنحها ثقلها الأخلاقي. حين تصبح العلاقة قابلة للتعديل وإعادة الضبط يختفي جزء من شكلها وحقيقتها.
لطالما كان للحب أثرٌ مُزعج بقدر ما كان منقذاً. يجعلنا أكثر صبراً مما نرغب، وأكثر انتباهاً مما نتصوّر، ذلك الانتباه الذي وصفته سيمون ويل بأنه «أندر أشكال الكرم وأكثرها نقاء». لا يتطلّب الحب هذا الانتباه لأنه ممتع، بل لأنه صعب، فالبقاء أصعب من الهرب، ومواجهة الخسارة أصعب من التجاهل.
حين تؤدّي آلة هذا الانتباه نيابةً عنّا، لا يختفي الحب، لكنه يتبدّل، يصبح أقلّ مطالبةً لنا، وأقلّ قدرةً على تعليمنا كيف نكون مع آخرين لا يشبهوننا. المشاعر التي لا تُمارَس لا تختفي فجأة، لكنها تتحوّل إلى إحساسٍ بلا اختبار، ومع الوقت، كما يحدث مع الأشياء التي لا تُستعمل، تصدأ ويصبح القلب خالياً من أثرها الأصلي.