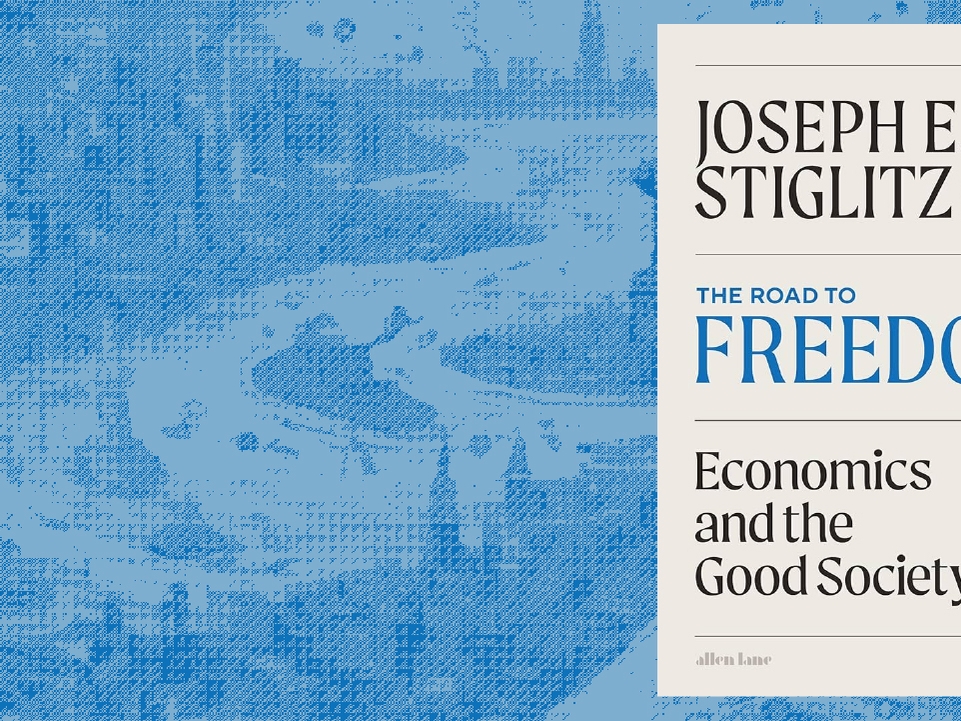الليبرالية ستكلفنا هذه الأرض
أثبتت الوسطية الليبرالية أو «النيوليبرالية التقدمية» التي تُصوِّر نفسها على أنها الحصن ضد الفاشية، أنها أي شيء آخر غير ذلك. فهي لم تُسهِم فقط في البؤس الاجتماعي الذي تتغذَّى عليه السياسات الرجعية، بل إنها تكشف عن نفسها باعتبارها علامة تجارية فاشلة ظلَّت حية في المقام الأول بفضل استثمارات النخب الحزبية والجهات المانحة.
لا تتطلَّب السياسة المناهضة للفاشية التنديد المستمر بفاشية خصمك (وهو ما قد يكون مُخدِّراً أو مُنفِّراً)، ولكنها بالتأكيد يجب أن تتمسَّك بمنطق مختلف عن المنطق الذي «يعتمد على اللحظة». إنها بحاجة إلى اكتشاف طرق لجعل الأفكار التحررية شعبية ونسجها في مشروع متجذِّر في الاحتياجات اليومية.
الواقع أن الهزيمة المُدوية التي مُنيت بها كامالا هاريس في الانتخابات، وما أشاد به بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، باعتباره عودةً سياسيةً تاريخية لدونالد ترامب، تضع حدَّاً لأي أمل في أن تكون الهيمنة الكوكبية للسياسات الرجعية ظاهرةً عابرة. فحملة «الحزب الديمقراطي»، التي رأت في نفسها استمراراً غير مشروط لحملات كلينتون وأوباما وبايدن، انهارت في مواجهة مُرشَّح احتضن اتهامه بالفاشية بقدرٍ أعظم من الابتهاج مقارنةً بحملتيه السابقتين: حيث دعا إلى إطلاق النار على منافسيه في وجوههم، وغازل الأفكار الدكتاتورية، وأعلن، قبل كل شيء، الترحيل الجماعي للمهاجرين سياسةً رئيسةً له. ولم تُسفِر نيران «مشروع 2025»، التي تستهدف الحقوق والمكاسب الاجتماعية، عن مقاومة كافية في صناديق الاقتراع. كما لم يُسفر ولَع ترامب المزعوم بجنرالات هتلر أو كرنفال السوقية العنصرية في «حديقة ماديسون سكوير» عن مقاومة كافية.
إذاً، كيف ينبغي لنا أن نفكر في حقيقة مفادها أن العملية الديمقراطية أكَّدت وشجَّعت ما شخَّصه كثيرون على أنه تهديد غير مسبوق للديمقراطية الأميركية؟
كما هي العادة، ينسب الخبراء السببية والمسؤولية إلى فئات سُكَّانية بعينها. وهناك قدر كبير من سوء النية والتفكير الخاطئ في ردِّ الفعل الأوتوماتيكي هذا. ففي حين تستحق الاتجاهات الملحوظة في أنماط التصويت عبر الفئات الجِندرية أو العرقية أو الطبقية أو الدَّخل أو التعليم دراسةً متأنيةً بالتأكيد - على سبيل المثال، شعبية ترامب بين الناخبين من ذوي الدَّخل المنخفض وشعبية هاريس بين الأثرياء - فمن المحزن أن يُطلَب مِنَّا بسرعة التركيز على صور كاريكاتورية ثنائية الأبعاد للفعالية: الرجال اللاتينيون، والرجال السود، والنساء البيض الجامعيات، وما إلى ذلك. إن العملية الانتخابية عملية تَذريريَّة بطبيعتها. فعلى النقيض من أشكالٍ أخرى من الممارسة السياسية - التظاهر، والتشريع، والشَّغب، وحتى الحملات الانتخابية - فإننا لا نصوت كمجموعات. وكما لاحظ الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر، فإن عملية التصويت في حَدِّ ذاتها ليست مثالاً على الممارسة الجماعية، بل على ما أسماه «تسلسليةً» من نوعٍ ما - مجموعة من الأفراد الذين يتجمعون معاً من دون أي شيء مشترك حقاً - ومن هنا تأتي القرابة العميقة بين العملية الانتخابية والإحصاءات والتسويق.
كيف ينبغي لنا أن نفكر في حقيقة مفادها أن العملية الديمقراطية أكَّدت وشجَّعت ما شخَّصه كثيرون على أنه تهديد غير مسبوق للديمقراطية الأميركية؟
لا شك أن أشكال العمل الجماعي وتكوين المجموعات تتطوَّر حول التصويت. فحركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» شكل من أشكال جماعات المعجبين والمتفرِّجين السلبيين، ولكنها أيضاً حركة مُنظَّمة ومُعقَّدة تضم مجموعة من المؤسسات، من الأبرشيات وبرامج «البودكاست» إلى الجمعيات ومجالس الإدارة. وكما يشير انهيار دعم «الحزب الديمقراطي» بين الناخبين الأميركيين من أصل عربي والفلسطينيين الأميركيين، في ظل الإبادة الجماعية التي تدعمها الولايات المتحدة في غزة، فإن هذه ليست مجرد فئات إحصائية، بل هي أيضاً هويات سياسية، وانشقاقها الانتخابي هو أيضاً نوع من الممارسة السياسية.
ويمكننا أن نستنتج الشيء نفسه بالنسبة إلى الناخبين الشباب الذين تُسيِّسهم حركة الاعتصامات المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية. فمن تجاهل «حركة غير الملتزمين» في «المؤتمر الوطني الديمقراطي» إلى إرسال بِل كلينتون إلى ميشيغان لترويج أكاذيب حول «الدروع البشرية» والثرثرة حول جذور إسرائيل القديمة في «يهودا والسامرة»، من الإنصاف أن نقول إن هذه هويات ومخاوف سياسية جماعية لم يُرِد الديمقراطيون التعامل معها على الإطلاق، حتى عندما أشارت الدراسات إلى أن ذلك قد يتسبَّب في خسارتهم للولايات المتأرجحة.
لقد ألقت حنا أرندت ذات مرة ملاحظة طريفة مُفادها أن «أولئك الذين يختارون الشر الأقل ينسون بسرعة كبيرة أنهم اختاروا شراً». وبالنسبة إلى العديد من الناس اليوم، فإن النسيان ليس بهذه السهولة، مما يجعل اتخاذ هذا الاختيار أكثر صعوبة.
لكن على الرغم من مدى إدانة تواطؤ الديمقراطيين الثابت مع العدوان الإسرائيلي، فإن شمولية الهزيمة تتحدَّث عن فشل أوسع نطاقاً، وهو ليس مُجرَّد مسألة مُتعلِّقة بالاستراتيجية - مَن يعتقد حقَّاً أن تأييد ليز تشيني لهاريس كان كافياً لناخبات الضواحي البيضاوات؟ - بل بالرؤية السياسية الهزيلة التي تُمثِّلها هاريس.
حركة «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» شكل من أشكال جماعات المعجبين والمتفرِّجين السلبيين، ولكنها أيضاً حركة مُنظَّمة ومُعقَّدة تضم مجموعة من المؤسسات، من الأبرشيات وبرامج «البودكاست» إلى الجمعيات ومجالس الإدارة
ومن الدلائل الواضحة بشكل خاص أن «إجراءات الإجهاض تفوَّقت على هاريس في كل ولاية كان فيها الاستقلال الجسدي موجوداً على ورقة الاقتراع»، كما ذكر موقع «ذا إنترسيبت»، حتى مع جعل حملة هاريس الحقوق الإنجابية ركيزة أساسية في حملتها الانتخابية. وينطبق نمط مماثل على حقوق العمال. فعلى الرغم من إظهار الديمقراطيين دعمهم لـ«اتحاد عمال السيارات المتحدين» في الأسابيع الأولى من الحملة، لم يكن هناك شعور يُذكَر بأن هذا كان جزءاً من مشروع جريء لتأمين وتوسيع عضوية النقابات وحقوق العمال في مواجهة مشروع الثورة المضادة الكابوسي، «مشروع 2025» - بل لم يكن هذا حتى تكراراً لحملة بايدن الأكثر تقدمية في عام 2020، والتي كان عليها تبنِّي شيئاً من أجندة حملة بيرني ساندرز بعد عرقلة طريقه إلى الرئاسة. وعندما ردَّت هاريس على الأسئلة المتعلقة بغزة بالتحول إلى مخاوف الناخبين بشأن أسعار المواد الغذائية، لم تكن إجابتها بذيئة أخلاقياً فحسب، بل كانت أيضاً فاشلة تماماً في تهدئة المخاوف الاقتصادية الحقيقية التي لَعِبَت دوراً بارزاً في هزيمة الديمقراطيين. وبالنظر إلى أنها أعلنت بالفعل أن إدارتها لن تختلف كثيراً عن إدارة بايدن - باستثناء إضافة عضو جمهوري في مجلس الوزراء - كان من الصعب تخيلها وهي ترسم مساراً أكثر إيجابية سواء تعلق الأمر بالبقالة أو بالإبادة الجماعية.
وبطبيعة الحال، لا يحتاج ترامب إلى «مفاهيم خطة» حتى ينجح. وليس من المستغرب أنه نبذ «مشروع 2025». ليس لأن أجزاء منه لن تُنفَّذ؛ إذ إنها ستُنفَّذ. ولكن لأن قوته تكمن في نوع من التناقض المُبَنيَن («نسيج» فاشي؟). وتماماً كما لم يؤثِّر عدم اكتمال الجدار الحدودي على فعالية صرخة معاداة الأجانب، فلا يوجد سبب للاعتقاد بأن فشل ترامب في تنفيذ «أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأميركي» من شأنه أن يُنفِّر أنصاره. وهذا لا يعني أنهم لن يحاولوا، أو أن ستيفن ميلر البغيض لن يكون على رأس عملية كهذه. ويمكننا أن نكون على يقين في كل الأحوال من أن الرعب اليومي الذي يطارد حياة المهاجرين غير الموثَّقين، والمشرَّدين، والمُعرقَنين، والمتقلقلين سيتصاعد.
في مجتمع غير متكافئ إلى حد كبير تعاني فيه الحياة اليومية لأغلب الناس من انعدام الاستقرار أو القلق أو الديون أو التضخم، تتمتَّع قوى الشعبوية السلطوية دائماً بميزة. وتحميل الضعفاء المسؤولية عن مصاعب الكثيرين أو وصم بعض النخب على تكريس عدم المساواة المتزايدة لعبة قديمة أضاف إليها ترامب لمسته الخاصة - جزء من المصارعة المُمَسرحة، وجزء من الإعلانات التجارية الاحتيالية، وجزء من برامج الواقع.
في الولايات المتحدة وأماكن أخرى (فكر في المكائد الانتخابية الكارثية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، أثبتت الوسطية الليبرالية أو «النيوليبرالية التقدمية» التي تُصوِّر نفسها على أنها الحصن ضد الفاشية أنها أي شيء آخر غير ذلك. فهي لم تُسهِم فقط في البؤس الاجتماعي الذي تتغذَّى عليه السياسات الرجعية - السجن الجماعي، والتمويل الافتراسي، والحروب الإمبريالية، وتراجع الرعاية الاجتماعية، كلها كانت مشاريع مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في نصف القرن الماضي - بل إنها تكشف عن نفسها باعتبارها علامة تجارية فاشلة ظلَّت حية في المقام الأول بفضل استثمارات النخب الحزبية والجهات المانحة، وأيضاً بفضل ما يُسمِّيه المؤرخ آدم توز «نرجسيتها العميقة». وهذا الاعتقاد الوهمي بأنها قوة تاريخية للتقدم والعقل والخير يجعل الساسة الليبراليين النخبويين ينزلقون بسهولة إلى الأبوية والاستعلاء - وهو شيء يجده العديد من الناخبين أكثر إساءة من الإهانات المباشرة.
في حين تُقدِّم الليبرالية المؤسسية نفسها باعتبارها الترياق لموجة فاشية صاعدة، فإنها تُنكِر الطرق العديدة التي كانت بها سبباً أو مصدر تمكين لهذا التصاعد
وفي حين تُقدِّم الليبرالية المؤسسية نفسها باعتبارها الترياق لموجة فاشية صاعدة، فإنها تُنكِر الطرق العديدة التي كانت بها سبباً أو مصدر تمكين لهذا التصاعد. إن دورها في تهيئة الظروف لهيمنة اليمين المتطرف حكاية قديمة، لكنها تتكرر مرة أخرى، حيث يؤدِّي «التحدث بصرامة» بشأن الحدود أو تلبية رغبات صقور الحرب إلى تآكل الناخبين الديمقراطيين، بينما يفشل تماماً في كسب الجمهوريين أو المستقلين، الذين يشعرون براحة أكبر في استخدام هذا التناقض. وكما أعلن موسوليني قبل وقت قصير من الاستيلاء على السلطة، فإن الفاشيين لديهم «الشجاعة لتفتيت كل الفئات السياسية التقليدية وتسمية أنفسنا، حسب اللحظة، أرستقراطيين وديمقراطيين، ثوريين ورجعيين، بروليتاريين ومناهضين للبروليتاريا، مسالمين ومناهضين للسلام».
إن ترامب - باعتباره المرشح المناهض للحرب/المؤيد للإبادة الجماعية، والذي يستطيع أن يشيد بتسريح العمال الذي قام به إيلون ماسك بينما يتظاهر بأنه صديق للعمال - سعيد بإحياء تلك «النسبية» التي ادَّعى الدكتاتور الإيطالي أنها واحدة من السمات المميزة للفاشية.
لا تتطلَّب السياسة المناهضة للفاشية التنديد المستمر بفاشية خصمك، وهو ما قد يكون مُخدِّراً أو مُنفِّراً، ولكنها بالتأكيد يجب أن تتمسَّك بمنطق مختلف عن المنطق الذي «يعتمد على اللحظة» أو على الحسابات الانتخابية وحدها. إنها بحاجة إلى اكتشاف طرق ليس فقط لجعل الأفكار التحررية شعبية - لحسن الحظ، العديد منها شعبي بالفعل - ولكن لنسجها في مشروع متجذِّر في الاحتياجات اليومية. ولتحقيق هذه الغاية، فإن الوسطية الليبرالية ليست عديمة الفائدة فحسب، بل إنها عقبة. إنها تتطلب تضحيات أخلاقية وسياسية لا نهاية لها من اليساريين والتقدميين، في حين لا تعمل حتى كوسيلة لائقة للتسويات الإصلاحية التي قد نتوقعها من السياسة التمثيلية. فعندما تكون هناك قضايا وجودية على الأجندة، من الإبادة الجماعية إلى كارثة المناخ المتصاعدة والأزمات المتعددة التي ستجلبها، فإن الرهان على الليبرالية مهمة حمقاء.
نُشِر هذا المقال في In These Times في 8 تشرين الأول/نوفمبر 2024، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الكاتب.