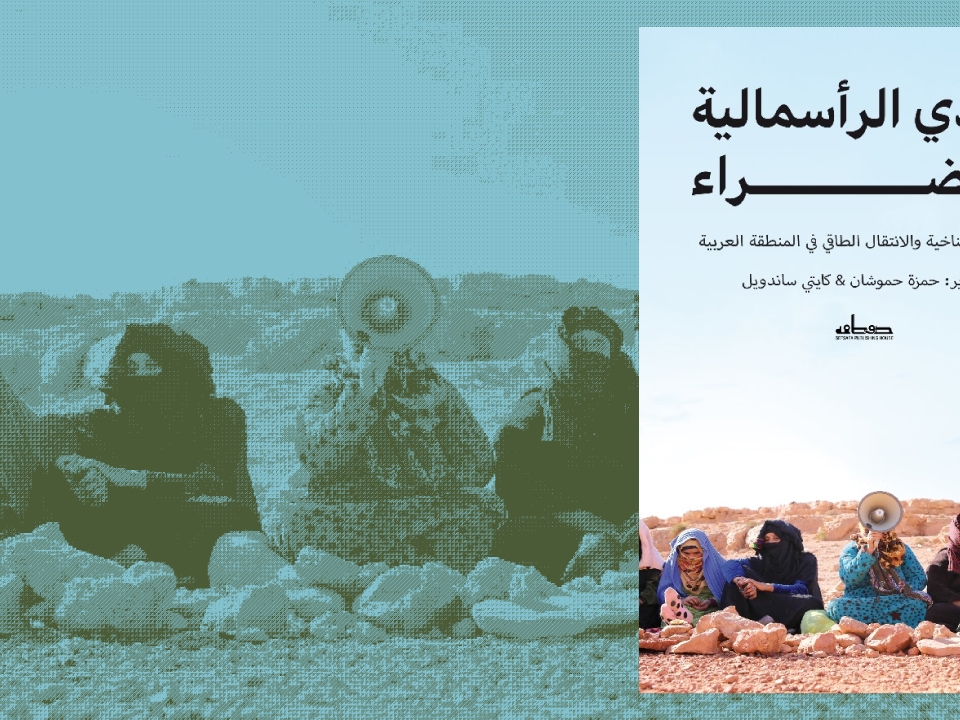مبادرة باكستان الخضراء
الرأسمالية الخضراء والاستيلاء على أراضي الأرياف في باكستان
في 11 تموز/يوليو 2025، كانت لاهور غارقة في أمطار الموسِم، بسماء رمادية وطرق مغمورة بالمياه. داخل نادي الصحافة، خيّم شعور كثيف بالترقّب مع اقتراب انعقاد مؤتمر صحافي خُصّص لتسليط الضوء على موجة جديدة من مشاريع التنمية الزراعية التي تقودها الدولة تحت مسمّى «مبادرة باكستان الخضراء». جلس الصحافيون بملابسهم المبللة بانتظار المتحدثين، وكان من بينهم شاب في منتصف الثلاثينيات، ملتحٍ، يُعرف شعبياً باسم «ذو الفقار جونيور».
يحمل ذو الفقار جونيور اسم جدّه، ذو الفقار علي بوتو، رئيس الوزراء الباكستاني الاشتراكي السابق الذي أعدمته الدكتاتورية العسكرية المدعومة أميركياً بقيادة محمد ضياء الحق عام 1979. وخلال العام المنصرم، برز هذا الفنان والناشط الاشتراكي البيئي بوصفه وجهاً غير متوقّع لحركات الفلاحين والمزارعين المعارضة لمبادرة باكستان الخضراء. وعندما توجّه إلى الصحافيين، تحدّث بهدوء وحزم قائلاً: «لن نترك مزارعينا وفلّاحينا تحت رحمة هذا الجنون».
في الخارج، كان المشهد السياسي الباكستاني مشحوناً بدعم شعبي واسع لرئيس الوزراء السابق عمران خان، المعتقل منذ إطاحته قبل 3 أعوام عبر أول تصويت ناجح بحجب الثقة في تاريخ البلاد. ومنذ ذلك الحين، يقبع خان في السجن بعد إدانته بتهم فساد وتسريب أسرار الدولة، وهي اتهامات يصفها أنصاره بأنها مفبركة. ومع ذلك، شكّل خان تحدياً مباشراً لهيمنة الجيش، الذي يتّهمه بالوقوف خلف عزله.
في أعقاب الإطاحة بخان، تولّى الحكم ائتلاف تقوده الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز (يمين الوسط)، في مرحلة اتّسمت بعدم الاستقرار السياسي، وتزامنت مع تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان وارتفاع معدلات التضخم، ما عمّق السخط الشعبي. وعلى الرغم من أن المواجهة العسكرية مع الهند في أيار/مايو 2025 ساعدت الجيش على تحسين صورته العامة، فإنها لم تُضعف شعبية عمران خان. ولا يزال الجيش يحتفظ بنفوذ سياسي واسع، في نظام يصفه كثيرون بأنه «هجين»: واجهة مدنية منتخبة، لكن القرارات المفصلية تبقى بيد المؤسسة العسكرية.
ضخّ نظام أيوب خان استثمارات ضخمة في الزراعة، غير أن هذه المساعدات لم تكن محايدة، بل شكّلت جزءاً من استراتيجية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري، واحتواء احتمالات التمرد الريفي التي كانت منتشرة في بلدان الجنوب آنذاك
وسط هذه الأزمات، الاقتصادية منها والسياسية، ومع تفاقم أزمة ميزان المدفوعات، أطلقت السلطات عام 2023 «مبادرة باكستان الخضراء»، وهو برنامج إنعاش اقتصادي طموح صاغه الجيش ويشرف عليه مباشرة. وتسعى المبادرة، عبر استثمارات محلية وأجنبية، إلى إدخال أساليب زراعية حديثة إلى الأراضي الصالحة وغير الصالحة للزراعة، في بلد يعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي، الذي أسهم بنحو 24% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024–2025.
ويُعدّ مشروع القنوات الست محوراً أساسياً في هذه المبادرة، إذ يهدف إلى إنشاء ست قنوات ريّ كبرى في المناطق القاحلة من إقليم البنجاب، أكبر أقاليم البلاد، لتحويل مساحات واسعة من الأراضي الجافة إلى مناطق قابلة للزراعة. غير أن المبادرة، على الرغم من خطابها الرسمي الذي يركّز على الإنتاجية والتنمية، تُستخدم عملياً كإطار مؤسسي لتأجير مساحات شاسعة من الأراضي العامة للشركات الزراعية.
بموجب هذا المخطط، تحدد الحكومات الإقليمية أراضي تُصنّف على أنها «قاحلة» أو «غير مستغلة»، ثم تُنقل إدارتها إلى شركة يشرف عليها الجيش تُدعى Green Corporate Initiative Pvt. Ltd.، أُنشئت تحت مظلة المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار. وتبرم هذه الشركة عقود إيجار طويلة الأمد، تمتد غالباً من 20 إلى 30 عاماً، مع مستثمرين محليين وخليجيين لتطوير هذه الأراضي في مشاريع زراعية موجّهة للتصدير.
وعلى الرغم من تغليف مبادرة باكستان الخضراء بلغة الاستثمار والتحديث، تشير حركات اجتماعية متنامية في مختلف أنحاء البلاد إلى جانبها المعتم: تهجير المجتمعات الريفية، وانتزاع الأراضي من أصحابها، وسيطرة رأس المال المحلي والأجنبي – ولا سيما القادم من دول الخليج – على موارد يفترض أنها عامة.
جذور هيمنة النخبة: الدولة المُعسكرة والتشكّل الطبقي في باكستان
في عام 1961، حظي أول حاكم عسكري لباكستان، الجنرال أيوب خان، باستقبال استثنائي في الولايات المتحدة عقب انضمام بلاده إلى حلفي «سيتو» و«سنتو» بقيادة واشنطن. وقد أُنشئ هذان التحالفان في ذروة الحرب الباردة لاحتواء المدّ الشيوعي في آسيا والشرق الأوسط، ما جعل باكستان دولة متقدمة في خطوط المواجهة الجيوسياسية.
بدعم غربي، ولا سيما أميركي، ضخّ نظام أيوب خان استثمارات ضخمة في الزراعة، أحدثت تحولاً عميقاً في البنية الزراعية للبلاد. وسارعت وسائل الإعلام الغربية إلى الترويج لباكستان بوصفها «نمراً آسيوياً» صاعداً. غير أن هذه المساعدات لم تكن محايدة، بل شكّلت جزءاً من استراتيجية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري، واحتواء احتمالات التمرد الريفي التي كانت منتشرة في بلدان الجنوب آنذاك. وفي هذا السياق، يرى نيك كولثير أن «الثورة الخضراء» لم تكن سوى أداة من أدوات الثورة المضادة، استخدمتها الولايات المتحدة لتأديب السياسة الآسيوية ودعم الأنظمة الحليفة عبر التكنولوجيا الزراعية.
من هذا المنظور، تحوّلت السيطرة التكنولوجية إلى وسيلة لإعادة تشكيل الريف سياسياً واجتماعياً. فقد جرى إدماج الفلاحين في منظومة معقّدة من الائتمان، والبذور المحسّنة، والأسمدة الكيماوية، والمحاصيل النقدية، ما قيّد استقلاليتهم وربطهم بدورات إنتاج خاضعة للرقابة. وبهذا، أُعيد تنظيم العلاقات الاجتماعية في الريف على نحو أضعف إمكانيات التنظيم والتمرّد، بينما أُعيد تعريف الجوع باعتباره مشكلة تقنية تتعلق بنقص السعرات الحرارية، لا نتيجة مباشرة لعدم المساواة ونزع الملكية.
وعلى عكس التجارب الراديكالية في الصين الماوية أو فيتنام بعد الثورة، كانت الإصلاحات الزراعية الجذرية خطاً أحمر في باكستان المتحالفة مع واشنطن. فبدل إعادة توزيع الأرض، جرى التركيز على رفع الإنتاجية عبر التكنولوجيا والتمويل الغربيين. داخلياً، هدفت هذه السياسات إلى ترسيخ نفوذ كبار ملاك الأراضي التقليديين والحفاظ على البنية الطبقية القائمة، بينما أدّت خارجياً وظيفة دعائية بوصف باكستان نموذجاً رأسمالياً بديلاً عن الشيوعية. ولم تكن هذه التجربة فريدة، إذ استُخدمت المساعدات الزراعية كأداة لمكافحة التمرّد في بلدان أخرى مثل الفلبين وإندونيسيا وتايلاند.
أسهم الدعم الجيوسياسي الأميركي في ترسيخ نموذج زراعي تراكمي يحتل فيه الجيش موقعاً محورياً، وهو نمط لا يزال قائماً حتى اليوم. تشير التقديرات إلى أن نحو 12 مليون فدان، أي قرابة 4% من مساحة باكستان، تخضع لسيطرة المؤسسة العسكرية. وقد أدى ذلك إلى نشوء طبقة من ملاك الأراضي العسكريين الذين يجنون الريوع من دون ارتباط فعلي بالعمل الزراعي. ففي مناطق مثل أوكارا وبهاوالبور وبلوشستان، أعاد الجيش في مطلع الألفية الاستيلاء على أراضٍ كان يزرعها مستأجرون تاريخياً، وقُمعت مطالبات هؤلاء بالملكية. ويُضاف إلى ذلك التمييز المائي، إذ تحظى أراضي الجيش بريٍّ منتظم من قنوات الدولة، بينما يعاني صغار المزارعين من قنوات مهملة، ما يضطرهم إلى الاعتماد على آبار مكلفة ترفع كلفة الإنتاج.
وعلى الرغم من امتلاك جيوش أخرى، مثل المصرية والتركية، نفوذاً اقتصادياً واسعاً، فإن درجة السيطرة المباشرة للجيش الباكستاني على الأراضي تُعدّ استثنائية. فقد تشكّلت في البلاد واحدة من أكثر الطبقات العسكرية المالكة للأراضي رسوخاً عالمياً. ومن خلال امتلاك الأرض، والتمتع بأولوية الوصول إلى المياه، والاستفادة من الدعم الحكومي، تهيمن هذه النخبة على الاقتصاد الريفي، بينما يتحمّل المستأجرون مخاطر الإخلاء، لا سيما مع تحويل الأراضي الزراعية إلى مشاريع عقارية مربحة.
وقد أدّى التحوّل من الإقطاع الزراعي إلى الرأسمالية العقارية الحضرية إلى تعميق الانقسام الطبقي، خصوصاً منذ الثمانينيات والتسعينيات مع توسّع مشاريع الإسكان المدعومة من الدولة. في هذا السياق، لم تعد الأرض مرتبطة بالإنتاج، بل أصبحت مجالاً للمضاربة والتراكم. وتحوّلت مساحات واسعة من الريف والأطراف الحضرية إلى مجمّعات سكنية مخصّصة للطبقات الوسطى والعليا. ففي لاهور مثلاً، تخضع نحو ربع الأراضي لسلطة الإسكان الدفاعي، التي تطورت من هيئة مخصّصة لإسكان الضباط إلى واحدة من أقوى إمبراطوريات العقارات في البلاد.
وينطبق الأمر ذاته على مشاريع خاصة كبرى مثل «بهرية تاون»، التي تجسّد نموذج الريعية العقارية وتحويل الأرض إلى رأس مال وهمي. فالثروة هنا لا تُنتج عبر العمل أو الابتكار، بل عبر التحكم بسوق الأراضي والمضاربة بها. وتُعدّ هذه المشاريع مثالاً واضحاً على «التراكم عبر نزع الملكية» كما وصفه ديفيد هارفي، إذ ارتبط اسمها بعمليات إخلاء قسري للمجتمعات المحلية. وحين يتعذّر الإخلاء المباشر، تُستخدم أساليب الضغط لشراء الأراضي بأسعار متدنية، ثم يُعاد تصنيفها تجارياً وتسويقها على نطاق واسع، مع بيعها مسبقاً للمستثمرين لتمويل توسّع مضاربي متواصل.
على الرغم من أن الرأسمالية العقارية تمثل مرحلة جديدة، فإنها تبني على الهياكل الإقطاعية القديمة، مع استمرار أنماط نزع الملكية واستيلاء النخبة، في تجسيد حيّ لمفهوم «رأس المال الوهمي»
الجديد في هذا المسار ليس منطق التراكم بحد ذاته، بل دخول نخب جديدة إلى دائرة السيطرة على الأرض: جنرالات، قضاة، بيروقراطيون، وأباطرة عقارات، يعملون ضمن شبكة متداخلة مع مؤسسات الدولة. وهكذا، وعلى الرغم من أن الرأسمالية العقارية تمثل مرحلة جديدة، فإنها تبني على الهياكل الإقطاعية القديمة، مع استمرار أنماط نزع الملكية واستيلاء النخبة، في تجسيد حيّ لمفهوم «رأس المال الوهمي» عند ماركس.
اقتصادياً، كانت نتائج هذا التحول كارثية. فقد انتقل الاقتصاد من الإنتاج إلى المضاربة، ما أضعف القدرة الصناعية وعمّق العجز التجاري. وبينما استقطب قطاع العقارات رؤوس أموال تفوق تلك التي جذبها قطاع النسيج بين 2015 و2020، استمر اعتماد البلاد على التحويلات الخارجية، في ظل ديون تجاوزت 90 مليار دولار.
اجتماعياً، ساهمت هذه الرأسمالية العقارية في تدهور أنظمة الإيجار الريفي وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، الذي يطال اليوم نحو 43% من السكان. ومع بقاء الفقر الريفي مرتفعاً عند 35%، تسارعت الهجرة إلى المدن والخارج، وازدادت مشاركة النساء في العمل الزراعي، غالباً من دون أجر أو بدخل متدنٍ، كما هو الحال في إقليم السند حيث تشكّل النساء الغالبية في العمل الزراعي غير المدفوع، وتقدّر القيمة السنوية لعملهن بنحو 2.46 مليار دولار، وهو ما يساوي 57% من إجمالي العمالة الزراعية في المقاطعة.
وفي المدن، رافق تحويل الأرض إلى سلعة أزمة إسكان حادة، مع عجز يقدّر بأكثر من عشرة ملايين وحدة سكنية، يتوزع بشكل غير متكافئ بين الأقاليم. وغالباً ما تُنفَّذ مشاريع «التنمية» عبر تهجير الأحياء الفقيرة، كما حدث في إسلام أباد عام 2015، حين هُدم أحد الأحياء العشوائية لصالح مشروع عقاري، ما شرد 8,000 شخص من الطبقة العاملة المنتمية إلى الأقلية المسيحية، في مثال صارخ على العنف الطبقي المتواطئ مع الدولة.
اليوم، دخل هذا المسار مرحلة جديدة تُعرف بـ«الرأسمالية الخضراء». فهي لا تغيّر منطق التراكم، بل تعيد تغليفه بلغة الاستدامة والزراعة الذكية مناخياً. وتُقدَّم التقنيات الجديدة بوصفها حلولاً حتمية، بينما يُصوَّر مستخدمو الأرض التقليديون كغير أكفاء. وكما تشير تانيا لي، تُختزل الصراعات الاجتماعية والبيئية المعقّدة في مشكلات تقنية ضيّقة، ما يشرعن الزراعة التجارية ويُخفي مصادرة الأراضي والمعرفة المحلية.
وبذلك، تتحوّل البيئة نفسها إلى مجال جديد لاستحواذ النخبة، حيث يُعاد إنتاج نزع الملكية باسم الحماية البيئية والكفاءة الزراعية وتعويضات الكربون، لا من أجل استعادة النظم البيئية، بل لتكريس أنماط قديمة من الهيمنة في لغة جديدة.
زراعة الأرباح: تفكيك مبادرة باكستان الخضراء
تستند الدولة الحديثة التي تحكم البنجاب اليوم إلى إرث استعماري قائم على تصنيف الأراضي ومستوطنات القنوات، التي أنشأها البريطانيون لتحويل الأراضي القاحلة إلى مساحات زراعية مربحة. غير أنّ الرؤية الرسمية الراهنة تُفرغ الأرض من نسيجها الثقافي والتاريخي، وتعيد تعريفها بلغة الأمن والتنمية والتقنيات. وبذلك، تُستبدل الذاكرة المتجذّرة في التربة بخطابات تكنوقراطية ترى الأرض أصلاً قابلاً للقياس والاستثمار، لا موطناً لمجتمعات نسجت حياتها ومعناها من العمل والثقافة. هذا الانفصال الأخلاقي والمعرفي هو امتداد مباشر لمنطق التنمية الاستعماري وما بعد الاستعماري، ويتجلّى بوضوح في مشاريع مثل «مبادرة باكستان الخضراء».
أُطلقت المبادرة رسمياً عام 2023، وقدّمت بوصفها حلاً شاملاً للأزمة الاقتصادية وتعزيزاً للأمن الغذائي عبر الزراعة الآلية واسعة النطاق. ويعرّفها موقعها الرسمي بأنها مشروع مشترك بين الحكومة الباكستانية والجيش يهدف إلى تطوير الزراعة من خلال التكنولوجيا الحديثة، وتقنيات الري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج، مع وعود بخلق فرص عمل واسعة في الريف.
غير أنّ ما يتجاوز الخطاب المعلن هو أنّ المبادرة تشكّل إطاراً مؤسسياً أوسع لإعادة تنظيم السيطرة على الأراضي والاستثمارات الزراعية، بالشراكة الوثيقة بين الدولة والمؤسسة العسكرية. ويشمل هذا الإطار إنشاء نظام إدارة معلومات الأراضي، وتأسيس شركة «المبادرة الخضراء» الخاصة، والمجلس الخاص لتسهيل الاستثمار، إلى جانب شقّ ست قنوات جديدة في البنجاب. وتعمل هذه الأدوات مجتمعة على تركيز قرارات استخدام الأراضي وتوزيع المياه والإدارة الزراعية تحت إشراف عسكري مباشر.
تُستبدل الذاكرة المتجذّرة في التربة بخطابات تكنوقراطية ترى الأرض أصلاً قابلاً للقياس والاستثمار، لا موطناً لمجتمعات نسجت حياتها ومعناها من العمل والثقافة. هذا الانفصال الأخلاقي والمعرفي هو امتداد مباشر لمنطق التنمية الاستعماري وما بعد الاستعماري
وقد بدأت نتائج هذا التوجّه بالظهور بالفعل. إذ تشير تقديرات إلى احتمال تهجير نحو مليون فلاح ومزارع صغير نتيجة مشاريع الزراعة التجارية المرتبطة بالمبادرة. كما أُثيرت اعتراضات واسعة حول قانونية وآليات الاستحواذ على الأراضي التي تُنفّذ باسم «أراضي الدولة».
تعود جذور هذه العملية إلى كانون الثاني/يناير 2023، حين اقترح الجيش، عقب تشكيل حكومة انتقالية في البنجاب، توسيع نطاق الزراعة التجارية. وعلى الرغم من غياب تفويض دستوري يجيز للحكومة المؤقتة اتخاذ قرارات طويلة الأمد، وافق مجلس الوزراء الانتقالي على تأجير أكثر من 45 ألف فدان من أراضي الدولة في مناطق بَكّار وخوشاب وخانيوال إلى منظمة أعمال الحدود، وهي ذراع إنشائية للجيش، بعقود تمتد لعشرين عاماً قابلة للتمديد. وفي حزيران/يونيو من العام نفسه، اعتبرت محكمة لاهور العليا هذه الخطوات غير دستورية، قبل أن يُعلَّق الحكم لاحقاً، ما فتح الباب لاستمرار الاستحواذ على الأراضي في إطار المبادرة.
تكمن المفارقة في أنّ كثيراً من هذه «أراضي الدولة» ليست فارغة أو مهجورة، بل يفلحها مزارعون مستأجرون منذ الحقبة الاستعمارية بموجب عقود إيجار طويلة الأمد، من دون أن يُعترف بحقوقهم في الملكية. كما أن مساحات واسعة مصنّفة على أنها غير مزروعة تُستخدم فعلياً من رعاة ومجتمعات بدوية على أساس عرفي وموسمي.
وقد مهّدت عقود الإيجار المثيرة للجدل الطريق أمام محاولات طرد متكرّرة للمزارعين. ففي قرية محمد ناغار بخانيوال، صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 قرار إداري مفاجئ بإخلاء عائلات استوطنت الأرض وزرعتها لأكثر من 120 عاماً. ردّ المزارعون بتظاهرات رُفع فيها شعار «الملكية أو الموت»، ما أجبر السلطات على التراجع مؤقتاً، لكن التهديد بالطرد لا يزال قائماً.
لتسهيل التوسّع، أُنشئت في تموز/يوليو 2023 آليتان محوريتان. الأولى هي نظام إدارة معلومات الأراضي، الذي يعمل تحت إشراف مشترك للحكومة الفيدرالية والجيش، ويهدف إلى تحديد ورسم خرائط الأراضي الحكومية وغير المزروعة المخصّصة للزراعة التجارية. وقد حُدّدت حتى الآن نحو 4.8 ملايين فدان للمرحلة الأولى من المشروع، في إطار توجّه أوسع لمركزة قرارات استخدام الأراضي والاعتماد على الحلول التكنولوجية.
أما الآلية الثانية فهي شركة المبادرة الخضراء، التي أنشأها الجيش لإدارة الأراضي المنقولة إلى سيطرته عبر اتفاقيات مع حكومات الأقاليم. وعلى الرغم من بقاء الملكية القانونية بيد الحكومات المحلية، تقوم الشركة بتأجير هذه الأراضي لمستثمرين محليين وأجانب بعقود طويلة الأجل تصل إلى 30 عاماً، لتسهيل مشاريع الأعمال الزراعية واسعة النطاق.
لاحقاً، توسّعت المبادرة إلى إقليم السند، حيث جرى تأجير نحو 52 ألف فدان في مناطق خيربور وسوكور وغوتكي. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبدو محدودة نسبياً، فإنها لا تمثّل سوى المرحلة الأولى من خطة أشمل تهدف إلى إخضاع ملايين الأفدنة من الأراضي الحكومية وغير المزروعة في البنجاب والسند لترتيبات إيجار مماثلة.
يمثّل هذا المسار تحوّلاً جذرياً في إدارة الأرض: إذ يُجرّد المزارعون المستأجرون من أي أفق للملكية، وتُعاد صياغة استخدامات الأراضي المشتركة لصالح شركات زراعية كبرى. كما يعكس الدور المتنامي للمؤسسة العسكرية في الاقتصاد السياسي الزراعي، ضمن نموذج يتبنّى لغة الاستدامة العالمية، لكنه يعيد إنتاج أنماط قديمة من الإقصاء ونزع الملكية، في ثوب «أخضر» جديد.
دخول الاستثمار الخليجي
أخذ انخراط دول الخليج في مبادرة باكستان الخضراء يتبلور عملياً عبر حزمة من الصفقات الاستثمارية الكبيرة، تقودها كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقد اضطلع المجلس الخاص لتسهيل الاستثمار، الذي أُنشئ عام 2023، بدور محوري في تسريع هذه التدفقات الرأسمالية ضمن إطار المبادرة.
في هذا السياق، أعلنت الإمارات في عام 2023 التزامها باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار في باكستان، شملت الزراعة التجارية، وإنتاج اللحوم الحلال، وزراعة نخيل التمر الموجّه للتصدير إلى السوق الإماراتية. كما وقّعت شركات إماراتية كبرى، مثل «الظاهرة» و«أبوظبي القابضة» و«مجموعة موانئ أبوظبي»، مذكّرات تفاهم مع الحكومة الباكستانية لتوسيع حضورها في قطاعات الموانئ واللوجستيات والجمارك، بما يعكس توجّهاً واضحاً لتعميق الاندماج الإماراتي في سلاسل الغذاء والنقل داخل باكستان.
وبالمثل، برزت السعودية كلاعب رئيسي في الأجندة الزراعية للمبادرة. فقد تعهّدت في عام 2023 باستثمار نحو 25 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، مع تركيز أساسي على القطاع الزراعي، وبدأت ذلك باستثمار أولي قدره 500 مليون دولار جرى تسهيله عبر نظام إدارة معلومات الأراضي. ودخلت شركات سعودية عدّة، من بينها «سرح التقنية» و«المراعي» و«الخريف» و«صالح»، في شراكات مع تكتلات باكستانية مثل مجموعة فاطمة، لتنفيذ مشاريع زراعة تجارية تشمل الأرز والشعير والشوفان والأعلاف.
كما طُرح على الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني مشروع لإنشاء مزرعة ماشية في البنجاب تضم نحو 30 ألف رأس، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ ستة آلاف طن من اللحوم المخصّصة للتصدير، إلى جانب اهتمامها باستئجار ما يقارب 49 ألف فدان من الأراضي الزراعية. وفي آذار/مارس 2024، خُصّصت صفقة أخرى لزراعة خمسة آلاف فدان من البرسيم في منطقة باهكار بالبنجاب، على أن يُصدَّر المحصول لتغذية الأبقار الحلوب في السعودية. ودُعيت شركة «المراعي» للمشاركة في المشروع، رغم الجدل الواسع المرتبط بأنشطتها في ولاية أريزونا الأميركية، حيث تُتّهم باستنزاف مياه نهر كولورادو لزراعة محصول شديد الاستهلاك للمياه. ويثير تطبيق هذا النموذج في منطقة شبه قاحلة مثل باهكار مخاوف جدية من تفاقم استنزاف المياه الجوفية الشحيحة أصلاً.
تُظهر هذه المشاريع مجتمعة مستوى متقدّماً من التكامل بين القطاع الزراعي الباكستاني وأجندات الأمن الغذائي الخليجية. غير أنّ هذا التكامل ينبغي فهمه ضمن إطار أوسع للاقتصاد السياسي، حيث يُعاد تقديم تراكم رأس المال بوصفه تحديثاً وأمناً غذائياً
تُظهر هذه المشاريع مجتمعة مستوى متقدّماً من التكامل بين القطاع الزراعي الباكستاني وأجندات الأمن الغذائي الخليجية. غير أنّ هذا التكامل ينبغي فهمه ضمن إطار أوسع للاقتصاد السياسي، حيث يُعاد تقديم تراكم رأس المال بوصفه تحديثاً وأمناً غذائياً. وكما يوضح آدم هنيّة، لا تستهدف هذه المشاريع في جوهرها تأمين الغذاء لسكان الخليج، بقدر ما تسعى إلى تعزيز نفوذ الشركات عبر إعادة تنظيم السيطرة على الموارد مكانياً، وتحميل التكاليف البيئية—وخصوصاً استنزاف المياه والتلوّث—للدول المضيفة.
في باكستان، يتجلّى هذا المنطق بوضوح من خلال مبادرة باكستان الخضراء، حيث يتقاطع رأس المال الخليجي مع شركات زراعية مرتبطة بالجيش لتحويل أراضٍ تُصنَّف رسمياً على أنها «خالية» أو «غير مستغلّة» إلى مزارع تجارية موجّهة للتصدير. غير أنّ هذه التصنيفات نادراً ما تكون محايدة، إذ لطالما استخدم الرعاة والمجتمعات المحلية هذه الأراضي بموجب أعراف راسخة أُقصيت حقوقها بفعل إعادة التصنيف البيروقراطي. ففي صحراء تشولستان، يعتمد نحو نصف مليون من رعاة الروهيين على الرعي الموسمي وتربية الماشية، إلا أنّ سبل عيشهم باتت مهدّدة نتيجة إعادة تخصيص المراعي لمشاريع زراعية واسعة النطاق. ويؤكد سكان محليون أنّ الاستيلاء على مناطق الرعي التقليدية يجري بصورة منهجية، من دون توفير بدائل قابلة للحياة.
وكما يجادل هنيّة، تندرج هذه المشاريع ضمن بيئة تراكم عابرة للحدود، تربط رأس المال الخليجي بنظيره في جنوب آسيا في مشروع مشترك لاستخراج الموارد ونقل المخاطر البيئية. ويأتي هذا التوجّه عقب إخفاقات سابقة في محاولات استصلاح صحارى الخليج نفسها، التي انتهت بتدهور بيئي وخسائر مالية كبيرة. وقد قاد ذلك إلى تحوّل استراتيجي وصفته رفيف زيادة بـ«تصدير انعدام الأمن الغذائي»، وهي عملية، كما يشرح كريستيان هندرسون، يجري من خلالها تحويل المخاطر البيئية والغذائية إلى الخارج عبر الاستحواذ العابر للحدود على الأراضي الزراعية.
هيدرولوجيا التملّك: مشروع القنوات الستّ
يُعَدّ مشروع القنوات الستّ أحد الأعمدة الأساسية لمبادرة باكستان الخضراء. وقد أُقِرّ المشروع في تموز/يوليو 2024، ويقضي بإنشاء شبكة قنوات بطول يقارب 176 كيلومتراً، يُفترض أن تروي نحو 1.2 مليون فدان من الأراضي القاحلة في صحراء تشولستان بإقليم البنجاب، بتمويل يجمع بين الاستثمارات العامة والخاصة. غير أنّ هذا المشروع، منذ الإعلان عنه، أثار موجة واسعة من الاعتراض، لا سيما في المجتمعات الواقعة في أسفل مجرى النهر، وخصوصاً في إقليم السند.
يُخطَّط لأن تستمدّ القنوات الجديدة مياهها من نهر سوتليج، إلا أنّ هذا النهر يعاني أصلاً من شحّ متزايد. فقد أصبح تدفّقه غير منتظم بفعل السدود التي أقامتها الهند في أعاليه، إضافة إلى التقلّبات المناخية. ووفقاً لمعاهدة مياه نهر السند الموقَّعة عام 1960، تخضع أنهار رافي وبياس وسوتليج بدرجة كبيرة للسيطرة الهندية. وتُظهر بيانات هيئة نظام نهر السند تراجعاً مستمراً في تدفّق هذه الأنهار، في وقت يعاني فيه إقليما البنجاب والسند من عجز مائي يقدَّر بنحو 20% و14% على التوالي. وفي ظل هذا الواقع، يُرجَّح أن يتم تحويل المياه اللازمة للقنوات الستّ من نهر السند نفسه، الخاضع لسيطرة باكستان، ما يعني تقليص حصة السند من المياه، في خرق مباشر لاتفاق تقاسم المياه بين الأقاليم لعام 1991.
سيكون لمثل هذا التحويل آثار بيئية واجتماعية بالغة الخطورة. إذ سيؤدي تقليص تدفّق نهر السند إلى دلتا النهر إلى الإضرار الشديد بغابات المانغروف، التي تعتمد على توازن دقيق بين المياه العذبة والمالحة. ارتفاع الملوحة سيقوّض هذه النظم البيئية، مهدداً سبل عيش نحو مئة ألف صياد يعتمدون على الصيد التقليدي، فضلاً عن إضعاف الحواجز الطبيعية التي توفّرها المانغروف في مواجهة الأعاصير والتسونامي. وإلى جانب ذلك، يُتوقَّع أن يؤدّي نقص المياه إلى تحويل ما يقارب أربعة ملايين فدان من الأراضي الزراعية في السند إلى أراضٍ قاحلة.
لا يمكن فهم هذا الخلل في توزيع المياه بمعزل عن جذوره الاستعمارية. ففي الحقبة البريطانية، كان البنجاب مسرحاً لمشروع ضخم لبناء «مستوطنات القنوات»، حيث أُنشئت شبكات ري واسعة في حوض نهر السند بهدف دعم الزراعة وتعزيز السيطرة الاستراتيجية. ومن خلال هذه البنية، نشأت ما يُعرف بالصلة العسكرية–الزراعية، إذ مُنح الجنود البنجابيون العائدون من الحروب الاستعمارية أراضيَ في هذه المستوطنات، في محاولة لخلق طبقة ريفية موالية تشكّل ركيزة للحكم الإمبراطوري.
بعد الاستقلال، استمرّ هذا الإرث، لترسخ هيمنة البنجاب على الوصول إلى المياه داخل الدولة الباكستانية. ويشير المؤرخ دانيش مصطفى إلى أن البنية التحتية الهيدروليكية في حوض نهر السند أصبحت أداة هيمنة، تُعامَل من خلالها المناطق الواقعة خارج البنجاب بوصفها «مستعمرات داخلية». فقد صُمّم نظام الريّ بما يخدم الرأسمالية الزراعية الاستخراجية، التي يستفيد منها كبار ملاك الأراضي والنخب العسكرية–البيروقراطية، عبر تحويل المياه إلى أعلى المجرى على حساب المستخدمين في أسفله. ومن هذا المنظور، لا تتعلّق اعتراضات السند بندرة المياه بحد ذاتها، بل بتاريخ طويل من الاستيلاء عليها.
يعيد مشروع القنوات الستّ، المُنفَّذ تحت مظلّة مبادرة باكستان الخضراء، إنتاج منطق مستوطنات القنوات الاستعمارية، لكن بلغة «التنمية الخضراء». يجري اليوم توجيه نحو مناطق مخصّصة لمشاريع زراعية ضخمة مدعومة برأس مال محلي وأجنبي، بينما تُلقى الكلفة البيئية والاجتماعية على عاتق مجتمعات السند
يعيد مشروع القنوات الستّ، المُنفَّذ تحت مظلّة مبادرة باكستان الخضراء، إنتاج منطق مستوطنات القنوات الاستعمارية، لكن بلغة «التنمية الخضراء». فكما استُخدمت القنوات في الماضي لتوسيع زراعة المحاصيل النقدية وتعظيم العائدات للإدارة الاستعمارية، يجري اليوم توجيه المياه نحو مناطق مخصّصة لمشاريع زراعية ضخمة مدعومة برأس مال محلي وأجنبي، بينما تُلقى الكلفة البيئية والاجتماعية على عاتق مجتمعات السند.
أُطلِق المشروع من دون إجراء تقييمات بيئية، ومن دون نقاش برلماني، أو تشاور مع الأطراف المتأثرة. كما لم تُستحصل موافقة إقليم السند عبر مجلس المصالح المشتركة، وهو الهيئة الدستورية المكلّفة بحل النزاعات بين الأقاليم. ويعكس ذلك استمرار السيطرة غير المتكافئة للبنجاب، بوصفه الإقليم الأعلى مجرى، على موارد المياه والأراضي، على حساب السند الأدنى. وكما تشير عائشة صديقي، فقد أسهمت ممارسات الدولة المكانية وإدارة المياه في إضفاء طابع مؤسسي على تهميش السند داخل الاقتصاد السياسي الباكستاني، بما ولّد إحساساً دائماً بالاستغلال والإقصاء.
وتتضاعف حدة الاعتراضات في السند لأنّها تنبع من واقع معيش لمجتمعات الدلتا. فالكثير من سكان جنوب الإقليم يعتمدون على النظم البيئية النهرية والدلتاوية في كسب رزقهم، خصوصاً من خلال الصيد التقليدي في الأنهار ومصباتها. إن تحويل مياه نهر السند يهدد هذه الأنشطة، ويدفع المجتمعات المحلية إلى الهجرة أو الارتماء في سوق العمل الهشّ في المدن الكبرى، ما يعمّق اغترابها السياسي. ولهذا، يرى كثير من السِنديّين في المشروع شكلاً جديداً من مصادرة أراضيهم ومواردهم.
الأكثر إثارة للدهشة في مشروع القنوات الستّ هو منطقُه الأساسي: محاولة تحويل صحراء تشولستان الهشّة بيئياً إلى أراضٍ زراعية، حتى لو كان الثمن تجفيف مساحات واسعة من الأراضي الخصبة في مناطق أخرى. ويبدو هذا الخيار أكثر تناقضاً حين نضعه مقابل بدائل أكثر عقلانية، مثل وقف الزحف العمراني على الأراضي الزراعية القائمة بدل التوسّع في بيئات صحراوية هشّة.
وتتجلّى هذه المفارقة بوضوح في مشروع التنمية الحضرية على ضفاف نهر رافي، الذي أطلقته حكومة البنجاب عام 2020. فقد قُدِّم المشروع رسمياً بوصفه خطة لإحياء النهر وترميم البيئة الحضرية، لكنه في الواقع ينطوي على الاستحواذ على أكثر من عشرة آلاف فدان من أخصب الأراضي الزراعية المحيطة بلاهور، لتحويلها إلى مشاريع عقارية واسعة النطاق. وهكذا، بينما تتحدّث الدولة عن «تخضير» الصحارى عبر القنوات، تقوم في الوقت نفسه بتفكيك أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في البنجاب لصالح الرأسمالية العقارية، في تناقض صارخ يكشف منطق التنمية القائم على نزع الملكية لا على الاستدامة.
المجلس الخاصّ بتسهيل الاستثمار
يقع المجلس الخاصّ بتسهيل الاستثمار في صميم مبادرة باكستان الخضراء، بوصفه الأداة المؤسسية الأهم لتسريع تنفيذ مشاريعها. وكما سبقت الإشارة، يعمل المجلس كقناة مركزية لمنح الموافقات السريعة، وتنسيق العمل بين السلطات الفيدرالية وحكومات الأقاليم، وإزالة العوائق البيروقراطية والتنظيمية أمام المستثمرين، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالزراعة. وتضمّ بنيته القيادية كبار ضباط الجيش، مع تموضع رئيس الوزراء وقائد أركان الجيش في موقع صانعي القرار الأساسيين. ووفقاً لتعريفه الرسمي، يهدف المجلس إلى جذب الاستثمارات من «الدول الصديقة» في مجالات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، مع اضطلاع الجيش بدور «تيسيري».
يمثّل هذا المجلس امتداداً متطوّراً للبريتوريانية التي طبعت الدولة الباكستانية منذ تأسيسها، حيث ظلّ الجيش صاحب اليد الطولى في القرارات الوطنية الكبرى. ولا يقتصر النقد الموجّه إلى المجلس على قوى المجتمع المدني، بل تشاركه فيه أيضاً أحزاب سياسية رئيسة، ترى فيه أداةً لتقويض الاستقلالية التشريعية والمالية التي كفلها التعديل الثامن عشر للدستور، الذي أُقرّ عام 2010 بوصفه أحد أهم الإصلاحات الديمقراطية في تاريخ البلاد. فقد عزّز هذا التعديل صلاحيات الأقاليم، وقلّص المركزية الاتحادية، ومنح البرلمان دوراً أوسع في صنع القرار، بما شكّل توازناً ديمقراطياً في مواجهة عقود من الحكم العسكري.
لم يُخفِ الجيش امتعاضه من هذا التحوّل، إذ قلّص التعديل الثامن عشر قدرة المركز على التحكم بالإدارة وتوزيع الموارد، ومنح الأقاليم استقلالية مالية أوسع، ما ضيّق هامش المناورة أمام الحكومة الاتحادية والمؤسسة العسكرية. ومن هذا المنطلق، يرى منتقدو المجلس أنّه محاولة لإعادة مركزة السلطة من «الباب الخلفي»، بما يقوّض روح التعديل الدستوري. فالمجلس يفتقر إلى سند دستوري واضح، ولا تخضع قراراته للنقاش البرلماني أو لرقابة الأقاليم، على الرغم من أنّه يتدخّل مباشرة في مجالات تقع، دستورياً، ضمن اختصاصها، مثل الزراعة والطاقة والتصنيع والسياحة.
وعلى خلاف الانقلابات العسكرية الصريحة في الماضي، تأتي هذه الهيمنة اليوم مغطّاة بخطاب الاستثمار والإصلاح والكفاءة. غير أنّ الهدف الجوهري لا يبدو مختلفاً: توسيع نفوذ الجيش المؤسسي وإعادة هندسة الاقتصاد السياسي بما يخدم النخب الراسخة. ففي ستينيات القرن الماضي، قاد «التحديث» في عهد الجنرال أيوب خان إلى إثراء الأرستقراطية المالكة للأراضي، بينما أسهمت الخصخصة في عهد الجنرال برويز مشرّف في صعود أباطرة العقارات. وفي كلتا الحالتين، جرى تسويق التحوّلات الكبرى بلغة التنمية والمصلحة الوطنية. ويعيد المجلس اليوم إنتاج هذا النمط نفسه: ففي مواجهة أزمة اقتصادية عميقة، تُبرَّر تغييرات جذرية في الحوكمة باسم «الكفاءة» على حساب الشرعية، و«التنمية» على حساب العدالة الاجتماعية.
لا يُعدّ هذا المسار جديداً، بل يستند إلى إرث الدولة الاستعمارية التي ورثت أجهزتها دولة ما بعد الاستقلال. فقد وصف المؤرخ حمزة علوي هذه البنية بـ«الدولة المفرطة في التطوّر»، إذ احتفظت الدولة الباكستانية بمؤسسات عسكرية وبيروقراطية قوية صُمّمت أساساً لتسهيل الاستخراج والسيطرة الإمبراطورية. وخلال الحقبة الاستعمارية، لم يكن القانون أداة لتحقيق العدالة، بل وسيلة لمصادرة الموارد وضمان الولاء السياسي.
تأتي هذه الهيمنة اليوم مغطّاة بخطاب الاستثمار والإصلاح والكفاءة. غير أنّ الهدف الجوهري لا يبدو مختلفاً: توسيع نفوذ الجيش المؤسسي وإعادة هندسة الاقتصاد السياسي بما يخدم النخب الراسخة
تجسّد ذلك في تشريعات مثل قانون البنجاب للتصرّف في الأراضي لعام 1900، الذي سَهّل فرض الضرائب وأبقى الأرض في أيدي طبقات زراعية موالية للتاج البريطاني، وكذلك في قوانين «القبائل الإجرامية» وتشريعات الغابات التي جرّمت أنماط الحياة الرعوية، وأعادت تعريف الأراضي المشتركة كملكية للدولة. وقد استمر العمل بهذه الأدوات القانونية إلى حدّ بعيد بعد الاستقلال، ما مكّن النخب من مواصلة السيطرة على الأرض والموارد.
ويمثّل قانون الاستحواذ على الأراضي لعام 1894 مثالاً صارخاً على هذا الاستمرار. فقد سُنّ في الأصل لتجميع الأراضي اللازمة للسكك الحديدية والبنية التحتية الإمبراطورية، لكنه لا يزال مستخدماً حتى اليوم، مع تعديلات طفيفة، استناداً إلى بند فضفاض يجيز الاستحواذ من أجل «الصالح العام». ويُستَخدم هذا البند لتبرير مصادرة الأراضي لصالح مشاريع تنموية وعقارية، كثير منها مرتبط مباشرة بالمؤسسة العسكرية.
بهذا المعنى، لا يمكن فهم المجلس الخاصّ بتسهيل الاستثمار بوصفه مجرّد هيئة تقنية لتسريع الاستثمار، بل كحلقة جديدة في تاريخ طويل من إعادة إنتاج المركزية، وتغليب منطق السيطرة والاستخراج، مع تغيير اللغة لا البنية.
مبادرة الطاقة المتجدّدة التي أطلقها «مختس»
على الرغم من أنّ الدور الأساسي للمجلس الخاصّ بتسهيل الاستثمار («مختس») يتمحور حول توجيه والموافقة على الاستثمارات الزراعية واسعة النطاق في إطار مبادرة باكستان الخضراء، فإن نطاق عمله يشهد توسّعاً متسارعاً ليشمل قطاعات استراتيجية أخرى، في مقدّمها الطاقة المتجدّدة. ويضع المجلس جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذا القطاع في صلب أولوياته، مستنداً إلى تقديرات رسمية تشير إلى أن القدرة النظرية للطاقة المتجددة في باكستان تبلغ نحو 3,300 غيغاوات.
يُقدَّم هذا التوجّه ضمن خطاب الاستدامة والانتقال الأخضر، حيث يعلن «مختس» سعيه لإضافة 60 غيغاوات من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الوطنية بحلول عام 2034. ووفقاً لهذا التصوّر، من شأن التوسّع في مصادر الطاقة النظيفة أن يخفّف اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد—ولا سيما الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم، القادم معظمها من دول الخليج—وبالتالي يخفّف الضغط على احتياطات النقد الأجنبي. كما يُفترض أن يسهم ذلك في تقليص انقطاعات الكهرباء («تخفيف الأحمال») ودعم التزامات باكستان المناخية في إطار مساهماتها المحددة وطنياً.
غير أنّ هذه الطموحات المعلَنة تتناقض بوضوح مع السياسات الحكومية الأخيرة في قطاع الطاقة، ولا سيما تلك التي تستهدف كبح التوسّع السريع للطاقة الشمسية اللامركزية على أسطح المنازل. فقد أشارت تقارير لوكالة «رويترز» وصحيفة «فاينانشال تايمز» إلى أنّ ازدهار الطاقة الشمسية المنزلية في باكستان يمثّل حالة نادرة من الابتكار «من القاعدة إلى القمّة» داخل نظام طاقة يعاني اختلالات بنيوية مزمنة. فبحلول أوائل عام 2025، سجّل أكثر من 125 ألف مستهلك توصيلات شمسية بنظام القياس الصافي، بقدرة إجمالية تتجاوز 1,200 ميغاوات، أي ما يعادل نحو 2.5% من إجمالي القدرة المركّبة في البلاد. وعلى الرغم من أن هذه النسبة لا تزال محدودة مقارنة بحجم الشبكة الوطنية، فإن الطاقة الشمسية على الأسطح تُعدّ القطاع الأسرع نمواً ضمن سوق الطاقة المتجددة.
أثار هذا التوسّع السريع مخاوف داخل قطاع الطاقة، إذ تشير التقديرات إلى أنّ نظام القياس الصافي فرض عبئاً سنوياً يتراوح بين 570 و720 مليون دولار على المستهلكين غير القادرين على تركيب الألواح الشمسية. فالمستخدمون الشمسيون يحصلون على رصيد مقابل الكهرباء التي يضخّونها في الشبكة بالسعر نفسه الذي يدفعونه مقابل الاستهلاك، من دون تحمّلهم كلفة البنية التحتية الثابتة. وقد أدّى ذلك إلى رفع التعريفات على بقية المستهلكين، ما أدخل القطاع في ما يصفه المحللون بـ«دوّامة الموت»: ارتفاع الأسعار يدفع مزيداً من الأسر إلى الخروج من الشبكة عبر الطاقة الشمسية، وهو ما يضيّق قاعدة المشتركين ويفاقم الأزمة.
في آذار/مارس 2025، ردّت الحكومة على هذه الإشكالية بخفض تعرفة القياس الصافي من 27 روبية للوحدة إلى 10 روبيات، ما قلّص بشكل حاد العائدات المتوقعة لمستخدمي الطاقة الشمسية المنزلية. ونتيجة لذلك، ارتفعت فترة الاسترداد المتوسطة—أي الزمن اللازم لتعويض كلفة تركيب النظام من خلال خفض فواتير الكهرباء—من نحو عامين إلى ما بين عامين وخمسة أعوام.
تكشف هذه السياسات عن توجّهين متناقضين داخل الدولة: فمن جهة، يجري الترويج لاستثمارات ضخمة كثيفة رأس المال في مجال الطاقة المتجددة عبر «مختس» وتحت مظلّة مبادرة باكستان الخضراء؛ ومن جهة أخرى، تُقوَّض المبادرات الشعبية اللامركزية التي تقودها الأسر والمجتمعات المحلية. ويشير هذا التناقض إلى تفضيل بنيوي لمشاريع الطاقة الكبرى القادرة على توليد أرباح للمستثمرين، على حساب نماذج تُعطي الأولوية للعدالة في الوصول إلى الطاقة أو لتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
ومن دون مواءمة التخطيط الكلّي مع ديناميات الابتكار من القاعدة إلى القمّة، تخاطر استراتيجية الطاقة المتجددة في باكستان بأن تتحوّل إلى شكل جديد من الاستخراج، لا يقتصر على الاستيلاء على الموارد الطبيعية، بل يشمل أيضاً—بحسب تعبير شاليني رانديريا—«إعادة تركيب ماكرة» لعلاقات السلطة بين الدولة والسوق. ففي هذا الإطار، تُستدعى لغة الاستدامة لتوسيع السيطرة البيروقراطية وتكريس منطق السوق، بما يهمّش المطالب المحلية بالمشاعات ويعيد إنتاج التراتبيات القائمة. وهكذا، تعزّز «الدولة الماكرة» نفوذها باسم التحوّل الأخضر، لا من أجل دمقرطة الحوكمة أو إعادة توزيع السلطة، بل لترسيخها في أشكال جديدة.
المقاومة ضدّ مبادرة باكستان الخضراء
في إقليم السِند، تقود طيفاً واسعاً من الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية معارضةُ مشروع القنوات الستّ والزراعة المؤسسية، من بينها «عوامي تحريك» و«جاي سِند ماهاز»، إلى جانب حركة «بولان باشاو» التي يقودها ذو الفقار جونيور، والمعروفة بدفاعها عن دلافين نهر السند. وتشكّل هذه القوى، مع حركات أخرى من أقاليم مختلفة، شبكة مقاومة عابرة للمقاطعات، تستند إلى خبرات مشتركة في نزع الملكية. وهو ما يؤكده ذو الفقار جونيور حين يصف مشروع القنوات الستّ بأنه يخدم رأس المال الخاص لا الفلاحين المعدمين في تشولستان والسِند.
وقد لاقت هذه المقاومة صدىً واسعاً في السِند على وجه الخصوص، حيث انخرط كتّاب وشعراء ومثقفون بارزون في إدانة المشروع، وشكّك خبراء في جدواه وقانونيته. وتحولت القضية إلى نقطة التقاء لقوى اجتماعية متباينة ترى في المشروع خيانة جديدة من حزب الشعب الباكستاني الحاكم. وعلى الرغم من إعلان الحزب معارضته الرسمية، يشير منتقدوه إلى عجزه عن الدفاع عن مصالح الإقليم في ظل تدخل الجيش، ويتهمونه بالتواطؤ مع نمط أوسع من «العسكرة التنموية» التي تعزّز سيطرة الدولة على الأرض والموارد. وقد عمّق ذلك فجوة الثقة بين الحزب وقاعدته الريفية التقليدية، حيث يُنظر إلى تحويل الأراضي إلى قنوات وتوسيع الزراعة التجارية بوصفه شكلاً من أشكال الاستعمار الداخلي.
في هذا السياق، أصبحت المؤتمرات العامة والمسيرات والاحتجاجات مشهداً متكرراً في السِند، مع صدور قرارات تطالب بتوزيع الأراضي على الفلاحين وإلغاء «مختس». وأدانت الأحزاب القومية، مثل «قومي عوامي تحريك» و«جي آي سِند ماهاز»، مبادرة باكستان الخضراء بوصفها تهديداً وجودياً للزراعة وسبل العيش، محذّرة من تداعيات سياسية واجتماعية أوسع. وبالنسبة لكثير من السِنديّين، يتجاوز هذا النضال مجرد الاعتراض على مشروع بعينه، ليصبح دفاعاً عن نهر السند باعتباره شريان الحياة، ورفضاً لتدخل الشركات والسلطة الاتحادية في شؤون الإقليم.
أما في البنجاب، فتقود «أنجومان-إي-مزارعين البنجاب» و«لجنة باكستان كيسان رابطة» مقاومة الزراعة التجارية ومبادرة باكستان الخضراء. وتستند هذه الحركات إلى تاريخ طويل من التعبئة الشعبية ضد المظالم المتراكمة. وتُعدّ «أمب» في طليعة حركة مزارع أوكارا العسكرية، وهي نضال سلمي يطالب بحقوق الفلاحين في ملكية الأراضي التي خصصتها الإدارة الاستعمارية البريطانية للعائلات المحلية منذ أكثر من 120 عاماً، لكنها باتت اليوم تحت سيطرة الجيش.
أُنشئت هذه المزارع ضمن مخطط الاستعمار بالقنوات لخدمة سلاسل الإمداد العسكرية، حيث استوطن الفلاحون الأرض مقابل إيجار ثابت. ويوضح مهر غلام عباس، رئيس «أمب»، أنّه كان يفترض أن تُمنح هذه الأراضي للفلاحين تلقائياً بعد قيام باكستان، لكن الدولة أبقتها تحت إدارات مختلفة وفرضت نظام المشاركة في المحصول. تفجّر النزاع مطلع الألفية حين حاول الجيش تحويل المستأجرين إلى عمّال متعاقدين، ما يعني تثبيت ملكيته القانونية للأرض. رفض الفلاحون هذا التحول، واعتبروا أنفسهم المالكين الشرعيين، وأطلقوا حركة جماهيرية سلمية واجهتها الدولة بالاعتقالات وتهم «الإرهاب» والعمالة للخارج.
منذ عام 2000، نجحت «أمب» في حشد مئات الآلاف من الفلاحين حول شعار واحد: «ملكية أرضنا أو الموت». ويعبّر هذا الشعار عن ارتباط وجودي بالأرض، كما يوضح غلام عباس حين يشير إلى أنّ أجيالاً متعاقبة من عائلته دُفنت في هذه الأرض ولن تتنازل عنها لأي شركة.
من جهة، يجري الترويج لاستثمارات ضخمة كثيفة رأس المال في مجال الطاقة المتجددة عبر «مختس» وتحت مظلّة مبادرة باكستان الخضراء؛ ومن جهة أخرى، تُقوَّض المبادرات الشعبية اللامركزية التي تقودها الأسر والمجتمعات المحلية
وفي لاهور، عُقد مؤتمر صحفي جمع أحزاباً وحركات سياسية وجمعيات زراعية تقدّمية، تعهّدت جميعها بمقاومة الزراعة التجارية ومبادرة باكستان الخضراء، وذلك عقب محاولة الشرطة طرد مستأجرين من مزرعة في هاسيلبور بباهاوالبور. ومنذ ذلك الحين، توسّعت المعارضة من نزاعات محلية حول الإيجار إلى حركة زراعية وطنية تحظى بدعم سياسي ومدني واسع.
إلى جانب «أمب»، تؤدي «لجنة باكستان كيسان رابطة» دوراً محورياً، وهي شبكة تضم أكثر من 20 منظمة فلاحية من 3 أقاليم. تأسست اللجنة لتنسيق النضال حول قضية مزارع أوكارا، لكنها اكتسبت زخماً جديداً مع مبادرة باكستان الخضراء. ويؤكد أمينها العام فاروق طارق أنّ المبادرة وحّدت قوى متفرقة، ومكّنت الحركة من التعبئة في عشرات المدن والبلدات. ويرى طارق أنّ معارضة القنوات الستّ شكّلت لحظة تاريخية، إذ وقفت حركات فلاحية في البنجاب إلى جانب نظرائها في السِند، في جبهة موحّدة ضد هيمنة الشركات.
يمثّل هذا التقارب العابر للأقاليم تحوّلاً لافتاً في المشهد السياسي. ففي نزاعات سابقة حول المياه، مثل مشروع سدّ كالاباغ في عهد مشرف، تعمّقت الانقسامات الإقليمية، وجرى استقطاب المجتمع المدني نفسه. أمّا اليوم، فقد أسهمت مقاومة مبادرة باكستان الخضراء في بناء تضامن جديد بين حركات المزارعين، كما يصفه طارق، قائم على توحيد النضال بدل تأجيج الانقسامات.
وقد جمعت مقاومة الزراعة التجارية والقنوات الستّ قوى تقدّمية متنوّعة، من أحزاب يسارية مثل «حزب حقوق الشعب» و«باكستان مازدور كيسان»، إلى فاعلين حضريين كالصّحفيين والمنظمات الطلابية. ويتميّز هذا التحالف بإعادة تعريف مفهوم التنمية، بحيث يُعاد توجيهه نحو حقوق الفلاحين والعدالة الاجتماعية، بدل الرؤى الوضعية التي تفرضها الدولة. ورغم ما ينطوي عليه هذا التحالف من إمكانات لإعادة تشكيل ميزان القوى بين الدولة والمجتمعات الريفية، فإنه يواجه مخاطر جسيمة، أبرزها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم التعبئة السلمية، والدعم الأمني الذي تحظى به مشاريع الزراعة التجارية، بما يزيد احتمالات الترهيب والإخلاء.
تطرح هذه التطورات أسئلة جوهرية عن انتقال باكستان من مجمّع صناعي–عسكري إلى مجمّع زراعي–صناعي–عسكري آخذ في التبلور. كما تفرض إعادة التفكير في كيفية توظيف خطاب الاستدامة لتبرير نزع الملكية وإلحاق أضرار بيئية إضافية، وفي الدور المتنامي للفاعلين العابرين للحدود. وأخيراً، تسلّط الضوء على مفارقة عميقة: فباكستان، رغم محدودية مساهمتها في تغيّر المناخ عالمياً، تشرف على نموذج «تنموي» غالباً ما يفاقم الآثار المناخية محلياً وإقليمياً بدل التخفيف منها.
نُشِر هذا المقال في الأصل في 30 تشرين الأول/أكتوبر في موقع «المعهد العابر للقوميات»، الذي يعيد نشره باللغة العربية في موقع «صفر».