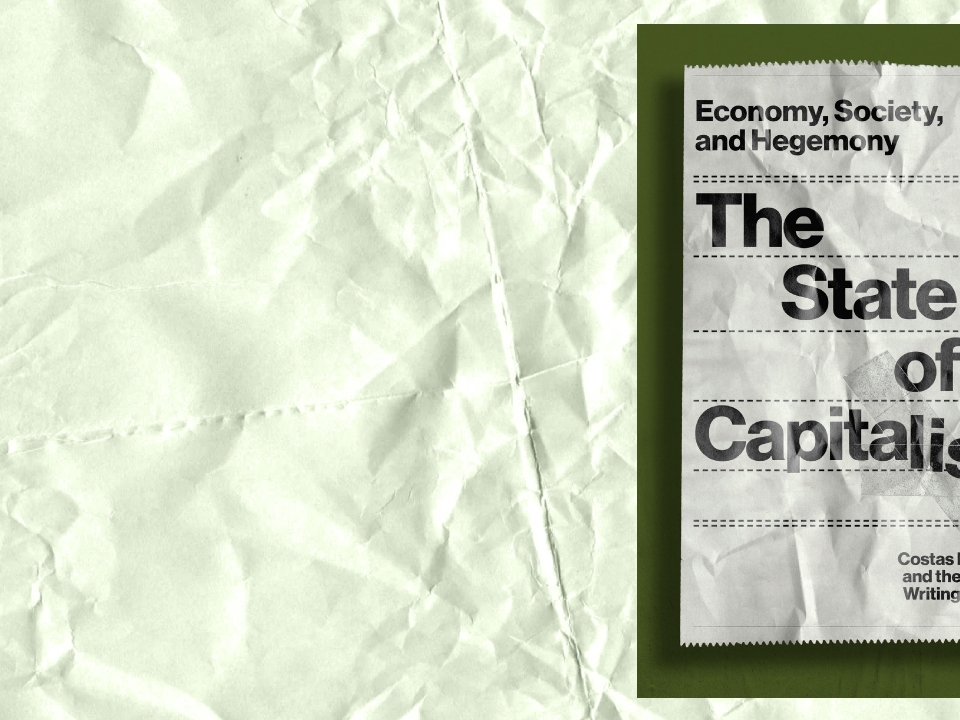حيازة العلم
- مراجعة لكتاب غابرييل غالفيز- بيهار: «حيازة العلم: الملكية العلمية في زمن الرأسمالية الصناعية» الذي يكشف كيف استخدم علماء بارزون مثل باستور وليبيغ براءات الاختراع لزيادة نفوذهم، وكيف أصبحت الملكية العلمية أداة احتكارية مع توسّع الرأسمالية والحروب. واليوم، على الرغم من الانتقال إلى الرأسمالية الرقمية، يبقى الاحتكار الفكري محور قوة شركات التكنولوجيا والأدوية، مدفوعاً بالبيانات والخوارزميات.
قُدرت قيمة سوق ترخيص الملكية الفكرية بنحو 340 مليار دولار أميركي في العام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 580 مليار دولار بحلول العام 2033، مما يعكس معدل نمو سنوي مركّب بنسبة 6.1% من العام 2025 إلى العام 2033. هذه السوق الكبيرة غير المرئية، كبقية أسواق السلع والخدمات، لم تولد فجأةً، وليست من آثار التطوّرات التكنولوجية الطارئة، بل تزامن ظهورها مع بداية تشكّل نمط إنتاج رأسمالي صناعي منظّم، وهو ما يبحث في جذوره غابرييل غالفيز- بيهار، المؤرخ المتخصّص في التاريخ الاقتصادي وتاريخ العلوم والتكنولوجيا، في كتابه «حيازة العلم: الملكية العلمية في زمن الرأسمالية الصناعية»، الصادر عن منشورات مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية في باريس. وذلك من خلال العودة إلى الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، والروابط التي ولدت بين المجتمع العلمي من جهة والطبقة البرجوازية الصاعدة، في سياقٍ تطوّر العلوم ومأسستها، وكيف أدّى ذلك إلى تشكّل مصالح مشتركة بين الطرفين، ظهرت من خلالها الملكية العلمية كأحد الأشكال الريعية في الاقتصاد الرأسمالي.
على الرغم من تراجع قوة الرأسمالية الصناعية في مقابل صعود الرأسمالية التكنولوجية والرقمية، إلا أن مركزية الملكية الفكرية لم تتأثر، بسبب الروابط القوية بين المجتمع العلمي والرأسمالية التكنولوجية
يشير غالفيز إلى أن دراسة العلاقة بين الجهات العلمية الفاعلة والملكية الفكرية، ليس مجرد فضول تاريخي بل أمراً أساسياً لسببين. أولاً، يُعدّ الاستخدام المكثف للملكية الفكرية من الجامعات ومؤسسات البحث حالياً أحد أبرز مظاهر «تسليع المعرفة». وسواء من منظور نقدي أم لا، غالباً ما تغفل الدراسات التي ترى في الملكية الفكرية إحدى القوى الدافعة وراء خصخصة المعرفة حقيقة أن هذه الأداة لا تحمل معنى حقيقياً إلا من خلال استخدامها. وتاريخياً، اتسمت الملكية الفكرية، بمشكلة تعريفية تقليدية نوعاً ما وتناقضٍ عميق. واليوم، يشير المصطلح العام «الملكية الفكرية» إلى جميع أشكال الحماية القانونية للإبداعات الفكرية. إلا أن هذا المعنى حديثٌ جداً، حيث اتخذت أشكال الملكية الفكرية المختلفة - حقوق المؤلفين، وحقوق المخترعين، وقانون العلامات التجارية، وغيرها - مساراتها الخاصة. وفي الكتاب، يُؤخذ هذا التعبير بمعناه الحالي مع الإشارة إلى تنوّع الملكية الفكرية وعدم استقرارها. ومع ذلك، فإن العلاقة بين الملكية الفكرية والرأسمالية ليست أحادية الاتجاه. فبينما رأى ماكس فيبر أن قوانين براءات الاختراع كانت ابتكاراً إيجابياً لدفع الرأسمالية، اعتبر مارسيل موس أن «الملكية الفنية والأدبية والعلمية» كانت رد فعل ضد «أخلاق التاجر»، وواحدة من أشكال بقاء «جو العطاء والالتزام والحرية».
خرافة النزاهة
ينطلق الكتاب من فرضية أساسية هي أن العلم لم يكن يوماً «نقياً»، فهو يقع في صلب قضايا سياسية واجتماعية متعدّدة، وتخترقه الأبعاد الاقتصادية، إذ لا يمكن الحديث عن العلم من دون وجود اقتصاد للعلم، لا يقتصر على الاقتصاد الرمزي فحسب، بل يتطلب أيضاً موارد مادية ويفترض أرباحاً في المقابل. لذلك يجب على أي اقتصاد سياسي حقيقي للعلم أن يربط دائماً بين هذين البعدين: الرمزي والمادي. وهنا تظهر الملكية الفكرية أو العلمية تحديداً، كرابطٍ بين البُعدين. لذلك يتحدّى الكتاب بوضوح وعلى مدى فصوله، تلك النظرة المثالية التي رسّخها العلماء أنفسهم عن طبيعة عملهم الذي يوصف بـ«النزاهة» والحياد عن المصالح المادية، مشيراً إلى أن النزاهة تترافق مع شكل من أشكال المنافسة الشرسة، ما يدل على وجود شكل من المصلحة. حيث التأكيد على البعد الاقتصادي للعلم يعني توسّعه ولكنه يعني أيضاً تبعيته للفاعلين الاقتصاديين.
يبدأ الكتاب بتأريخ ظهور الملكية العلمية، والتي كانت في البداية تتشابك مع مطالبات الأولوية العلمية. ففي أوائل القرن التاسع عشر، أدّت الزيادة في المطبوعات الدورية وظهور تقارير أكاديمية العلوم في فرنسا في العام 1835 إلى تغيير قواعد المطالبة بالأولوية. حيث أثارت مسألة الملكية الفكرية اهتمام العلماء الأوائل، مثل فرانسوا أراغو، الأمين الدائم للأكاديمية الفرنسية للعلوم، الذي دافع عن مبدأ أن الجمهور «لا يدين بشيء لمن لم يقدم له خدمة». ورأى أن الملكية المميزة والمطلقة يجب أن تُمنح للمخترعين لفترة محدودة. وقد ساهم أراغو في صياغة قانون البراءات الفرنسي لعام 1844، الذي يسمح بـ«براءة المبدأ»، حيث أشار إلى أنه لا يمكن منح براءة لاكتشاف فكرة ليس لها تطبيق صناعي. ومع ذلك، اقترح تعديلاً يسمح ببراءة مبدأ علمي شريطة أن يشير مؤلفه إلى تطبيق صناعي واحد على الأقل. وقد ساهم هذا في تليين التمييز بين الاكتشاف العلمي البحت والاختراع الصناعي.
لا يمكن الحديث عن العلم من دون وجود اقتصاد للعلم، لا يقتصر على الاقتصاد الرمزي فحسب، بل يتطلب أيضاً موارد مادية ويفترض أرباحاً في المقابل
ويقدّم الكاتب من خلال الوثائق التاريخية نماذج لعلماء استخدموا براءات الاختراع لزيادة ثرواتهم، مثل الكيميائي الألماني يوستوس فون ليبيغ، الذي كان يرفع شعار «العلم يحسن الثروة»، وأعلن في العام 1843، عن اكتشافه للسماد الفوسفاتي وباع حقوق اختراعه لشركة بريطانية. كما ينسف الكتاب أسطورة الكيميائي الفرنسي وأحد أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب، لوي باستور، الذي كان عكس ما يشاع عن زهده في الكسب من براءات الاختراع، يستخدمها كأداة لتحقيق مداخيل كبيرةٍ. مثل براءة التخمير الكحولي لعام 1857 وكذلك تحويل براءات اختراع الجعة الخاصة به إلى شركة مساهمة، ما وفّر له دخلاً كبيراً وحصة من الأرباح. كما تم استخدام اسم «باستور» كعلامة تجارية - مثل «لقاحات باستور» أو «مرشح شامبرلاند- نظام باستور» - حيث كافح ورثته للحفاظ على رأسماله الرمزي وقيمته التجارية. وفي بريطانيا استخدم اللورد كلفن الملكية الصناعية بشكل مكثف في مجال التلغراف الكهربائي. فقد قام بتسجيل 70 براءة اختراع، والتي كانت مصدر دخل كبير له ولورثته من بعده.
الرأسمالية واحتكار العلم
مع تطوّر الرأسمالية الصناعية في خلال النصف الثاني للقرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، تطوّرت الروابط بين العلم والرأسمالية، كما تطوّرت روابطه مع السياسة الاستعمارية. وأخذت القوى الرأسمالية العالمية مسارات مستقلّة في تشكيل قوانين وتشريعات للملكية الفكرية، وعلى الرغم من أن الاختلافات بين هذه المسارات كانت صغيرةً إلا أنها أنتجت أثاراً كبيرةً. في الولايات المتحدة - التي تعتبر النموذج المؤسّسي المبكر - كان نظام البراءات مركزياً. وقد شجّع عدم وجود التزام بالاستغلال للشركات الكبيرة على استخدام البراءات كأداة احتكارية. كان النظام الأميركي يتميّز بكثافة الروابط بين العلماء والصناعيين. وقد ظهرت مؤسسات مبكرة مثل Research Corporation التي أسسها فريدريك غاردنر كوتريل في العام 1912، لإدارة براءات الاختراع الجامعية وتوفير التمويل للبحث، ما يعكس ترسّخ هذا النموذج في طريقة تنظيم البحث في البلاد. أما في ألمانيا، فقد أدّت صرامة الفحص المسبق للبراءات، التي فرضتها الحكومة، إلى جعلها في متناول الشركات الكبرى على حساب المخترعين الأفراد. وفي بريطانيا عزّز قانون 1907 من البراءات لمواجهة المنافسة الألمانية. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، تم إنشاء مؤسسات مثل «الصندوق الإمبراطوري لتشجيع البحث العلمي والصناعي» لتسهيل إدارة البراءات الناتجة عن البحوث المموّلة حكومياً. لكن في فرنسا أدّى غياب الفحص المسبق وعدم إمكانية تسجيل براءات الأدوية إلى إضعاف الدور الاحتكاري للملكية الصناعية. وعلى الرغم من أن الملكية الصناعية ظلت مهمة في نظر المخترعين الأفراد أكثر من الشركات الكبرى، إلا أن الانتقال من نظام فردي إلى نظام مؤسسي كان عملية مركزية، ما يفسر سبب تركيز مؤسسة واحدة مثل المركز الوطني للبحث العلمي لاحقًا على إدارة الملكية الفكرية.
ثم جاءت الحرب العالمية الأولى كلحظة حاسمة لتأكيد الملكية الفكرية والعلمية، حيث كانتا تُنظر إليهما كعامل أساسي لتنظيم العلم والاقتصاد في سبيل بناء «المجتمع الحربي». كانت الحرب سبباً في زعزعة أركان الرأسمالية الصناعية العالمية، حيث توقفت عملية تراكم رأس المال بسبب الدمار المادي والبشري، ما أدّى إلى اضطرابات مالية وتضخم عالمي، بينما قدمت الثورة الروسية نظاماً اقتصادياً بديلاً. شارك الابتكار التكنولوجي في البحث عن شكل جديد من «الرأسمالية الجديدة»، وكان النشاط العلمي عنصراً مساهماً في هذا التحوّل. وفي هذا السياق، برزت الملكية العلمية كعنصر لتنظيم العلاقات بين الحقول العلمية والاقتصادية والسياسية. ومن خلال تحليل وثائق التنافس بين القوى الإمبريالية يكشف الكتاب عن بروز استراتيجيات مختلفة لحيازة ما عُرف حينذاك بـ «علم الحرب». في الولايات المتحدة وبريطانيا كانت السياسات المعتمدة أكثر عدوانية تجاه ألمانيا، مع مشاركة قوية من العلماء في تنفيذها. في الولايات المتحدة، أدت مصادرة البراءات الألمانية إلى إنشاء مؤسسة في العام 1919 سيطرت على آلاف البراءات والعلامات التجارية لتمكين الصناعة الكيميائية الأميركية.
برزت الملكية العلمية كعنصر لتنظيم العلاقات بين الحقول العلمية والاقتصادية والسياسية. ومن خلال تحليل وثائق التنافس بين القوى الإمبريالية يكشف الكتاب عن بروز استراتيجيات مختلفة لحيازة ما عُرف حينذاك بـ «علم الحرب»
وقد أثمرت مختلف أشكال التعبئة العلمية خلال المجهود الحربي إلى تعزيز مركزية الملكية الفكرية، وكذلك تأكيد البعد الإستراتيجي كأداة احتكارية على حساب ألمانيا. وقد أدّى ذلك إلى أن تصبح الملكية الفكرية في فترة ما بين الحربين، جزءاً لا يتجزأ من هيكلة المؤسسات العلمية، وإن كان ذلك بنماذج وطنية متباينة. وهو ما أضفى الشرعية على البعد الاقتصادي للعلم، إذ لم يعد بالإمكان النظر إلى العلم بمعزل عن بُعده الاقتصادي. وأصبح تمويله وتوظيف القوى العاملة فيه وتقاسم الأرباح الناتجة عنه أسئلة مشروعة وضرورية. وكذلك إلى تحوّلٍ مفاهيمي جذري، فقد شهد المفهوم تحولاً من حق فردي إلى حق يخص مؤسسة جماعية، تتطلب تمويلاً محددًا نظراً لوظيفتها الاقتصادية والسياسية.
لا يقلل الطرح التاريخي للكتاب من راهينية موضوعه. على الرغم من تراجع قوة الرأسمالية الصناعية في مقابل صعود الرأسمالية التكنولوجية والرقمية، إلا أن مركزية الملكية الفكرية لم تتأثر، بسبب الروابط القوية بين المجتمع العلمي والرأسمالية التكنولوجية. وعلى الرغم من أن رأسمالية الاحتكار الفكري أساسية بالنسبة للقطاع الرقمي، إلا أنها تتجاوزه، إذ تُعد شركات الأدوية الكبرى مثالًا نموذجياً آخر. فضلاً عن تأثيرات الاحتكار الفكري على الأطراف، ذلك أن التوزيع غير المتكافئ والمستمر للابتكار في العالم هو حقيقة هيكلية تتفاقم بسبب توسّع الاحتكارات الفكرية في بلدان المركز، وخصوصاً في الولايات المتحدة. ولأن المعرفة تراكمية، فإنه عندما يُقيَّد الوصول إلى المعرفة الأكثر تقدّماً، فإن أولئك الذين يتمتعون بهذا الوصول سيطوّرون قدرة استيعابية أكبر لمواصلة الابتكار، ما يجعل امتياز المبتكر ميزة دائمة ويؤبد الريعية بمرور الوقت. وقد أدى التوسّع العالمي لحقوق الملكية الفكرية منذ الثمانينيات، خصوصاً مع التوقيع على «الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية»، في منتصف التسعينيات، إلى تمكين التوسع العالمي للاحتكارات الفكرية. لكن التطور الرقمي خلق شكلاً جديداً من أشكال الاحتكار الفكري القائم على البيانات من خلال استغلال في الشراكات العلمية، حيث تعتمد الشركات بشكل كبير على عمل الباحثين والتمويل العام لأبحاثها ولكنها تحتكر أرباح الاستغلال التجاري. ونظراً لأن عمالقة التكنولوجيا يتقنون توظيف الخوارزميات، فإنهم يجنون تدفقات ثابتة من مصادر البيانات الأصلية بشكل حصري تقريباً. وربما يكون الحل مشابهاً على طريقة مبادرة «المشاع الإبداعي»، لخلق مشاعات رقمية مماثلة تتعلق بالبيانات والخوارزميات والبنية الرقمية لمواجهة المراقبة واحتكارات الملكية الفكرية القائمة على البيانات، وهو مقترح يدافع عنه سيدريك دوران، صاحب أعمال أساسية في نقد الإقطاع التكنولوجي والرأسمالية الرقمية.