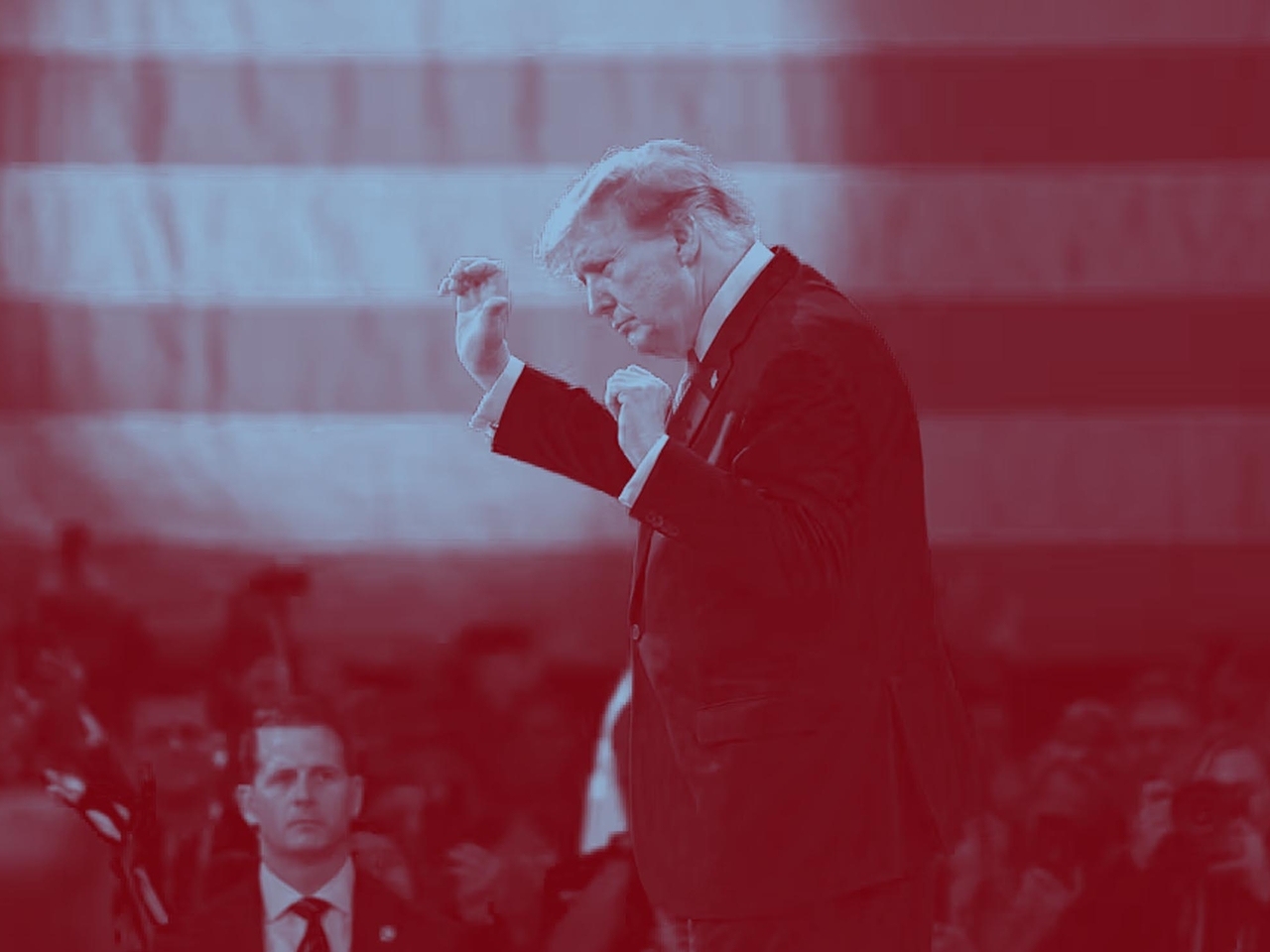أكان عالم التسعينيات أفضل من عالم اليوم؟
- جل ما كان يؤمن به الناس في التسعينيات ثبت بطلانه أو تبين أنّه لم يكن سوى وسيلة لخدمة مصالح ذاتية.
- لم تكن حرية التعبير في الجزء المهيمن أيديولوجياً من العالم خاضعة لرقابة شرطة الفكر، بل كانت تحت سيطرة سدنة المعرفة وشروط تحقيق النجاح.
هذا سؤالٌ جوهري. هل سلكنا، أعني العالم، مساراً خاطئاً لينتهي بنا المطاف إلى هذا الواقع المتردّي؟ قد يبدو السؤال غريباً في أعين الكثير من الشباب لأنّ عالم التسعينيات عندهم حقبة غابرة لا يكاد يعرفون عن تفاصيلها شيئاً. بيد أنّهم يعرفون جيداً دلالات مصطلحات الأزمة المالية العالمية والإمبريالية الليبرالية وإجماع واشنطن.
ومع أنّنا لا نستطيع الجزم بأنّ عالم اليوم «أفضل»، أرى أنّ بوسعنا التأكيد بثقة أنّ عالم التسعينيات كان عالماً من النفاق الذي لا يضاهى، وحافلاً بأفكار ثبت خطأ معظمها لاحقاً، سأستعرضها بعد قليل. لنبدأ بما قالته هنا آرنت عن النفاق: «ما يجعل من افتراض النفاق رذيلة الرذائل افتراضاً منطقياً، أنّ الاستقامة يمكن أن توجد فعلاً تحت ستار كلّ الرذائل الأخرى باستثناء هذه الرذيلة. فالمجرم وجريمته يضعانا أمام حيرة الشرّ الجذري، أما المنافق فوحده الفاسد حقاً حتى النخاع» (عن الثورة).
ومع أنّنا لا نستطيع الجزم بأنّ عالم اليوم «أفضل»، أرى أنّ بوسعنا التأكيد بثقة أنّ عالم التسعينيات كان عالماً من النفاق الذي لا يضاهى، وحافلاً بأفكار ثبت خطأ معظمها لاحقاً
لعل آرنت قد غالت في حكمها، فقدر من النفاق يعد شرطاً ضرورياً لقيام أي مجتمع؛ إذ ندرته تجعل المجتمع فظاً وعنيفاً، أما الإفراط فيه - وهنا أصابت أرندت - فيأخذ به إلى الفساد والتحلل.
ما أباطيل التسعينيات؟
الأمولة جيدة. ساد الظن أنّ زيادة الأمولة، محلياً ودولياً، سوف يسرّع نمو الأفراد والدول. حلّت الأمولة بديلاً عن المساواة الاقتصادية؛ فكل مَن يملك فكرة جيدة أو يرغب في الدراسة يمكنه الاقتراض بسهولة ليصبح ثرياً. انطبق هذا على الأفراد داخل دولهم، وعلى الدول الفقيرة في العالم. وكما كتب جون رولز في كتابه قانون الشعوب التسعينياتي بامتياز، كان بإمكان الدول الفقيرة الاقتراض بسهولة من «مجتمع الأمم» لحل مشكلاتها. بدا القطاع المالي المتطوّر علاجاً لكل داء، لكن أكان كذلك حقاً؟ الواقع يقول لا، إذ أسفرت حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول عن نشوب الأزمة المالية الآسيوية التي تسببت في تدهور حاد في المداخيل في كوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وإندونيسيا، قبل أن تمتد إلى روسيا وأميركا اللاتينية. وفي العامين 2007 و2008، أسفر التحرير المالي غير المنضبط في الغرب، مع اتساع فجوة التفاوت، عن وقوع أزمة مالية عالمية وركود اقتصادي. حينها أنقذت الحكومات المسؤولين عن الركود، وتُرِك المتضررون لمواجهة مصيرهم. وهكذا ثبت بطلان إحدى حقائق التسعينيات.
المجتمعات متعددة الأعراق جيدة. ساندت النخب ووسائل الإعلام، على الرغم من التشديد العلني على أهمية التعدد العرقي، تفكك الاتحادات متعددة الأعراق في الدول الشيوعية السابقة في أوروبا وأفريقيا (إثيوبيا)؛ فكيف يكون التعدّد العرقي خيراً في مكان وشراً في آخر؟ تكمن الإجابة في أن تلك النظرية لم تكن سوى أداة في يد الواقعية السياسية الفجّة، هدفها تفتيت أعدائنا المزعومين لزيادة قوتنا. فكانت كذبةً مُجَمَّلة. ومع تحول التعدد العرقي إلى معضلة في الغرب، وضع المسؤولون عراقيل متزايدة أمام حرية انتقال اليد العاملة، وبدا ذلك جلياً في أوروبا التي أحاطت نفسها بأسوار مكهربة (تلك التي شهد العام 1989 هدمها استعراضياً على الحدود المجرية النمساوية) ونشرت زوارق سريعة في المتوسط لتحمي نفسها مما كانت تدعي نخبها دعمه أيديولوجياً. وهكذا ثبت بطلان إحدى حقائق التسعينيات.
كيف يكون التعدّد العرقي خيراً في مكان وشراً في آخر؟ تكمن الإجابة في أن تلك النظرية لم تكن سوى أداة في يد الواقعية السياسية الفجّة، هدفها تفتيت أعدائنا المزعومين لزيادة قوتنا
يمكن للدول الفقيرة أن تصبح غنية بسهولة، بل عليها فعل ذلك. مفاد هذا الزعم أنّ الدول الغنية ونخبها تتوق لمساعدة الدول الفقيرة على النهوض. أما فقر تلك الدول فمرده إلى فسادها وفشلها في توظيف المعارف التكنولوجية المتاحة عالمياً. كان نقل التكنولوجيا وتطبيق مبدأ الميزة النسبية أمرين مرغوبين لا يعيقهما سوى فساد الدول الأقل تقدماً. لكن حين استغلت الصين تلك المعرفة التكنولوجية وتفوقت على الجميع، تغيّرت الرواية فجأةً، وصار الفقراء يسرقون تكنولوجيا هي حق للأغنياء. وهكذا ثبت بطلان إحدى حقائق التسعينيات، أو بعبارة أدق، تبين أنّ ما رُوِّج له لم يكن محل إيمان صادق أبداً.
المشكلة في الحكومة. فالقطاع الخاص كفيل بإنجاز كل شيء على نحو أفضل، غير أنّه حين اجتمعت الدولة والقطاع الخاص في الصين وأعادت ترتيب الأوراق العالمية وحققت لها معدلات نمو من رقمين، تبدل هذا الشعار تماماً؛ فأصبح لزاماً على الدولة تبني سياسات صناعية، ووضع حواجز أمنية، والدفاع عن نفسها.
وهكذا، فإنّ جل ما كان يؤمن به الناس في التسعينيات ثبت بطلانه أو تبين أنّه لم يكن سوى وسيلة لخدمة مصالح ذاتية. إذ همَّشَ طغيان النفاق المطلق أي آراء جريئة أو مغايرة وحصرها في هامش الجنون. ولم تكن حرية التعبير في الجزء المهيمن أيديولوجياً من العالم خاضعة لرقابة شرطة الفكر، بل كانت تحت سيطرة سدنة المعرفة وشروط تحقيق النجاح. وهؤلاء خنقوا الفكر وأنتجوا لغة خشبية شوهت الواقع، حتى صار الجميع يدركون ما يجب التفكير فيه - أو قوله على الأقل - لضمان التقدم. لقد كانت حقبة قاحلة فكرياً، عُدَّت فيها الأفكار المبتذلة قمة منجزات العقل البشري، وربما لا يكون عالم اليوم أفضل حالاً، لكنه بالتأكيد أكثر حرية على الصعيد الفكري.
نُشِر هذا المقال على مدوّنة برانكو ميلانوفيتش في 3 كانون الثاني/يناير 2026، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة منه.