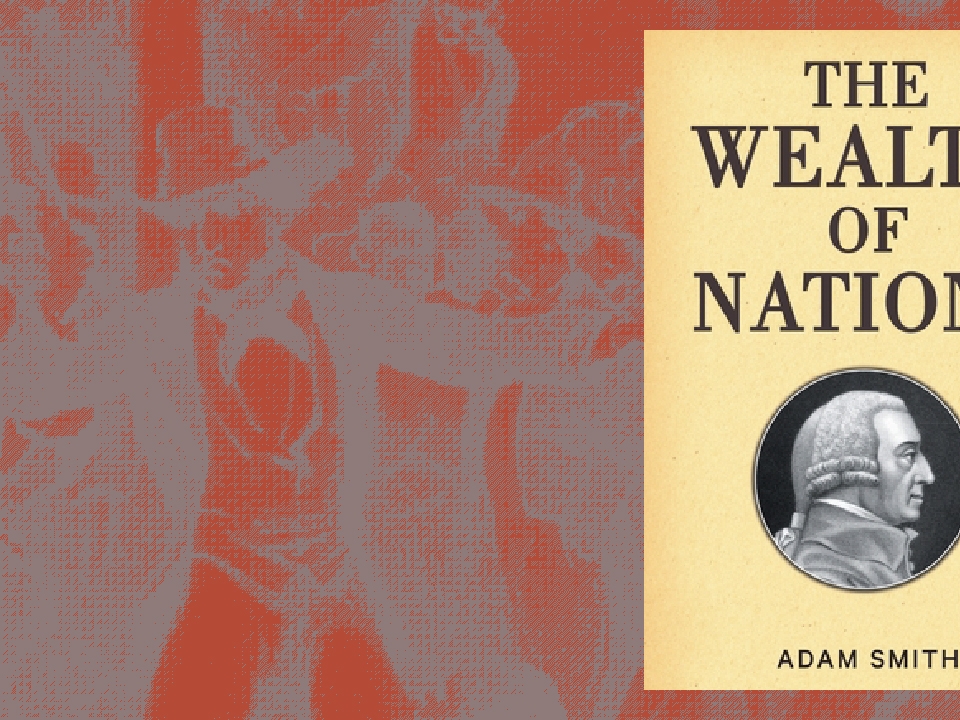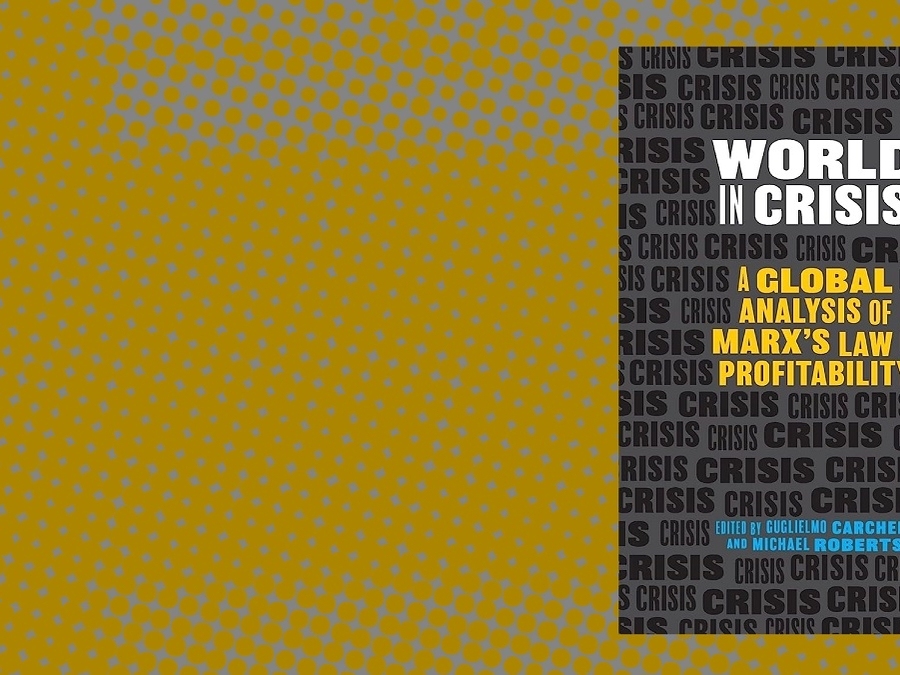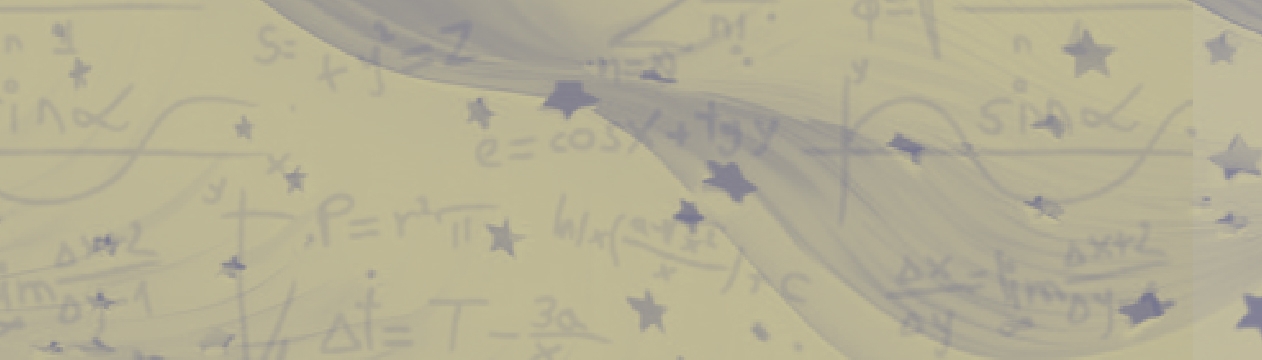
الكثير من ريكاردو أم القليل منه؟
مراجعة لكتاب «حلم ريكاردو» للكاتب نات داير الذي يقدّم نقداً جريئاً للاقتصاد النيوكلاسيكي من خلال تتبّع إرث ريكاردو، لكنه يتجاهل إسهامه في إدخال الصراع الطبقي إلى التحليل الاقتصادي، كما ينحصر في رؤية غربية ترى العولمة كارثة على الطبقة الوسطى في الغرب من دون الاعتراف بانتشال مئات الملايين من الفقر في آسيا، ليصبح الكتاب مثالاً على نقد ليبرالي يهاجم الاستعمار الماضي بينما يبرّر قومية اقتصادية في الحاضر.
هذا كتاب بالغ الصعوبة في مراجعته. لا لأن أطروحته الرئيسة غامضة، أو لأن أسلوبه عصيّ على الفهم، بل لأنه يجمع، برأيي، بين نقد رصين وعميق للاقتصاد النيوكلاسيكي، وبين طروحات لا يمكن الدفاع عنها أو ضلّت طريقها. كما يكشف عن تعامٍ عن الواقع لا يقلّ عمىً عمّا يدينه في غيره.
تتمثل أطروحة نات داير في فكرة بسيطة للغاية: تكمن الخطيئة الأصليّة للاقتصاد في القبول غير النقدي لنموذج ديفيد ريكاردو التحليلي، المبني على افتراض الفرد العقلاني أو «الحسابي» كما يسميه داير، الذي يسعى لتحقيق مصلحته الذاتية. هذا النموذج، الذي اشتهر من خلال نظرية الميزة النسبية، لم يخلُ من النقد منذ لحظة صدور مبادئ الاقتصاد السياسي في العام 1817، بل حتى في مرحلة كتابته. إلا أنّه استمر بفعل الدعم الذي حظي به من جون ستيوارت ميل وألفريد مارشال اللذين كرّسا مكانته، وإن بدرجات من الانتهازية الفكرية (خصوصاً مارشال). ثم يقفز داير قرناً إلى الأمام، نحو الولايات المتحدة، حيث اعتنق ميلتون فريدمان ومدرسة شيكاغو الثانية ومعهما بول صامويلسون، النموذج ذاته وروّجوا له. أدّى ولع الاقتصاديين هناك بالتجريد وبالحقائق الأنيقة القاطعة والمبسّطة، إلى تجاهل القيود الاجتماعية وإلى الإيمان الأعمى بـ«الإنسان الاقتصادي». ونتيجة لذلك، جرى تمويل الاقتصاد الأميركي واندفعت العولمة بما أضرّ بالطبقة الوسطى ووقعت أزمة 2007–2008 المالية وتفاقم التدهور البيئي وارتفعت موجة الشعبوية، حتى كأنّ الكتاب يومئ ضمناً، إلى اقتراب نهاية الحضارة الغربية.
قد يكون ريكاردو أفرط في استخدام التفكير التجريدي، لكن هذا التجريد بالذات هو ما أتاح بروز مقاربة أكثر واقعية للاقتصاد السياسي، = تدور حول صراع الطبقات على توزيع الدخل القومي وحيث تؤدّي السلطة والفاعلية دوراً مركزياً
يسرد داير القصة بأسلوب مقبول إلى حدّ بعيد، ويضمّ الكتاب فصولاً جديرة بالاهتمام، وخصوصاً في القسم الأول الذي يتناول حياة ديفيد ريكاردو ويعرض بتفصيل دقيق كيف أنّ التجارة بين إنكلترا والبرتغال، التي استخدمها ريكاردو كمثال في تطويره لنظرية الميزة النسبية، كانت في الواقع جزءاً من بنية أوسع تشمل تحالفات سياسية وحروباً واستعماراً وعبودية. لا تكمن أهمية هذا الفصل في كونه، كما يبدو أنّ داير يظن، يقدّم تفنيداً للنظرية (فالمثال يبقى سارياً نظرياً بغض النظر عن أسماء الدول والسلع)، بل في تقديمه لخلفية اقتصادية تاريخية معمّقة، تسلّط الضوء على معاهدة ميثوين بين إنكلترا والبرتغال وما رافقها من استغلال للعبيد ونهب لذهب البرازيل. وهذه الجوانب تحديداً، برأيي، ليست معروفة على نطاق واسع، وقد عرضها داير بأسلوب ممتع بل وأحياناً مؤثّر.
ستكون مراجعتي للكتاب أكثر نقداً ممّا يستحقه فعلياً، لأنني أتعامل مع عمل داير باعتباره نموذجاً لطريقة تفكير الليبراليين الغربيين، بل وحتى عدد من اليساريين، في فهم التاريخ والعولمة المعاصرة. لديّ اعتراضان جوهريان.
يرتبط الأول بما يمكن تسميته بـ«اتهام» ريكاردو، الذي يشكّل محوراً أساسياً في الكتاب. وكما ذكرت، فإنّ انتقاد التجريد ليس جديداً، بل هو إلى حدّ كبير مبرّر. لكن داير، يتجاهل في توافق كامل (وربما غير واعٍ) مع الاقتصاديين النيوكلاسيكيين، حقيقة أنّ المنهج التجريدي لدى ريكاردو سمح له أيضاً بإدخال تحليل الصراع الطبقي كجزء جوهري من الاقتصاد في ظل الرأسمالية. ومن هنا، ليس من المفاجئ أن يستلهمه الريكارديون الاشتراكيون، ثم ماركس - الذي اعتبر ريكاردو، بحسب شومبيتر، «معلّمه الوحيد» - وكذلك الماركسيون الجدد والريكارديون الجدد. وقف هؤلاء جميعاً ضدّ الاقتصاد النيوكلاسيكي انطلاقاً من تحليل ريكاردو نفسه، وخصوصاً بعده الطبقي الذي استُبعد كلياً من النظرية النيوكلاسيكية لأسباب في معظمها سياسية، ما جعلها، كما أوضحت في الفصل السابع من كتاب رؤى اللامساواة، منفصلة عن الواقع الملموس.
وهكذا يغفل داير، للأسف، النقطة الحاسمة: قد يكون ريكاردو أفرط في استخدام التفكير التجريدي، لكن هذا التجريد بالذات هو ما أتاح بروز مقاربة أكثر واقعية للاقتصاد السياسي، = تدور حول صراع الطبقات على توزيع الدخل القومي وحيث تؤدّي السلطة والفاعلية دوراً مركزياً. ببساطة: من دون ريكاردو، بل وحتى سميث، ومن دون تحليل طبقي، لا وجود لأي تصوير واقعي للاقتصاد الرأسمالي. غير أن داير، شأنه شأن معظم الليبراليين النقّاد اليوم، غارق إلى أذنيه في بنية الاقتصاد النيوكلاسيكي، الذي لا ينتقد فيه سوى فرضية «الإنسان الاقتصادي»، من دون أن يلتفت إلى ما يشكّل في نظري أضعف حلقاته: نفي البنية الطبقية للمجتمعات الرأسمالية. لذا، وإن جاز الربط بين منهج ريكاردو وبعض امتداداته لدى روبرت لوكاس مثلاً، فلا يمكن تحميل ريكاردو مسؤولية تجاوز النيوكلاسيكيين لهذا المنهج إلى حدود عبثية ولا تجاهل دوره التأسيسي في إظهار مركزية الطبقات ضمن النظام الرأسمالي، كما يفعل داير صراحة أو مواربة. ليست المشكلة في افتراض الفرد العقلاني، الذي قد يبدو واقعياً في مجتمعات اليوم المُفرطة في التسلّع والمأهولة بأفراد متمرسين في الحساب، المشكلة في إنكار الطبقة الاجتماعية كوحدة تحليل ذات مغزى. لذا، ليست مشكلتنا أنّ لدينا الكثير من ريكاردو، بل القليل جداً منه.
ليست المشكلة في افتراض الفرد العقلاني، الذي قد يبدو واقعياً في مجتمعات اليوم المُفرطة في التسلّع والمأهولة بأفراد متمرسين في الحساب، المشكلة في إنكار الطبقة الاجتماعية كوحدة تحليل ذات مغزى
تكمن السمة الثانية «النموذجية» في هذا الكتاب، التي يشترك فيها الليبراليون واليساريون، والتي أختلف معها، في تناوله للعولمة الراهنة في القسم الأخير من الكتاب من منظور غربي صرف. يُسرد الفصل الذي يتحدّث عن تدهور أوضاع الطبقات الوسطى في الغرب جرّاء العولمة (وهي ملاحظة صحيحة) من دون أن يأتي على ذكر ما أتاحته هذه العولمة للفقراء في العالم، وخصوصاً في آسيا، من تحوّلات هائلة. فمشكلات الطبقة الوسطى الغربية، أي أولئك الذين يتموضعون عند الشريحة 80 أو حتى 90 من الدخل العالمي، ويشكّلون ما بين 3% إلى 4% فقط من سكّان العالم، تُقدَّم وكأنها تمثّل مصير البشرية كلّها. تُروى القصة كما لو أنّ قرابة مليار إنسان لم يُنتشَلوا من الفقر المدقع بفضل النمو الاقتصادي والعولمة.
لا تُروى القصة في هذا الجزء من الكتاب من زاوية أنغلو-أميركية فحسب، بل يتسلّل إلى النص نَفَس قومي مزعج، كما في المقطع الوحيد الذي يرد فيه ذكر الصين ضمن سياق الحديث عن «تحدّي… الصين الناهضة» (ص. 206). فجأة، تصبح الجغرافيا السياسية هي المعيار الوحيد ذي الشأن. هذا التلوّن القومي-الاجتماعي في النبرة يبدو لافتاً، وإن لم يكن نادراً، في أوساط اليسار الليبرالي، لا سيّما حين يُقرن بمشهدٍ كامل من الرقابة الأخلاقية، حيث تُدان كلّ إحالة إلى سميث أو ريكاردو مراراً لأنّها لا تستخدم لغة محايدة جندرياً، ويُسلّط سيف «شرطة الأفكار» على نصوصٍ عمرها 200 عام.
يعكس داير رؤية شائعة في أوساط النخبة الليبرالية الأنغلو-أميركية المعاصرة، حيث تتجاور الانتقادات اللاذعة للإمبريالية البريطانية مع غياب تام لأي اطّلاع على الإنتاج الاقتصادي لاقتصاديين غير ناطقين بالإنكليزية، بل والأهم، مع تجاهل مطلق لأعمال اقتصاديين غربيين وغير غربيين على السواء، ممن لا ينتمون إلى المدرسة النيوكلاسيكية. وتُعرض إلى جانب ذلك ظاهرة تقارب الدخول العالمية اليوم باعتبارها شرّاً محضاً دمّر الطبقات الوسطى في الغرب. ويبدو أنّ توجيه نقد صارم للاستعمار يكفي، في أعين البعض، لتبرئة الذات من كلّ مركزيّة غربية حالية. وهكذا يغدو نقد الاستعمار طقساً رمزياً يُطمئن القارئ إلى أنّ بوسعه، وبضمير مرتاح، أن يكون قومياً اقتصادياً في الحاضر.
لأكون واضحاً: لا أرى أنّ هذا المنظور خاطئ في حدّ ذاته حين يتبنّاه سياسيون أو اقتصاديون يكتبون في الشؤون الاقتصادية الداخلية وينطلقون، عن حق، من حرصهم على رفاه مواطنيهم أولاً، وربما حصرياً. لكنّ اعتماد هذا المنظور من اقتصاديين، بصفتهم تلك، أمر غير مقبول. فكما أظهر سميث وريكاردو وماركس، على الاقتصادي أن يتوجّه إلى العالم بأسره وأن يمنح، ولو ضمنياً، وزناً متساوياً لكلّ فرد أينما عاش، حين يقيّم السياسات ويحدّد ما يُعدّ منها نافعاً أو ضاراً.
نُشِر هذا المقال في 13 حزيران/يونيو 2025 على مدوّنة برانكو ميلانوفيتش، وترجمت إلى العربية ونشرت في موقع «صفر» بموافقة منه.