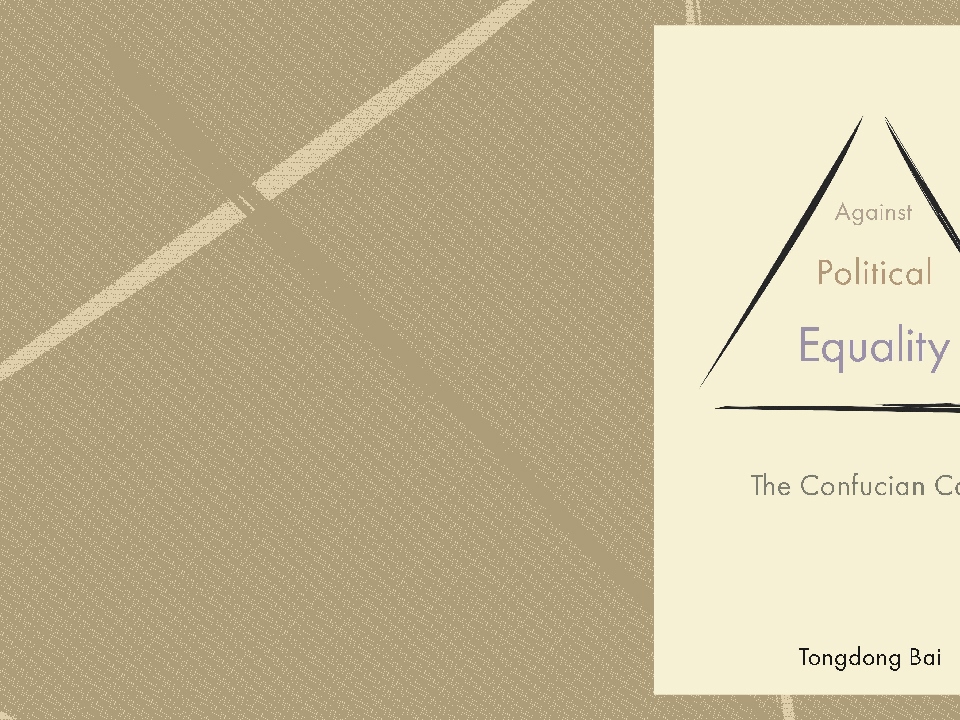استكشاف معنى المساواة وأهميتها
مراجعة لكتاب «المساواة: معناها وأهميتها»، وهو عبارة عن حوار منقّح دار بين توماس بيكيتي ومايكل ساندل في أيار/مايو 2024 في «كلية باريس للاقتصاد»، ويتناول تحديد مشكلة اللامساواة وبعض أبعادها الأكثر خصوصية (مثل الجدارة والضرائب) و«مستقبل اليسار».
أول ما يجب معرفته عن كتاب «المساواة: معناها وأهميتها» هو أنه حوار، وهو مُنقَّح من حوار دار بين توماس بيكيتي ومايكل ساندل في أيار/مايو 2024 في «كلية باريس للاقتصاد». ويُشكِّل هذا الحوار تجربة قراءة دينامية وجَذَّابة على مدار 119 صفحة، تُبرز فقط الأفكار الرئيسة للمؤلِّفَين، وأيضاً لمحات من شخصيتيهما المتمايزتين.
لا يحتاج المؤلّفان إلى تَقدِمَة. يتشارك بيكيتي وساندل، وهما أستاذان جامعيان ومثقفان بارزان، ثروة من المعرفة والرؤى عن اللامساواة، تلخّص بفعالية في هذا العمل في قالبٍ حواري. كما تبرز نقاط تباين مثمرة من خلال النقاش، أبرزها بين تخصّصي الاقتصاد والفلسفة السياسية، وأيضاً بين وجهات النظر في أوروبا والولايات المتحدة.
دراسة مشكلة اللامساواة
تَرِد الأسئلة التي يتناولها الكتاب في عنوانه الفرعي: استكشاف معنى المساواة وأهميتها. وتتتبع فصول الكتاب التسعة تطور النقاش من تحديد مشكلة اللامساواة إلى بعض أبعادها الأكثر خصوصية (مثل الجدارة والضرائب)، قبل التطرّق مجدداً إلى «مستقبل اليسار». ومع ذلك، تُعدّ هذه الفصول بمثابة علامات إرشادية ثيميّة، لا تُعيق سير ما يُعتبر نقاشاً متواصلاً واحداً.
يُبرز ساندل 3 أسباب تُفسر أهمية اللامساواة، وهي أسباب تتجاوز هذه القاعدة التوزيعية، لكنها تبقى مرتبطة بها: توفير السلع الأساسية للجميع، والمساواة السياسية، والكرامة
في افتتاحه للنقاش، يُعلّق ساندل قائلاً: «لقد كشف بحث [بيكيتي] لنا جميعاً وبوضوح مدى جلاء أوجه اللامساواة في الدخل والثروة. ولنبدأ بأشكال اللامساوة هذه». تُعدّ هذه خطوة افتتاحية حاسمة في ترسيخ المساواة كمسألة مادية وتوزيعية في المقام الأول. وسُرعان ما يُبرز ساندل 3 أسباب تُفسر أهمية اللامساواة، وهي أسباب تتجاوز هذه القاعدة التوزيعية، لكنها تبقى مرتبطة بها: توفير السلع الأساسية للجميع، والمساواة السياسية، والكرامة (ص. 4).
وفي معظم الأحيان، يستكشف المفكران بعضهما البعض بلطف واحترام، مستخدمين الأدوات التي صقلها كل منهما على مدار مسيرته المهنية: يطرح ساندل تجارب فكرية مُصمّمة بعناية لاستخلاص فروق التفكير الأخلاقي الدقيقة (ص. 97)، بينما يدعو بيكيتي إلى مواقف سياسية أكثر وضوحاً (ص. 75). يتيح هذا، مجتمعاً، مناقشة مُرضية وواسعة النطاق للأفكار، من الرؤيوية (نزع صفة التسليع عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية) إلى الواقعية (إدخال نظام اليانصيب كعنصر في قبول الجامعات النخبوية). كما أن الكتاب متفائل في جوهره. ويرجع هذا بشكل خاص إلى صوت بيكيتي، الذي يتميز بالحزم في المجادلة بوجود مسار تاريخي شامل عبر مجموعة واسعة من البلدان نحو قدر أكبر من المساواة منذ الثورة الفرنسية، فضلاً عن التحريض على المزيد من التفكير الطوباوي، مثل قوله: «أود أن يكون هناك شيء أشبه بالولايات المتحدة العالمية» (ص. 81).
الخلاف حول الشعبوية واليسار
أين، إذاً، يختلف مُفكِّرانا؟ يبدو أن هناك اختلافاً جوهرياً في الرأي يتعلق بالشعبوية، وتحديداً ما إذا كان ينبغي تصنيف سياسيين يساريين مثل بيرني ساندرز وإليزابيث وارن كشعبويين أم لا. يرى ساندل أنه من الصحيح وصفهم بالشعبوية، لأن سياساتهما تتضمن ادعاءات بإعطاء الشعب صوتاً وسلطة في مواجهة النخب، بينما يعترض بيكيتي على التأثير المُقوِّض للشعبوية كصفة. يُحلل غويفارتس وآخرون هذا الخلاف من منظور الطبيعة المُفرطة للشعبوية كمصطلح، وما إذا كان ينبغي التعامل معها كمفهوم (ساندل) أم كدال ذي عواقب سياسية (بيكيتي). ويقترح ساندل في النهاية: «لا داعي للقلق كثيراً بشأن هذا يا توماس»، ومع ذلك، فإن الخلاف وعدم حسمه يُحوّلان بنية الحوار من مجرد فكرة شكلية إلى شيء أكثر حيوية.
أوجه القصور عند مناقشة الجندر والعرق والوَصْم
يُعدُّ الكتاب سجلاً لحوار واحد، ولذلك ليس من المستغرب عدم التطرّق بشكلٍ كافٍ أو مُعتبر لبعض الثيمات. ومع ذلك، ينبغي على القراء الاستعداد لغياب الاهتمام العام بأوجه اللامساواة الفئوية، وأبرزها ما له علاقة بالأبعاد الجندرية والعرقية، سواءً في حد ذاتها أو من خلال تقاطعها وتكوينها المتبادل مع العوامل الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذا يُعزى جزئياً إلى الإيجاز الذي يفرضه أسلوب الكتاب، فإنه يُفسح المجال لبعض الثغرات بين وعد الكتاب باستكشاف «معنى المساواة» وما يُقدِّمه النص.
من الصعب تجاهل الشعور بأن مركزية هذه الأنواع من الوَصْم في نقاش الكتاب تنبع من ما يُنظر إليه على أنه المشروع السياسي المركزي لليسار المتمثل في إعادة التوزيع، أكثر من كونها انخراطاً أعم في معالجة أوجه اللامساواة في التقدير والاحترام
وهذا يُفضي أيضاً إلى حالة غريبة نوعاً ما، حيث يُناقَش الوَصْم، ولكن بحماسة أكبر فيما يتعلق بالأشخاص غير الحاصلين على شهادات جامعية، في البلدات غير الصناعية والمدن الصغيرة. وهذه، بلا شك، أشكال حقيقية من الوَصْم وذات أهمية أخلاقية وسياسية، ومع ذلك، فإنها تُغفل الكثير من أشكال الوَصْم واللامساوة الأخرى المُعترف بها (كما تتصور الأمر ميشيل لامونت، على سبيل المثال). من الصعب تجاهل الشعور بأن مركزية هذه الأنواع من الوَصْم في نقاش الكتاب تنبع من ما يُنظر إليه على أنه المشروع السياسي المركزي لليسار المتمثل في إعادة التوزيع، أكثر من كونها انخراطاً أعم في معالجة أوجه اللامساواة في التقدير والاحترام. فماذا عن الجماعات الموصومة التي لا تُقرر نتائج الانتخابات، ومطالباتها بالمساواة؟
ومع ذلك، وبصفته تشخيصاً للمخاطر التي تواجه أحزاب يسار الوسط اليوم، لا يمكن إلحاق العيب بالكتاب. ويُحذِّر بيكيتي اليسار بوضوح من إرسال رسالة إلى الناخبين مفادها: «هناك سياسة اقتصادية واحدة فقط يُمكننا اتباعها، وهي ضبط حدودنا فيما يتعلق بالمهاجرين والهوية. ذلك أنك إذا كررتَ هذا للجمهور على مدى عقود، وتظاهرتَ بأنه الشيء الوحيد الذي يُمكنك التحكم فيه، فلا عجب أن يدور النقاش السياسي برمته حول ضبط الحدود والهوية. أعتقد أن هذا فخ، وأن هذا أمر يجب تجنبه بأي ثمن، لأنه في النهاية سيؤدي إلى انتصار الجانب القومي». (107)
على الرغم من أن المناقشة جرت في باريس في أيار/مايو 2024، فإن هذه الرسالة عن أهمية الـ(لا)مساواة يجب أن تكون قراءة إلزامية للقادة السياسيين في بريطانيا بعد عام.
نُشِر هذا المقال في 02 تموز/يوليو 2025 في LSE Review of Books بموجب رخصة المشاع الإبداعي.