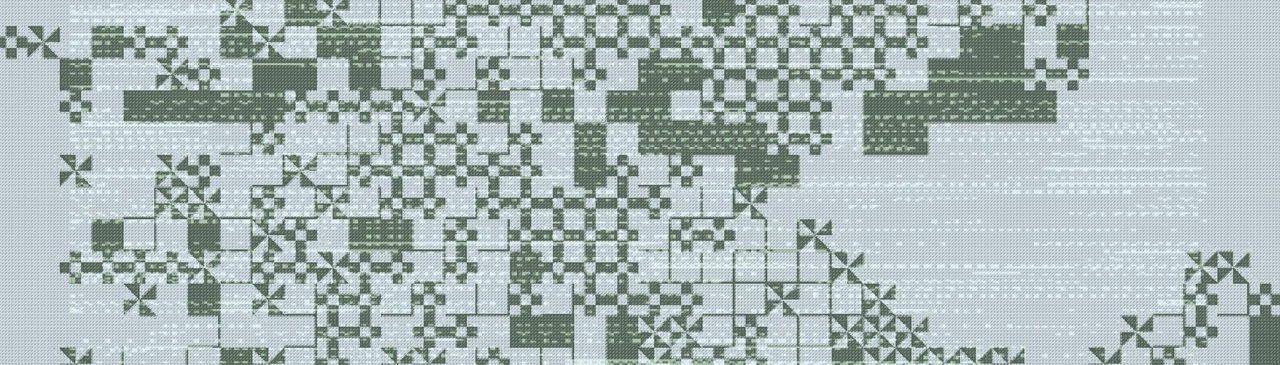
هل يجب الاستغناء عن التكنولوجيا الرقمية لإنقاذ الكوكب؟
- مراجعة لكتاب سيدريك دوران الجديد تحت عنوان «هل يجب الاستغناء عن التكنولوجيا الرقمية لإنقاذ الكوكب». يحاول دوران الدفاع عن طريق ثالث بين التفاؤل التقني الساذج والتشاؤم التقني المُشل. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الرغم من «كونها مُنفِّرة ومدمرة بشكلها الحالي، إلا أنها أدوات تحررية لا غنى عنها لتنظيم التحول البيئي والاجتماعي».
بعد كتابه «الإقطاع التكنولوجي: نقد الاقتصاد الرقمي»، الصادر في عام 2020، يعود أستاذ الاقتصاد في جامعتي السوربون وجنيف، سيدريك دوران، إلى «الإقطاع التكنولوجي» من زاوية المعضلة المناخية، في كتابٍ جديد هو ثمرة ثلاث محاضرات قدمها في «معهد لابواسي» للتفكير بباريس، وصدر في اذار/ مارس الماضي تحت عنوان «هل يجب الاستغناء عن التكنولوجيا الرقمية لإنقاذ الكوكب».
يفتح العنوان الاستفزازي للكتاب مجالاً للنقاش حول المأزق الذي يواجه كل نقدٍ للإقطاع التكنولوجي الصاعد وعلاقته بالأزمة المناخية، في سياقٍ تاريخي، أصبح فيه التفكير في الاستغناء عن التكنولوجيا، ليس فقط مستحيلاً من الناحية العملية، بل تفكيراً رجعياً تختلط فيه الطوباوية بالشعبوية. في مواجهة هذا المأزق يحاول دوران الدفاع عن طريقٍ ثالثٍ للتفكير، وسطاً، بين التفاؤل التقني الساذج والتشاؤم التقني المُشل. فتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى الرغم من «كونها مُنفِّرة ومدمرة بشكلها الحالي، إلا أنها أدوات تحررية لا غنى عنها لتنظيم التحول البيئي والاجتماعي».
الوجوه الثلاثة للإقطاع
يعيد الكاتب تقديم مفهوم «الإقطاع التكنولوجي»، الذي طوّره في عمله السابق، والذي يسعى إلى استيعاب الطبيعة العميقة للتحول الاقتصادي والسياسي الناتج عن صعود عمالقة التكنولوجيا الرقمية. وهو تحولٌ جذري في نمط الإنتاج الرأسمالي، يتميز بثلاث ركائز أساسية. أولها الطبيعة الإقطاعية، فكما كان القِنْ مرتبطًا بأرض سيده في عصر الإقطاع التقليدي، أصبح الفرد المعاصر، والمؤسسة، وحتى الدولة، معتمدين هيكلياً على البنية التحتية التكنولوجية التي توفرها الشركات الكبرى. حيث أصبح الاستغناء عن محرك غوغل للبحث، ومنصة أمازون للتسوق، وبرامج مايكروسوفت المكتبية، أو برامج ميتا للتواصل الاجتماعي أمراً شبه مستحيل للعمل وبناء العلاقات وتسديد الحاجات المادية والمعنوية للبشر. ولم تعد الخدمات التي تقدمها هذه الشركات مجرد منتجات استهلاكية، بل أصبحت بنى تحتية حيوية، وسلعًا هجينة تُهيكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للوجود الإنساني. وهو ما يخلق علاقة تبعية وخضوع، حيث تُؤطر وتُحدد حرية تصرف المستخدم باستمرار من خلال خوارزميات وواجهات المنصات.
أما الركيزة الثانية لهذا التحول فهي اندماج السياسي والاقتصادي في أيدي «أسياد التكنولوجيا»، الذين لا يكتفون ببيع الخدمات، بل أصبحوا ينظمون الحياة الجماعية. من خلال إنتاج المعرفة، عبر تجميع وتحليل البيانات الضخمة، وتحديد الخيارات، عبر الذكاء الاصطناعي، وبالتالي أصبحوا يتمتعون بسلطة عالمية فائقة، تفوق حتى سلطة الدولة المحكومة بإقليم محدد. فضلاً عن امتلاكهم للسلطة المعيارية القادرة على تحديد ما هو مرئي، وما يُقال، وحتى ما يُمكن التفكير فيه. وهذا الاندماج أصبح ممكناً بفضل قدرتهم على تحويل المعلومات إلى مورد استراتيجي، أي إلى شكل جديد من أشكال رأس المال. أما الركيزة الثالثة، التي يقدمها الكاتب، والتي ربما تشكل إضافةً تحليلية لافتة، فهي الطبيعة الافتراسية والريعية. ذلك أن «الإقطاع التكنولوجي» لا يعتمد في التراكم على فائض القيمة المستخرج من العمل فحسب، بل من خلال الاستيلاء على القيمة المتداولة داخل النظام الرقمي. فالمنصات تعمل كجامع رسوم، فتستخرج الريع من أي نشاط اقتصادي يعتمد على بنيتها التحتية. مثل تقاضي عمولات على عمليات البيع أو استغلال انتباه المستخدم في الإعلانات أو تأجير مساحات للتطبيقات. وتستند هذه الديناميكية الافتراسية من خلال احتكار المعرفة، وهي ما يسميها دوران «الرأسمالية الفكرية الاحتكارية». ورغم التحليل المتماسك الذي يقدمه الكاتب، كونه يسمح بتجاوز النظرة التبسيطية للرأسمالية الرقمية، إلا أنه لا يهتم كثيراً بدور الدولة، ولا سيما دور الدولة الأميركية، في نشأة وتطور شركات التكنولوجيا الكبرى. وكيف أن هذا التحول الجذري في نمط الإنتاج الرأسمالي هو في الأساس صنيعة المجمع العسكري التكنولوجي الأميركي، سواء من حيث خلق حاجات ومبررات التحول أو من حيث البنية التحتية أو من حيث التمويل.
«الاشتراكية البيئية السيبرانية»
في مواجهة هذا التحول، برز اتجاهان نقديان، يبحثان عن مخرجٍ قبل استواء الكارثة المناخية نهائياً. الاتجاه الأول هو «شيوعية النمو السلبي»، ورائدها الياباني كوهي سايتو، التي تدافع عن نهج دمج الضرورة البيئية (حدود الطبيعة) مع الأهداف الاشتراكية في العدالة وإنهاء الاستغلال، وذلك من خلال الدعوة إلى تقليص حجم ووتيرة النمو الاقتصادي بما في ذلك الرقمي. أما الاتجاه الثاني فهو «الحداثة البيئية»، التي تدافع عن فكرة حياد التكنولوجيا، وأنه يكفي تسخيرها لخدمة الأهداف الاجتماعية لتصبح رافعة للتحرر، بل وللوفرة. داخل هذا النقاش الفلسفي، يحاول سيدريك دوران شقَ طريقٍ ضيقٍ بين هاويتين، مقترحاً ما سماه «الاشتراكية البيئية السيبرانية»، التي تهدف لحشد قوة الحوسبة، والقدرة على معالجة البيانات الضخمة، وشبكات الاتصال «لتحديد كيفية تحقيق الأهداف العالمية والجماعية»، ألا وهي الحفاظ على المحيط الحيوي والتحرر الاجتماعي. ومع أن الكاتب يُقرّ بأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وضعها الحالي معادية للطبيعة والانسان، كونها كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتُعزز خضوع العمل والمجتمع لمنطق رأس المال .لكنه يعتقد أنها أصبحت لا غنى عنها لإدارة تعقيدات العالم الحديث وتطبيق تخطيط بيئي فعال. مجادلاً بأنه لا يمكننا الاستغناء عن التكنولوجيا الرقمية لإنقاذ الكوكب، لأنها تُمكّننا من قياس الأثر البيئي لأنشطتنا آنياً، ونمذجة سيناريوهات التحول، وتنسيق الإجراءات على نطاق الكوكب. لذلك، يجب علينا استخدامها كغنيمة حربٍ، وقبول درجة مقبولة من الاغتراب على المدى القصير، مع العمل، على المدى المتوسط، على تطوير أشكال جديدة من التكنولوجيا الرقمية مصممة وفقاً للمبادئ الاشتراكية والبيئية.
ولإدارة هذا التوازن بين توظيف التكنولوجيا الرقمية وبين مقاومة أثارها السلبية على البشر والطبيعة، يقترح دوران إستراتيجية من ثلاثة تدابير، أولها، محاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى، أي استعمال المسارات القانونية المتاحة لمحاربة سلوك هذه الشركات في خرق قوانين العمل وقوانين الحفاظ على الخصوصية ومعدلات الانبعاث وغيرها من أشكال محاصرتها بالمراقبة والغرامات. وثانياً، إنشاء «مشاعات رقمية» مثل البرمجيات الحرة لتخفيف حدة الاحتكار وخلق مساحات بديلة. وثالثاً، إنشاء «أسهم ذهبية»، وهي أسهم خاصة تمنح الدولة حق النقض داخل مجالس إدارة الشركات الكبرى. لكن الإستراتيجية الأهم وفقًا لدوران، هي «السيادة الرقمية»، التي يجب على الدول خلقها من خلال التشريع والتنظيم، ولا سيما دول الجنوب العالمي، لاستعادة السيطرة على بنيتها التحتية الرقمية. داعياً إلى بناء «تكتل تكنولوجي جنوبي»، شبيه بحركة عدم الانحياز، لبناء استقلال تكنولوجي جماعي، بعد أن أصبحت التبعية التكنولوجية شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار.
يقدم سيدريك دوران مساهمةً أساسية في النقاش الدائر حول التحول الجذري لنمط الإنتاج الرأسمالي نحو هيمنة التكنولوجيا، وعلاقته بالمأزق المناخي الذي يواجهه الكوكبّ. فضلاً عن تشخيص عميق لطبيعة هذا التحول ونزوعه نحو إقطاعية جديدةٍ. لكن ما يقدمه من إستراتيجيات لإدارة التوازن بين توظيف التكنولوجيا الرقمية وبين مقاومة أثارها السلبية، يبدو أقل من المأمول لخلق هذا التوازن. فالتشابك القائم بين الدولة - وأساساً في الولايات المتحدة - والطبقة الإقطاعية التكنولوجية يجعل من التدابير المقترحة، مثل وجود الدولة في مجالس الإدارات أو المحاسبة، مقترحاتٍ غير مجديةٍ، ذلك أن قوة هذه الطبقة وسلطتها تجعلها فوق المحاسبة أو أقله فاعلاً أساسياً في صنع وتشكيل الطبقة البيروقراطية الحاكمة. لكن يظل مقترح «السيادة الرقمية»، بالنسبة لدول الجنوب، مفيداً ووجيهاً، كونه الحلّ الوحيد في ظل الوضع الراهن لبناء لبنات سيادة اقتصادية نسبية، في سياقٍ جيوسياسي مفتوحٍ على تحولاتٍ تسير في اتجاه تراجع الولايات المتحدة وصعود الصين.


