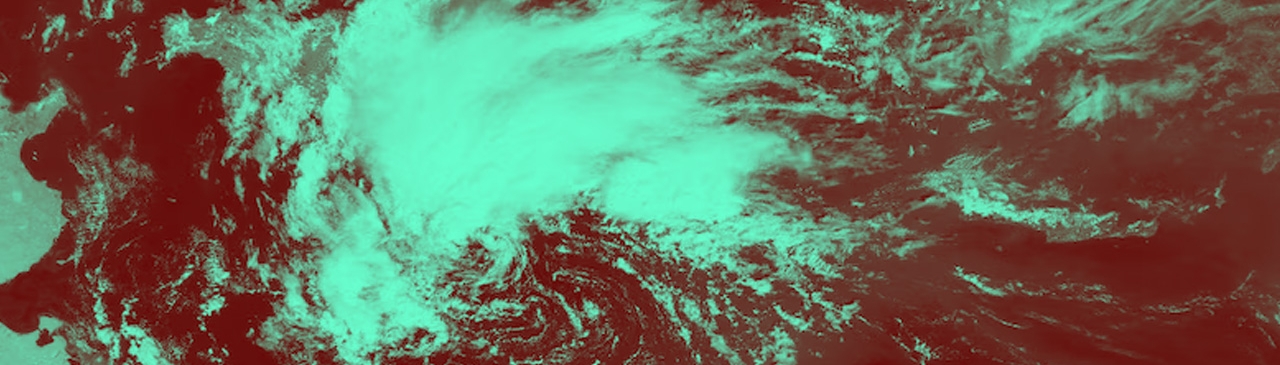
لعبة «الروليت الروسية» في بلدان الشرق الأوسط النفطية
على الرغم من موجات الحر الجهنمية والفيضانات العارمة، يرسب الشرق الأوسط في امتحان مجابهة التغيّر المناخي.
شهد أيلول/سبتمبر الماضي ما اعتدنا على اعتباره ظاهرة مناخية نادرة حقاً: إعصار البحر الأبيض المتوسط، أو «ميديكين». قبل وقت طويل، لم يكن البحر الأبيض المتوسط ساخناً لدرجة التسبّب بالأعاصير إلّا مرّة كل بضع مئات من السنين. نعم، بضع مئات من السنين. لكن في هذه الحالة، هاجمت العاصفة دانيال ليبيا بطوفان شبيه بطوفان نوح دام أربعة أيام متتالية. وكان ذلك كافياً لغمر سدِّي البلاد وأبو منصور اللذين بنيا بالقرب من مدينة درنة في سبعينيات القرن العشرين وفق المواصفات القديمة الخاصة بالحفاظ على حرارة الأرض. ودمّر الفيضان الناجم عن ذلك ما يقرب من 1000 مبنى، جارفاً آلاف الأشخاص إلى البحر، ومشرداً عشرات الآلاف الآخرين.
تحكي المحامية صالحة أبو بكر حكاية مروعة عن ارتفاع المياه المتواصل في المبنى حيث تقطن حتى كادت تبلغ السطح جارفة معها بالمعنى الحرفي للكلمة كثيراً من السكان. تشبثت صالحة بقطعة أثاث خشبية لثلاث ساعات في الماء. وقالت لأحد المراسلين لاحقاً: «أستطيع السباحة، لكني حين حاولت إنقاذ عائلتي، لم أقوى على شيء». كان تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية والانبعاثات التي تنفثّ سنوياً 37 مليار طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون الخطير في غلافنا الجوي، قد زاد من احتمال وقوع الكارثة الليبية 50 ضعفاً قياساً إلى السابق. والأسوأ أن هذا الكابوس، بالنسبة إلى الشرق الأوسط، كما بالنسبة إلى بقية العالم، ليس سوى البداية لكوارث متسلسلة أكيدة مقبلة من شأنها أن تشرّد ملايين البشر أو أن تودي بهم إلى ما هو أسوأ.
أداءٌ متعثّر
في السباق الرامي إلى الحيلولة دون ارتفاع حرارة الكوكب بأكثر من 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية) فوق المعدل الذي كان سائداً قبل الثورة الصناعية، نجد أنّ الأرقام أو الدرجات التي أحرزها العالم مشينة بالفعل. ويخشى العلماء أن تغمر النظام المناخي للكوكب برمته حالة من الفوضى، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً للحضارة ذاتها. وثمة استنتاجات تدق ناقوس الخطر نجدها في التقرير الصادر في آذار/مارس الماضي عن مؤشر أداء تغير المناخ الذي يرصد تنفيذ اتفاقات باريس للمناخ. لقد غمر فريق المؤشر إحباط شديد بسبب نتائجه - ما من بلد قد اقترب من تحقيق الأهداف التي وضعتها تلك المعاهدة - حتى أنهم تركوا الخانات الثلاث الأولى في نظام التصنيف الخاص بهم خالية تماماً.
أمّا بخصوص انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري الذي سبق أن رفع حرارة الكوكب بدرجات كثيرة، تعد بلدان الشرق الأوسط الأشد ابتلاءً. ومن المعروف أنّ المغرب، بأهدافه طويلة الأمد والطموحة في مجال الطاقة الخضراء، جاء في المركز التاسع، أما مصر، باعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية وعلى بعض مشاريع الطاقة الشمسية، فقد احتلت مركزاً متواضعاً هو الثاني والعشرون. لكّن بعض دول الشرق الأوسط مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة جاءت في أسفل الجدول الذي وضعه المؤشّر. وهذا مهم، وليس مفاجئاً على اعتبار أن المنطقة تنتج نحو 27% من النفط العالمي سنوياً وتضم 5 من أكبر 10 منتجي نفط في العالم.
من المفارقات أن منطقة الشرق الأوسط تواجه خطر تغير المناخ بشدّة. ووجد العلماء أنّ فيها ضعف معدل الاحترار مقارنة بالمتوسط العالمي وحذّروا من أنها ستعاني في المستقبل القريب من «موجات حر شديدة، وانخفاضاً في هطول الأمطار، وموجات جفاف طويلة، وعواصف رملية وفيضانات أكثر شدة، وارتفاعاً في منسوب مياه البحر
من المفارقات أن منطقة الشرق الأوسط تواجه خطر تغير المناخ بشدّة. ووجد العلماء أنّ فيها ضعف معدل الاحترار مقارنة بالمتوسط العالمي، وحذّروا في دراسة حديثة أجراها معهد كارنيغي للسلام الدولي، من أنها ستعاني في المستقبل القريب من «موجات حر شديدة، وانخفاضاً في هطول الأمطار، وموجات جفاف طويلة، وعواصف رملية وفيضانات أكثر شدة، وارتفاعاً في منسوب مياه البحر. لكنّ بعض البلدان التي تواجه التهديد الأكبر المتمثل في أزمة المناخ تبدو عازمة بإصرار على جعل الأمر أسوأ بكثير.
إسبارطة الصغرى
يعمد مؤشر أداء تغيّر المناخ الصادر عن Germanwatch ومعهد NewClimate وشبكة العمل المناخي، إلى تصنيف جهود الدول في تحقيقها الأهداف التي حدّدتها اتفاقية باريس وفقاً لأربعة معايير: انبعاثاتها من غازات الدفيئة، واعتمادها مصادر الطاقة المتجددة، واستهلاكها لطاقة الوقود الأحفوري، وسياسات حكوماتها المناخية. جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 65 من هذه القائمة، ووصفت بأنها «واحدة من أسوأ الدول أداءً». وينتقد التقرير حكومة الرئيس محمد بن زايد بشدة، قائلاً إن «انبعاثات غازات الدفيئة للفرد في الإمارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات في العالم، كما هو نصيب الفرد فيها من الثروة، لكنّ أهدافها المناخية الوطنية غير كافية. وتواصل الإمارات تطوير حقول النفط والغاز الجديدة وتمويلها محلياً وخارجياً». ومع أنّ عدد مواطني الإمارات العربية المتحدة، على الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية، لا يزيد عن مليون مواطن (يضاف إليهم نحو 8 ملايين عامل أجنبي). فإنّها تبقى عملاقاً جيوسياسياً من الدرجة الأولى في مجال الطاقة وغازات الدفيئة.
لدى شركة بترول أبو ظبي الوطنية، أو أدنوك، التي يرأسها رجل الأعمال سلطان أحمد الجابر (وهو أيضاً وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة)، بعض الخطط الطموحة لتوسيع إنتاج النفط في العالم. وتسعى أدنوك، في الحقيقة، إلى زيادة إنتاجها النفطي من 4 ملايين إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2027، مع مواصلة تطوير حقل النوف النفطي الحيوي الذي تبني الإمارات العربية المتحدة بجواره جزيرة صناعية للمساهمة في توسعه المستقبلي المتوقع. ولكي نكون منصفين، لا يختلف سلوك الإمارات كثيراً عن سلوك الولايات المتحدة، التي لم تحرز أي تقدّم يذكر واحتلت المرتبة 57. ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصل إنتاج النفط الأميركي الذي لا يزال يحظى بدعم كبير من الحكومة (شأنه شأن تلك الصناعة في أوروبا) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
في العالم الذي يساهم الجابر في خلقه، حتى الكهوف سوف تصبح عاجلاً أم آجلاً أسخن من أن يعاش فيها
تعتبر الإمارات العربية المتحدة من المؤيدين الكبار لتقنية احتجاز الكربون وتخزينه المشكوك فيها، والتي لم يثبت بعد أنها تحدّ كثيراً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تفعل ذلك بصورة آمنة وممكنة. وتشير مجلة «Oil Change International» إلى أن جهود احتجاز الكربون التي تبذلها الإمارات قد لا تؤدي إلى احتجاز أكثر من 17% من ثاني أكسيد الكربون المنتج فيها، عدا أن ثاني أكسيد الكربون المخزّن يُحقن بعد ذلك في حقول نفط قديمة غير منتجة للمساعدة في استرداد آخر ما فيها من قطرات البترول.
إنّ الإمارات العربية المتحدة، التي يشير إليها البنتاغون بإعجاب باسم «إسبارطة الصغرى» بسبب تدخلاتها العسكرية الشرسة في أماكن مثل اليمن والسودان، تنتهك بلا خجل الإجماع العلمي الدولي بشأن العمل المناخي. وتجرّأ الجابر في الخريف الماضي على القول إنه «لا يوجد أي علم، أو أي سيناريو، يقول إن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو ما سيحقق 1.5 درجة مئوية».
ترقى مثل هذه النزعة الإنكارية المفرطة إلى مستويات تكاد تكون ترامبية (نسبة إلى ترامب) في كبر أكاذيبها. ومن المفارقات أيضاً أنّ الجابر كان في حينه رئيساً لقمة المناخ السنوية التي يعقدها مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف. وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، طرَح هذا التحدي بجرأة: «الرجاء مساعدتي. أرني خريطة الطريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي سيسمح بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، إلا إذا كنت تريد إعادة العالم إلى الكهوف». في العالم الذي يساهم الجابر في خلقه، حتى الكهوف سوف تصبح عاجلاً أم آجلاً أسخن من أن يعاش فيها. وهذا العام ردّت وكالة الطاقة الدولية بصورة حاسمة على تصيّده الملحمي هذا بقولها إنّ الدول الأكثر ثراءً، لاسيما الأوروبية منها، زادت نواتجها الوطنية الإجمالية في العام 2023 على الرغم من خفضها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة مذهلة بلغت 4.5%. بعبارة أخرى، يمكن للابتعاد عن الوقود الأحفوري أن يجعل البشرية أكثر ازدهاراً وأمناً من الكوارث الكوكبية بدلاً من أن يحوّل أكثرنا إلى مشرّدين.
«بالطبع لا!»
ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من سياسة الإمارات العربية المتحدة الداعمة بلا خجل لطاقة الوقود الأحفوري؟ إنّها سياسة إيران في تمسكها الشديد بالنفط والغاز، واحتلالها المرتبة 66، أي أدنى من الإمارات بمرتبة واحدة. لكنّ المفارقة هنا أنّ العقوبات الأميركية واسعة النطاق على صادرات النفط الإيرانية قد تسهم على المدى الطويل في دفع حاكمي البلاد نحو إقامة مشاريع ضخمة لتوليد الطاقة من الرياح والشمس.
كلّي ثقة بأنّ القارئ لن يُفاجأ حين يعلم أنّه في المركز الأخير الأدنى - مع التشديد على «الأدنى» - تأتي السعودية محبوبة دونالد ترامب. تحل السعودية في المرتبة 67 «محرزة درجات منخفضة للغاية في جميع فئات مؤشر أداء تغيّر المناخ الأربع وهي: استخدام الطاقة، وسياسة المناخ، والطاقة المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة». وقد أشار مراقبون آخرون إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة زادت بمعدل 4% سنوياً منذ العام 1990. وفي العام 2019، كانت تلك البلد الصغيرة نسبياً عاشر أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
الأسوأ الذي لا تظهره الطريقة التي يتصرف بها قادة كل من الإمارات والسعودية، هو أنّ شبه الجزيرة العربية القاحلة والحارة أصلاً ليست محصّنة قط ضد الكوارث المحتملة الناجمة عن تغير المناخ. وكان العام 2023 ثالث أحرّ الأعوام التي سجّلت على الإطلاق في السعودية، فيما اعتبر العام 2021 الأكثر سخونة على الإطلاق حتى الآن. لا يُطاق الطقس هناك في الصيف. وفي 18 تموز/يوليو 2023، بلغت درجة الحرارة في الأحساء مستوى لا يكاد يمكن تصوره، ووصلت إلى 122.9 درجة فهرنهايت (50.5 درجة مئوية). وإذا ترافقت درجات الحرارة هذه في المستقبل مع نسبة رطوبة تصل إلى 50%، يشير بعض الباحثين أنها قد تكون قاتلة للبشر. ووفقاً للبروفيسور لويس هالسي من جامعة روهامبتون في إنكلترا وزملائه، فإن هذا النوع من الحرارة يمكن أن يرفع درجة حرارة الفرد بمقدار 1.8 درجة فهرنهايت. بعبارة أخرى، سيكون الأمر كما لو أن البشر يعانون الحمى، والأسوأ من ذلك أنّ « معدلات الأيض سترتفع أيضاً بنسبة 56%، وكذلك معدلات ضربات القلب بنسبة 64%».
في حين أن شبه الجزيرة العربية جافة نسبياً، فإن المدن الواقعة على البحر الأحمر وخليج عدن يمكن أن تكون في بعض الأحيان رطبة وحارة، ما يعني أن الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة قد تجعلها غير صالحة للسكن عاجلاً أم آجلاً
في حين أن شبه الجزيرة العربية جافة نسبياً، فإن المدن الواقعة على البحر الأحمر وخليج عدن يمكن أن تكون في بعض الأحيان رطبة وحارة، ما يعني أن الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة قد تجعلها غير صالحة للسكن عاجلاً أم آجلاً. بل إنّ مثل هذه الحرارة المرتفعة قد تهدّد الحج وهو واحد من «أركان الإسلام الخمسة». ففي العام الماضي، صادف توقيت الحج إلى مكة في شهر تموز/ يونيو، حين بلغت درجات الحرارة في بعض الأحيان 118 درجة فهرنهايت (48 درجة مئوية) في غرب السعودية. ووقع أكثر من 2,000 حاج ضحية الإجهاد الحراري، وهي مشكلة من المؤكد أنها سوف تتفاقم كثيراً مع ارتفاع حرارة الكوكب.
على الرغم من تهديد تغير المناخ لرفاهية سكان ذلك البلد، فإن حكومة الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان تكاد لا تفعل شيئاً لمعالجة المشاكل المتفاقمة. وكما يقول مؤشر أداء تغير المناخ، فإنّ «انبعاثات غازات الدفيئة للفرد في السعودية آخذة في الارتفاع على نحو مطرد. ونصيبها من الطاقة المتجددة في إجمالي إمدادات الطاقة الأولية (TPES) يقترب الصفر». وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ للعام 2022 الذي عقد في مصر، «قامت السعودية بدور غير بناء في المفاوضات. وضمّ وفدها جماعات ضغط متنوعة ذات صلة بالوقود الأحفوري. كما حاولت تخفيف حدّة اللغة المستخدمة في القرار الشامل لمؤتمر الأطراف».
في الاجتماع التالي الذي انعقد في دبي في الخريف الماضي، لم تدعُ الوثيقة الختامية بقمة المناخ سوى إلى «الانتقال بعيداً من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050 تماشياً مع العلم». لقد تجنبت الوثيقة العبارة الأكثر أهمية «التخفيض التدريجي» أو «التخلص التدريجي» عندما يتعلق الأمر بالوقود الأحفوري وحتى العبارة الأكثر اعتدالاً «الانتقال بعيداً» لم تٍضمَّن بسبب اعتراضات الرياض الشديدة، وقد قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان: «بالطبع، لا لأي لغة من هذا القبيل». وأضاف: «وأؤكد لكم أنه لا يوجد شخص واحد - وأنا أتحدث عن الحكومات - يؤمن بذلك». وكان تأكيده، بالطبع مجرّد هراء. والواقع أن بعض الزعماء، مثل زعماء دول جزر المحيط الهادئ، يعتبرون أنّ إلغاءً فورياً للوقود الأحفوري ضرورة أساسية لبقاء بلدانهم.
التخلّي عن منطق الخطوات الصغيرة
مع أنّ قادة السعودية ينخرطون في الغسل الأخضر، بما في ذلك إصدار إعلانات دورية عن خطط مستقبلية لتطوير الطاقة الخضراء، فإنهم لم يفعلوا أي شيء تقريباً في هذا الصدد، على الرغم من الإمكانات المهولة التي تتمتع بها السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. والمفارقة هنا أن أكبر إنجاز سعودي في مجال الطاقة الخضراء تحقق في الخارج، بفضل شركة أكوا باور (ACWA Power)، وهي مشروع مشترك بين القطاعين العام والخاص في السعودية. قامت الحكومة المغربية، وهي الحكومة الوحيدة في الشرق الأوسط التي خطت خطوات هامة في مكافحة تغير المناخ، بإحضار أكوا باور كجزء من تجمّع شركات لبناء مجمع «نور للطاقة الشمسية المركزة» بالقرب من مدينة ورزازات القديمة على حافة الصحراء الكبرى. وقد حدّدت هدفاً يتمثل في الحصول على 52% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. وحين أشار النقاد إلى فشلها في تحقيق هدفها في الحصول على 42% بحلول العام 2020، ردّ الداعمون الحكوميون أنه بحلول نهاية العام 2022، سيتم توفير 37% من الكهرباء في المغرب من مصادر الطاقة المتجددة، وقد قفزت هذه النسبة، في العام الماضي فحسب، إلى 40%، بإجمالي إنتاج من مصادر الطاقة المتجددة يبلغ 4.6 غيغاوات من الطاقة.
مع أنّ قادة السعودية ينخرطون في الغسل الأخضر، بما في ذلك إصدار إعلانات دورية عن خطط مستقبلية لتطوير الطاقة الخضراء، فإنهم لم يفعلوا أي شيء تقريباً على الرغم من الإمكانات المهولة التي تتمتع بها السعودية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
علاوة على ذلك، لدى المغرب عدد كبير من مشاريع الطاقة الخضراء قيد التنفيذ، من بينها 20 منشأة أخرى للطاقة الكهرومائية، و19 مزرعة رياح، و16 مزرعة للطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن تولد محطات الطاقة الشمسية وحدها 13.5 غيغاوات في غضون بضع سنوات، أي 3 أضعاف إجمالي إنتاج الطاقة الخضراء الحالي في البلاد. وفي الربع الأول من هذا العام، دخلت مزرعتان ضخمتان للرياح إلى الخدمة، جُهّزت إحداهما بجيل جديد من التوربينات الكبيرة. والحقيقة أنّ توسع البلاد في إنتاج الكهرباء الخضراء منذ أن أطلقت خططها الرؤيوية في العام 2009 لم يقتصر على مساعدتها في اتخاذ خطوات كبرى على طريق إزالة الكربون، بل ساهم أيضاً في كهربة ريفها، حيث أصبحت الكهرباء متوفرة للجميع. وفي العقدين ونصف العقد الماضيين فحسب، زوّدت الحكومة 2.1 مليون أسرة بالكهرباء. ولا يمتلك المغرب كثيراً من الهيدروكربونات، وتوفر الطاقة الخضراء المحلية على الدولة استنزاف ميزانيتها بأعبائها الثقيلة.
بخلاف الهراء الضار الذي كثيراً ما يطلقه المسؤولون السعوديون والإماراتيون، فإن الملك المغربي، محمد السادس، لا يشك مطلقاً بخطورة التحديات التي تواجهها بلاده الفقيرة. وقد قال أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في أوائل كانون الأول/ ديسمبر: «وبالنظر إلى التفاقم الحتمي للتغيرات المناخية، فإن على مؤتمرات الأطراف أن تنأى، اعتباراً من هذه الدورة، عن منطق التدرج البطيء الذي ظل يلازمها لزمن طويل».
لا شك أنّ اتخاذ خطوات كبيرة للوصول إلى شرق أوسط وعالم لا ينتج الكربون من شأنها أن تمثّل تحسناً كبيراً. لكن المؤسف أنّ الإمارات والسعودية، تعمل على رفع حرارة الكوكب بطريقة كبيرة، وتساهم بمزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. والأسوأ أنها تقع في جزء من العالم تكاد أن تكون هذه السياسات المتردية أشبه بلعب لعبة الروليت الروسية بمسدس كامل الذخيرة.
نُشِر هذا المقال في TomDispatch في 16 نيسان/أبريل 2024، وتُرجِم وأعيد نشره في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.


