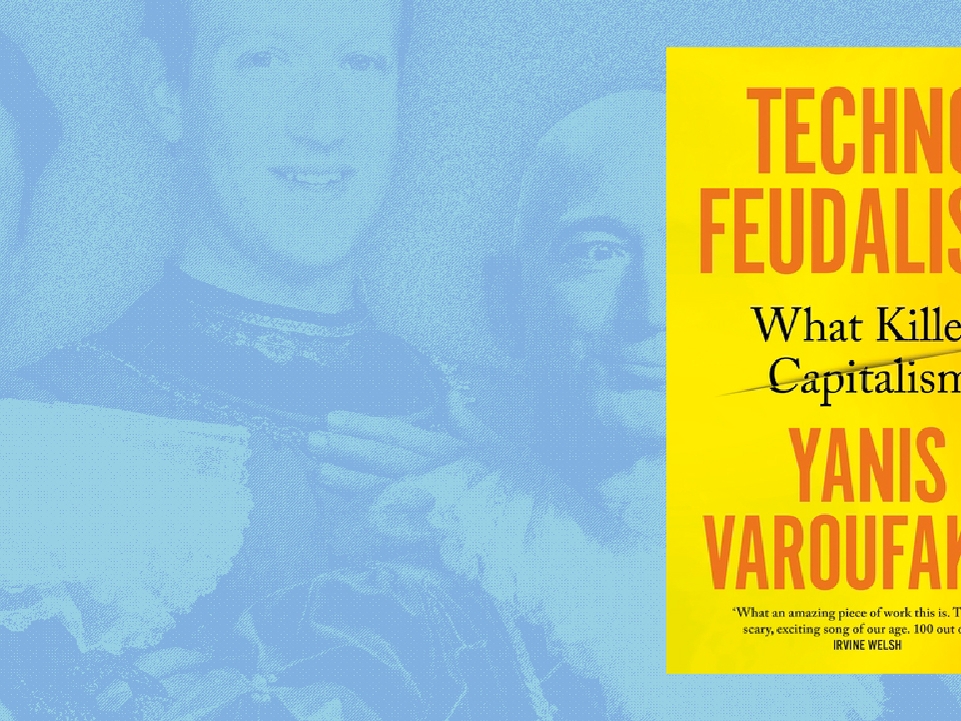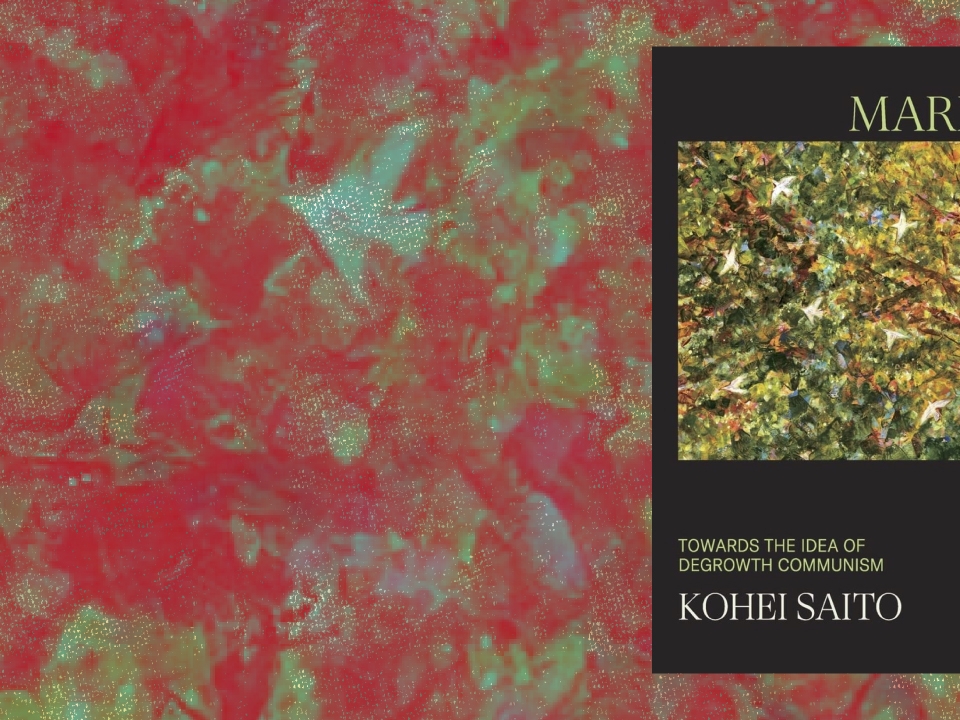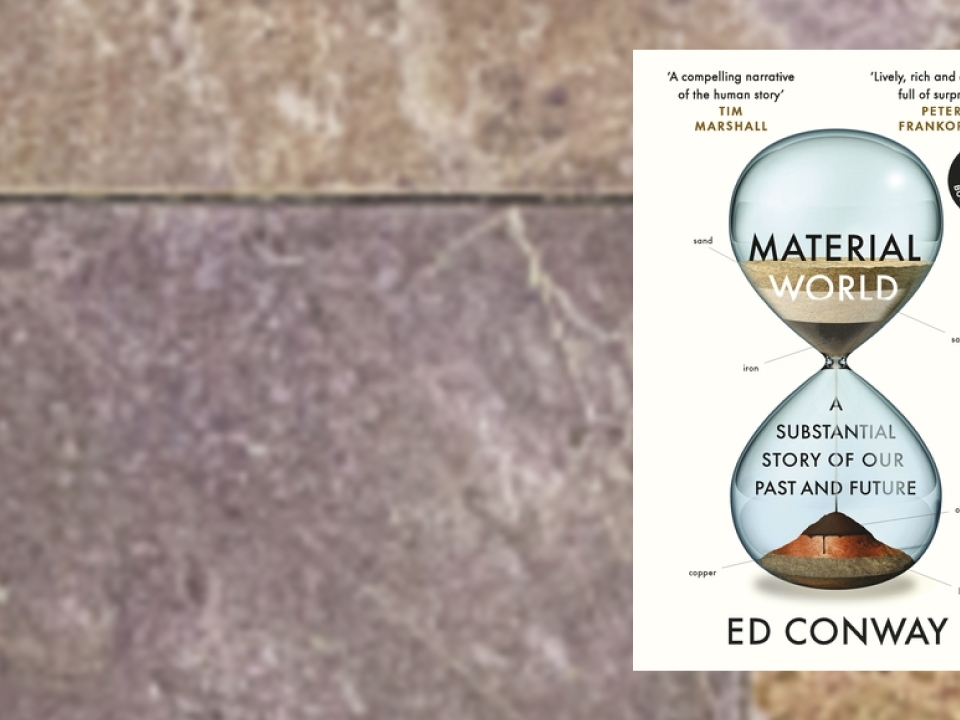ثورة الروبوتات التي لم تبصر النور
- مراجعة لكتاب «نهاية الكدح: كيف تسبّبت وعود الأتمتة بانحطاط العمل» لجايسون ريزنيكوف الذي يجادل بأن الأتمتة خطابٌ تتستّر بعباءته الشركات لكي تعيد تكوين بيئة العمل. وعلى الرغم من تعاظم دور الأتمتة في بلورة هذا الواقع، فإنّ مكانة العمل مرهونة بما يقرّره الساسة وأصحاب الشركات. والتحدّي الحقيقي يكمن في حفظ كرامة العمّال أيّاً كانت الوظيفة.
تحظى الأتمتة بما لها من تداعيات على العمل باهتمام متزايد في الآونة الأخيرة، في ظلّ توقعات تفيد بأنّها ستقضي على عشرات الملايين من الوظائف الأميركية في خلال العقدين المقبلين، وفقاً لمراكز فكر مرموقة مثل مؤسّسة بروكينغز ومعهد ماكينزي العالمي للأبحاث. بدورها، أفرَدَت صحيفة أتلانتيك الأميركية تقريراً خاصاً من ثمانية آلاف كلمة لهذه القضية، تحت عنوان «عالمٌ بلا عمل».
في كتابه «نهاية الكدح: كيف تسبّبت وعود الأتمتة بانحطاط العمل» (Labor’s End: How the Promise of Automation Degraded Work)، يذكّرنا المؤرّخ جايسون ريزنيكوف بأنّ ما نعيشه اليوم ليس إلّا تكراراً لسيناريو راج في أربعينيات القرن الماضي حتى سبعينياته. آنذاك، انشغلت طائفة واسعة من المفكّرين الأميركيين بفرضية مفادها أنّ التكنولوجيا سوف تستبدل العمل اليدوي في غضون فترة وجيزة. فهلّل بعضهم فرحاً لنهاية الكدح وبزوغ فجر الوفرة والراحة، بينما أبدى آخرون قلقهم ممّا يخفيه هذا الوعد من مخاطر تستدعي تدابير جريئة لصون معيشة العمّال ورفاههم. لكنّ الكلّ أجمعوا، ما خلا بعض الاستثناءات، على حتمية هذا التغيير.
وبعد مرور أكثر من خمسة عقود من الزمن، لا يزال السواد الأعظم من عمّال بلدنا يكدحون في وظائف يدوية لقاء أجور زهيدة، بينما لا تنعم إلّا شريحة صغيرة منهم بعيشة ميسورة، وتجني قلّة قليلة ثروات فاحشة. فالعمل اليدوي ما زال منتشراً على نطاق واسع، وإن تبدّلت أشكاله مع الوقت، وباتت تشتمل على وظائف مثل خدمة العملاء أو الرعاية.
لا يزال السواد الأعظم من عمّال بلدنا يكدحون في وظائف يدوية لقاء أجور زهيدة، بينما لا تنعم إلّا شريحة صغيرة منهم بعيشة ميسورة، وتجني قلّة قليلة ثروات فاحشة، فالعمل اليدوي ما زال منتشراً على نطاق واسع، وإن تبدّلت أشكاله مع الوقت
يؤكّد ريزنيكوف في كتابه أنّ ليس في ذلك مفاجأة، فالغرض من «الأتمتة» (يضعها بين علامتَي اقتباس في كلّ الكتاب للتشديد على وجهة نظره) لم يكن أبداً إحداث تحوّلات تكنولوجية تخفّف عبء العمل في عمليات الإنتاج. إنّما هي خطاب تتستّر الشركات بعباءته لتعيد تكوين بيئة العمل. في ظاهرها، تَعِدُنا الأتمتة بثورة في الكفاءة الإنتاجية تقلّص الجهد البشري أو تنفي الحاجة إليه تماماً في المصانع والمكاتب والمنازل. أمّا باطنها فينطوي على تسريع عجلة الإنتاج، والاستغناء عن العمالة الماهرة، وفي حالات كثيرة زيادة المخاطر المهنية، فضلاً عن محاولات أخرى لإضعاف قدرة العمّال التفاوضية من خلال نقل أنشطة العمل إلى مناطق أدنى أجوراً.
أقنع دُعاة الأتمتة العالم بأنّ السبيل الوحيد للتخلّص من العمل البائس يكمن في التغلّب على القيود التي تفرضها الطبيعة. وإذ أقرّ منتقدو الأتمتة بصحّة هذا التحليل، شدّدوا على مبدأ الإنصاف في توزيع الوظائف المتبقية والمردود الوفير الذي تدرّه التطوّرات التكنولوجية. وبذلك، حجب الطرفان النظر عن الطرق التي تُسهم من خلالها السلطة والسياسة في إعلاء مكانة العمل أو انحطاطها. فهل هوس الأتمتة الذي نشهده اليوم يُعيد تشتيت انتباهنا عن الواقع؟ سأعود إلى هذا السؤال في نهاية هذه المراجعة.
يَنسِب ريزنيكوف كلمة «أتمتة» إلى د.س. هاردر، نائب رئيس شركة فورد لشؤون الإنتاج آنذاك، على اعتبار أنّه أوّل من استخدمها في العام 1946. وكما هو الحال بالنسبة للعديد من المصطلحات التي راجت على نطاق واسع، يدّعي كثيرون أنّهم أوّل من استخدم مصطلح «أتمتة»، أشهرهم المُبتكر في مجال الإلكترونيات جون دايبولد في كتابه الصادر في العام 1952 بعنوان «الأتمتة: بزوغ عصر المصنع الآلي» (Automation: The Advent of the Automatic Factory). يوثّق كتاب نهاية الكدح حجم التأييد الذي حظي به هذا المفهوم وبعضاً من جوانب الرؤية المستقبلية التي انطوى عليها، خصوصاً وأنّ التأييد جاء من شخصيات مؤثّرة شديدة التنوّع، أبرزهم عالم الاجتماع دانييل بيل، ورئيس نقابة عمّال مصانع السيّارات المتّحدة (United Auto Workers) والتر روثر، وعالم الكمبيوتر نوربرت واينر، فضلاً عن رؤساء أميركيين أمثال جون ف. كينيدي وليندون ب. جونسون، ومفكّرين راديكاليين مثل هيربيرت ماركيوز. وكاتبنا ينجح في إيصال هذا التعدّد في الآراء الذي لم يخلُ من بعض الأصوات المُناهضة، وذلك من خلال التنقّل بين دراسات حالة عن تطبيق الأتمتة (في تصنيع السيّارات وتعدين الفحم الحجري وتعبئة اللحوم والأعمال المكتبية والمنزلية) ومناظرات فكرية طغت عليها قناعة بأنّ العمل اليدوي يندثر بسرعة («هل ينسجم مفهوم الحرية مع الرأسمالية الصناعية؟»، «هل ما زالت الطبقة العاملة قوّة الدفع الرئيسية للتحول الصناعي؟»).
يقدّم الكتاب أربع قراءات لافتة تُثري فهمنا لواقع العمل في الولايات المتّحدة في أواخر القرن الماضي، وتسلّط كلّ منها الضوء على وضعنا الراهن. أوّلاً، يفكّك ريزنيكوف ببراعة الممارسات التضليلية التي لجأ إليها الصناعيون الأميركيون لإغراء العمّال، فقد وعدوا بتخفيف أعباء العمل بواسطة التكنولوجيا في حين كان هدفهم الأساسي تسريع العمل من دون أي مقابل للعمّال. هذه الفكرة ليست بجديدة، فقد توصّل إليها هاري بريفرمان في كتابه بعنوان «العمل ورأس المال الاحتكاري» (Labor and Monopoly Capital) الذي قدّم تحليلاً مُقنعاً أعاد تشكيل الحوار الدائر وقتذاك. ويستشهد ريزنيكوف في طروحاته بمؤلفات لمؤرّخين متخصّصين بالعمل يشاطرونه الرأي. لكن ما يميّز هذا الكتاب هو نجاح ريزنيكوف في إبراز التناقض الحادّ بين الخطاب الاستعلائي للمديرين التنفيذيين أمثال دايبولد في وصف إنجازات الأتمتة، والشهادات الواقعية لعمّال المصانع والموظفين المكتبيين الذين يوثّقون فيها إجهادهم البدني ومعاناتهم مع شتّى ضروب الإرهاق النفسي كالقلق والتبرّم.
باطنها فينطوي على تسريع عجلة الإنتاج، والاستغناء عن العمالة الماهرة، وفي حالات كثيرة زيادة المخاطر المهنية، فضلاً عن محاولات أخرى لإضعاف قدرة العمّال التفاوضية من خلال نقل أنشطة العمل إلى مناطق أدنى أجوراً
ثانياً، يكشف لنا الكتاب التضافر الخطابي بين النقاشات التي تناولت الأتمتة في أواخر القرن العشرين والجدل التاريخي بشأن العمل في الولايات المتّحدة والعالم. ولعلّ أبرز محطّاته كانت الجدل الذي حصل بين توماس جيفرسون وألكسندر هاميلتون بشأن إشكالية دمج الرخاء الاقتصادي بمبادئ الديمقراطية والحرية في بلدهم المستقل حديثاً. فمن جهته، رأى جيفرسون، الذي للمفارقة كان أحد كبار ملّاك الأراضي والرقيق، أنّ صون الديمقراطية يتحقق من خلال «جمهورية اليومَن» (yeoman أي الفلاحين والملاّك الصغار) التي يتألف قوامها من مزارعين صغار ومنتجين مستقلين بوسائل إنتاج شبه متكافئة وبتدخّل محدود من الحكومة يستند نطاقه إلى التشاور بين هؤلاء. أمّا هاميلتون فشدّد على أنّ التطور الاقتصادي مرهون بالتحوّل الصناعي، وبالتالي تدخّل أوسع من الحكومة لدعم القطاعات وتنظيمها، وهو ما كان يخشاه جيفرسون بحجّة أنّ التطوّر الصناعي سيُفضي إلى تركّز القوة الاقتصادية وإعادة إنتاج نموذج «المطاحن الشيطانية» البريطانية الذي يُفرز طبقة عاملة بائسة وجاهلة وفاسدة الأخلاق. وبالطبع، اعتبر كارل ماركس أنّ الحلّ هو بسط سيطرة الطبقة العاملة الجماعية على وسائل الإنتاج. وقد تبنّت شرائح واسعة من الطبقة العاملة الأميركية شكلاً من أشكال نظرية ماركس إبّان حركاتها النضالية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي سعياً منها لبناء قوّتها. ويفترض ريزنيكوف أنّ دُعاة الأتمتة طرحوا حلّاً مغايراً يقوم على استغلال التقنيات الجديدة المتاحة للتخلّص من كلّ تلك الوظائف الصناعية البائسة ونقل العمّال إلى وظائف مكتبية مُريحة ونظيفة.
لكنّ ريزنيكوف يؤكّد كذلك أنّ الأتمتة وعدت بحلّ معضلة فلسفية قديمة العهد. فبحسب أرسطو، ينبغي للبشر ممارسة العمل المُجهِد والمملّ ليتمكّنوا من الصمود والاستمرار، غير أنّه أقرّ بأنّ المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية يجب إعفاؤهم من الكدح غير اللائق نظراً لقدرتهم على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات المهمة، فيما يتعيّن على من هم دون هذا المستوى الانخراط في الأعمال البدنية الشاقة، من منطلق أنّهم الأقدر عليها (بما يتماهى مع تركيبة المجتمع الإغريقي القديم المكوّن من مواطنين وعبيد). وهنا يحيلنا خطاب الأتمتة مجدّداً إلى ضرورة التخلّص من المشقّة في العمل وتحويل العمّال إلى وظائف تتطلّب مهاراتهم الفكرية والإبداعية. وفي حين استخفّ رؤساء الشركات من أمثال دايبولد بالصعوبات التي يطرحها هذا التحوّل، ملمحّين إلى أنّه سيحدث تلقائياً إلى حدٍّ ما، أعرب آخرون عن قلقهم إزاءه، بينهم والتر روثر وويلارد ويرتز، وزير العمل في إدارة الرئيس كينيدي آنذاك، مُشدّدين على أنّ نجاح التحوّل مرهون بإقرار سياسات وطنية فعّالة لإعادة تأهيل العاملين وإعادة توزيع عائدات الإنتاجية. أمّا بالنسبة للمحافظين التقليديين، فقد ظلّوا متمسّكين بنهج أرسطو، قائلين بأن السبيل إلى رخاء المجتمع لا يكمن في التسامي عن العمل بل في العودة إلى القيم والتراتبيات المُجرّبة التي فُقدَت في خضمّ موجة الحداثة.
ثالثاً، يكشف لنا كتاب نهاية الكدح أن شريحة واسعة من حركة اليسار الجديد في ستينيات القرن الماضي كانت مقتنعة بأنّ الأتمتة تؤدي إلى تبخّر العمل الصناعي بصورة حتمية وسريعة. ومن الأدلّة التي يعرضها ريزنيكوف على ذلك كتابات الفيلسوف النيو-ماركسي هربرت ماركيوز، فضلاً عن الفيلسوف اللاسلطوي البيئي موري بوكتشين، والمفكّر الاشتراكي الأميركي من أصول أفريقية كارل بوغز. ولعلّ الدليل الأبرز كان مشهد قائدَي منظمة «طلاب من أجل مجتمع ديموقراطي» تود غيتلين وتوم هايدن وهما يدعوان منتسبيهم لتنظيم حشود من العمّال المُسرّحين، فقط ليستنتجان في النهاية، وبحسب كلمات غيتلين المحبطة «فشلنا ولا زلنا نفشل في إثبات الأثر الكمّي للأتمتة».
وأخيراً، يعرض ريزنيكوف أوجه شبه مثيرة للاهتمام بين النظرة اليسارية لمستقبل العمل والانتقادات النسوية للكدح المنزلي. ففي كتاب اللغز الأنثوي (The Feminine Mystique)، تؤكّد الكاتبة النسوية الليبرالية بيتي فريدان أنّ الأتمتة استولت على معظم مهام العمل المنزلي، تاركةً ربّات المنازل منشغلات بأعمال تلهية فارغة، بعد أن كان التدبير المنزلي عملاً ذا قيمة. أمّا المفكّرة النسوية الراديكالية شولاميث فايرستون فقد رحّبت بالأتمتة على اعتبار أنّها المخلّص المنتظر للمرأة، مناديةً بثورة «تعيد توزيع الكدح بشكل عادل، قبل التخلّص منه نهائياً» من خلال «أتمتة» الأعمال المنزلية، بما في ذلك الإنجاب بحدّ ذاته. بعبارة أخرى، افترضت الكاتبتان أنّ الأتمتة ستنفي الحاجة إلى العمل المنزلي المجهد. وبالطبع، فاتت ريزنيكوف فكرة أنّ المحافظين الثقافيين والدينيين أصرّوا على أنّ رفاه المرأة لا يتحقق بأتمتة مهامها المنزلية لتتفرّغ لأنشطة أكثر تحفيزاً، بل بتقبّلها لدورها «الطبيعي».
تبنّت شرائح واسعة من الطبقة العاملة الأميركية شكلاً من أشكال نظرية ماركس إبّان حركاتها النضالية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي سعياً منها لبناء قوّتها
لم تقتصر مناهضة الأتمتة على المحافظين. فمن بين أبرز الأصوات المعارضة التي أوردها كتابنا – وإن بالمرور عليها سريعاً – قادة حركة الحقوق المدنيّة الأميركيّة الأفريقيّة، فهم بدلاً من الانقياد لفكرة أنّ الأتمتة ستقضي على الوظائف الوضيعة، طالبوا بأن يستثمر المجتمع الأميركي في الأعمال البسيطة التي تدرّ قيمة اجتماعية ومردوداً اقتصادياً. لذلك، نجد أنّ مارتن لوثر كينغ دعم إضراب عمّال النظافة في ممفيس في العام 1968 مؤكّداً أنّ «كل الأعمال فيها كرامة». وفي الفترة نفسها تقريباً، طالب قائد منظّمة حقوق الرعاية الوطنية جوني تيلمون بإصدار إعلان رئاسي بأنّ «عمل النساء عمل حقيقي»، قائلاً إنّه يجب أن تحصل كلّ الأمّهات على أجر لقاء «القيام بالعمل الذي نقوم به فعلاً، أي تربية الأطفال والتدبير المنزلي».
يقدّم ريزنيكوف في كتابه مُطالعةً مستنيرة لتاريخ الأتمتة مدعومةً بوفرة من الأدلّة، إلّا أنّ كاتبنا يبالغ أحياناً في طرحه. وتتّضح هذه المبالغة في تلميحه إلى أنّ الأتمتة لم تكن إلّا وسيلة اعتمدها أصحاب الشركات لمجرّد التخلّص من طرق الإنتاج القديمة وتسريع العمل، وأنّ الكفاءة الإنتاجية لم تكن أبداً ضمن حساباتهم. وعلى الرغم من اعترافه في أكثر من موضع بأنّ الإنتاجية شهدت تحسينات فعلاً - خصوصاً في خاتمة الكتاب: «نعم، تستطيع الآلة تخفيف عبء العمل البشري اللازم لإنتاج السلع» – يظلّ من الصعب إدراك ذلك وسط وابل الحجج التي تُثبت العكس.
لا يمكن إنكار أنّ الأتمتة عزّزت الإنتاجية على نطاق واسع. فلنأخذ قطاع الاتصالات مثالاً ولنفترض أنّ كلّ مكالمة هاتفية (أو عبر «سكايب» أو «زوم») ما زالت تستلزم عاملاً أو اثنين لتحويل الاتصال يدوياً على مقسم (أو بدالة) الهاتف. في هذه الحالة، كنّا سنشهد أحد هذين السيناريوهين في زمننا الحالي: إمّا عدد أقل من المكالمات أو توظيف شريحة ضخمة من عمّال العالم كعاملي اتصالات. ولكننا لسنا بحاجة لهذه التجربة الفكرية وتجربتي الشخصية تكفي. ففي العقود الأخيرة، انتقلت من العمل على مقسم هاتف شبه آلي (بالضغط على مفاتيح لتحويل المكالمات) في الثمانينيات، إلى زيارة مراكز اتصال تحوّل المكالمات آلياً في التسعينيات، ثم إلى استخدام مُتّصل آلي (تلقائي) و«سكايب» في العقد الأوّل من الألفية، وصولاً إلى إجراء الاتصالات عبر تطبيق «زوم» في العقد الثاني من الألفية.
وهذا التحوّل ينطبق على قطاع الصناعة. وبمكننا هنا قياس الإنتاجية الصناعية بطريقة بسيطة من خلال النظر إلى تطوّر نصيب العامل الصناعي من القيمة المضافة المُعدّلة بالتضخم مع الوقت، بالجمع بين بيانات من مكتب إحصائيات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي. وفقاً لحساباتي، فإنّ هذا المقياس لمخرجات العامل الصناعي الواحد شهد زيادة فاقت الضعف بين 1947 و1974، ثمّ مجدّداً بين 1974 و1997. ويُعزى جزء من ذلك إلى التغيّرات التي طرأت على المزيج التصنيعي (بحيث تراجع تصنيع الملابس وزاد تصنيع الرقائق الإلكترونية مع مرور الوقت في ظلّ إعادة توزيع العمالة العالمية)، والجزء الآخر إلى التسريع الذي تحدّث عنه ريزنيكوف، ولكنّ الغالبية تعكس بلا شكّ تطوّر إنتاجية التقنيات المستخدمة. وبالنسبة لتجميع السيارات، وهو المثال المفضّل لريزنيكوف، ازدادت المهام المُسندة إلى الروبوتات منذ الثمانينيات، وهي مهام كان البشر يقومون بها سابقاً. والأنماط ذاتها نراها في إنتاج الصلب وتعدين الفحم، حيث أسهمت تقنيات مبتكرة – مثل المصانع المصغّرة والتعدين بالحفرة المكشوفة على التوالي – في رفع الكفاءة بشكل ملحوظ (وإن كان المنتج النهائي أقل جودة في الحالتين).
ولكن كيف يتوافق ذلك مع الأدلّة التي جمعها ريزنيكوف لإثبات أنّ إدخال المعدّات الجديدة زاد عدد العمّال أو أبقى على العدد نفسه؟ تنقسم الإجابة إلى شقّين. الشقّ الأوّل يستند إلى ملاحظة الخبراء الاقتصاديين بأنّ تركيب معدّات أكثر كفاءة يمكن أن يؤثر على عدد العاملين من خلال «الاستبدال» و«المخرجات» في الوقت عينه. فما يُسمّى بتأثير الاستبدال يشير هنا إلى استبدال اليد العاملة بالآلات، ما يؤدي إلى انخفاض عدد العاملين. أمّا تأثير المخرجات فيعني أنّه عندما تقلّل الآلات والمعدات تكاليف الإنتاج، تميل أسعار المنتجات إلى الانخفاض ويشتري المستهلكون أكثر، وبالتالي يزداد عدد العاملين. وإن فاق تأثير المخرجات تأثير الاستبدال، يؤدي استبدال العمّال بالآلات إلى ارتفاع التوظيف. بالنسبة للشقّ الثاني من الإجابة، فاعتماد التقنيات الجديدة ينطوي دوماً على منحنى تعلّمي، أي أنّه وفي المراحل الأولى من العملية، غالباً ما تفشل الأنظمة الجديدة وتتعطل الآلات، ولكنّ العمال والمديرين يتعلّمون مع الوقت كيفية تشغيل التقنيات لتؤدي وظائفها بكفاءة (وإلّا تُضطر الإدارة عادةً إلى سحبها من الخدمة).
مارتن لوثر كينغ دعم إضراب عمّال النظافة في ممفيس في العام 1968 مؤكّداً أنّ «كل الأعمال فيها كرامة». وفي الفترة نفسها تقريباً، طالب قائد منظّمة حقوق الرعاية الوطنية جوني تيلمون بإصدار إعلان رئاسي بأنّ «عمل النساء عمل حقيقي»، قائلاً إنّه يجب أن تحصل كلّ الأمّهات على أجر لقاء «القيام بالعمل الذي نقوم به فعلاً
على الرغم من أنّ إنكار ريزنيكوف لمبدأ الإنتاجية القائمة على التكنولوجيا لم يكن في محلّه، فهو أصاب عندما قال إنّ الشركات استغلّت وجود الآلات الجديدة لتغيير الأوصاف الوظيفية وإدخال عنصر السرعة على العملية الإنتاجية. فالشركات اعتادت تطبيق «عقيدة الصدمة»، مستخدمةً المكننة لتبرير إعادة صياغة قواعد العمل. هذا الواقع خلق موجة استياء في صفوف العمّال، وجعل ريزنيكوف ينهي مطالعته التاريخية في أوائل ومنتصف السبعينيات. ففي هذه الفترة، ضاق العمّال العاديون ذرعاً من تسريع عملهم بلا مقابل، وتدهور ظروفهم، والاستغناء عن مهاراتهم بسبب الأتمتة، فلجأوا بالتالي إلى الإضرابات والتخريب والعزلة على نطاق واسع. وبين حقيقة أنّ العمل الصناعي (إلى جانب المكتبي والمنزلي) كان أبعد ما يكون عن الاندثار، وحقيقة أنّ الأتمتة لا تؤدّي إلى تحسين ظروف العمّال، تحطّم لغز الأتمتة.
لم يكن ذلك آخر فصل من فصول حكاية الأتمتة. يذهب ريزنيكوف إلى وصف واقعنا الحالي بأنّه الموجة الثالثة من خطاب الأتمتة (بعدما امتدّت الثانية من أواخر الثمانينيات إلى مطلع التسعينيات). وعند البحث في المنشورات التي تتناول التطوّر التكنولوجي ودوره في إعادة تشكيل وظائف تجارة التجزئة، نجد أنّ الصحافة التجارية في أيامنا تعجّ بمقولات تجد صداها في كتاب نهاية الكدح، مثل هذه (من RIS News: «يواجه عدد متزايد من تجّار التجزئة الذين يعتمدون الأتمتة خطر المقاومة من موظفيهم... ينبغي للشركات توفير ضمانات وتوضيح ما يقدمونه – رحلة جديدة مشوقة تتطلب مشاركة الموظّف». يطغى على النقاشات الحالية بشأن التكنولوجيا والعمل الافتراضات الخاطئة نفسها التي يفنّدها ريزنيكوف في كتابه: التغيّر التكنولوجي يتطور من تلقاء نفسه وينتشر بلا رادع؛ التكنولوجيا وتطبيقاتها في العمل لا تخضع للاعتبارات السياسية.
مع ذلك، هناك فارق مهمّ بين خطاب الأتمتة في منتصف القرن العشرين والخطاب الحالي: التفاؤل الذي ساد في البداية تبدّد وحلّت محلّه مخاوف واسعة. فبدلاً من التفاؤل ببزوغ عصر الروبوتات وما يحمله لنا راحة ورفاهية، بتنا الآن نخشى ما ينتظرنا من زعزعة كبيرة تتطلّب منا التحرّك بسرعة لاستيعاب تداعياتها. ومن أبرز مقترحات المعالجة المطروحة برامج إعادة التأهيل والتدريب الواسعة (التي يروّج لها التيار الاقتصادي السائد وصنّاع السياسات الليبراليون الذين يتبعونه) أو الانقضاض على المهاجرين أو المنافسين الأجانب بذريعة أنّهم يسرقون «وظائفنا» (بحسب وصفة اليمين المؤيّد للرئيس السابق ترامب)؛ وفي كلتا الحالتين، نحن أمام حلول بلا جدوى.
تكمن مشكلة السرديّتين في أنّهما تفترضان أنّ الأتمتة قادمة لا محالة بغض النظر عمّا نفعله، وهذا ما يحذّر منه ريزنيكوف، في حين أنّ البشر هم من يقرّرون أيّ تقنيات يجب تطويرها وأيّ منها تُستخدم وكيف. هذا الوضوح في الرؤية يتيح لنا الابتعاد عن خيارات السياسة الضيّقة والشروع في بلورة نظرة تقدّمية لكيفية إعادة تكوين بيئة العمل. كان مارتن لوثر كينغ محقّاً عندما أصرّ على مبدأ حفظ الكرامة مهما كانت الوظيفة. وهذا ممكن إذا رفعنا الحدّ الأدنى للأجور وظروف العمل، ومنحنا العمّال مجالاً أكبر للتعبير عن آرائهم من خلال النقابات وغيرها من المنظّمات، وأعدنا تصميم الوظائف على نحو يستفيد من مهارات شاملة ويتضمن مهاماً متنوعة. ففي ألمانيا مثلاً، خضع معظم العاملين في قطاع التجزئة إلى التدريب عن طريق برنامج تلمذة مهنية مدّته عامين، وباتوا مؤهلين للقيام بأي مهمة داخل المتجر، ويستفيدون من عقد وطني فاوضت عليه نقابة عمّال التجزئة وجمعية شركات القطاع – وهذا مختلف تماماً عن وضعنا في الولايات المتّحدة. وكان ما طرحه تيلمون مبرراً عندما طالب بمقابل للعمل الرعائي غير المأجور الذي يدرّ قيمة اجتماعية. ولا بدّ لنا من توسيع نطاق هذا المطلب ليشمل أنواعاً أخرى من الأعمال ذات القيمة الاجتماعية، مثل بناء المجتمعات، وفقاً لما طرحته الخبيرة الاقتصادية نينا بانكس وغيرها من الاقتصاديين. كما لا بدّ لنا من الاقتداء بكينغ في مطالبته بدخل كفاف سنوي مضمون، في إطار خطوة نحو فصل مصدر الدخل عن العمل أو الملكية ومنح العمّال ضمانةً تسمح لهم برفض الوظائف الوضيعة والإصرار على ظروف عمل أفضل.
تزوّدنا المطالعة التاريخية في كتاب نهاية الكدح بمعلومات تمكّننا من دحض الادعاءات الخاطئة بشأن الأتمتة والمطالبة ببيئة عمل تمنح العمّال درجة أكبر من التأثير والكرامة والرخاء. يوجّه تحليل ريزنيكوف الاستقصائي نظرنا بعيداً عن الجانب السطحي للتقنيات الجديدة ويصوّبه نحو العنصر الأهم في المعادلة، ألا وهو العمّال.
نشرت هذه المراجعة في مجلة catalyst.