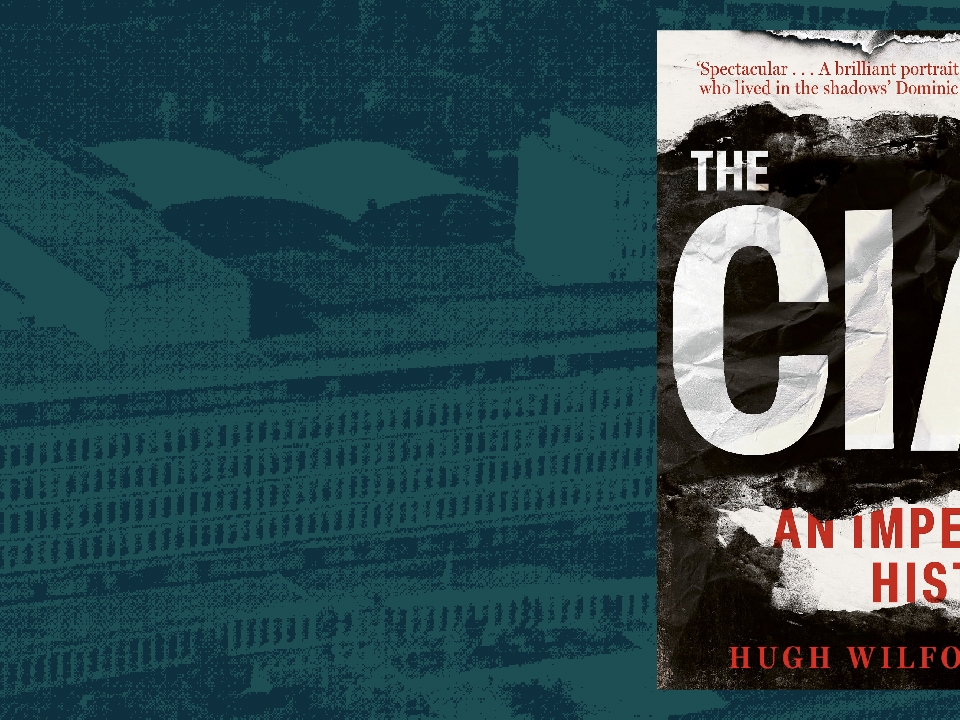مصفوفات الإمبراطورية
أعلن دونالد ترامب، عقب إصداره الأوامر باختطاف نيكولاس مادورو، أنّ الولايات المتحدة تعتزم الآن «إدارة» فنزويلا، وقال: «لن يكلفنا شيئاً... بحكم الثروات الهائلة الكامنة في باطن الأرض... سوف تدخل شركات النفط وتضخ استثماراتها. ونسترد النفط الذي كان من الواجب - بصراحة - استرداده منذ أمد بعيد. نحن على موعد مع تدفقات مالية ضخمة من باطن الأرض».
قديماً، حين كانت واشنطن تتذرّع بالدوافع الإنسانية أو الديمقراطية أو الحرية، كان لزاماً علينا - نحن المشتغلين بالاقتصاد السياسي - إماطة اللثام عن مآربها المُستترة، وكشف المصالح المادية الكامنة خلف الهالة الإعلامية المضلّلة. أما اليوم، وكما كتب تي جي كلارك، فيبدو أنّ النفاق السياسي نفسه بات تحت التهديد. لئن أضحى نهب الموارد الإمبريالي أمراً يجاهر به أصحابه، فماذا يتبقى لنا لنحلّله؟
انصبت معظم السجالات الدائرة عن الهجوم الأميركي على التساؤل عما إذا كان النفط الدافع المحرّك فعلياً لهذا التحرّك. يرى فريق أنّ استخراج النفط الفنزويلي الثقيل مكلف للغاية، ما يجعله عديم الجدوى الاقتصادية للشركات الأميركية، لا سيما في ظل واقع السوق الراهن واستبعاد حدوث طفرة في الأسعار في المدى المنظور. وفي المقابل، يلفت فريق آخر الأنظار إلى أنّ قرابة نصف احتياطيات فنزويلا ليست من النوع الثقيل الموجود في حزام أورينوكو، ويزعم هذا الفريق وجود فرص واعدة لتحقيق «مكاسب سريعة» لكبرى شركات النفط والخدمات البترولية في حقول حوضي ماراكايبو وموناغاس.
وفي كلتا الحالتين، توجد دوافع وجيهة أخرى قد تفسر هذا العدوان الأميركي. يمكننا قراءته بوصفه استيلاءً على الموارد لا ينطلق من رؤية إستراتيجية بعيدة المدى، بل من كونه فعل ابتزازٍ عارض يصب في مصلحة أطرافٍ بعينها داخل تحالف النخبة المحيط بترامب - نهب فنزويلا لسداد تعويضات واهية تطالب بها شركات مثل كونوكو فيليبس وإكسون موبيل مثلاً، أو لخدمة مصافي النفط الأميركية المتخصصة في تكرير الخام الثقيل. ومن زاوية أخرى، قد لا يعدو هذا التحرك كونه استعراضاً موجهاً للداخل، غايته استنهاض قواعد ترامب واليمين اللاتيني التي دأبت على المطالبة بتغيير الأنظمة في كوبا وفنزويلا برعاية أميركية.
لعل الستار ينزاح عن خفايا هذا المشهد مع تطورات الأوضاع في فنزويلا في الشهور المقبلة، بيد أنّ السؤال عندي الآن ينصب على العلاقة بين تلك العملية العسكرية وسياسة احتواء الصعود الصيني المتبعة منذ أمد بعيد. ينبغي لنا هنا عدم الاكتفاء بتقييم التبعات المباشرة للهجوم وكفى، بل علينا أيضاً رصد الرسالة التحذيرية إلى أرجاء أميركا اللاتينية قاطبة. فبجانب الرسوم الجمركية والرقابة على الاستثمارات الأجنبية وقيود التصدير، يمكن قراءة إحياء عقيدة مونرو بوصفه ركيزة جديدة ضمن استراتيجية مناهضة الصين التي تنتهجها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء منذ أزمة 2008 المالية. لئن عَدّ كثيرون اختطاف مادورو ضرباً من الجنون، فإنّنا قد نستشف من ثناياه ملامح نهجٍ معين.
وقبل الوقوف على هذه الفرضية، لا بد من كلمة عن فنزويلا ذاتها. لا يرمي هذا المقال إلى وزن نقاط قوة الحكومات البوليفارية وضعفها، فثمة شواهد يضيق الحصر بها على أنّ الآمال النابعة من صعود هوغو شافيز قد خبت منذ زمن بعيد، وأن ما جنته خيارات مادورو بالتوازي مع العقوبات الخارجية قد بلغ مبلغاً مأساوياً. لكن غني عن البيان أنّ الهجوم الأميركي لن يزيد الأزمة إلا سوءاً، وما تاريخ سياسات «تغيير الأنظمة» من العراق وأفغانستان إلى ليبيا وما بعدها إلا شاهد على ذلك. ولقد أسهب البيت الأبيض نفسه في الحديث عن جني النفط الفنزويلي أكثر من حديثه عن تحرير شعب فنزويلا، وكأنّه يقر بعدم صلاحية أوهام إدارة بوش في العام 2026.
نصفنا من الكرة الأرضية»
لم تلبث وزارة الخارجية الأميركية أن نشرت على منصة تويتر، بعد 3 أيام من الهجوم على كاراكاس، صورةً لترامب بالأبيض والأسود ممهورةً بعبارة: «هذا نصفنا من الكرة الأرضية». فالوزارة ليس لها بالمواربة والمراعاة. ولم يكن هذا بالخبر المفاجئ لمن طالع إستراتيجية الأمن القومي الصادرة عن البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وفيها ورد «تذييل ترامب» على عقيدة مونرو. أبصرت هذه العقيدة النور في العام 1823، إبان موجة التحرّر من الاستعمار التي اجتاحت أميركا اللاتينية، وأرست مبدأً مفاده أنّ تدخل القوى الأجنبية في أي بقعة من هذا الشطر من العالم بمثابة تهديد للأمن الأميركي. ومع أنّ هذه العقيدة ظلت تفتقر لآليات التنفيذ الفعلي حتى أواخر القرن التاسع عشر، غدت منذ ذلك الحين مسوغاً لمختلف صنوف التدخلات العنيفة: من بنما إلى كوبا، وصولاً إلى الانقلابات العسكرية التي رعتها وكالة الاستخبارات المركزية في الستينيات والسبعينيات. ولقد كانت فنزويلا نفسها هدفاً لمحاولات فاشلة لتغيير النظام في العامين 2002 و2019.
تزعم إستراتيجية ترامب للأمن القومي ضرورة بعث عقيدة مونرو من جديد بعدما «طواها الإهمال لسنوات». ومن بين أهدافها المعلنة كبح جماح «الهجرة الجماعية صوب الولايات المتحدة». ومن بين أهدافها الأخرى إخراج الصين من أميركا اللاتينية: «نصبو إلى نصف كرة أرضية يظل بمنأى عن أي تغلغل أجنبي معادٍ أو استحواذ على أصول حيوية، وبما يضمن دعم سلاسل التوريد الإستراتيجية؛ ونسعى لتأمين وصولنا المستمر إلى المواقع الاستراتيجية الكبرى».
كما يولي تذييل ترامب أهمية قصوى لضرورة التنسيق بين واشنطن وحكومات أميركا اللاتينية لمجابهة من يُوصفون بـ«إرهابيي المخدرات والعصابات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود»؛ ومن هذا المنطلق جرى تلفيق تهم تهريب المخدرات لمادورو. وقد عمدت الحكومات اليمينية في المنطقة، في السنوات الأخيرة، إلى إدراج المنظمات الإجرامية بازدياد على قوائم الإرهاب، لتجعل منها أهدافاً مشروعة للتدخل الأميركي بموجب اتفاقية بربادوس. وفي البرازيل، ذهب نجل بولسونارو الأكبر إلى حدّ الإعراب عن تطلّعه لرؤية القصف الأميركي للقوارب في منطقة الكاريبي يتكرّر قبالة سواحل ريو دي جانيرو. لئن شاء أي عمل عسكري أميركي مستقبلي الحصول على غطاء قانوني - مهما كان واهياً - سيجد مسوغه لا محالة في التشريعات الجديدة لمكافحة إرهاب المخدرات.
الصين وأميركا اللاتينية
ليس من قبيل الأوهام الترامبية القول بأنّ الصين، ذلك «المنافس القادم من خارج القارة»، قد وطدت أواصر صلاتها بأميركا اللاتينية على مدار العقدين الماضيين. فمع تحول العملاق الآسيوي إلى ورشة العالم وبسط هيمنته على شبكات الإنتاج في شرق آسيا، بات يعوّل في نهضته على إمدادات هائلة من المعادن والوقود والمحاصيل الزراعية. وقد أفضى ذلك إلى زيادة أسعار المواد الأساسية - ما يُعرف بالدورة السلعية الكبرى - ليعيد بذلك صياغة دور الكثير من دول الجنوب العالمي في خارطة التقسيم الدولي للعمل. وفي هذا الصدد، أدت أميركا الجنوبية، بنزوعها نحو تصدير المواد الأولية، دوراً مفصلياً في هذه العملية.
إبان تلك الحقبة، لم تسلم حتى أكثر الدول رفعاً لحصة المنتجات المصنعة ضمن صادراتها من الانزلاق السريع نحو النهج الاستخراجي. ففي خلال العقد الأول من الألفية، شكّلت الصادرات الصناعية في المتوسط 50% من إجمالي صادرات البرازيل، و35% في كولومبيا، و32% في الأوروغواي. وبإمعان النظر في إحصاءات العقد الثاني، نجد أنّ هذه الأرقام قد تهاوت لتصل إلى 33% و20% و22% على التوالي. ولا يقتصر هذا التحول الجذري على طبيعة السلع، بل يمتد ليشمل وجهتها؛ ففي حالة أميركا الجنوبية ككل، قفزت حصة الصادرات المتجهة إلى الصين من نحو 2% في أواخر التسعينيات إلى قرابة الربع منذ العام 2019، وسجلت الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة تراجعاً موازياً. وهكذا، أخذت أميركا الجنوبية تكرّس دورها كمورد للمواد الأولية ذات القيمة المضافة المحدودة لشبكات الإنتاج الصينية.
تتبلور ملامح هذه الدينامية بجلاءٍ أكبر عند النظر في سلع بعينها. فمنذ العام 2004، استأثرت أميركا الجنوبية في المتوسط بنحو 35% من صادرات خام النحاس العالمية. لم تكن واردات الصين من هذا المعدن تتجاوز 10% في العام 2000، لكنّها قفزت إلى 62% بحلول العام 2023. وعلى الرغم من التراجع النسبي لحصة القارة في صادرات خام الحديد مؤخراً، لا تزال ترفد السوق الدولية بأكثر من خُمس الإنتاج الكلي؛ وتستقطب الصين وحدها منذ العام 2019 ما يفوق ثُلثي تجارة الحديد المتداول دولياً. وعلاوةً على ذلك، تتركز المعادن المصيرية لمستقبل تقنيات الطاقة المتجددة - كالليثيوم والنيكل والمعادن النادرة - بكثافةٍ في أميركا اللاتينية. وبحسب توصيف هيلين تومسون، «تبدأ ثورة الطاقة العالمية المرتقبة بالتجلي كصراع محتدم بين الصين والولايات المتحدة على الموارد المعدنية في نصف الكرة الغربي».
وبالعودة إلى النفط، نجد أنّ حصة أميركا اللاتينية ليست هينة بحال. فحجم إنتاجها من البراميل، إذا ما أُضيف إليه إنتاج كندا والولايات المتحدة، يضاهي في مجمله إنتاج منطقة الشرق الأوسط، بل قد يرتفع هذا الزخم الإنتاجي إذا ما أُعيد تأهيل البنية التحتية النفطية في فنزويلا. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لأحدٍ أن يجزم بإقصاء النفط عن المشهد لصالح التحول الطاقي؛ وحتى لو حدث ذلك في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يظل النفط شرياناً حيوياً لا غنى عنه لتمويل العمليات العسكرية الأميركية. وكما يرى خافيير بلاس، فإنّ إحكام الولايات المتحدة سيطرتها على الإنتاج في عموم القارة الأميركية قد يُمكّنها من فك الارتباط بين حروبها الخارجية وأسعار الوقود في أسواقها المحلية:
طوال عقود من الزمن، ظلّت المغامرات العسكرية الأميركية مكبلةً بتداعيات أي نزاع على أكلاف الطاقة. أما اليوم، فقد بات البيت الأبيض يمتلك اليد الطولى والسيادة المطلقة على منتجي النفط، حلفاءً وخصوماً على حدّ سواء؛ من السعودية إلى إيران، ومن نيجيريا إلى روسيا. وقد كشفت الأشهر الـ18 الماضية بجلاء عما تعنيه هذه الوفرة الهيدروكربونية الجديدة للسياسة الخارجية الأميركية. إذ أقدمت إدارة ترامب على خطواتٍ كانت يوماً ما ضرباً من المستحيل: من قصف المنشآت النووية الإيرانية إلى مساعدة أوكرانيا في استهداف مصافي النفط الروسية. ولعل عملية اقتناص نيكولاس مادورو من بيته الآمن في ضواحي كاراكاس كانت المثال الأفظع على ما يمكن أن يفعله البنتاغون حينما لا يعود النفط قيداً يكبله.
في أعقاب تداعيات أزمة 2008، انتقلت الروابط بين الصين وأميركا اللاتينية من التبادل التجاري إلى التمويل والبنية التحتية، مع قفزةٍ نوعية في الاستثمارات الصينية المباشرة وانخراط شركاتها في مشروعاتٍ إنشائية كبرى، لعل أبرزها ميناء تشانكاي العملاق في بيرو الذي سيضاعف من زخم التدفقات التجارية. كما نحت دولٌ لاتينية عديدة نحو الاقتراض من بكين تفادياً لاشتراطات البنك والصندوق الدوليان. وفي العام 2018، دعت الصين القارة للانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق، لتعمّق بذلك تشابك المنطقة مع شبكات الدبلوماسية والتمويل الصينية. وشراكة بكين مع البرازيل المترسخة عبر مجموعة من مؤسسات البريكس جزءٌ من الصورة الأكبر.
التجارة المُهذِّبة
ما الذي يدفع الصين نحو هذا الانخراط في المنطقة؟ انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2001، ورسمت استراتيجية تنموية تطلبت دمج اقتصادها في دورة الرأسمالية العالمية: قرار باركته الدوائر السياسية الأميركية آنذاك، مدفوعةً بالأمل في أن تطلق هذه الخطوة سيرورةً حتميةً من اللبرلة الصينية والتبعية للنظام العالمي بقيادة واشنطن. ويمكن قراءة هذا الافتراض بوصفه من مخلفات العقيدة القديمة المعروفة بـ«التجارة المُهذِّبة»، المرتبطة بمونتسكيو، والقائلة بأنّ التجارة «تُهذب الطباع وتلطف السلوكيات البربرية». وبناءً على هذا التصور، فرض المسؤولون الأميركيون المفاوضون بشأن انضمام بكين للمنظمة شروطاً قاسية وصارمة، مطالبين الصين بـ«فتح أسواقها في قطاعات المصارف والتأمين والأوراق المالية وإدارة الصناديق وغيرها من الخدمات المالية».
حظيت إعادة تشكيل الرأسمالية العالمية التي تلت ذلك بقبول الولايات المتحدة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ديناميات الاستهلاك الممول بالديون. فبحلول العام 2001، كان الاقتصاد الأميركي قد قطع بالفعل شوطاً طويلاً لأكثر من عقد في مسار تراجع التصنيع، مع هجرة الإنتاج الصناعي نحو القارة الآسيوية. ومع تراجع سطوة النقابات العمالية، تضافرت هذه العوامل لتكرس حالةً من ركود الأجور. ولجعل هذا الواقع متسقاً مع ما أسماه ديفيد هارفي «القاعدة الذهبية للاستهلاك اللانهائي»، كان لا بد من استنفار الأدوات المالية: تمكنت معظم الأسر الأميركية، ولفترة من الوقت، من مواصلة تحسين مستويات معيشتها بالاتكاء على الاقتراض، باستثناء الفئات القابعة في أدنى هرم الدخل. أسهم تدفق السلع المصنعة الرخيصة من الصين في دعم هذا النموذج عبر إبقاء معدلات التضخم في مستويات منخفضة.
استمر هذا حتى العام 2008، حين كشفت الأزمة المالية العالمية عن استحالة الاستمرار في سياسة إغراق العمال في الاستدانة. ومنذ ذلك الحين، بدأ أصحاب المهن غير المستقرة - من سكان البلدات المفقرة على طول حزام الصدأ الأميركي والمثقلين بأعباء الديون - يتجرعون مرارة إعادة هيكلة تقسيم العمل الدولي. ولم يلبث هذا التدهور الاقتصادي أن أعقبته أوبئة من حالات الانتحار والجرعات الزائدة المميتة من المخدرات، لا سيما بين مَن لم يتلقَ تعليماً جامعياً: إحدى أكبر الفئات الخاسرة في لعبة «العولمة». هكذا، تهيأ المسرح تماماً لصعود ترامب. تُبيّن الدراسات التجريبية التي أجراها ديفيد أوتور وزملاؤه أنّ المناطق الأكثر تأثراً بما يُعرف بـ«صدمة الصين» أدّت دوراً حاسماً في هذا التحول السياسي الجذري.
مع صعود ترامب إلى سدة الرئاسة في 2016، تهاوت هالة التجارة الحرة ليحل محلها صراعٌ تجاري وتقني محتدم مع الصين. ولم يكن هذا التحول مجرد عَرَضٍ عابر، بل عززته إدارة بايدن لاحقاً بجعل هذه التدابير حجر الزاوية فيما أسمته «سياسة خارجية تخدم الطبقة الوسطى». وثمة حدثان محوريان رسخا هذا الانتقال: الأول جائحة كوفيد التي أصابت سلاسل التوريد بالشلل ودفعت النقاش السياسي نحو حتمية تعزيز المنعة الوطنية، والثاني الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتحديد أثره في أسواق الطاقة الأوروبية. عند هذه النقطة، حتى أعتى المدافعين عن السوق الحرة أفاقوا من غفوتهم. جادلت مجلة الإيكونوميست في العام 2022 بأنّ «الحرب الروسية أثبتت أنّ سلاسل التوريد بحاجة إلى إعادة تصميم جذرية لمنع الدول السلطوية من ابتزاز الدول الليبرالية». وذكرت الصحيفة وجود تضاد بين حرية التجارة والحرية. ساد شعورٌ عام بتبدد الأوهام حيال مقولة التجارة المُهذِّبة.
يتمثّل أحد المفاصل الجوهرية في سياسة واشنطن الخارجية، طوال العقد المنصرم، في فرض حظرٍ على تصدير التقنيات الأميركية إلى الصين، ومنع الشركات الأميركية من التعامل مع نظيراتها الصينية، فضلاً عن تضييق الخناق على مبيعات سلعٍ تقنية متطورة بعينها. (قدَّم شون ستارز وجوليان جيرمان وصفاً تفصيلياً لهذه التدابير). ولعل المفاوضات الأخيرة بشأن شرائح إنفيديا ليست إلا أحدث حلقات هذا المسار الذي انطلق مع قانون إصلاح ضوابط التصدير للعام 2018. بيد أنّ هذا النهج يصطدم اليوم بمعضلةٍ: فبمجرد تقويض القدرات الإنتاجية للصين في محاولةٍ لكبح جماح صعودها، ستجد نفسك مضطراً للبحث عن مصادر بديلة للسلع المستوردة. وهنا يبرز الحديث عن إعادة هندسة سلاسل التوريد، وكل ما يثار حول إعادة التوطين والتوريد من الحلفاء. غير أنّ حجر العثرة أمام إعادة التنظيم هذه يكمن في حقيقة أنّ معظم الموارد الطبيعية في العالم تُباع للصين وتُكرر فيها؛ وهذا بدوره يعيدنا مجدداً إلى أميركا اللاتينية ومصلحة الولايات المتحدة الحيوية في إحكام سيطرتها على مواردها.
هيمنة هشة؟
في أعقاب الهجوم على كاراكاس، يبدو أنّ الولايات المتحدة باتت تتوق لتقديم فصلٍ جديد من فصول استعراض القوة الخشنة، موجهةً بوصلة اهتمامها شطر غرينلاند وربما إيران. وسواء مضى ترامب قُدماً في خطته بـ«إدارة» البلاد أم لا، أعتقد أنّ السياق الجيوسياسي الأوسع يؤكد أنّ منطق التنافس الإمبراطوري قد بات المحرك الأساسي للأحداث. لقد ولى زمن النفاق والمداهنة والرياء، وعاد عهد إمبريالية الموارد الفجة. وفنزويلا أول من وقع في مرمى النيران، ولربما تجد كولومبيا وكوبا في الغد نفسيهما الهدف القادم. ومن شأن الانتخابات الرئاسية الوشيكة في المنطقة - في بيرو وكولومبيا والبرازيل - أن تفتح لترامب آفاقاً جديدة لبسط هيمنته على نصف الكرة الغربي، لربما عبر توظيف أدوات التدخل المالي ذاتها التي استخدمها في الانتخابات الأرجنتينية العام الماضي.
بيد أنّ قدرة عقيدة مونرو على إعادة صياغة سلاسل التوريد العالمية مسألة أخرى. تدرك الولايات المتحدة تمام الإدراك نقاط ضعفها الاقتصادية - سواء في الموارد أو في تقنيات أساسية بعينها -، وتبدو اليوم أميل لتعويض ذلك النقص عبر التلويح بآلتها الحربية واستعراض عضلاتها العسكرية. لكن في الربع قرن الذي أعقب انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية، نشأت علاقات اعتماد متبادل وثيقة بين الشرق والغرب، لدرجة أنّ أي محاولات لفك هذا الارتباط قد ترتد آثارها على فاعلها بسهولة. ولعل حالة التذبذب لرسوم ترامب الجمركية ليست إلا علامةً من علامات هذه الصعوبة.
كما أنّ الفاعلين الآخرين لن يقفوا مكتوفي الأيدي. ففي ظل الضغوط المتزايدة، تعمد الصين إلى إحكام سيطرتها على صادرات المعادن الحيوية. وحين فرض ترامب رسوماً جمركية على البرازيل، انتقاماً لسجن بولسونارو، صمد لولا في وجه هذه الضغوط، وأجبر الولايات المتحدة في نهاية المطاف على التراجع، والراجح أنّ ذلك يعود إلى خشيتها من أن ترفع تلك الرسوم الأسعار المحلية للقهوة واللحوم، ودفع البرازيل أكثر نحو الصين. أما في الحالة الفنزويلية، فإنّ الابتزاز الأميركي تحت تهديد السلاح يجعل المقاومة أصعب. لكن يبدو أنّ الإكراه وحده ليس وسيلة مضمونة لحسم الصراع بين القوى العظمى.
نُشِر هذا المقال في 16 كانون الثاني/يناير 2026 على Phenomenal World، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموجب اتفاق مع الجهة الناشرة.