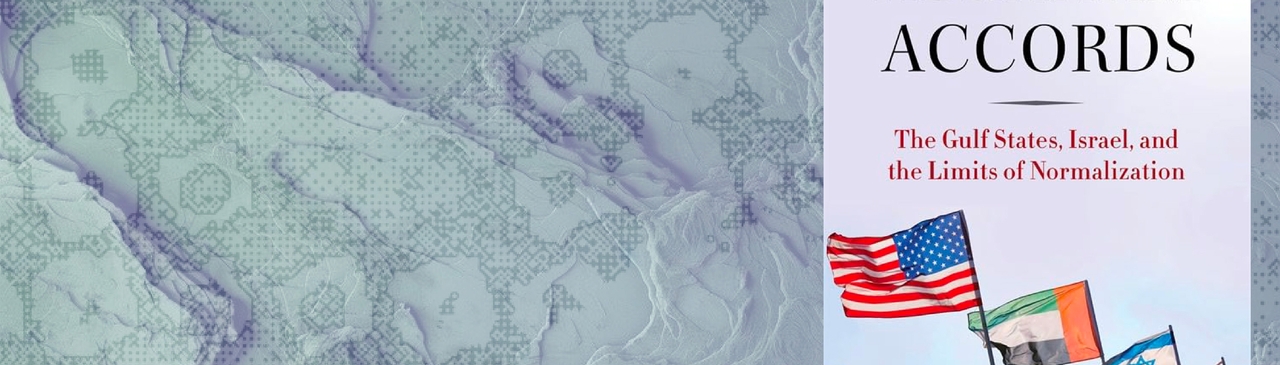
5 سنوات على اتفاقيات أبراهام: حدود الحماية والمكاسب
- مراجعة لكتاب إلهام فخرو «اتفاقيات أبراهام: دول الخليج، إسرائيل، وحدود التطبيع»، الذي يحاجج بأنّ الاتفاقيات التي وُقّعت في العام 2020 لم تكن مشروع سلام، بل صفقة أمنية واقتصادية خدمت النخب الحاكمة. وتكشف فخرو كيف مهّد الخوف من إيران وثورات «الربيع العربي» لتقارب الخليج مع إسرائيل فيما بقي الفلسطينيون خارج المعادلة، ما عمّق القمع الداخلي والعزلة الفلسطينية، وجعل «النظام الإقليمي الجديد» يقوم على المصالح لا على العدالة.
في 15 أيلول/سبتمبر 2020، شهد البيت الأبيض توقيع اتفاقيات أبراهام بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري خارجية البحرين والإمارات العربية المتحدة.
مع توقيع الاتفاق المتعدد الأطراف، أصبحت البحرين والإمارات أول دولتين عربيتين تطبّعان علاقاتهما مع إسرائيل منذ مصر في العام 1979 والأردن في العام 1994. وبعد مرور 5 سنوات، تبدّدت المفاجأة الأولى بين شعوب المنطقة والمراقبين الدوليين، ليُنظر إلى الاتفاقيات كترتيب مصلحي يعكس تحوّلات التوازنات الإقليمية، أكثر مما هو مشروع استراتيجي لإعادة رسم الشرق الأوسط. وبات يُنظر إليها كدليل على تراجع النفوذ الأميركي، وعلى اعتماد واشنطن المتزايد على الحلفاء والوكلاء في زمن تتواصل فيه النزعة العسكرية وتتراجع فيه هيمنتها العالمية.
في سردها المتقن، ترى إلهام فخرو أنّ اتفاقيات أبراهام تتجاوز كونها ملحقاً هامشياً في عملية إعادة تشكيل الشرق الأوسط، لتغدو مدخلاً لفهم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها الربع قرن الماضي، وما أفضت إليه من مرحلة فوضوية وعنيفة يحكمها الطغاة وأصحاب الثروات من الخليج إلى المتوسط. وعلى الرغم من ما تروّجه وسائل الإعلام التقليدية من أنها جزء من «عملية السلام» بين إسرائيل والفلسطينيين، توضّح فخرو أن الاتفاقيات لا تمتّ بصلة بحياة الفلسطينيين، بل تشكّل منظومة أمنية مغلقة صُمّمت لحماية مصالح فئة ضيّقة من النخب السياسية والمالية العابرة للحدود.
فإذا كان الاتفاق صُمّم لحماية دول الخليج من التهديدات الخارجية والداخلية، فهل يمكن أن يحميها من «الوصيّ» نفسه، أي إسرائيل؟ ويزداد وقع هذا السؤال بعد أن انتهكت إسرائيل مؤخراً سيادة دولةٍ عضوٍ في مجلس التعاون الخليجي، هي قطر
استندت إلهام فخرو في كتابها «اتفاقيات أبراهام: دول الخليج، إسرائيل، وحدود التطبيع» إلى أرشيف واسع من المقالات العربية والإنكليزية ووثائق ويكيليكس ومقابلات شخصية أجرتها مع مسؤولين ومحلّلين في بلدان عدّة، وسردت كيف فتحت القنوات الخلفية المتشابكة، ومعها الفاعلون من القطاع الخاص، الطريق أمام جمع هذه الأطراف على طاولةٍ واحدة، وكيف حصد هؤلاء المكاسب الأولى على الرغم من الخيبات والتناقضات المتكرّرة. ومع أنّ المغرب والسودان انضمّا لاحقاً، وجّهت فخرو اهتمامها إلى العقد الأخير من العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة وبين العائلات الحاكمة في الإمارات والبحرين والسعودية.
موجات التطبيع
استندت اتفاقيات أبراهام إلى فكرةٍ قديمة لدى بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين، مفادها أن عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول العربية يمكن أن يوفّر الأمن عبر التجارة والتبادل الاقتصادي، مع تهميش الفلسطينيين وتأجيل أي مواجهة مع مطالبهم بتقرير المصير. في الواقع، لم تلزم الاتفاقيات إسرائيل بالتخلّي عن أي أرض، خلافاً لمبدأ «الأرض مقابل السلام» الذي أقرّه قرار مجلس الأمن 242 للعام 1967، وتجسّد لاحقاً في عملية السلام ومعاهدات التسعينيات مع مصر والأردن. حتى ادعاء الإمارات أنها نجحت في وقف خطة إسرائيل لضمّ الضفة الغربية قبل توقيع الاتفاق سرعان ما انهار، بعدما كشفت الترجمات المتباينة لنص الاتفاق وشهية إسرائيل الاستيطانية المفتوحة عن فراغ هذا الادعاء من مضمونه.
تحدّد فخرو سلسلة من العوامل والتصوّرات التي مهّدت الطريق للتطبيع. فقد خشي صانعو القرار في إسرائيل ودول الخليج من تقدّم البرنامج النووي الإيراني، ومن «خطة العمل الشاملة المشتركة» (JCPOA) التي قادتها الولايات المتحدة للحدّ من هذا البرنامج، لما تنطوي عليه من احتمال تحسين العلاقات الأميركية–الإيرانية. من وجهة نظرهم، شكّلت هذه التطوّرات تهديداً لتفوّق إسرائيل ولأمن الدول العربية المجاورة في الخليج. في الوقت نفسه، أدّت الفوضى التي أعقبت الإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين في العام 2003، ثم انتفاضات «الربيع العربي» في العام 2011، التي رآها كلّ من إسرائيل والممالك الخليجية تحدّياً لأنظمتهم، لأنها استهدفت إسقاط الديكتاتوريات وإيصال قوى ديمقراطية وإسلامية إلى الحكم. وأخيراً، شجّع صانعو القرار في واشنطن على تعزيز التعاون بين أبرز حلفائهم الإقليميين، إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي، باعتباره وسيلةً لاحتواء التهديدات، بما فيها التحدّيات الحقيقية والمتخيّلة القادمة من الصين.
تولّى جيلٌ شاب من أبناء الأسر الحاكمة إدارة الملفات الحسّاسة في السياسة والأمن والاقتصاد، وافتُتن بفكرة توظيف التكنولوجيا لبناء مرحلة ما بعد النفط وبقدرتها على مراقبة المجتمعات والعمال المهاجرين. وأدّت المشاريع الإسرائيلية، الخاصة والعامة، أدواراً محورية في هذه المنظومة الجديدة
تجادل فخرو أن انسجام رؤية التهديد بين أبوظبي والمنامة والرياض وتل أبيب لم يُملِه الخارج وحده، بل جاء أيضاً مع بروز جيل جديد من رجال الدولة مطلع الألفية. جيلٌ تراجع لديه خطاب القومية العربية، وانشغل أكثر بمخاطر الإسلاميين وبفكرة إعادة توجيه اقتصادات الخليج نحو التكنولوجيا والأمن، تمهيداً للتخفيف من الاعتماد على النفط ومواجهة الخصوم في الداخل والإقليم. ومن رحم هذه التحوّلات وُلدت صفقة تبادلية: لإسرائيل الاعتراف والأسواق، وللحكّام الخليجيين الحماية والعوائد.
تحرص فخرو على وضع هذه التطوّرات في سياقها التاريخي الأوسع ضمن المسار الطويل لتاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعود في الفصل الأول إلى ثلاثينيات القرن الماضي لتروي كيف كانت القضية الفلسطينية وقوداً للحركات العمالية والمناهضة للاستعمار البريطاني في شرق الجزيرة العربية، وكيف ازداد الدعم الرسمي لها بعد هزيمة 1967. كما تستعيد قصص «موجات التطبيع» التي أعقبت اتفاقيات أوسلو في العام 1993، ثم الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003، مذكّرةً بأنّ المبادرات الأولى للاعتراف بإسرائيل لم تأتِ من البحرين أو الإمارات، بل من عُمان وقطر.
أخذ مسار التطبيع زخمه منذ بدايات الألفية من تبدّل الأجيال داخل الأنظمة الخليجية، كما تفصّل فخرو في الفصل الثاني. تولّى جيلٌ شاب من أبناء الأسر الحاكمة إدارة الملفات الحسّاسة في السياسة والأمن والاقتصاد، وافتُتن بفكرة توظيف التكنولوجيا لبناء مرحلة ما بعد النفط وبقدرتها على مراقبة المجتمعات والعمال المهاجرين. وأدّت المشاريع الإسرائيلية، الخاصة والعامة، أدواراً محورية في هذه المنظومة الجديدة. كما فتحت دول الخليج، ولا سيّما الإمارات، قنوات دبلوماسية نسجتها الوزارات الرسمية والشركات الخاصة معاً، مثل ImageSat International وAsia Global Technologies International ص(45–46).
أسهمت شركات استشارية مثل ماكينزي في تغذية شبكة المصالح التي تشكّلت قبل توقيع اتفاقيات أبراهام مباشرة وبعدها، وجمعت بين رؤوس الأموال الإسرائيلية والخليجية، العامة والخاصة، وأحياناً الأميركية، في مجالات تمتدّ من تجارة الألماس إلى الصناعات الدفاعية. وتقاطعت هذه المصالح بوضوح في ميادين الطيران والتجسّس الإلكتروني والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يظلّ سؤالٌ مفتوح: لماذا لم تنضمّ قطر وعُمان، وهما من أوائل من سعى إلى تخفيف التوتّر مع إسرائيل ويشتركان في سمات كثيرة مع الإمارات والبحرين، إلى هذه الاتفاقيات، ولماذا يغيب اسماهما عن قائمة الموقّعين المحتملين؟
تثبيت التقارب رسمياً
بحسب فخرو، أدّت رئاسة دونالد ترامب دوراً حاسماً في نقل العلاقات السرّية بين إسرائيل ودول الخليج إلى مستوى رسمي من خلال اتفاقيات أبراهام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة (ص. 71). يخصّص الفصل الثالث من الكتاب مساحة لتفصيل كيف تولّى عدد من وزراء ترامب ومستشاريه ربط خيوط التواصل بين البيت الأبيض ونتنياهو والمقرّبين منه، موجّهين الرئيس نحو ما يُعرف بنهج «من الخارج إلى الداخل» الذي يفضّله اليمين الإسرائيلي: أي بناء التحالف مع الدول العربية قبل التعامل مع المطالب الفلسطينية أو بدلاً منها. وكان من أبرز هؤلاء ديفيد فريدمان وجايسون غرينبلات وجاريد كوشنر وآفي بيركوفيتز ومايك بومبيو الذين أدّوا دور الوسطاء بين المكتب البيضاوي وتل أبيب.
في الوقت نفسه، تولّى عدد من المسؤولين والمقرّبين من ترامب في مجال الأعمال دفع العلاقات الأميركية–الخليجية نحو مزيد من الارتباط بإسرائيل. برز في مقدّمتهم إريك برنس، مؤسّس «بلاك ووتر» السابق ومستشار ترامب غير الرسمي، إلى جانب جورج نادر، مستشاره السابق، وتوم باراك، رجل الأعمال وصديق الرئيس. كلّفهم ولي عهد أبوظبي بالعمل كوسطاء أساسيين مع حكومات خليجية أخرى. وتشير فخرو إلى الدور الحاسم الذي أدّاه يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، في توجيه هذه الجهود، إذ نجح مع المجموعة في إقناع إدارة ترامب بتغيير مواقفها التقليدية من قضايا الاستيطان والأونروا ومبيعات السلاح والتكنولوجيا المتقدّمة للعرب. أمّا الخطوة الأبرز فكانت انسحاب ترامب في العام 2018 من الاتفاق النووي مع إيران، وبدء حملة «الضغط الأقصى» التي زادت من اشتعال التوترات الإقليمية.
مسعى البحرين والإمارات إلى التسامح بات يشبه استراتيجيات الهسبرا الإسرائيلية، تلك التي تُقدّم إسرائيل كملاذٍ ليبرالي في محيطٍ متوحّش، أو كفيلا وسط غابة
سارت الرياح بما يشتهي مطلقو اتفاقيات أبراهام؛ فحتى تردّد نتنياهو في اللحظات الأخيرة، وحساباته الانتخابية التي أزعجت ترامب أكثر من مرة، لم توقف الاندفاعة نحو التوقيع. وما إن اعترفت الولايات المتحدة بمطالب المغرب في الصحراء الغربية، ورفعت السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب وساعدته على تسديد ديونه للبنك الدولي، حتى التحقت الرباط والخرطوم بركب الاتفاق في أواخر العام 2020.
لا تزال السعودية، التي يُنظر إليها على أنها جوهرة التاج في مبادرة التطبيع، خارج اتفاقيات أبراهام، لا بسبب تقصير إدارة ترامب أو خلفه جو بايدن في السعي لتحقيق ذلك. وتتجنّب فخرو تقديم تفسيرٍ شامل لاستراتيجية السعودية في عدم توقيع نسخة من الاتفاقيات، أو لسبب لجوئها إلى الوساطة العراقية والصينية لإعادة العلاقات مع إيران في آذار/مارس 2023. ولا يزال من المبكر الجزم بما إذا كان الردّ الإسرائيلي المدمّر على غزة ولبنان وإيران عقب هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 سيقضي نهائياً على آمال توسيع التطبيع أم سيعيد رسم شروط التبادل بين الولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الجدد المحتملين.
جاءت أولى ثمار اتفاقيات أبراهام وأكثرها وضوحاً في الميدان العسكري. بانضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية، بات التنسيق أعمق مع شبكات الصواريخ والبنى اللوجستية الأميركية والخليجية. ومن المرجّح أن هذا الاندماج هو ما منح إسرائيل القدرة على خوض حربها ضد إيران والتصدّي لردّها في خلال الحرب التي استمرّت 12 يوماً في حزيران/يونيو 2025.
شكّل التنسيق العسكري حافزاً إضافياً للإمارات والبحرين لشراء مزيد من الأسلحة والتقنيات المتقدّمة، سواء من شركات أميركية أو إسرائيلية. ففي العام 2021 فقط، بلغت قيمة مشترياتهما من السلاح الإسرائيلي أكثر من 853 مليون دولار. ومع إزالة القيود الجمركية وتوسّع التبادل التجاري، أعلنت الإمارات عن استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في «القطاعات الإسرائيلية الاستراتيجية، من الطاقة إلى التصنيع والرعاية الصحية» (ص. 112). وشاركت في هذه الصفقات مجموعة من الشركات الإسرائيلية وصناديق الثروة السيادية الإماراتية مثل مبادلة وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ). وإلى استياء قطاعات واسعة من المواطنين، امتدت بعض هذه الاتفاقيات لتشمل شركات تعمل في مستوطنات الضفة الغربية.
يخصّص الفصل الخامس مساحة لبعدٍ خفي في اتفاقيات أبراهام، إذ أدّت دوراً في تلميع صورة التسامح في البحرين والإمارات. فبعد أعوام من الانتقادات على خلفية قمع احتجاجات البحرين في العام 2011، والمشاركة في حرب اليمن، والتقارير المتكرّرة عن انتهاكات حقوق العمال والمواطنين، لجأ حكّام البلدين إلى الاتفاقيات لتجديد صورتهم أمام العالم. وكما يوحي الاسم، اعتمدت هذه الحملة على مفردات «التعايش والقرابة الدينية» لتقديم البحرين والإمارات كدول متسامحة ومتقدّمة ومنفتحة. والأهم أنها سمحت لهما بالابتعاد عن الصورة النمطية للشرق الأوسط التي ترسّخت بعد 11 أيلول/سبتمبر كمنطقة يغلب عليها التطرّف الإسلامي والعداء للغرب.
تولّى الترويج لحملة «التسامح» نخبة من المؤثرين والمنظمات الصهيونية الكبرى مثل مركز سايمون فيزنتال ومعهد MEMRI، الذين صاروا بمثابة الناطقين باسمها. تكتب فخرو أنّ «مسعى البحرين والإمارات إلى التسامح بات يشبه استراتيجيات الهسبرا الإسرائيلية، تلك التي تُقدّم إسرائيل كملاذٍ ليبرالي في محيطٍ متوحّش، أو كفيلا وسط غابة» (ص. 180). ومن بين الحاخامات المجنّدين مارك شناير، المستشار الديني لملك البحرين، الذي اعتبر البلاد «نموذجاً عربياً للتعايش والتسامح» (ص. 165)؛ بينما وصفها حاخام آخر بأنها «شعاع ضوء صغير في عالمٍ مظلم تغمره الأصولية العرقية». وفي هذا الفصل وسواه، تغوص فخرو في تحليل حالة البحرين، التي بقيت على هامش الاهتمام الإعلامي والأكاديمي مقارنةً بتجربة الإمارات أو مسار السعودية نحو التطبيع.
القمع والمقاومة
وجّه حكّام الخليج اتفاقيات أبراهام نحو الخارج لتلميع صورتهم، لكنهم لم يجدوا في الداخل آذاناً صاغية. ترى فخرو أن غياب الحماس الشعبي لتوسيع العلاقات الاجتماعية والثقافية مع إسرائيل يعكس تاريخاً راسخاً من التضامن مع فلسطين في مجتمعات شبه الجزيرة. ففي البحرين والإمارات وسواهما، لم تمحُ موجة التطبيع إرث المجتمع المدني والنقابات العمالية التي طالما تحرّكت من أجل القضية الفلسطينية. تستند فخرو إلى استطلاعات للرأي وحملات مقاطعة واسعة ضد «ستاربكس» وسواها من العلامات التجارية لتُظهر أن اتفاقيات أبراهام لا تجد صدى شعبياً في الخليج، بل تنسجم مع اتساع القبضة الأمنية في البحرين والإمارات في خلال العقدين الماضيين ومع ازدياد ضيق الممالك بالنقد والمعارضة.
ومع ذلك، كما تخلص فخرو، فليس من المستغرب أن تصمد اتفاقيات أبراهام أمام موجة التعاطف الشعبي مع فلسطين، إذ «بُنيت، عن قصد، على استمرار تهميش الفلسطينيين وعزلهم» (ص. 226). وتحت غطاء الدبلوماسية المكوكية والنشوة النخبوية بفكرة «شرق أوسط جديد»، سرّعت إسرائيل وتيرة احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبعده. واللافت أنّ العلاقات الجديدة لكلّ من الإمارات والبحرين مع إسرائيل لم تمنحهما القدرة أو الإرادة لحماية الفلسطينيين أو كبح العنف الإسرائيلي. ولم يُقدِم أيّ من البلدين على سحب سفيره من تل أبيب، على الرغم من إبقاء البحرين منصب سفيرها هناك شاغراً منذ نيسان/أبريل 2025.
ما يحدث لا يناقض الاتفاق بل يجسّده: «فبدلاً من صنع سلامٍ بين الأطراف المتحاربة، رعَت إدارة ترامب اتفاق تطبيع بين إسرائيل ودولٍ ليست طرفاً في الصراع، ومنحت نتنياهو الغطاء ليوسّع الاستيطان ويشدّد قبضته على الأراضي المحتلّة
لم تهتزّ اتفاقيات أبراهام على الرغم من ما ترتكبه إسرائيل من قتلٍ وتجويعٍ للفلسطينيين، ومن حصارٍ لغزة وتوسيعٍ لهيمنتها على الضفة الغربية. ففي رواية فخرو، ما يحدث لا يناقض الاتفاق بل يجسّده: «فبدلاً من صنع سلامٍ بين الأطراف المتحاربة، رعَت إدارة ترامب اتفاق تطبيع بين إسرائيل ودولٍ ليست طرفاً في الصراع، ومنحت نتنياهو الغطاء ليوسّع الاستيطان ويشدّد قبضته على الأراضي المحتلّة» (ص. 109).
ترصد فخرو من خلال متابعتها الدقيقة للمصادر نبض العلاقات المعقّدة والتحديات التي تواجه حتى أكثر الموقّعين على الاتفاق تصميماً. تفرز المصالح المتشابكة والأجندات المتناقضة التي تحرّك محاولات الوصل بين أنظمة الحكم والأجهزة الأمنية ورؤوس الأموال. غير أن ما يبقى في الظل هو الأسئلة عن المنطق غير المعلن: هل تُلهم تجربة إسرائيل في السيطرة على الفلسطينيين حكّام الخليج الذين تُقسّم مجتمعاتهم وفق درجات من المواطنة والقيمة؟ وهل تتنقّل الوسائل والقوانين والتقنيات بين الخليج والأراضي المحتلّة لتُستخدم في ضبط الداخل كما في مواجهة الخارج؟
في تناولها لـ إيران كـ«تهديد مشترك»، تكتفي فخرو إلى حدّ بعيد بترداد خطاب المسؤولين، من دون أن تحسم موقفها من الاتهامات التي تصوّر طهران كقوةٍ طامحة إلى التوسّع. يبقى النقاش عند مستوى التصوّرات السياسية أكثر منه التحليل الفعلي للقدرات. فالمخاوف التي تبديها عواصم كتل أبيب وأبوظبي والرياض والمنامة وواشنطن تنبع من إرث الغزو الأميركي للعراق في العام 2003 وصمود حزب الله في حرب 2006. لكنّ الردع والخطر المشترك يمكن أن يصبحا بسهولة ذريعة للعدوان. وكما يبيّن ولي نصر، فإنّ سياسة إيران بين 2001 و2020 لم تكن تجسيداً لتوسّعٍ هيمني، بل ردّاً دفاعياً على الحرب الأميركية على الإرهاب، وعلى الطوق العسكري من القواعد والقوات المحيطة بها1.
يستحقّ كتاب إلهام فخرو عن اتفاقيات أبراهام القراءة لما يقدّمه من تفسيرٍ واضح ومقنع لأصول الاتفاق ونتائجه المباشرة. وهي تُوجّه اهتمامنا بحقّ إلى الحدود السياسية للاتفاقيات وضيق قاعدة الدعم التي يقوم عليها «النظام الإقليمي الجديد» المتخيَّل. لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو ما إذا كان الملوك ومستشاروهم يعيدون، في الأشهر الأخيرة، تقييم المقايضة الاستراتيجية التي اعترفوا بموجبها بإسرائيل في مقابل ضمان أمنهم. فإذا كان الاتفاق صُمّم لحماية دول الخليج من التهديدات الخارجية والداخلية، فهل يمكن أن يحميها من «الوصيّ» نفسه، أي إسرائيل؟ ويزداد وقع هذا السؤال بعد أن انتهكت إسرائيل مؤخراً سيادة دولةٍ عضوٍ في مجلس التعاون الخليجي، هي قطر، بقصف اجتماعٍ لمفاوضي حماس الذين كانوا يبحثون وقفاً محتملاً لإطلاق النار في غزة. وبالنظر إلى أنّ إسرائيل، بدعمٍ أميركي مطلق، أمضت العامين الماضيين في انتهاك سيادات الدول تحت ذريعة الدفاع عن النفس، وتوسيع سياسة «جزّ العشب» لتشمل المنطقة كلّها بعد أن كانت مقتصرة على غزة، فماذا يمكن لوثائق وُقّعت في واشنطن أن تضمن من أمنٍ فعلي؟
نُشِر هذا المقال في 15 أيلول/سبتمبر 2025 في MERIP، وترجم إلى العربية ونشر في موقع «صفر» باتفاق مع الجهة الناشرة.
- 1
Vali Nasr, Iran’s Grand Strategy: A Political History (Princeton: Princeton University Press, 2025).


