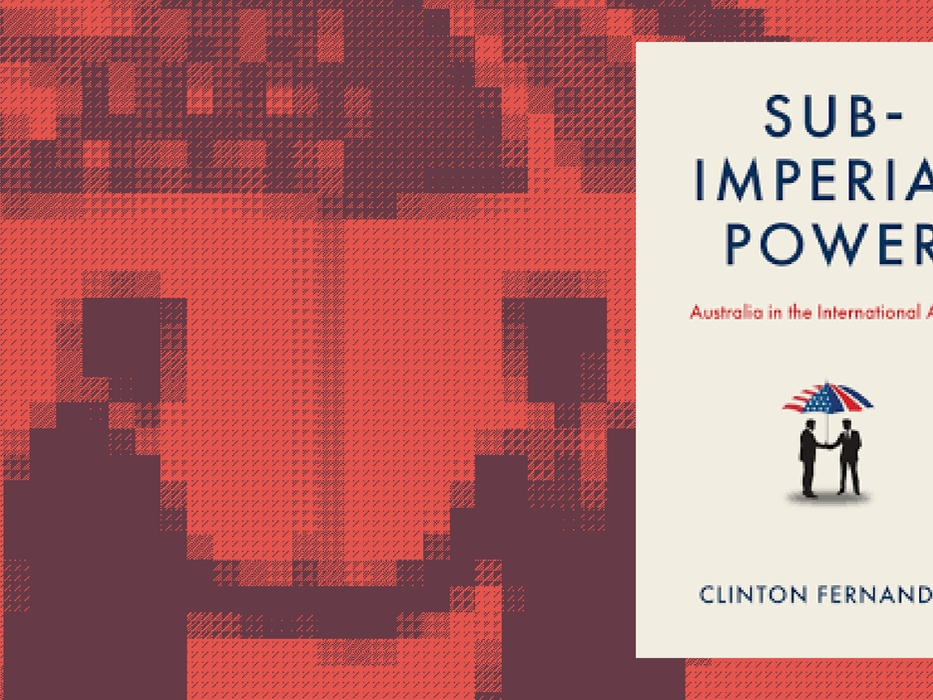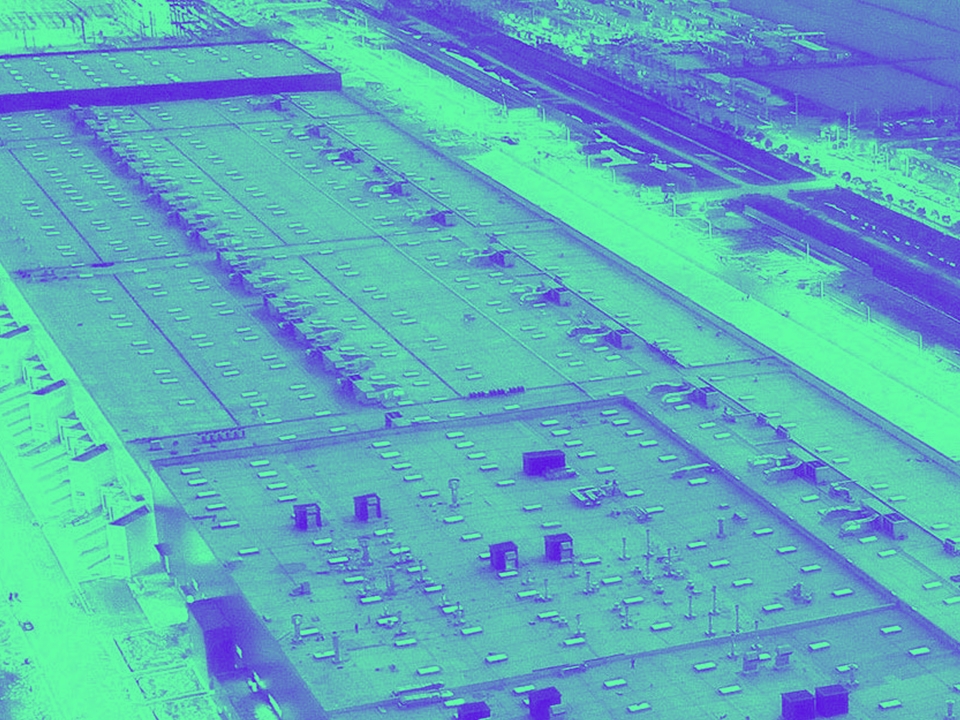السياسة الصناعية وإعادة الاصطفاف الإمبريالي
تُطبَّق السياسة الصناعية على نحوٍ غير متماثل عبر الاقتصاد العالمي. إذ ما تزال قدرة الدول على تبنّي سياسات صناعية تحويلية وأشكال تنفيذ هذه السياسات رهينة تراتبيات النظام المالي والنقدي العالمي، ودرجة اندماج الدول في سلاسل التوريد العالمية، وتموضعها الجيوسياسي.
تتأثَّر قدرة الدول على تطبيق السياسة الصناعية بالقيود المالية والنقدية. فبالمقارنة مع الاقتصادات المتقدّمة، تعاني الاقتصادات الناشئة والنامية من قيود مالية أشد، من بينها انخفاض العائدات الضريبية وعجزها عن الاقتراض بالعملات المحلية.
سُجّل، في العام 2023 وحده، ما يربو على 2500 سياسة صناعية، نصفها أو يزيد صدر من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين. فقد باتت الاقتصادات المتقدّمة والدول النامية على السواء تتّجه نحو اعتماد سياسات أكثر تدخّلاً، وتنخرط في عمليات تجريب في ميدان السياسات الصناعية.
ففي الدول المتقدّمة، تدفع السياسات الصناعية عجلة التقدّم في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات (semiconductors) والحوسبة الكمّية والطاقة النظيفة، وتعزّز مرونة سلاسل التوريد، و«تعيد توطين» الصناعات الحساسة في أراضيها. أما في الدول النامية، فهي تُوظَّف لدمج الشركات المحلّية في سلاسل القيمة العالمية، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين «التصنيع الأخضر» عبر استخراج المعادن الحيوية وإنتاج الطاقة المتجدّدة.
لعلّ ما نشهده من تطبيع السياسة الصناعية يُنبئ بتحوّل تاريخي كبير في مسار الدول النامية؛ إذ إنّ قدرتها على اعتماد سياسات صناعية ذاتية ومستقلّة كانت، على مدار العقود الأربعة الماضية، مقيَّدةً بشدّة، ضمن عملية وصفَها الاقتصادي ها-جون تشانغ بـ«ركل سُلّم» التنمية بعيداً عن المتناول. وعليه، قد يمنح إجماع جديد يُعيد شرعنة هذه الأدوات الصناعية الدولَ النامية هامشاً سياسياً أرحب لتوظِّف أدواتٍ وممارسات ظلّت حتى الآن بعيدة عن متناولها.
بيد أنّ تزايد هذه السياسات الصناعية لا يعني بالضرورة تطبيعها، ولا هي دليل على إجماع؛ بل هي على العكس من ذلك، باتت موضوعاً لنزاعٍ حول معايير التدخّل الحكومي وأشكاله. ذلك أنّ الأطراف المؤثّرة (من بينها الاقتصادات المتقدّمة والقوى الصاعدة ومؤسسات الحوكمة العالمية) تختلف اختلافاً عميقاً في مسائل: (1) الشكل الأمثل للسياسة الصناعية و(2) كيفية إدارتها وتنظيمها و(3) نطاقها وحدودها و(4) أهدافها المتوخاة و(5) الهامش السياسي المتاح أمام الدولة للتجريب.
لكن في الواقع العملي، تُطبَّق السياسة الصناعية على نحوٍ غير متماثل عبر الاقتصاد العالمي. إذ ما تزال قدرة الدول على تبنّي سياسات صناعية تحويلية وأشكال تنفيذ هذه السياسات رهينة تراتبيات النظام المالي والنقدي العالمي، ودرجة اندماج الدول في سلاسل التوريد العالمية، وتموضعها الجيوسياسي. ومن ثمّ، فالفجوة تتّسع بين الاقتصادات المتقدّمة والدول الأقلّ نموّاً في وتيرة اعتماد هذه السياسات؛ إذ تتمتّع الأولى بموقع يؤهّلها أكثر من غيرها لاستغلال المرحلة الحالية من التحوّل المضطرب. كذلك تختلف الأدوات والوسائل التي تُوظّفها كل من الاقتصادات المتقدّمة والأقلّ نموّاً اختلافاً بيّناً، عاكسةً بذلك تفاوتاً شديداً في القدرة على التجريب في السياسة الصناعية. تكشف لنا هذه الفوارق عن اختلالات بنيوية في قدرة الدولة على التصرّف ضمن الاقتصاد العالمي، فالاقتصادات المتقدّمة تتحرّك بلا قيود تُذكَر، وتتمتّع القوى الصاعدة ذات الأهمية الجيوستراتيجية بقدرٍ محسوبٍ من المرونة، أما الدول منخفضة الدخل فتظلّ أسيرة التهميش.
هامش سياسي تحويلي
شهدت العقود الأربعة الماضية، مثلما أكّد باحثو التنمية النقديون منذ زمن بعيد، تراجعاً حادّاً في «حرية التصرّف في السياسة التنموية»، أي قدرة الدول، وبالتحديد دول الجنوب العالمي، على تصميم وتنفيذ استراتيجيات التنمية الوطنية على نحو مستقلّ. وذلك التراجع يتجلّى بوضوح في مساعي التصنيع، حيث تواجه الدول النامية عوائق قانونية ومالية ومؤسسية تُعيق تبنّي السياسات التدخّلية.
تأتي تلك القيود من ثلاثة مصادر أساسية: (1) هيمنة معايير السياسات النيوليبرالية، بعدما رسختها برامج التكييف الهيكلي والإقراض المشروط في إطار إجماع واشنطن؛ و(2) القوانين الاقتصادية الدولية الملزمة، لا سيما تلك المتضمّنة في الاتفاقات التجارية والاستثمارية متعددة الأطراف؛ و(3) الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية والاستثمارية الثنائية والإقليمية. حدّت هذه العوامل مجتمعةً بشدّة من قدرة الدول النامية على تبنّي السياسات الصناعية، فأعاقت عملياً مسيرة التنمية الساعية إلى اللحاق بركب الدول المتقدّمة.
لعلّ الاهتمام المتجدّد بالسياسة الصناعية يشي بتراخي هذه القيود. أوّلاً، لقد خبت هيمنة النيوليبرالية الأيديولوجية، أو بالأحرى خبا تماسكها، فأضعفت بالتالي جاذبية السياسات القائمة على محدودية تدخل الدولة وأولوية القطاع الخاص في مسيرة التنمية. ونتيجة لذلك، صار من الصعب تجاهل السياسة الصناعية، لا سيما مع تبنّي الاقتصادات المتقدّمة نفسها استراتيجيات أكثر تدخّلاً. وبالرغم من أنّ نموذجاً بديلاً متكاملاً للنيوليبرالية لم ينبثق بعد (مع بروز أشكال جديدة من رأسمالية الدولة تتقاطع مع المقتضيات القائمة الموجّهة للسوق)، فلربما ندخل فيما تسمّيه إيلين غريبل مرحلة «عدم الاتساق المنتِج» في الإدارة الاقتصادية والمالية العالمية، وهي فترة يغيب فيها الاستقرار عن المعايير التنموية بما يتيح فرصاً متزايدة للتجريب. ويمكن القول إنّ غياب إطار تنظيمي متماسك وفعّال يزيد من الهامش السياسي ونطاق التجريب بأدوات تخرج عن مناهج النيوليبرالية «التقليدية». وعلاوة على ذلك، قد يسفر هذا التجريب عن صياغة معايير عالمية جديدة في هذا الشأن.
ثانياً، يفتح التراجع الحادّ للنظام التجاري متعدّد الأطراف آفاقاً من المرونة المحتملة أمام الدول النامية لتنفيذ سياسات صناعية. فقد عُطِّل عملياً نظام تسوية المنازعات في «منظمة التجارة العالمية» بفعل إعاقة الولايات المتحدة لتعيين جميع أعضاء هيئة الاستئناف الجدد. وكما تشير كريستين هوبويل في دراستها بشأن قيود التصدير وبرامج الدعم في إندونيسيا والهند المخالِفة لقواعد المنظمة، فقد استغلّت الدول النامية هذا الفراغ القانوني (وهي تصفه بـ«الاستئناف في الفراغ») لمواصلة تطبيق سياسات صناعية تُعَدّ مخالفةً لقواعد «منظمة التجارة العالمية». وهذا الوضع قد يشجع صانعي السياسات في الجنوب العالمي على المضي قدماً في استراتيجيات صناعية بلا خوف من تبعات قانونية أو عواقب ملموسة فورية.
قيود مستمرّة
على الرغم ممّا يبشّر به إحياء مساحة السياسة الصناعية من آمال، لا يمكن فصل ذلك عن الهياكل الأوسع للسلطة داخل النظام المالي والنقدي العالمي. تؤكد الأدلة التجريبية وجود تفاوت صارخ في توظيف السياسات الصناعية، حيث تمارس الدول الأغنى تدخّلات تفوق بكثير تدخّلات نظيراتها من الدول المنخفضة الدخل.
توزيع وتواتر تطبيق السياسات الصناعية عالمياً بحسب شرائح الدخل القومي (الناتج المحلّي الإجمالي للفرد)، بين العامين 2010 و2022.
تتأثَّر قدرة الدول على تطبيق السياسة الصناعية بالقيود المالية والنقدية. فبالمقارنة مع الاقتصادات المتقدّمة، تعاني الاقتصادات الناشئة والنامية من قيود مالية أشد، من بينها انخفاض العائدات الضريبية وعجزها عن الاقتراض بالعملات المحلية. وبناءً عليه، تعتمد هذه الدول على التمويل الخارجي من أجل التنمية والتصنيع، وهذا التمويل مشروط في الغالب بقيود تقيّد استقلالية سياساتها. في ظل ظروف «التبعية المالية الدولية»، تصبح الدول النامية عرضة لعدم الاستقرار المالي وتقلبات أسعار الصرف، والتقلبات المفاجئة في السيولة العالمية، وتقلبات الاقتراض السيادي. يتطلب الحفاظ على تدفقات رأس المال الخارجية تقديم عوائد مرتفعة للمستثمرين الدوليين، ما يعزز دوافع التمسك بسياسات اقتصادية محافظة، على الرغم من اتساع هامش التجريب في السياسة الصناعية. وفي سياقات الدول النامية، حيث يُنظر إلى الاستثمار الأجنبي على أنّه محفوف بالمخاطر، فإنّ أي انحراف طفيف عن المبادئ الاقتصادية التقليدية كفيلٌ بالتسبب بهروب رؤوس الأموال أو التوقف عن الاستثمار أو كليهما، ولذا يغدو التجريب السياسي مكلفاً جداً.
علاوة على ذلك، يختلف شكل السياسة الصناعية (أي المزيج الملموس من الأدوات السياسية وآليات التنفيذ والترتيبات المؤسسية والأطر التنظيمية) بين الاقتصادات الناشئة والنامية والاقتصادات المتقدمة. فكما يبيّن الشكل أدناه، تعتمد الاقتصادات الناشئة والنامية بالأساس على إجراءات «تشوّه التجارة»، مثل القيود على الاستيراد والتصدير، في حين يغلب على الاقتصادات المتقدمة استخدام المنح المالية المباشرة والمساعدات الحكومية، وهي أدوات سياسية تعتمد على الإنفاق الحكومي. وفي حين تعقّد هذا الاتجاه العام جراء تطبيق إدارة ترامب مؤخراً حزمة من الإجراءات الجمركية المشوّهة للتجارة، وتهديد الاقتصادات المتقدمة حول العالم بالرد بالمثل، يبقى من الصحيح وجود انقسام واضح بين الشمال والجنوب في شكل السياسة الصناعية المطبّقة.
وهذا الانقسام نتاج تبعية الجنوب الماليّة أيضاً. فالسياسة الصناعية في دولٍ تعتمد في تمويلها على الاستثمار الخارجي، تميل إلى الاعتماد أكثر على «الجزرة» (من قبيل الإعانات السخية والمنح والحوافز الضريبية والقروض المدعومة والضمانات) بدلاً من «العصا» (من قبيل القواعد الصارمة أو القيود أو العقوبات). كما تعتمد السياسة الصناعية في هذه السياقات على إشارات الأسعار والتنسيق السوقي، أكثر من اعتمادها على التوجيه الحكومي أو نهج الانضباط الصارم. وتميل إلى تبني شكل ضيق من التدخل الحكومي يركّز على تعديل منحنيات المخاطر والعوائد في الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، أو ما يُعرف بـ«تقليل المخاطر» للمشروعات بهدف جذب الاستثمار الخاص. لكنّ الاستخدام الواسع لمثل هذه الاستراتيجيات يرسّخ التبعية المالية، لا سيما في دول تعاني من تبعية هيكلية ضمن الهرميات المالية والنقدية العالمية، ما يزيد من مخاطر تعرضها لأزمات ديون وهروب مفاجئ لرؤوس الأموال.
ليس المقصود من ذلك أنّ الدول النامية تفتقر إلى القدرة على تصميم وتنفيذ خطط السياسة الصناعية في سبيل تحقيق رؤى استراتيجية. إلّا أنّ الأمر يكشف عن أنّ السياسة الصناعية تشتغل ضمن اقتصاد سياسي عالمي تتشكّل ملامحه بفوارق القوة والعنف الخفي للنظام المالي والنقدي العالمي. ومن ثم، فالسؤال الحاسم ليس عن اتساع هامش التصرف في السياسة الصناعية فحسب، بل يتعداه إلى نوع السياسة الصناعية المتبعة وفي أي ظروف وبأي أكلاف، خاصة فيما يتعلق بالتحويلات العامة إلى القطاع الخاص وتعزيز التفاوت في السلطة والاقتصاد.
المنافسة الجيوسياسية
يشكِّل تصاعد التنافس الجيوسياسي العديد من الاختلالات البنيوية ويحركها. فالاقتصادات المتقدمة تكنولوجياً تخوض عملية محاكاة تنافسية، حيث تُطبَّق السياسات الصناعية بطريقة استراتيجية ومستمرة استجابةً لما يتبناه المنافسون الجيواقتصاديون. هذا السباق في السياسات الصناعية يُحدث تأثيراً مضاعفاً، يتجلّى بوضوح في المنافسة على تقديم الإعانات، من قبيل «سباق الدعم الأخضر»، وازدياد الإجراءات التجارية الدفاعية، ومن بينها فرض رسوم جمركية متبادلة على السيارات الكهربائية.
تتمتع دول نامية معيّنة بموقع متميّز يؤهلها للاستفادة من هذا التنافس الجيوسياسي. يسميها صندوق النقد الدولي «دول الربط»، أما غولدمان ساكس فيسميها «دول التأرجح الجيوسياسية». من بين هذه الدول هنغاريا وبولندا والمغرب وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك، وهي تكتسب أهميتها من قربها الاستراتيجي من الأسواق الرئيسة أو امتلاكها أصولاً استراتيجية كالمعادن الانتقالية الحيوية والصناعات القائمة على التصدير ووفرة اليد العاملة الماهرة (أو مزيج من هذه العوامل). وتعدّ هذه الدول أيضاً مرشحة بقوة لتكون ضمن استراتيجيات «الصين+1»، حيث تسعى الشركات بموجبها إلى تقليل مخاطر التعرض للصراعات الجيوسياسية عبر تنويع مواقع الإنتاج خارج الصين.
على سبيل المثال، تشجع الصفقة الخضراء الأوروبية الاستثمار في التقنيات النظيفة المحلية، مع الاعتماد في الوقت نفسه على مصادر الطاقة المتجددة من دول أفريقية من بينها المغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا. وعلاوة على ذلك، وقبل حزمة الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضتها إدارة ترامب، شرعت الولايات المتحدة في إعادة هيكلة سلاسل التوريد الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الشركات الصينية من خلال عمليات «إعادة التوطين»، والأهم من ذلك «التوطين مع الدول الصديقة» (friendshoring)، أي تعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الحليفة. لذا، قد يعود تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بالنفع على دول مثل الهند التي تتطلع إليها شركة آبل اليوم لتكون بحلول نهاية العام 2026 مصدر أكثر من 60 مليون هاتف آيفون تُباع سنوياً في السوق الأميركية.
تسعى العديد من «دول الربط» وغيرها من دول الجنوب العالمي إلى توسيع آفاق طموحاتها الصناعية استجابةً لهذا المشهد الجيواقتصادي المتغير. وقد تبنّت بعض هذه الدول استراتيجية «الانحياز المتعدّد»، مستفيدةً من شراكات مالية متنوعة لتمويل التنمية الصناعية، مع تجنّب الانحياز إلى دولة أو تكتل جيوسياسي بعينه. وتهدف من وراء ذلك إلى جذب الاستثمارات عبر إبراز نفسها شريكاً مستقراً واستراتيجياً لعدد من القوى العالمية الكبرى.
على سبيل المثال، تسعى المغرب إلى جذب الاستثمارات من مجموعة واسعة من الشركاء، من بينهم فرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة والبرتغال وتركيا والإمارات والسعودية وإسرائيل وكوريا الجنوبية وروسيا، لتمويل سياستها الصناعية الخضراء. وقد حققت استراتيجية «الانحياز المتعدّد» هذه نجاحاً باهراً حتى الآن، إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعلنة في المغرب من 3.8 مليار دولار في 2021 إلى 20.4 مليار دولار في 2023. وبالمثل، استقطبت فيتنام تدفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة في قطاع التصنيع من سنغافورة واليابان والولايات المتحدة وكوريا والصين، مسجلةً 4.33 مليار دولار في كانون الثاني/يناير 2025 وحده، بزيادة سنوية بلغت 48.6%. وشهدت المكسيك أيضاً موجة استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية من شركة تسلا الأميركية، وكاتل الصينية، إلى جانب شركات أوروبية وكورية. وعلى المنوال نفسه، اتبعت إندونيسيا استراتيجية طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات «تنموية جديدة» لاستخراج النيكل وتحويله، وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة 55 مليار دولار في 2024، بزيادة 21% عن العام السابق، جاءت من سنغافورة والصين وماليزيا والولايات المتحدة. ومن ثمّ، قد يدفع هذا التوسع المشترك في السياسات الصناعية المدفوع بالمنافسة في القطاعات التكنولوجية المتقدمة، إلى مزيد من التجريب في السياسية الصناعية في بعض دول الجنوب العالمي.
إعادة بناء السلم؟
على الرغم مما يتيحّه هذا السياق الجديد من فرص، فإنه يُبقي على الاختلالات الساحقة في موازين القوى في الاقتصاد العالمي. إذ تظل الدول النامية رهينة لتقلب السياسات وتغير الأولويات لدى الدول الأغنى في الشمال العالمي.
على سبيل المثال، بعد أن بذلت إندونيسيا جهوداً متضافرة لاستثمار احتياطيات النيكل لديها في تطوير صناعات تُنتج مكونات أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة (كبطاريات السيارات الكهربائية) وجدت نفسها محرومة إلى حد ما من أكبر سوق مستهدفة لها، وهي الولايات المتحدة، بعد صدور قانون كبح التضخم في العام 2022. فقد استثنى هذا القانون من الدعم أي منتجات تُنتجها كيانات تمتلك فيها الصين أكثر من 25% من رأس المال. وبما أنّ الشركات الصينية تبني 90% من معامل صهر النيكل في إندونيسيا، وتُنشئ عدة مصانع متخصصة في معالجة البطاريات، فقد توقفت استراتيجية البلاد الصناعية عند هذه النقطة، وبالرغم من محاولات عديدة للتفاوض من أجل الحصول على استثناءات، رفضت الولايات المتحدة التراجع، وطالبتها بالخفض الشديد لدور الصين في هذه الصناعة، وهو أمر يصعب تحقيقه لقلة البدائل التمويلية المتاحة.
كما قد تلتهم المنافسة الدول النامية، لا سيّما تلك الواقعة في منطقة واحدة، إذ تتصارع على جذب الاستثمارات وفرص التصنيع. فمثلاً، تتنافس هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا لتكون قاعدة لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية تصل سلاسل التوريد في شرق آسيا وأوروبا بالأسواق الأوروبية الغربية الغنية. ولكن في نهاية المطاف، سيختار مصنعو السيارات الفرنسيون والألمان والكوريون والصينيون الاستثمار في عدد محدود من المواقع الإنتاجية. ولا يمكن لجميع هذه الدول (هنغاريا وصربيا وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك) أن تصبح عقداً محورية لشبكات إنتاج السيارات الكهربائية في وسط وشرق أوروبا. وبالمثل، في آسيا، ليس بإمكان الجميع الاستفادة من استراتيجيات «الصين+1». فالهند وفيتنام وتايلاند وكمبوديا وماليزيا وغيرها تتنافس بقوة على قطاعات رئيسة من سلاسل توريد أشباه الموصلات والطاقة الشمسية والإلكترونيات، مع مخاطر الانحدار إلى سباق نحو القاع. علاوة على ذلك، تهيمن الصين بالفعل على العقد الرئيسة في سلاسل التوريد، وتمارس سياسة صناعية نشطة. وتحتكر السيطرة على الآلات الأساسية والمعدات الثقيلة والمعادن الانتقالية الحيوية، ما يصعّب على باقي الدول إقامة صناعات عالية القيمة.
في الأشهر الأخيرة، شدّدت الصين ضوابطها الرسمية وغير الرسمية على تصدير تقنيات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية ومعالجة المعادن الحيوية، رداً على الرسوم الجمركية المتزايدة والعدوانية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية وسلع أخرى. وهذا لا يعرقل فحسب قدرة الشركات التايوانية والأميركية وغيرها على نقل جزء من عمليات التصنيع والتجميع خارج الصين استجابةً للمخاطر الجيوسياسية، بل تستهدف الدولة الحزبية الصينية أيضاً الهند صراحةً في محاولة لمنعها من ترسيخ مكانتها كوجهة مفضّلة لإعادة توطين عمليات التصنيع. باختصار، تستخدم الصين سيطرتها على الشبكات الاقتصادية الاستراتيجية لتخريب محاولة دولة أخرى في اتباع استراتيجية الانحياز المتعدّد.
كما تضيف عودة ترامب الفوضوية إلى البيت الأبيض مخاطر كبيرة وحالة من عدم اليقين إلى آفاق الاقتصادات في «دول الربط». المشكلة لا تقتصر على السلوك العشوائي لترامب في ولايته الثانية واستخدامه المنهجي للتخويف كوسيلة لممارسة السلطة، بل تشمل أيضاً فرضه المتهور لرسوم جمركية هدفها إعادة تشكيل ملامح النظام العالمي، ما يهدد بتقويض النظام التجاري العالمي والبنية المالية الدولية. ومن البديهي أنّ هذا لا يتناسب مع استراتيجيات الانحياز المتعدّد والسياسات الصناعية الموجهة نحو التصدير في الجنوب العالمي.
أخيراً، على الرغم من أنّ الأهداف البيئية وفرص العمل في قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي تُقدَّم في الغالب على أنّها تكاملية، فإنّ السعي لتحقيقها من خلال سياسات صناعية تنافسية يخلق في الواقع توترات بينها. فالتنمية الخضراء تعتمد على سياسة صناعية فعالة، غير أنّ تطبيقها غير المتوازن يفرض مخاطر أوسع، لا سيما مع بقاء سياسات المناخ في الدول الغنية أحادية الجانب وعالية التنافس وإقصائية في الغالب. فمن خلال الحد من انتشار التقنيات الأساسية وحماية الملكية الفكرية والاحتفاظ بالمعرفة التقنية وإقامة الحواجز التجارية والاستثمارية بذريعة المنافسة الجيوسياسية، تُخاطر هذه السياسات بجعل التكنولوجيا النظيفة أكثر كلفة، وإبطاء وتيرة التحول الطاقيّ على مستوى العالم. فمثلاً، باستبعاد السيارات الكهربائية الصينية من السوق الأميركية، تضعف فرص الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها بخفض الانبعاثات، نظراً لتراجع تطور هذه الصناعة داخلها. وباختصار، حين تتبع عدة دول سياسات التصنيع الأخضر في آن واحد، قد يأتي نجاح بعضها في (إعادة) التصنيع أو تطويره على حساب أخرى.
نحو سياسة صناعية عالمية ثلاثية المستويات
هذه الديناميات مجتمعة قد تعمّق، وفي النهاية ترسّخ، هرمية ثلاثية المستويات في تطبيق السياسات الصناعية العالمية. في قمة هذا الهرم، تتمتع الاقتصادات الغنية والمتقدمة تكنولوجياً، ذات القدرات المالية الضخمة والسيطرة الاستراتيجية على سلاسل القيمة العالمية، بهامش واسع من الحرية لتطبيق سياسات صناعية متزايدة الجرأة، في ظل تنافسها الشرس فيما بينها، ومحاولاتها احتواء الأزمات الاقتصادية، والاستقطاب السياسي الداخلي، وتسارع التغير المناخي. وهذه الدول صاحبة المزايا البنيوية ستعزز وتوسع ريادتها الاقتصادية وتفوقها التكنولوجي.
تضمّ الفئة الثانية الاقتصادات الناشئة الكبرى ذات الأهمية الجيوستراتيجية التي تمتلك قدرة انتقائية على تطبيق السياسة الصناعية لتكون نقاط محورية في شبكات الإنتاج المُعاد هيكلتها، بدلاً من الاندماج السلبي في الأسواق العالمية. ويتوقف نجاحها على قدرتها في تأمين نقل التكنولوجيا وشروط تمويل مواتية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتمويل المناخي. كما يعتمد ذلك على قدرتها على المناورة ضمن سياق جيوسياسي مضطرب وإعادة الاصطفاف السريعة في الهرمية الإمبريالية للرأسمالية العالمية. وهذا بدوره يؤثر في قدرتها على صياغة استراتيجيات صناعية خضراء طموحة وطويلة الأمد تعزز التحول الهيكلي والاستدامة البيئية والتنمية الشاملة.
لكن لكثير من الدول النامية الأخرى، من المرجح أن تبقى مساحة السياسة محدودة بشدة، وأن يحمل التجريب السياسي مخاطر متزايدة. ستظل الظروف الخارجية تطالب بالامتثال لما يُعتقَد أنّه متطلبات ملحة للمستثمرين الخاصين، وقد تصبح هذه الدول أكثر عرضة لتقلبات أهواء الهيمنة، سواء القديمة أو الجديدة.
أعظم المخاطر إذن تكمن في أنّ إحياء السياسة الصناعية المعاصرة لن يعيد بناء سلم التنمية للحاق بالركب، بل يرفع ذلك السلم أكثر فأكثر بعيداً عن متناول بعض الدول. وباختصار، قد لا يقتصر الأمر على ترك بعض البلدان خلف الركب، بل قد يزيد من تهميشها.
نُشِر هذا المقال في 14 حزيران/يونيو 2025 في Phenomenal World، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع صفر باتفاق مع الجهة الناشرة.