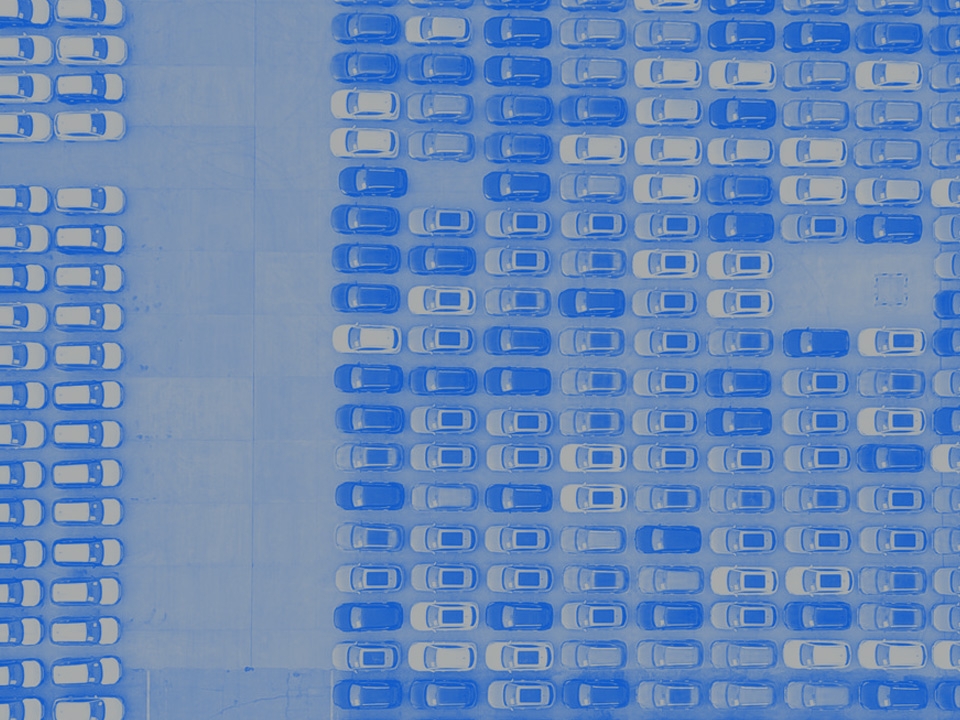هل تكسر الصين أخيراً القبضة الخانقة الأميركية؟
تخوض الولايات المتحدة «منافسة» اقتصادية وعسكرية مريرة مع الصين، وقد خسرت كثيراً من الأرض بسرعة فائقة.
والطبقة الحاكمة الرأسمالية في أميركا تعني بـ«المنافسة» فعلياً ترسيخ هيمنتها على الصين، ومنع المجتمع الصيني من التطور بأي شكل يقلّص سيطرة الولايات المتحدة على الصين وبقية العالم.
في المقابل، تروم السياسة الصينية التحرر من قبضة الإمبريالية الخانقة التي أحكمت على الجنوب كله ووضعته في دائرة الفقر والتبعية لما يزيد عن قرن.
انعقد إجماع عريض على أنّ الولايات المتحدة تخسر أو توشك أن تخسر هذه المواجهة، ما لم تتخذ إجراءات حاسمة؛ وقد أسفر هذا الإدراك عن رسوم ترامب الجمركيّة على الصين، وأسفر من قبلُ عن سياسات مماثلة منها برنامج بايدن السخيّ لإغداق الدعم على الصناعة الأميركية وحظر التقنيات عن بكين. تتباين سياسات الرجلين، غير أنّ النية واحدة: سحقُ الصين.
لا يُجسِّد هذا الصراع «تنافس القوى العظمى» كما تريد لنا البروباغندا الشوفينية المعادية للصين أن نصدِّق؛ فرفع هذا الشعار يطمس حقيقةَ المواجهة، إذ يدور بين مجتمعين مختلفين جذريّاً. فالصين مجتمع جنوبي هائل مستقلّ الإرادة السياسية، يسعى إلى انتزاع اليدين الخانقتين عن عنقه. أما الولايات المتحدة فأغنى دولة رأسمالية وأعنفَها على الكوكب. وتحاول الولايات المتحدة جهدها، ومعها حلفاء أثرياء (كأستراليا)، إبقاء قبضتها الخانقة على الصين، وعلى الجنوب العالمي بأسره.
من وجهة نظر العنصريين الإمبراطوريين، لا قيمة لحقّ مليارٍ وأربعِ مئة مليون صينيّ في عيشٍ كريمٍ وتنمية، ولا للجنوبِ العالميِّ كلِّه. ويحمل اشتراكيّو الشمالِ ممن يُقِرّون بوجود «تنافس بين القوى العظمى» لكن يستبدلون به عبارة «تنافس بين إمبرياليّ» رأياً مماثلاً ولا بد.
ليس للصين قبضة خانقة على عنق الولايات المتحدة
يتمثّل «التهديد» الحقيقي من الصين على الإمبريالية في أنّ بكين قد تكسر قيد الخضوع أو تخففه. فالصين بإبعادها أصابع الإمبريالية عن حنجرتها، وكسبها لمجتمعها متنفساً أرحب، تسعى إلى تخفيف درجة استغلال المجتمعات الإمبريالية لها. هنا يكمن التهديد الحقيقي الذي تطرحه التنمية الصينية على الإمبريالية.
لقد أقامت اقتصادات الشمال توسُّعها وتراكم ثروتها، ولا سيما في العقود الثلاثة الأخيرة، فوق أكتاف العمال في الصين وسائر الجنوب؛ فقامت صناعاتُ القرن الجاري على جيش صناعيٍّ جنوبيّ ضخمٍ متنامٍ ومتزايد الإنتاجية ومستغَل أقصى الاستغلال. لكن، بعد عقود من التقدّم، يبقى النادي الضيّق نفسه من الدول، وفيه أستراليا، أغنى بأضعاف من جميع مجتمعات الجنوب، بما فيها الصين.
لا تهدّد التنمية الصينية بإخضاع القوى الإمبريالية. لكنّ المجتمعات الإمبريالية لا قِبَل لها على الاستمرار بشكلها الراهن ما لم تحافظ على إخضاع الصين والجنوب
شادت الإمبريالية رخاءها على استغلال الجنوب؛ تلك هي الحقيقة الأساسية الكامنة خلف هستيريا العداء المفرط للصين. لا تهدّد التنمية الصينية بإخضاع القوى الإمبريالية. لكنّ المجتمعات الإمبريالية لا قِبَل لها على الاستمرار بشكلها الراهن ما لم تحافظ على إخضاع الصين والجنوب. لذا كل تقدّم تحرزه الصين يهدِّد الإمبريالية. وتهدِّدها بخسارة قدرتها على الاستغلال أو درجة الاستغلال (أعني شفط الثروة، أو «القيمة» إذا شئنا استخدام المصطلح الماركسي، التي ينتجها العمّال في الصين وتمثّل رافداً جوهريّاً لأرباح الإمبريالية). هذا الاعتماد الطفيليّ استحكم حتى ارتهن له المجتمع الإمبريالي، ولا سبيل إلى الفكاك منه من دون دخول ذلك المجتمع في أزمةٍ ضارية.
فضلاً عن ذلك، إذا مكّنت التنمية الصينية شعبها من انتزاع الأكفّ الكابسة على عنقه، أو على الأقل نزع يدٍ خانقةٍ واحدةٍ أو بعض أصابعٍ تضغط على حنجرته؛ فإنّ لهذا التهديد احتمالاتٍ غير محسوبة قد تمهّد الدرب لبلدان الجنوب لتحذو حذو الصين.
الاحتكار الإمبريالي والصين اليوم
يعزى تمكّن الدول الإمبريالية من الاستيلاء على معظم الثروة المتولِّدة في مصانع الجنوب إلى احتكاراتها التكنولوجيّة والعِلميّة. إنّها القبضة الإمبريالية الخانقة في شكلها الأصلي ومنها تتفرّع سائرُ أشكال الاحتكار الإمبرياليّ الماليّ والعسكريّ والتجاريّ. وهذه الحقيقة يعترف بها صراحةً كلٌّ من السياسة الإمبريالية والسياسة الصينيّة على حدٍّ سواء.
يركّز السؤال «أترى الصين تفكّ الخِناق؟» على قدرة الصين على فك الخِناق العلمي المفروض من الولايات المتحدة والدول الإمبريالية الأخرى. وللإجابة، يلزمنا معرفة كيف يتجلّى احتكار المعرفة الإمبريالي في الإنتاج الرأسمالي العالمي المُوجَّه للسوق العالمية، وفي التقسيم الدولي للعمل بين الدول الإمبريالية ودول الجنوب. ولمعرفة كيف تعمل المنافسة في الحقيقة، لا يكفي التطلّع من علٍ؛ بل ينبغي الاقتراب ورصد سيرورة العمل عند مختلف المنتجين، والتأمّل في كيف تغدو أصناف العمل المتمايزة أساساً لاحتكارٍ هنا، أو تعجز عن ذلك هناك.
ترتكز الهيمنة الإمبريالية الحديثة على احتكار الدول الإمبرياليّة القدرةَ على «تثوير أدوات الإنتاج» (على حدّ تعبير ماركس في البيان الشيوعي). لم تُقدِم الصين على اختراع تقانةٍ جديدةٍ «تثوِّر أدوات الإنتاج»، وعلى الأرجح لا تستطيع ذلك. ولم تطرح شركاتها في الأسواق ابتكاراً علميّاً يضاهي، مثلاً، الكهرباء أو النفط أو الإنترنت.
غير أنّ تأمُّل الطليعة الصناعيّة في الصين اليوم يكشف عن بداية ظاهرة لافتة. فالتسارع المضطرد في قدرة المنتجين الصينيّين على استيعاب التقنيات القائمة وتطويعها شرع يقوِّض مقدرة الدول الإمبرياليّة على تسويق تقنياتها الجديدة بأسلوب احتكاري فائق الربحيّة اعتادت عليه الإمبرياليّة عبر تاريخها.
تكاثرت في العقدين الماضيين المزاعم بأنّ الصين شرعت تحل محل الولايات المتحدة. تركزت معظم المنافسة الصينية حتى زمن قريب في ميادين الإنتاج منخفضة القيمة والهامشية. لكن الجديد أنّ المنتجين الصينيين باتوا قادرين على استيعاب تقنياتٍ تتربّع في المراتب العليا من سلسلة القيمة. هذه ظاهرة جديدة لم تظهر على نطاق واسع إلّا عقب جائحة كورونا.
استجابت بكّين لتباطُؤ نموِّها، ولا سيّما انفجار الفقاعة العقارية في العام 2021، بضخّ محفِّزاتٍ حكوميّة في قطاع التصنيع. تركزت تلك المحفزات في ما تُسمّيه السياسة الصينية «قوى الإنتاج النوعيّة الجديدة»، وفي القلب منها «الثلاثيّ الجديد» في الصناعة: السيارات الكهربائيّة والبطاريات ومنتجات الفوتوڨولتيك ومن ضمنها الألواح الشمسيّة. الحال أنّ السوق المحلّي الصيني ضخم، غير أنّ ضخامة هذه الصناعات تفرض اعتماداً كثيفاً على التصدير. وقد هدَّدت موجة الصادرات الصينية الرخيصة الشركات المنافِسة في دولٍ إمبرياليّة كثيرة، حتى وُسمت الظاهرة بـ«صدمة الصين الثانية». هكذا جاء قسم كبير من رسوم ترامب الجمركية وسائر أشكال العدوان الاقتصادي الأميركي ردّاً مباشراً عليها. وفهمُ الخصائص الأساسية لهذه الموجة يُعدّ مدخلاً لازماً لاستيعاب حالة التنافس بين الصين والولايات المتّحدة.
التنمية الصينية وأرباح الإمبريالية الفاحشة
وقعت «صدمة الصين» الأولى بعد انضمام بكّين إلى منظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2001؛ فتدفّقت صادراتٌ صينية رخيصة في صناعات منخفضة القيمة منها الملابس والأحذية والمنسوجات والأثاث والسلع الاستهلاكية الرخيصة، وهي ميادين انكفأت عنها احتكارات الإمبريالية الكبرى لهزال أرباحها. وتُظهِر مقارنة الصدمتين مدى تحوّل طبيعة المنافسة بين الصين والولايات المتحدة.
تشيع الأسطورة الوطنية الأميركية أنّ التقدّم السريع للتصنيع في الصين، ولا سيّما بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، دَمَّر قطاع الصناعة الأميركي فأفقده ملايين الوظائف ومحا مجتمعاتٍ صناعيةً برمتها. تكشف الوقائع خلاف ذلك؛ فقد بدأ تراجع العمالة الصناعية في الولايات المتحدة قبل ظهور الصين في سوق الرأسمالية العالمية بسنوات طويلة. ويرجع بالأصل إلى ارتفاع إنتاجية العمل داخل أميركا بفعل استبدال المصانع بالعمل اليدويّ مستويات متزايدة من الأتمتة. وبينما تقلّصت فرص العمل الصناعية، ارتفعت القيمة المطلقة للناتج الصناعي الأميركي، بما في ذلك بعد 2001.
إلى جانب الأتمتة، كان من أسباب تراجع فرص العمل في الصناعة الأميركيّة حدوث تحوّلات عميقة في سيرورة الإنتاج والتقسيم الدولي للعمل، دبّرتها الطبقات الحاكمة الإمبرياليّة، وفي طليعتها واشنطن، لابتغاء مكاسبها الخاصّة. كان التخصّص التقني العالي أساس «العولمة النيوليبرالية» لعمليّات التصنيع في الثمانينيات والتسعينيات وبداية الألفيّة. يظل الفيصل هنا صنف العمل الذي يقدّمه كلُّ بلدٍ إلى سيرورة العمل الكلّية.
ينقسم نمطُ التخصّص الإنتاجيّ (ولا يزال) انقساماً يعكس الفوارق بين ثروة الدول ودخلها. تتخصّص بلدانُ الجنوب العالمي فيما سمّاه سمير أمين العمل «العادي» بصنوفه المتعددة. تتخصص الدولُ الإمبرياليّة بنقيضه: العمل التقني والعلمي العالي. هذا التخصص في أنماط العمل، ومن ثمّ التخصص الإنتاجي، يُطابق خريطة الفقر والثراء على سطح الكوكب، وهو السبب الأوّل في اتساع الهوّة الهائلة بين ثروات الأمم.
كانت الصين لفترة طويلة الوجهة الأبرز للتحوّل جنوباً في سيرورات العمل العادي، ولا سيّما بعد 2001، غير أنّها لم تكن الوجهة الوحيدة. ولم تُملِ هذا المسار أو تُمسك بزمامه. وكثيرٌ من المصانع المتزايدة على أراضيها جاء نتيجة نقل شركات أميركيّة خطوط إنتاجها إلى الصين ثمّ إعادة السلع إلى السوق الأميركيّة (يدأب المخطّطون الأميركيون منذ أعوام على محاولة نقل جل ذلك الإنتاج صوب المكسيك أو دول أخرى في الجنوب يأملون إخضاعها بيسر أكبر).
لقد جاء ارتقاء الصين السريع إلى مصاف الدول الصناعية والمُصدّرة في إطار هذه المنظومة الإمبرياليّة بقيادة واشنطن. وجنت الرساميل الأميركيّة أرباحاً فاحشة مهولة من هذا الترتيب المعولم. فقد ضاعف الاستغلال الفائق لعمال الصين وسائر الجنوب ربحية رأس المال الأميركي إذ خفّض كلفة الإنتاج ورخَص ثمن السلع الاستهلاكيّة، فسهُل كبح الأجور المحليّة. وصحيح أنّ بعض الرأسماليّين الهامشيّين تخلّفوا وأفلسوا، غير أن رأس المال الأميركي بالمجمل غدا أغنى من أيّ وقت مضى، ولا سيما رأس المال الكبير.
لم تكن «صدمة» تدفّقُ السلع الاستهلاكية الصينية إلى السوق الأميركية في العقد الأول من الألفية السبب الرئيس لتشريد مجتمعات العمّال في المناطق الصناعية السابقة، لكنه كان كبش فداءٍ سهل. سعى الرأسماليون الأميركيون، منذ السبعينيات والثمانينيات، إلى تحطيم النفوذ الصناعي والاجتماعي للطبقة العاملة داخل البلاد. اعتمدوا، لتحقيق ذلك، على نقل سيرورات العمل العادي إلى الخارج (أي تنظيم التقسيم العالمي المستقطَب للعمل والموصوف أعلاه)، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأتمتة.
نمطُ العولمة المستقطبة
يبدو الزعمُ أنّ الولايات المتحدة اليوم عاجزة عن مجاراة الإنتاج الصيني، وأنّ تشديد رسومها الجمركية ليس إلا ردّاً على تراجع قدرتها التنافسية، مجرّد تجريدٍ نظري. يصحّ هذا الحكم على بعض السلع أو الخدمات دون غيرها، غير أنّ الاختلاف هنا ليس اعتباطياً، بل ينتظم وفق نمط محدّد مفهوم.
بالفعل، تعجزُ الولايات المتحدة عن مجاراة بنغلاديش أو إندونيسيا، فضلاً عن الصين، في إنتاج معظم الملابس والأحذية؛ إذ تستوردُ على سبيل المثال أكثر من 99% من حاجتها من الأحذية. في المقابل، تستطيع واشنطن المنافسة وتتفوق في طيفٍ واسعٍ من السلع الأخرى. على سبيل المثال، تصدِّر الولايات المتحدة كميات هائلة وتحقِّق فوائض في النفط والغاز، والطائرات وقطع غيارها، وأنواع مخصصة من الآلات، وبعض المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الخدمات المالية والتجارية وصناعة الإعلام. فما السبب في هذا التباين؟
تركزت معظم المنافسة الصينية حتى زمن قريب في ميادين الإنتاج منخفضة القيمة والهامشية. لكن الجديد أنّ المنتجين الصينيين باتوا قادرين على استيعاب تقنياتٍ تتربّع في المراتب العليا من سلسلة القيمة
لنفهم النمط ليس علينا سوى أن نستحضر صنفَي العمل المتقابلين في مجمل سيرورة العمل: العمل العادي والعمل الرفيع العلمي أو التقني. صنف العمل الغالب في أيّ عملية إنتاج يحدّد أي شيء تنافسي يمكن إنتاجه في اقتصادات الشمال حيث العمل مكلف أو في الجنوب حيث العمل رخيص. فإن تكوّنت السلعة (أو جزءٌ منها) من عمل علمي وتقني رفيع، ترجح كفّة منتجي دول الشمال مرتفعة الأجور. أمّا إن استندت في الأساس إلى عمل «عاديّ»، فدول الجنوب ترجح كفتها وتنتجها.
حين يتكوّن المنتج المعقّد من خليطٍ من هذين الصنفين من العمل، يميل إنتاجه إلى التعولم: يُنجز جزء منه في دول الجنوب رخيصة اليد العاملة، ويُستكمل في دول الشمال الإمبريالية مرتفعة الأجور. وتتميّز قطاعاتٌ وسلعٌ كثيرةٌ بهذه الطبيعة المركّبة، إذ تتداخل فيها درجاتٌ متفاوتة من صنفي العمل كليهما. وفي هذه الحال، لا تدور المنافسة فحسب حول أيّ شركة أو منتج يُباع في السوق (أو حول تسعيره)، بل تتسع لتشمل أي الشركات (وأي المجتمعات) تحصّل لنفسها الجزء الأكبر من العوائد المالية عند بيع هذه السلعة.
وبديهي أنّ مساهمة بلد ما بنسبة 50% من اليد العاملة اللازمة لإنتاج سلعة معيّنة، في مقابل حصوله على 10% لا غير من ثمن بيعها النهائي، إنّما تمثّل موقعاً غير احتكاري. ولعلّ أشهر الأمثلة هنا هاتف آيفون من شركة آبل، إذ أظهرت دراسات عديدة أنّ نسبة الصين من ثمن البيع النهائي لا تتجاوز 10%، على الرغم من تجميع الجهاز داخل أراضيها، ومساهمة المنتجين الصينيين بجزء كبير من العمل المطلوب لإنتاجه.
ما لا يُعرف على نطاق واسع أنّ هذه الديناميّة نفسها تنطبق أيضاً على منتجات معقّدة تطرحها في الأسواق شركات من بلدان الجنوب. فمثلاً، الطائرة المدنية الصينية «كوماك سي 919» تعتمد على شركات أميركية وفرنسية، منها جنرال إلكتريك وهانيويل، في تزويدها بمكوّنات متقدّمة كالمحرّك وأنظمة الطيران الإلكتروني ووحدات الطاقة المساعدة ونظام التحكّم الطيراني عبر الإشارات (fly-by-wire) وأنظمة الملاحة. وحتى إن تكبّدت شركة كوماك خسائر، فإنّ هذه الشركات الإمبريالية تظل قادرة على تحقيق أرباح احتكارية، بل إنّها قادرة على دفع كوماك نحو الخسارة من خلال فرض أسعار باهظة، إذا ظلت الصين تعتمد على هذه الشركات في تأمين المدخلات التقنية العالية.
إيقاع تكوين الاحتكار وكسره
تسويق التكنولوجيا الجديدة (تنتجها في العصر الحديث الدول الإمبريالية لا الشركات) يمنح الشركات الاحتكارية في الدول الإمبريالية أرباحاً فاحشة. فصناعة النسيج في مانشستر في القرن التاسع عشر، أو صناعات السيارات وبناء السفن والمكائن في الولايات المتحدة في القرن العشرين، أو حالة «السبعة العظام» من عمالقة التكنولوجيا الأميركية اليوم، حصلت جميعها على أرباحها الفاحشة (أي أرباح تفوق المتوسط العام) نتيجة لتفوّقها التكنولوجي على منافسيها في عصرها.
غير أنّ أي عمليّة إنتاجية تبدأ كتكنولوجيا متقدّمة لا تبقى كذلك إلى الأبد. فتلك العملية مع شيوعها واستقرار معارفها وتنميطها، تنزلق بالتدريج وقد خبت جدّتها نحو خانة إنتاج لا يتطلب، في معظمه، سوى «عمل عادي». وحين تكتمل هذه النقلة، تضعف أو تنعدم الحاجة للعلم والخبرة المتقدمة. وعلى سبيل المثال، كانت هذه حالة معظم صناعة الملابس منذ زمن بعيد.
وحين يغدو الإنتاج نمطياً مستقرّاً، تنتفي من صلب العملية الإنتاجية أي مرتكزات تتيح للشركات احتكاره. فكلما ازداد عدد المنتجين القادرين على تصنيع السلع نفسها أو نظائرها، جفَّت ينابيع الأرباح الاحتكارية الفاحشة (أي تلك الأعلى من المتوسط) وانكمشت إلى حدود الأرباح العادية أو دونها. وعند هذه النقطة، يصير من العبث، بمنطق الرأسمالي، الاستمرار في دفع أجور مرتفعة لليد العاملة في بلدان الشمال، لقاء أعمال يمكن تنفيذها، بكفاءة مماثلة، عبر عمالة أرخص بكثير في بلدان الجنوب.
بالنظر إلى دور الصين في السوق العالمي طوال العقود الأخيرة، بتنا على دراية وثيقة بهذا الإيقاع من الاحتكار وكسره. لقد اشتهرت الشركات الصينية منذ زمن بقدرتها الابتكارية الفريدة على الهندسة العكسية لكثيرٍ من أصناف المنتجات وإعادة هندستها. وعلى الرغم من التقليل من المنتجات الأولى لهذه القدرة بحجة أنّها نسخ «مقلدة»، يُظهر الواقع أنّ الشركات الصينية الأقدر عالمياً على هذا النوع الخاص من البراعة: تطوير أساليب جديدة لتبسيط تصنيع المنتجات، وبالتالي تخفيض كلفتها، مع الحفاظ على تماثلها أو تقاربها مع المنتجات الاحتكارية الأعقد. وهذه سِمة مهمّة من سمات الإنتاج الصيني، بل سِمة تقدّمية اجتماعياً أيضاً.
الحال أنّ تبسيط المنتجات القائمة يخدم تطوّر القوى الإنتاجية البشرية، لكنّه لا يُفضي إلى ترسيخ موقع احتكاري للمنتجين الصينيين. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك روبوت المحادثة الصيني «DeepSeek AI». فهو لا يكتفي بالتفوق على نظائره من الروبوتات الأميركية المنافِسة، بل يُحرز نتائج مماثلة أو قريبة باستخدام موارد أقل بكثير (لا سيّما الطاقة) ورقائق أقل تطوراً. إنّ DeepSeek لا يُؤسِّس احتكاراً تقنياً لنفسه. بل إنّ تبسيط العمل وتحقيق النتائج ذاتها بمعالجات أدنى تقنياً يعني تقويض الطابع الاحتكاري للعملية برمّتها، بما يضرّ بالشركات الأميركية التي بنت قراراتها الاستثمارية على افتراض ديمومة موقعها الاحتكاري.
هذا التخصص في أنماط العمل، ومن ثمّ التخصص الإنتاجي، يُطابق خريطة الفقر والثراء على سطح الكوكب، وهو السبب الأوّل في اتساع الهوّة الهائلة بين ثروات الأمم
ومن خلال هذا النمط من المنافسة مع منتجين لا احتكاريين من الجنوب العالمي تخلّص رأس المال الاحتكاري الأميركي، طيلة العقود الماضية، من قطاعات التصنيع الأدنى قيمة، مثل صناعة الألبسة والأحذية والسلع الاستهلاكية الرخيصة، أو الصناعات القذرة منخفضة الهامش الربحي، كمعالجة «المعادن الأرضية النادرة» أو غيرها من العمليات البيئية الخطرة والمُضرّة. ولم يكن «فقدان» هذه الأنشطة الإنتاجية المتدنية يشكّل تهديداً حقيقياً لهيمنة الإمبريالية الأميركية في السوق العالمية. بل إنّ سحب الاستثمارات منها وإعادة توجيه الاستثمار نحو قطاعات هوامش ربحيتها أعلى كان جزءاً محورياً من إعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي في الحقبة النيوليبرالية، بهدف الحفاظ على موقعه المهيمن.
وهذا الإيقاع المتواصل من احتكار فكسر احتكار يفرض على الشركات الإمبريالية أن تبتكر، على نحو منتظم، عمليات إنتاجية متقدمة وجديدة، وتطرحها في السوق بوتيرة سريعة تكفل لها احتكارها وصدارتها قبل أن تنهار احتكاراتها القديمة. لا ريب أنّ بعض الشركات تخفق في تحقيق ذلك، لكنّ بالمجمل أفاد النظام في الماضي الطبقات الحاكمة الإمبريالية ككل. بيد أنّ الأمور، في الآونة الأخيرة، توحي بأنّ تلك الطبقات قد بدأت تفقد توازنها.
الطابع اللا احتكاري للإنتاج الصيني
من المهم التشديد مجدداً على أنّ الاحتكار الإمبريالي، حين تقوّضه المنافسة القادمة من بلدان الجنوب العالمي، لا يُستبدل به احتكارٌ من تلك البلدان، أو على الأقل احتكار من النوع نفسه. ومثال DeepSeek يُجسّد هذا النمط العام. إذ بتبسيط المنتج، يتغيّر معه نوع العمل المطلوب لإنتاجه من عملٍ متقدّم إلى عمل «عادي».
ولهذا السبب، يمكن للرأسماليين في أرجاء شتى من الجنوب أن ينهضوا بهذه العمليات بسهولة أكبر. فكل عملية إنتاجية تُبسّط على هذا النحو تفقد طابعها الاحتكاري. ذلك أنّ المُنتِج لا يسعه أن يرفع سعر منتجه (ليكسب ربحاً فوق المتوسط) إذا أمكن إنتاجه بسهولة نسبية. فالسيطرة على عملية إنتاجية منمّطة لا تصلح أساساً لضمان استمرار الأرباح الاحتكارية الفاحشة.
تعود العمليات الإنتاجية المتقدّمة بأرباح احتكارية فاحشة، أمّا العمليات المنمّطة فلا تُدرّ سوى أرباح غير احتكارية. وبوجه عام، لا تستطيع الصين أن تحقّق إلا هذا النوع الثاني من الأرباح، حتى في القطاعات الصناعية المتقدّمة نسبياً حيث تمكّنت فيها من كسر الاحتكارات والتفوّق في المنافسة العالمية.
إنّ هذه الدينامية الشرسة التي تضغط على الصين تعزّزها بقوّة طبيعة إنتاج السلع من أجل السوق العالمية. فالأرباح اللا احتكارية التي تجنيها الصين وسائر منتجي الجنوب (أي تلك التي تقلّ معدلاتها عن أرباح منافسي الصين من الدول الإمبريالية) محدودة بطبيعتها، ولا تكفي لتمويل استثمارات بالحجم المطلوب لابتكار تقنيات جديدة على مستوى العالم. وليس هذا فحسب، بل إنّ تقسيم العمل الدولي الراسخ والمستقطب بين المنتجين في السوق العالمية يعني إجبار الجزء الأكبر من القوة العاملة في الصين وفي سائر مجتمعات الجنوب على أداء أشكال من العمل الروتيني المعياري، لا العمل العلمي. ولا بد أن يسفر هذا بالضرورة عن ترسيخ حواجز ثقافية إضافية تحول دون أي محاولة لـ«تثوير» عملية الإنتاج.
كما أسلفنا، ما من سبيل لامتلاك الصين احتكارات تكنولوجيّة على مستوى السوق العالمية إلّا عبر تقديم ابتكاراتٍ علميّة جديدة. غير أنّ الصين لم تُقدّم إلى السوق أي تقنية كبرى جديدة حتى الآن. والسبب الجوهري في ذلك يعود إلى أنّ التقسيم الإمبريالي للعمل على الصعيد العالمي، والاحتكار التاريخي للمعرفة العلميّة، لا يُتيحان للجنوب أن يكون مبدعاً على ذلك النحو. وما دامت الصين وسائر بلدان الجنوب حبيسة منطق السوق الرأسمالية العالمية، يظل نظام الأبارتيد العالمي على حاله ويستمر.
يفسر لنا الطابع اللا احتكاري لمعظم الإنتاج الصيني لِمَ لَم تُفضِ الهيمنة الظاهرة للصين في ميادين إنتاجٍ شتّى، ولا صادراتها الهائلة، إلى ارتفاع كبير في دخلها القومي. فمتوسّط دخل الفرد في الصين اليوم يقلّ بسبعة أضعاف عن نظيره في الولايات المتحدة، وبخمسة أضعاف عن نظيره في أستراليا! وهذا التفاوت الضخم بين النجاح الإنتاجي الساحق وبين تدنّي الدخل ومستوى الاستهلاك، مردّه إلى أنّ الصين تحقّق تفوّقاً في سباق المنافسة على الهيمنة على قطاعات الإنتاج اللا احتكاري حول العالم.
«الصدمة الصينية الثانية» والرعب الإمبراطوري
ما تسمى الـ«صدمة الصينية» الأولى لم تهدِّد احتكارات الدول الإمبريالية في قمّة سلّم الإنتاج، بل عجّلت في حركة نقل الصناعات الدنيا نحو الجنوب. أمّا «الصدمة الصينية الثانية»، فطبيعتها مختلفة كليّاً؛ فهي لا تتعلّق بالمنتجات الرخيصة، بل تمتدّ إلى منتجات متوسّطة أو مركّبة، أبرزها السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية. وهذه صناعات ذات طابع تقني أعلى بكثير، وتمثّل بالتالي نسبة من أرباح الإمبريالية أكبر مقارنةً بمجالات هيمنة الصين السابقة. فصناعة السيارات وحدها، مثلاً، تمثّل رافعة أساسيّة في المبيعات والأرباح لمعظم الاقتصادات الرأسمالية الكبرى.
ثمّة تحوّل كبير آخر لا يقلّ شأناً. في الماضي، دمرت «الهندسة العكسيّة» الصينيّة الطابع الاحتكاري لمنتجات دخلت بالأصل حيّز الإنتاج الكثيف. لقد تمتعت الشركات الإمبريالية بفترة مطولة من الربحية الفائقة. ولم تتمكّن الشركات اللا احتكارية من الظهور إلا بعد حين. هذا ما حدث، مثلاً، في قطاع تجميع الحواسيب الشخصيّة؛ إذ حين استحوذت شركة لينوڨو الصينيّة على أعمال الحواسيب في شركة آي بي أم في العام 2005، كانت الأخيرة قد أنهت مرحلة طويلة من جني الأرباح كان فيها تجميع الحواسيب عملاً متقدماً، ثم آثرت الانتقال إلى مجالات أخرى أربح بعدما خسر هذا العمل طابعه المتقدم.
أما اليوم، في قطاع المركبات الكهربائية، فلا يبدو المشهد مشابهاً لما كان عليه في السابق. فعلى الرغم من أنّ تسويق المركبات الكهربائية المتقدمة بدأ أولاً في المركز الإمبريالي، فإنّ شركةً وحيدة (تسلا) كانت قد بلغت مرحلة الإنتاج الضخم قبل أن تتمكّن الشركات الصينية من بلوغ مستوى جودة مماثل إلى حدّ كبير. وقد تجلّى التحدي الصيني لموقع تسلا الاحتكاري في التخفيضات الكبيرة التي أجرتها الأخيرة على أسعارها في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2024. واليوم، تُسَوِّق شركاتٌ صينية عدّة هذا الطراز من المركبات الجديدة نسبياً (أو الفئة الفرعية المستحدثة من المركبات) قبل أن تُنهي الشركات الأوروبية واليابانية والأميركية الكبرى انتقالها الكامل من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية.
ليست المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات تكنولوجيا جديدة. فعلى سبيل المثال، أصدرت شركة جنرال موتورز في الفترة ما بين 1996 و1999 المركبة الكهربائية (EV1)، استجابةً لقانون أصدرته ولاية كاليفورنيا في العام 1990 ألزم بطرح مركبات عديمة الانبعاثات. وقد لاقت تلك السيارة رواجاً واسعاً. لكنّ جنرال موتورز أوقفت إنتاجها بعد العام 1999، بل استرجعت جميع المركبات المُوزعة ضمن نظام التأجير التمويلي وأتلفتها، وقد روى تلك القصة الفيلم الوثائقي الموسوم مَن قتل السيارة الكهربائية؟ الصادر في العام 2006. وبحسب الفيلم، فقد نجحت شركات السيارات والنفط، بحلول نهاية التسعينيات، في إلغاء ذلك القانون.
الأرباح اللا احتكارية التي تجنيها الصين وسائر منتجي الجنوب محدودة بطبيعتها، ولا تكفي لتمويل استثمارات بالحجم المطلوب لابتكار تقنيات جديدة على مستوى العالم
وفي حين لم تكن التكنولوجيا في حد ذاتها جديدة، فإنّ دخول الصين بقوة إلى مجال تصنيع المركبات الكهربائية يُربك بشدة عملية الانتقال الطاقي لكبريات الشركات الإمبريالية. فهل ستُقدم الاحتكارات الأميركية واليابانية والأوروبية في قطاع السيارات - وهي التي طالما راكمت أرباحاً احتكارية فاحشة من تصنيع وبيع مركبات الاحتراق الداخلي - على التحول إلى المركبات الكهربائية، في وقت تناقصت فيه القدرة على تحقيق أرباح احتكارية فاحشة في هذا القطاع؟ لا تُتّخذ قرارات الاستثمار في النظام الرأسمالي على هذا النحو. ولهذا، جاءت الرسوم الترامبية الهائلة على السيارات الصينية لتحمي شركات صناعة السيارات الأميركية في أثناء خوضها هذه المرحلة الانتقالية.
قد تُشكّل الهيمنةُ الصينية على إنتاج البطاريات عالمياً تهديداً أكبر للإمبريالية الأميركية. فبحسب ما أورده تقرير صحيفة أستراليان فايننشال ريڨيو في عددها الصادر بتاريخ 28 نيسان/أبريل «تشكِّل البطاريات الصينية، مدفوعةً بازدياد الطلب الداخلي في الصين نفسها، قرابة 90% من القدرة العالمية في مجال أنظمة تخزين الطاقة، متربعة على أكثر من 80% من الحصة السوقية داخل الولايات المتحدة، وما يفوق 75% في أوروبا».
يسعنا من جديد أن نرى في إنتاج البطاريات النمط نفسه: منتجات صينية مماثلة لكن أرخص. البطاريات غير الصينية ذات المحتوى العالي من النيكل (وهذه تُصنع غالباً في كوريا الجنوبية) تتميّز بكثافةٍ طاقية أعلى من البطاريات الصينية القياسية، بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. يجعل هذا من البطاريات الكورية منتجاً من الطراز العالي. غير أنّ صحيفة أستراليان فايننشال ريڨيو تشير إلى أنّ «صعود البدائل الصينية الأرخص وذات الأداء الأعلى بازدياد، قد أسفر على مدى العقد الماضي عن تحوّلٍ نحو بطاريات الليثيوم لتصبح المعيار الصناعي الجديد». وتُضيف الصحيفة أنّ «الشركات الكورية... بدأت تبني خطوط إنتاج جديدة لبطاريات الليثيوم، وتحوّل بعض خطوط عالية النيكل» إلى الليثيوم. كما أنّ الشركات الكورية الرائدة في هذا المجال من أمثال إل جي وسامسونغ لم تتمكن بعدُ من إنتاج بطاريات الليثيوم بكفاءة تنافسية وبكميات ضخمة.
يبدو أنّ المشكلة مع إنتاج السيارات تتكرّر مع إنتاج البطاريات، وربما بدرجة أكبر. تواجه الشركات الأعلى كلفة في بلدان الأجور الأعلى (في حالتنا هنا كوريا واليابان) صعوية في منافسة الصين في تكنولوجيا ليست متقدمة (أي بطاريات الليثيوم ذات الكثافة الطاقية الأقل). غير أنّ هذه التقنية إذا هي قد هيمنت، أو حتى صارت معياراً صناعياً، فإنّ أمام مُنتجي الدول الغنية خيارات محدودة - إلا إذا أُقيمَت حواجز جمركية شاملة.
في معرض حديثه عن انتشار الروبوتات الصناعية في بعض المصانع الصينية، أشار جيمي غودريتش، المستشار البارز في تحليل التكنولوجيا لدى مؤسسة راند، إلى الديناميّة ذاتها. فقد صرّح لقناة سي أن إيه الإخبارية الحكومية في سنغافورة قائلاً: «من الواضح أنّ الصين لم تكن الرائدة في تلك التقنيات. فقد اختُرعت أولاً في اليابان ومناطق من أوروبا وألمانيا وكوريا، لكن ما تفوّقت فيه الصين حقاً هو خفض كلفة تلك الروبوتات الصناعية».
وما يُقلق الإمبرياليين على وجه التحديد أنّ البطاريات، وإلى حدّ ما المركبات الكهربائية، تبدو من نوعية الصناعات الناشئة التي دأبت الإمبريالية تاريخياً على الهيمنة عليها. ومع تسارع وتيرة كهربة وسائل النقل والصناعة، وازدياد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الأرخص (أي الأكفأ في استخدام اليد العاملة) التي تستلزم في المقابل أنظمة تخزين كهربائي تعتمد على البطاريات، يُتوقّع أن يشهد الطلب على البطاريات نمواً سريعاً. ويرجّح أن يشهد هذا القطاع طفرة ممتدة تُدرّ أرباحاً كبيرة. والأمر ذاته ينطبق على تصنيع الألواح الشمسية.
تاريخياً، كانت الأسواق الجديدة بهذا الحجم الهائل تمثّل منجم أرباح طائلة لمَن يهيمن على عملية إطلاقها وتوسيعها. لكن في العام 2025، لم تكن الدول الإمبريالية الكبرى مَن يهيمن على إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات، وإلى حدّ ما المركبات الكهربائية؛ بل الصين. وهذا يُظهر لك أيّ تهديد باتت تمثّله الصين لقدرة الإمبريالية على إعادة إنتاج ذاتها.
ألا يزال الاحتكار الإمبريالي ممكناً؟
التهديد الذي تسعى رسوم ترامب الجمركية وسياسة بايدن الصناعية إلى مواجهته لا يتمثّل في أنّ الصين بدأت تحلّ محلّ المجتمعات الإمبريالية أو تتولّى إحداث ثورة في وسائل الإنتاج، أي أنّ تصبح هي نفسها قوة احتكارية مهيمنة. ولهذا السبب، لا يمكن للصين أن تتحوّل إلى قوة إمبريالية.
بيد أنّ ما أحرزته الصين من تقدّم في تطوير قواها الإنتاجية يُعدّ منعطفاً تاريخياً بكل المقاييس. فلقد بلغت الطفرات التي حقّقتها في مجالات الإنتاج اللا احتكاري حدّاً جعلها تبدأ زعزعة التشكيلة الاحتكارية الإمبريالية. إذ من الواضح أنّ إمكانيّة قيام الاحتكار نفسه تنعدم حال كانت الاحتكارات الجديدة تُكسَر بوتيرة سريعة. فتطوير تكنولوجيا متقدّمة كبرى وإيصالها إلى السوق يتطلّب استثماراً هائلاً عادة. لكن إن لم يكن بالإمكان توقّع فترة مطولة من الأرباح الفاحشة، بسبب التطوّر السريع للمنافسين من الجنوب، فإنّ نشوء أي احتكار على أساس رأسمالي يغدو مستحيلاً.
في العام 2025، لم تكن الدول الإمبريالية الكبرى مَن يهيمن على إنتاج الألواح الشمسية والبطاريات، وإلى حدّ ما المركبات الكهربائية؛ بل الصين. وهذا يُظهر لك أيّ تهديد باتت تمثّله الصين لقدرة الإمبريالية على إعادة إنتاج ذاتها
إذا ما فقدت المجتمعات الإمبريالية قدرتها على مواصلة تحقيق أرباح احتكارية فاحشة من خلال تطوير أو تسويق عمليات إنتاج جديدة، كما دأبت على ذلك طوال تاريخها الحديث، فإنّ ذلك يقوّض بصورة جوهرية قدرة الإمبريالية على مواصلة عملها بطريقتها المعتادة. إذ بدايةً، لا يمكن تأمين مستويات الاستهلاك المادي المرتفعة لسكّان الشمال إلّا على قاعدة تلك الأرباح الاحتكارية المستمرة.
الأدهى أنّ المجتمعات الإمبريالية بغياب الأرباح الفاحشة تفقد القدرة على تراكم ما يكفي من رأس المال والموارد الاجتماعية الضرورية لإعادة استثمارها في إعادة إنتاج موقعها الاحتكاري في مواجهة بلدان الجنوب. وبعبارة أخرى، إنّ القدرة التاريخية للإمبريالية الرأسمالية على أن تحتكر لنفسها ثمرة التقدّم العلمي والتقني الإنساني بأسره قد ارتكزت على إنتاج سلعٍ تُطرح في الأسواق بأسعار باهظة تضمن لها أرباحاً فاحشة. فإذا انهارت تلك الأرباح، انهارت معها قبضة الإمبريالية الخانقة على الموارد الاجتماعية العالمية.
يصعب الجزم بمدى التهديد الحقيقي الذي تمثّله قوى الإنتاج الصينية للإمبريالية من دون تحليل تقني أكثر تفصيلاً وتعمقاً. فتصاعد العدوان العسكري والاقتصادي الأميركي المعمّم ضدّ الصين يدفع كثيرين إلى الظنّ (من غير تمحيص غالباً) أنّ مستوى التهديد وجوديّ لا ريب. لكنّ تاريخ الإمبريالية يكشف عن عدوانيتها المفرطة حتّى في مواجهة تهديدات لا ترقى إلى مستوى التهديد الوجودي. بل إنّ مجرّد تقويض جزئي للهيمنة الأميركية، أو خفض ولو محدود في قيمة رأس مالها، يُعدّ مرفوضاً بالمطلق لدى النخبة العنصرية المتربّعة على رأس الدولة الأميركية. على أي حال، قد لا يكون أمامها خيار آخر.
نُشِر هذا المقال في 5 حزيران/يونيو 2025 في Monthly Review، وترجم إلى العربية ونشر في موقع «صفر» بموافقة من الجهة الناشرة.