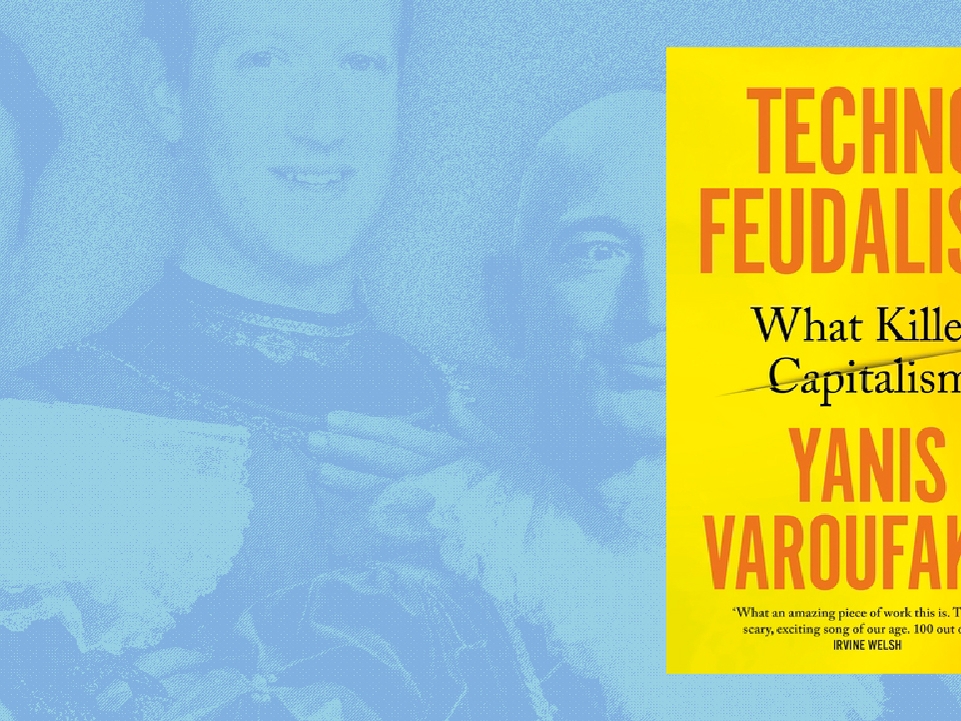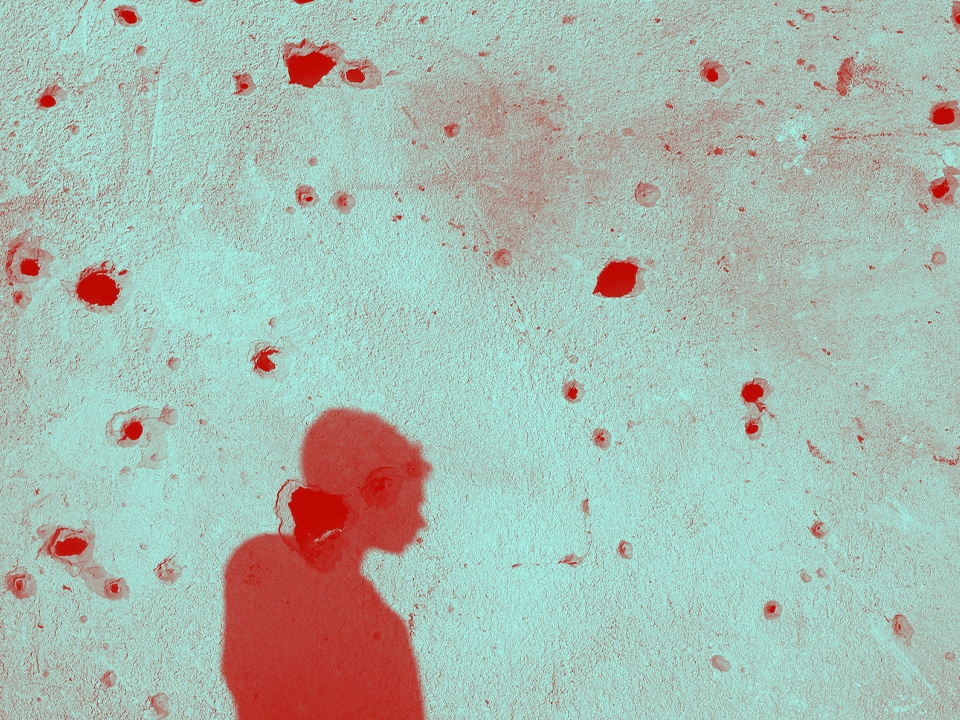الإقطاع الجديد والصراع الطبقي الجديد
قبر رأس المال
- مراجعة لكتاب «قبر رأس المال: الإقطاع الجديد والصراع الطبقي الجديد» لجودي دين، الذي ترى فيه أن الرأسمالية لا تتجه نحو الشيوعية، بل ترتدّ إلى الوراء، نحو «إقطاع جديد» قائم على الريع، والنهب، والإكراه. فالمنصّات الرقمية ليست تقدّماً، بل إقطاعيات حديثة تحوّل العمّال إلى «أقنان رقميين». ومن هذا التشخيص، تخلص دين إلى أننا نعيش في عالم يسوده شعور بأن «لا أحد يهتم»، لتطرح بديلاً حاسماً: إمّا بربرية الإقطاع الجديد، أو شيوعية الخدمات الأساسية بقيادة عمّال قطاع الخدمات.
بدأتُ الاهتمام بجودي دين عام 2019، مع صدور كتابها اللافت «الرفيق: مقالة عن الانتماء السياسي»، الذي سرعان ما غدا إحدى القراءات الأساسية لكلّ من لا يزال عالقاً بين تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة. غير أنّ اسمها عاد ليطفو بقوة بعد السابع من أكتوبر، حين أصدر رئيس كلية هوبارت وويليام سميث، مارك جيران، في نيسان/أبريل 2024 بياناً أعلن فيه إعفاء دين من مهامها التدريسية، على خلفية مقال عبّرت فيه عن دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الكفاح المسلّح.
لم يكن هذا الموقف خروجاً عن مسارها الفكري، بل تأكيداً حيّاً على التزامها بكل ما نظّرت له في كتبها، وعلى قدرتها على وصل التنظير بالممارسة، في سياقات أميركية وعالمية ذات طابع مكارثي، يجعل من هذا الالتزام مخاطرة عالية الكلفة وشديدة الوطأة. ومع ذلك، لا تتوقّف دين عن المضي قدماً، وبنزعة جذرية متماسكة، في نقد وتفكيك البنى الاقتصادية والسلطوية السائدة اليوم، تلك البنى نفسها التي شكّلت الأرضية المادية والخطابية لتبرير دعم الإبادة في غزة وتطبيعها.
في كتابها الجديد «قبر رأس المال: الإقطاع الجديد والصراع الطبقي الجديد»، تُسقط جودي دين مذهب المراحل التاريخية، لتبيّن أن ما يُقدَّم بوصفه تقدّماً قد يكون في جوهره ارتداداً إلى الخلف. فالرأسمالية لا تنهار بالضرورة لصالح الشيوعية، بل تحفر قبرها بنفسها لتفسح المجال أمام نظام اجتماعي–اقتصادي جديد هو «الإقطاع الجديد».
في هذا التحول، تنكفئ القوانين الحركية الكلاسيكية للرأسمالية، كالمنافسة والتحسين التقني وزيادة إنتاجية العمل، على ذاتها، نتيجة أربعة عقود من الليبرالية الجديدة، لتفسح المجال أمام استراتيجيات تراكم كانت سِمة العصور الإقطاعية: السعي وراء الريع والنهب والإكراه الفوق-اقتصادي. وبدل أن يكون التراكم مدفوعاً بإنتاج السلع داخل «المصنع الاجتماعي»، يُعاد تشكيل المجتمع نفسه بوصفه «ضياعاً اجتماعياً» تحكمه علاقات شخصية وشبكات تبعية، حيث يهيمن «أسياد المنصات» الرقمية على البنية التحتية للحياة اليومية، فارضين «إتاوات» أو ريعاً دائماً على العمّال والمستهلكين مقابل الوصول إلى الأسواق. وتُنتج هذه البنية مناخاً عاطفياً ذهانياً ناجماً عن تآكل «الكفاءة الرمزية» وشيوع الإحساس بأن «لا أحد يهتم»، ما يترك الأفراد عالقين في صراعات هوياتية وتنافسية لا تنتهي.
الخلاص لا يمكن أن يكون فردياً، بل يمرّ حتماً عبر استعادة التنظيم السياسي الجماعي، وعلى رأسه الحزب. فالحزب، في تصورها، هو الذات «التي يُفترض بها أن تهتم»
ويتجلى هذا التحوّل بوضوح في «اقتصاد الخدم»، حيث لم يعد العامل منتجاً بالمعنى الرأسمالي الكلاسيكي، بل تحوّل إلى «خادم» يكرّس جهده لتعزيز راحة الأثرياء، في وضع يعيد إنتاج علاقات العبودية القديمة تحت مسميات معاصرة. وتنتهي دين إلى خلاصة حاسمة مفادها أن العالم يقف اليوم أمام خيار وجودي ثنائي: إما الخضوع لركود وتبعية الإقطاع الجديد، أو النضال من أجل العدالة الاجتماعية عبر رؤية تتمحور حول «الخدمات الأساسية الشاملة»، تقودها «طليعة» جديدة من عمّال قطاع الخدمات، تمتلك القدرة على تعطيل إعادة الإنتاج الاجتماعي ومواجهة هيمنة أسياد الأصول.
التاريخ يسير القهقرى
يسود إجماع داخل النخب النقدية على أننا نعيش طوراً انتقالياً، لم يعد فيه الربح والمنافسة المحرّكين الحصريين للاقتصاد، بل أخذ الإكراه من خارج السوق، والارتهان للامتيازات، يحتلّان موقعاً مركزياً. غير أن مساهمة جودي دين لا تكتفي بتشخيص هذا الانتقال، بل تسعى إلى الإجابة عن سؤال أكثر إلحاحاً: ماذا يمكن فعله في مواجهته؟
في الفصل الأول من كتابها، المعنون «ما تخبرنا به مخطوطات الغروندريسه عن شركة أوبر»، تفكّك دين التحوّل العميق في بنية الاقتصاد المعاصر. فالرأسمالية اليوم، بحسب قراءتها، لم تعد تعمل وفق قوانين حركتها التاريخية، بل تنزلق تدريجياً نحو نمط «إقطاعي جديد» يقوم على الريع والنهب والسيطرة السياسية.
وترى دين أن هذا التحول لا يمكن فهمه بوصفه تطوراً طبيعياً، بل هو نتاج سياسي–اجتماعي لهزيمة الطبقة العاملة خلال أربعة عقود من الليبرالية الجديدة. فالرأسمالية، تاريخياً، تميّزت بمجموعة قوانين حركة محدّدة: المنافسة، وتعظيم الأرباح، وإعادة استثمار الفوائض، والضرورة النظامية لرفع إنتاجية العمل. غير أنّ هذه القوانين، بدل أن تعمل في تناغم، باتت تصطدم ببعضها البعض؛ إذ تحوّلت المنافسة من آلية لتحسين الإنتاج إلى دينامية للغزو والتدمير والاستحواذ، حيث يُستبدل الربح الناتج عن الإنتاج بالريع، ويحلّ الإكراه الفوق-اقتصادي محلّ منطق السوق.
وفي هذا السياق، تدخل دين في سجال نظري مع يفغيني موروزوف، الذي يرى في مفهوم «الإقطاع التقني» ضرباً من الكسل الفكري أو محاولة غير مباشرة لإعادة تأهيل الرأسمالية بوصفها «الخيار الأقل سوءاً». في المقابل، تنحاز إلى أطروحة سيدريك دوران، التي تؤكد أهمية مفهوم «الإقطاع الجديد» لفهم طبيعة التراكم السائدة اليوم، بوصفها تراكماً يعتمد على الريع والنهب والسطو، أكثر مما يعتمد على إنتاج السلع.
ومن هنا، تحرص دين على توضيح الفارق الجوهري بين الإقطاع والرأسمالية. فبينما يقوم الإقطاع على «الانتزاع بالقوة» عبر وسائل سياسية وقانونية قسرية، تقوم الرأسمالية على «الاستغلال» الاقتصادي لعمّال أحرار شكلياً داخل السوق.
ولمقاربة هذه الفوارق البنيوية، تتخذ جودي دين من أوبر نموذجاً تحليلياً، لتبيان الكيفية التي تعمل بها المنصّات الرقمية بوصفها إقطاعيات حديثة. تروّج «أوبر» لنفسها كأداة لتحرير العمّال عبر شعار «المرونة»، غير أن القضاء البريطاني كشف زيف هذا الادعاء عام 2021، حين اعتبر السائقين تابعين فعلياً للشركة، التي تحتكر تحديد الأجور وشروط العمل وآليات التقييم والانضباط.
ولا تقوم استراتيجية «أوبر»، وفق قراءة دين، على تحسين كفاءة النقل كما يزعم الخطاب «الريادي»، بل على تدمير القطاع نفسه. فقد ضخّت الشركة مليارات الدولارات من رأس المال الاستثماري لتمويل رحلات مدعومة، بهدف القضاء على سيارات الأجرة التقليدية والاستحواذ الكامل على السوق. وهذا السلوك لا يندرج ضمن منطق المنافسة، بل يمثل نمطاً من الغزو المنهجي. أما النتيجة، فهي ما تصفه دين بـ«عبودية التطبيق»، حيث يُجبر السائقون على العمل لساعات أطول مقابل أجر يقل في كثير من الأحيان عن الحد الأدنى القانوني.
ولتأصيل هذا التحليل، تعود دين إلى قراءة الغروندريسة، مستحضرة تحليل كارل ماركس للانفصال التاريخي بين المنتج ووسائل إنتاجه. ففي الأنماط السابقة على الرأسمالية، وُجدت «وحدة أصلية» بين العامل وأدوات عمله أو أرضه، كما في الحِرَف أو المشاعات. أما الرأسمالية، فقد قامت على تفكيك هذه الوحدة، وجعل شروط العمل تظهر كقوة «غريبة وخارجية» عن العامل.
في حالة «أوبر»، يتجسّد هذا الانفصال في ما تسميه دين «الحرية المزدوجة». فالسائق، من جهة، «حرّ» من وضع الموظف، أي محروم من الحقوق والحماية القانونية. ومن جهة أخرى، هو «حرّ» بفضل ملكيته الخاصة لسيارته، التي تتحوّل من وسيلة استهلاك شخصي إلى رأسمال يعمل لصالح المنصّة. فالسيارة التي اشتراها السائق من ماله الخاص تصبح أداة لتراكم ثروة «أوبر»، بينما يتحمّل هو وحده أعباء صيانتها وديونها واستهلاكها.
وتُفضي هذه المعادلة إلى تبعية مزدوجة: تبعية للسوق، وتبعية للمنصّة التي تحتكر الوصول إلى هذه السوق مقابل «إتاوة» أو ريع دائم. وبهذا المعنى، يعيد اقتصاد المنصّات إنتاج علاقة السيد والقن، حيث يتحوّل العمّال والمستخدمون إلى «أقنان رقميين» ينتجون البيانات والقيمة، فيما تستحوذ المنصّات عليها عبر ما تصفه دين بـ«الريع التقني».
يتحوّل القلق إلى وقود لحركات سياسية تعد الأفراد بتحويلهم إلى «أسياد» على حساب فئات أضعف، كالمهاجرين والأقليات. وهو ما تصفه دين بـ«الإقطاع الديمقراطي»: لحظة يُستبدل فيها طموح المساواة والعدالة بطموح ممارسة السلطة على الآخرين
لكن هذا التحوّل لا يقتصر على كونه تغييراً في آليات التراكم، بل يوجّه ضربة مباشرة للتصوّرات الخطيّة للتاريخ، التي تفترض أن المجتمعات تنتقل بالضرورة من الأسوأ إلى الأفضل عبر مراحل متعاقبة ومحدّدة سلفاً. فهو يبيّن، على العكس، أن النظام الرأسمالي الراهن يمرّ بمرحلة انتقالية معقّدة قد تفضي إلى ارتداد نحو «الإقطاع الجديد»، لا إلى التقدّم نحو الشيوعية.
وعلى هذا الأساس، تنقض دين «مذهب المراحل» الذي لا يزال يهيمن على كثير من التحليلات اليسارية، والقائم على افتراض أن التاريخ يتحرّك في خط مستقيم يبدأ بالعبودية، ثم الإقطاع، فالرأسمالية، فالاشتراكية، وصولاً إلى الشيوعية. إذ إن هذا التصوّر الخطي يعمينا عن إدراك التحوّلات الجارية؛ فإذا افترضنا أن الرأسمالية ستستمرّ في العمل وفق قوانينها إلى أن تُهزم على يد بروليتاريا صناعية مكتملة، فلن نتمكّن من فهم ما يحدث حين تُهزم الطبقة العاملة نفسها، وحين تبدأ قوانين الرأسمالية بالتحوّل.
تؤكّد دين، في هذا السياق، أن رأس المال ليس «ميتاً»، بل بصدد «حفر قبره بنفسه»، لا عبر التقدّم التاريخي، بل من خلال الانكفاء على ذاته واعتماد استراتيجيات تراكم كانت سِمة الإقطاع مثل السعي وراء الريع والنهب. وتلفت دين إلى أن التقليد الماركسي نفسه كان أبعد ما يكون عن التفسيرات التبسيطية أو الخطية للتاريخ، إذ يقدّم فهماً غنياً للتداخل الزمني بين أنماط الإنتاج. فالماضي لا يختفي بمجرّد ظهور نمط جديد، بل يستمر ويتشابك معه. ومن هذا المنظور، فإننا نعيش اليوم في «مرحلة زمنية معقّدة»، تتداخل فيها قوانين رأسمالية متآكلة مع ديناميات إقطاعية صاعدة.
وفي هذه المرحلة، لم تعد الرأسمالية قادرة على تأمين شروط بقائها. فهي، في سعيها المحموم إلى التراكم، تُدمّر الأسواق التي قامت عليها، وتستنزف البنى التحتية الاجتماعية، وتحوّل العمّال من منتجين إلى «خدم» يعيشون في حالة تبعية دائمة.
السِمات الأربع
وقبل أن تحدّد جودي دين السمات الرئيسة لـ«الإقطاع الجديد»، تعود إلى تفكيك التحوّل العميق الذي طرأ على شكل الدولة نفسها. فقد أدّت الهجمة النيوليبرالية إلى تقويض السيادة الوطنية، التي ارتبطت تاريخياً بالديمقراطيات البرجوازية، واستبدالها بما يمكن تسميته «تبعية سيادية». فالدول لا تزال تمتلك حكومات وحدوداً وأقاليم، لكنها باتت تفتقر إلى القدرة الفعلية على الفعل المستقل.
في هذا الوضع، تُقيَّد حركة الدول بمعاهدات دولية، وتفضيلات المستثمرين، وهيمنة القوى الإمبريالية، فضلاً عن تفكّك سلطاتها الداخلية. تقارن دين هذا الوضع بما كان عليه الأمر في الحقبة «الفوردية»، حين أدّت الدولة دور «الرأسمالي المجرّد» الذي يدير «المصنع الاجتماعي» عبر تسويات اجتماعية. أمّا اليوم، فقد جرى تفكيك هذا المصنع الاجتماعي لصالح حالة تصفها بـ«الضياع الاجتماعي»، حيث يُخضع التمويلُ الأسواق، وتتحوّل الدولة من منظِّم عام إلى خادم مباشر لمصالح حائزي الأصول.
ويترتّب على هذا التحوّل انتقالٌ نوعي من «القانون العام» إلى «الروابط التعاقدية الشخصية». فلم يعد الجميع خاضعين لقانون تجريدي واحد، بل يتصرّف كل فرد وفقاً لموقعه في شبكة التبعية.
في تفكيكها للبنية الهيكلية للنظام الصاعد، تشرح جودي دين «الإقطاع الجديد» عبر أربعة مستويات متداخلة.
أولاً: السيادة المُجزّأة. تستعير دين هذا المفهوم من بيري أندرسون لوصف تفتّت السلطة في الإقطاع الأوروبي الكلاسيكي، مؤكدةً أن ملامح مشابهة باتت واضحة في العصر الراهن. ويتجلّى ذلك، بدايةً، في خصخصة القضاء، حيث تحلّ المصالح التجارية الخاصة محلّ القانون العام عبر آليات التحكيم الإلزامي. ففي الولايات المتحدة، يُجبر أكثر من 55% من العمّال على توقيع اتفاقيات تحكيم كشرط للتوظيف، ما يحرمهم من حق التقاضي أمام المحاكم العامة، ويحوّل النزاعات إلى عمليات مغلقة تديرها شركات خاصة وفق قواعدها ومصالحها. ويتّخذ هذا التفتّت شكلاً أكثر فجاجة في آليات تسوية النزاعات بين المستثمرين والدول، التي تتيح للشركات الأجنبية مقاضاة الحكومات الوطنية أمام هيئات دولية خاصة إذا ما أقرّت قوانين لحماية البيئة أو الصحة العامة قد تمسّ أرباحها. وبهذا، تُرفع مصالح الشركات فوق سيادة الدول وإرادة مجتمعاتها. كما يظهر تعدّد السلطات المكاني في انتشار المناطق الاقتصادية الخاصة، والموانئ الحرّة، والملاذات الضريبية، التي تشكّل «جيوباً سيادية» خارجة عن سلطة الدولة الوطنية، ومصمَّمة لتلائم متطلبات رأس المال.
النظام الرأسمالي الراهن يمرّ بمرحلة انتقالية معقّدة قد تفضي إلى ارتداد نحو «الإقطاع الجديد»، لا إلى التقدّم نحو الشيوعية
ثانياً: الأسياد والأقنان الجدد. يتعلّق هذا المستوى بعلاقات الملكية الاجتماعية. فالإقطاع الجديد يتّسم بتركيز هائل للثروة في أيدي قلّة من المليارديرات، مقابل تركّز العمل في قطاع الخدمات. «الأسياد» الجدد هم مالكو البنى التحتية الرقمية، مثل أمازون وغوغل وأوبر، الذين لا يراكمون الثروة أساساً عبر إنتاج السلع، بل عبر الريوع، بوصفهم وسطاء يفرضون إتاوات ورسوماً مقابل الوصول إلى السوق. في المقابل، يعمل العمّال كـ«أقنان» معاصرين: أحرار قانونياً، لكنهم مستعبدون اقتصادياً. ويتعمّق هذا الوضع مع تحويل الممتلكات الشخصية إلى أدوات للتراكم؛ فالسيارة أو المنزل لم يعودا وسائل استهلاك خاص، بل تحوّلا عبر تطبيقات مثل «أوبر» وإير بي إن بي إلى أصول تُسخَّر لمراكمة ثروات المنصّات، فيما يتحمّل الأفراد وحدهم أعباء الصيانة والديون وانعدام الحماية الاجتماعية.
ثالثاً: الهندسة المكانية. وهي توصيف للجغرافيا السياسية للإقطاع الجديد، حيث ينقسم العالم إلى مراكز رابحة محميّة، مثل سان فرانسيسكو ونيويورك ولندن، التي تتركّز فيها الاستثمارات والخدمات الفاخرة والبنى التحتية المتقدّمة. في المقابل، تمتد مناطق نائية ومهمّشة، من مدن صغيرة وأقاليم ريفية، تعاني من تدهور البنية التحتية وندرة فرص العمل. وتتحوّل هذه المناطق إلى مواقع للاستغلال المكثّف، حيث تنتشر مستودعات الشركات العملاقة، ومراكز الاتصال، ومخازن البيانات. وترافق ذلك مؤشرات اجتماعية مقلقة، من تراجع متوسط العمر المتوقع، إلى انهيار المرافق العامة كالمدارس والمستشفيات. ومع ذلك، تشكّل هذه الأطراف المهمّشة الخزان الأساسي للاحتجاجات الاجتماعية، سواء حول قضايا البيئة، أو الخدمات الأساسية.
أمّا السمة الرابعة، والأكثر إثارة للجدل، فتسميها جودي دين «القلق الكارثي». وهو مناخ نفسي–اجتماعي عام، يسوده شعور دائم بانعدام الأمان، والذعر من المستقبل. يعيش «القنّ الجديد» في حالة خوف مستمر من أي طارئ صحي أو عائلي أو اقتصادي قد يدمّر حياته بالكامل، في ظل غياب شبكات الأمان الاجتماعي. ويؤدي القلق المزمن إلى تآكل القدرة على الفهم والسيطرة، ما يفتح المجال لانتعاش نظريات المؤامرة، والعودة إلى أنماط من الشعوذة والخرافة، بوصفها وسائل رمزية للتعامل مع واقع معقّد لا يمكن الإحاطة به عقلانياً. وعلى مستوى أوسع، يتحوّل القلق إلى وقود لحركات سياسية تعد الأفراد بتحويلهم إلى «أسياد» على حساب فئات أضعف، كالمهاجرين والأقليات. وهو ما تصفه دين بـ«الإقطاع الديمقراطي»: لحظة يُستبدل فيها طموح المساواة والعدالة بطموح ممارسة السلطة على الآخرين.
غير أن هذه السمات الأربع ليست ظواهر منفصلة، بل عناصر متشابكة تشكّل معاً اتجاه الرأسمالية المعاصرة نحو «الإقطاع الجديد». فالسيادة المجزّأة تؤمّن حماية لثروات الأسياد، فيما تُحاصر الأقنان الجدد في أطراف مهمّشة، يعصف بها القلق والفقر. وهكذا يقوم النظام الاجتماعي الصاعد على الامتياز والعلاقات الشخصية والتبعية، لا على المنافسة أو الحرية الفردية التي وعدت بها الليبرالية الكلاسيكية.
لا أحد يهتم
لكن من هي الذات التي يُفترض بها أن تهتم؟ في الفصل الرابع، ترصد جودي دين البنية العاطفية–النفسية لنظام «الإقطاع الجديد»، من خلال التركيز على ظاهرة اجتماعية آخذة في الاتساع، وهي الشعور السائد بأن «لا أحد يهتم». لا تُفهم هذه العبارة بوصفها مجرّد تعبير عن اللامبالاة، بل كمؤشّر على تدهور «الكفاءة الرمزية» وغياب فضاء رمزي مشترك، يمكن داخله استعادة المعنى العام، وتجاوز منطق الخلاص الفردي.
تلاحظ دين تكرار هذه العبارة في العناوين الإخبارية، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عند تناول قضايا مصيرية مثل التغيّر المناخي، والحرب على غزة، والفساد السياسي، وحتى تراجع متوسط العمر المتوقع. وترى أن هذا التكرار يشير إلى غياب ما يسميه التحليل النفسي بـ«الآخر الكبير»، أي الذات الجماعية القادرة على الاهتمام، والاستجابة، وتحميل الأحداث معنى سياسياً وأخلاقياً. ففي الإقطاع الجديد، لا توجد ذات جماعية تستقطب الانتباه، ما يترك الأفراد في عزلة وجودية، يواجهون قوى كارثية خارجة تماماً عن سيطرتهم.
ويؤدي هذا الفراغ إلى انغماس المجتمع في ما تصفه دين بـ«مناخات ذهانية»، تتسم بتضخّم المطالب، واستمتاع مفرط ومنفلت، في غياب أي موجّهات رمزية ثابتة. وبدل المواطن المنضبط الذي ميّز الحداثة والرأسمالية الكلاسيكية، يُنتج الإقطاع الجديد ذاتاً تائهة، مشتّتة.
رأس المال ليس «ميتاً»، بل بصدد «حفر قبره بنفسه»، لا عبر التقدّم التاريخي، بل من خلال الانكفاء على ذاته واعتماد استراتيجيات تراكم كانت سِمة الإقطاع مثل السعي وراء الريع والنهب
ولشرح هذا التحوّل، تستعين دين بالتحليل النفسي اللاكاني، مستندة إلى أعمال جاك لاكان، لتبيان كيف انتقلت البنية العاطفية للمجتمع من «المستوى الرمزي» القائم على القوانين والقيم المشتركة إلى «المستوى التخيّلي»، القائم على الهوية، والمقارنة، والتنافس. وفي هذا السياق، تحدّد ثلاثة أنماط من الذهان تشكّل التجربة اليومية للأفراد في ظل الإقطاع الجديد. أولها البارانويا، المتمثّلة في الإحساس الدائم بالاضطهاد، وإلقاء اللوم على الآخرين، والتي تزدهر في مجتمع يشجّع الأفراد على تعريف أنفسهم بوصفهم ضحايا دائمين. وثانيها الفصام، حيث يفقد الفرد اتصاله بذاته وبالآخرين، وتنهار الحدود بين الداخل والخارج، وبين الذات والعالم. أمّا ثالثها فهو الملانخوليا، التي تتجسّد في لوم الذات والشعور المستمر بانعدام القيمة، وهو نمط يغذّيه التعرّض المتواصل لأخبار كارثية أو محتوى تافه.
في ظل هذا التفتّت الرمزي، تبرز سياسات الهوية بوصفها محاولة يائسة للتمسّك بأرضية ثابتة في عالم يسوده اللايقين. غير أن دين ترى أن هذا الشكل من السياسة لا يعيد بناء المعنى، بل يسرّع انهيار الدلالات: فلم يعد المهم ما يُقال، بل من يقوله. ويتحوّل المتحدّث من حامل قضية تُعبَّر عنها عبر اللغة، إلى موضوع للتأييد أو الهجوم بناءً على هويته، فيما يعمل عقل المتلقّي كخوارزمية تصنيف، تقوّم الخطاب وفق مكانة المتكلّم لا وفق مضمونه.
في مواجهة هذا «القلق الكارثي» الذهاني، ترى دين أن الخلاص لا يمكن أن يكون فردياً، بل يمرّ حتماً عبر استعادة التنظيم السياسي الجماعي، وعلى رأسه الحزب. فالحزب، في تصورها، هو الذات «التي يُفترض بها أن تهتم»، والقادر على تحويل الفرد من مجرّد موضوع لمطالب واستمتاع مشتّت، إلى جزء من إرادة عامة تتجاوز أنانيته وتعيد له معنى الفعل السياسي.
وتختتم دين هذا المسار برؤية مستقبلية للصراع الطبقي في عصر الإقطاع الجديد، تتمحور حول مفهوم «الخدمات الأساسية الشاملة» بوصفه جوهر الأفق الشيوعي الممكن على كوكب يزداد حرارة. فإعادة التصنيع لم تعد خياراً قابلاً للاستمرار بيئياً، ما يفرض توجيه الاستثمارات نحو أنشطة ذات عائد منخفض، لكنها ضرورية للحياة مثل الرعاية الصحية، والتعليم، وإعادة تأهيل البيئة. وترى أن هذا هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمة إعادة الإنتاج الاجتماعي، خصوصاً في المناطق النائية والمهمّشة.
وتضع دين هذه المهمّة على عاتق عمّال قطاع الخدمات، بوصفهم القوة القادرة على استعادة الذات الجماعية. فالممرّضات، والمعلّمون، وعمّال المستودعات، وعمّال التوصيل، هم في طليعة الاحتجاجات الاجتماعية اليوم. وتكمن أهمية نضالاتهم، أولاً، في قدرتهم على تعطيل إعادة الإنتاج الاجتماعي، ما يمنحهم قوة سياسية تتجاوز موقعهم التقليدي في عملية الإنتاج. وثانياً، في كون عملهم يمزّق منطق القيمة الرأسمالية ذاته، إذ يصعب تسليعه بالكامل أو أتمتته، ويظل موجّهاً لتلبية الاحتياجات لا لتعظيم الربح.
وترى دين في هؤلاء العمّال، على الرغم من تشتّتهم، القوة القادرة على نقل المجتمع من «حالة الضياع الاجتماعي» التي تخدم استهلاك الأسياد، إلى نظام شيوعي يضمن ازدهار الجميع. فالخيار المطروح اليوم، في نظرها، واضح وقاسٍ: إمّا القبول بـ«بربرية» الإقطاع الجديد، أو النضال من أجل شيوعية الخدمات الأساسية، التي تضع بقاء الكوكب وكرامة الإنسان فوق كل اعتبار.