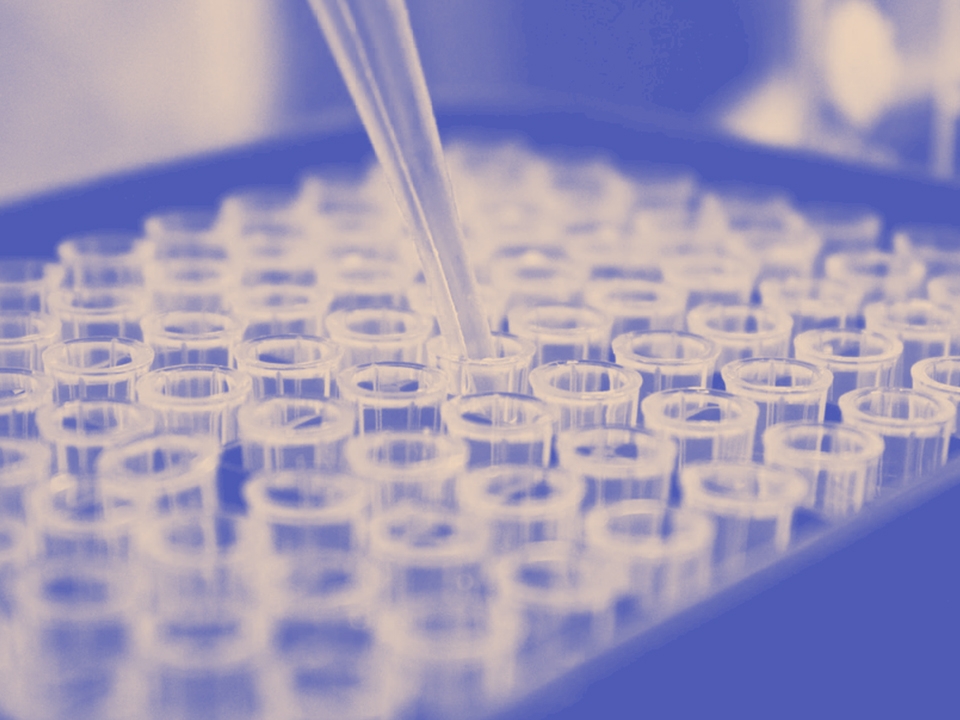أربع ديناميات خلف تراجع الابتكار
الـ«بيغ فارما» ورأس المال الاحتكاري
منذ منتصف التسعينيّات، تُعاني شركات الـ«بيغ فارما» من أزمة إنتاجية من سماتها ركود عملية تطوير الأدوية الجديدة وقرب انتهاء صلاحية براءات الاختراع. على سبيل المثال، في العام 1995، استند 75 من أصل أكثر 100 دواء مبيعاً إلى 4 عائلات جُزيئية لا غير. وتشير التقديرات إلى أنّ زهاء 180 مليار دولار من مبيعات أكبر 20 شركة أدوية ستكون عرضةً للخطر بين عامَي 2024 و2028، نتيجةً لانتهاء صلاحية براءات الاختراع. لكن لم تُقْدِم هذه الشركات على تعزيز استثماراتها في البحث والتطوير لمواجهة هذه التحديات، بل اتّجهت بازدياد إلى مصادر خارجية لتحصيل الابتكار الطبّي. ففي العام 2023، تراوحت نسب الإنفاق على البحث والتطوير لدى أكبر 10 شركات أدوية بين 15.6% و23% لا غير. ومن بين 323 دواءً جديداً صادقت عليها «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» بين 2015 و2021، لم تُطوِّر الشركات العشرون الكبرى سوى 138 دواءً. أما الحصّة الأكبر (65%) فجاءت من مصادر خارجية، و5% من تعاونٍ بين الطرفين، و28% من إنتاجٍ داخلي. ويتّسق هذا الاتجاه مع تقرير صدر عن مكتب الميزانية في الكونغرس، خلُص إلى أنّ شركات الأدوية الكبرى، على الرغم من أنّها كانت وراء أكثر من نصف الأدوية الجديدة المُعتمدة منذ العام 2009، لم تبدأ سوى 20% من تجارب المرحلة الثالثة السريرية، وهي المرحلة الحاسمة في تقييم فعالية الأدوية وتحديد فرص نجاحها.
أثيرت مخاوف عدّة بشأن المسارات الراهنة للابتكار الطبّي في شركات الـ«بيغ فارما»، حتى غدت هذه الصناعة تُرى مكبّلةً بعلاقات إنتاج تُعيق قواها الإنتاجية. وفي هذا السياق، يُستعان بمصطلح رأسمالية الاحتكار الفكري لفهم الكيفية التي يدفع بها التقدّم التقني في قطاع الأدوية عجلة الابتكار نحو منطق الاستحواذ والريع، بدلاً من المنطق الرأسمالي التقليدي المتمثّل بالاستغلال وتحقيق الأرباح. لا تقتصر الاحتكارات الفكرية في صناعة الدواء اليوم على كونها طبقة من الريعيين الكسالى من دون إسهامٍ يُذكَر في عملية الإنتاج واستغلال العمل فحسب، بل تتعدّى ذلك إلى كبح الاستثمار في البحث والتطوير، ما يفضي إلى جمودٍ في الابتكار الطبّي من زاوية إحداث تغييرات تسفر عن تحسينات علاجية بكلفةٍ تنافسية. وإذا ما قيس الابتكار الطبّي بمعيار التحسين العلاجي الجوهري، فإنّ معظمه اليوم ليس إلا تنويعات طفيفة على منتجات قائمة أصلاً. وفي سبيل فهم هذا الاتجاه، لا يزال مفهوم الرأسمالية الاحتكارية لبول باران وبول سويزي نقطة انطلاق صالحة. تنفرد رأسمالية الاحتكار الفكري بسمات مميّزة تفصلها عن نظيرتها التقليدية. ويُعدّ قطاع الأدوية الكبرى مثالاً كاشفاً عن نظام الابتكار وآليات عمل رأسمالية الاحتكار الفكري في الصناعة الدوائية. وتحليلنا هنا لا يكتفي بكشف القوى الفاعلة التي أنتجت هذا النمط من الرأسمالية فحسب، بل يسلط الضوء أيضاً على التحوّلات الكبرى الجارية في هذه الصناعة في يومنا هذا.
رأسمالية الاحتكار الفكري والابتكارات في الرعاية الصحية
شدَّد كارل ماركس على أنّ الفهم السليم لرأس المال لا بدّ أن يبدأ من تحليل القيمة. فمن زاوية رأس المال، لا تكون للقيمة أيّ دلالة ما لم تتجلَّ في صورة فائض قيمة. وكما كتب في الغروندريسة: «لكي نُطوِّر مفهوم رأس المال، لا بدّ أن نبدأ لا من العمل، بل من القيمة، وتحديداً من القيمة التبادلية في حركة التداول وقد بلغت طورها المتقدّم». فلكي يصير المال رأس مالٍ، لا بد أن يمتلك قابلية توليد الفائض في أثناء تداوله في عمليات تبادل السلع.
لا تقتصر الاحتكارات الفكرية في صناعة الدواء على كونها طبقة من الريعيين الكسالى، بل تتعدّى ذلك إلى كبح الاستثمار في البحث والتطوير، ما يفضي إلى جمودٍ في الابتكار الطبّي
على الرغم من ارتباط مفهوم الفائض في النظرية الماركسية التقليدية بنظرية القيمة في العمل، رأى باران وسويزي أنّ مفهومهما للفائض أوسع وأنسب لتفسير تطوّرات الرأسمالية الحديثة في بلدان الغرب. والرأسمالية الاحتكارية عندهما تشمل مزيداً من المناحي الاجتماعية، منها تصاعد النزعة العسكرية والإمبريالية، بوصفها وسائل لزيادة الفائض الاقتصادي، وهو المفهوم المركزي الذي قامت عليه أطروحتهما عن الرأسمالية الاحتكارية. وفي كتابهما «رأس المال الاحتكاري»، يذهبان إلى أنّ المجتمع الرأسمالي منتِجٌ لفائضٍ اقتصادي متنامٍ، ويُعرّفان ذلك الفائض بأنّه «الفرق بين الدخل الممكن توليده بالوسائل الاقتصادية والتقنية المتاحة وكلفة العمل المنتج». وفي رأيهما، يزيد صعود الشركات العملاقة ذات البنية الأوليغارشية الفائضَ الاقتصادي. ومن جانبه، أوضح الاقتصادي النمساوي جوزيف شتايندل أنّ السوق التنافسية تدفع الشركات إلى الاستثمار والابتكار لضمان البقاء، والمنافسة بدورها تؤدي إلى توسّع الشركات القوية وإخراج الشركات الأعلى كلفة من السوق. وحينئذٍ تميل الشركات الأوليغارشية إلى تنسيق أسعارها، لينتهي الأمر إلى جمودٍ سعري. وبما أنّ التكيّف لا يحدث من خلال تعديل الأسعار، بل من خلال الكميات، فإنّ الشركات الأقلّ كفاءة تستمرّ في البقاء، وتنمو الأرباح غير المُعاد استثمارها، وعلى إثرها تزداد الطاقة الإنتاجية غير المستغَلّة. ومن ثمّ، يرى باران وسويزي «بما أنّ الفائض الذي لا يمكن امتصاصه لن يُنتَج، فإنّ الحالة الطبيعية لاقتصاد الرأسمالية الاحتكارية هي الركود». وهكذا تنشأ مفارقة لا مفرّ منها بين ارتفاع الفائض الاقتصادي وانخفاض الحوافز لاستخدام تقنيات جديدة في ظل الرأسمالية الاحتكارية. تكشف لنا هذه النتيجة جوهر المعضلة الراهنة في رأسمالية الاحتكار الفكري. وقبل العودة إلى هذه النقطة، سنتناول معالجة أوغو باغانو وسوزان سِلْ لها.
يوضّح الاقتصادي الإيطالي باغانو أنّ السمة الأساسية لرأسمالية الاحتكار الفكري أنّ «الاحتكار لم يعد قائماً فحسب على القوة السوقية الناتجة عن تركُّز المهارات في الآلات والإدارة، بل بات أيضاً احتكاراً قانونياً لمجموعة من المعارف، يمتدّ أثره إلى ما وراء الحدود الوطنية». ويبيّن هذا التفسير النمو الهائل في مجال الملكية الفكرية وعلاقات القوة الناتجة عنها قانونياً. ففي ظل رأسمالية الاحتكار الفكري، يدفع التقدّم التكنولوجي الاقتصاد المعرفي في اتجاه منطق الاستحواذ والريع، بدلاً من المنطق الرأسمالي التقليدي المتمثّل بالاستغلال وتحقيق الأرباح. ويمكن تحديد ثلاث سمات جوهرية هنا:
في حين يجب أن تكون المعرفة سلعة عامّة من زاوية طابعها البعيد عن المنافسة والاحتكار، فإنّ إسباغ طابع الملكية القانونية عليها عبر ما يُعرف بحقوق الملكية الفكرية يجعلها حقاً خاصاً ينتج عنه أثرٌ مزدوج: تحفيز الابتكار من جهة، وتعطيله من جهة أخرى؛
وبمقدار ما تتمكّن رأسمالية الاحتكار الفكري من إحاطة الأفكار بسياجات الملكية الخاصة، فإنّ هذه الملكية الفكرية الخاصة تُنتج أثراً تعطيلياً على فرص الآخرين في التطوير؛
وفي حين شهد الاقتصاد المعرفي في التسعينيات ازدهاراً، فإنّ الأثر الكلّي للحمائية التي تتّسم بها رأسمالية الاحتكار الفكري أسفر منذ مطلع الألفية عن انكماش عالمي في فرص الاستثمار، وهو اتجاه تسبّب بأزمة هذا النمط من الرأسمالية، وكان سبباً رئيساً في أزمة 2008 والركود العظيم بعدها.
أما الباحثة سوزان سِلْ، فقد حلّلت أثر رأسمالية الاحتكار الفكري على الابتكار الطبّي، ولاحظت تباطؤاً واضحاً في وتيرة تطوير الأدوية الجديدة، مُشيرةً إلى 3 سمات رئيسة لهذا النمط داخل الصناعة الدوائية:
شهدت الصناعة الدوائية تحوّلاً تمثّل في الانتقال من شركات ضخمة متكاملة عمودياً تتولّى جميع مراحل اكتشاف الدواء، إلى شركات كبرى أقل إبداعاً تعتمد في معظم نشاطها على التفكّك العمودي والاندماج الأفقي من خلال صفقات الاستحواذ والدمج؛
تشير ظاهرة الأموَلة في هذه الصناعة إلى تحوّل أولوياتها الاستراتيجية من تحقيق القيمة للمستهلك إلى تحقيق القيمة لحمَلة الأسهم؛
ويشير الاقتصادي وليم لازونيك وزملاؤه إلى أنّ الأموَلة تُبطئ من وتيرة الابتكار الطبّي، إذ تُوجَّه معظم الأرباح نحو إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، وبالتالي لا يتبقى ما يكفي من الأموال للبحث والتطوير. تميل البيغ فارما إلى تكديس الملكيات الفكرية لتَفِي بطلبات صناديق رأس المال المُغامر.
عند تحليل العوامل المساهمة في عمل نمط رأسمالية الاحتكار الفكري، ربط باغانو وسِلْ بين هذه الرأسمالية من جهة، وبين الأموَلة المتزايدة للاقتصاد وعملية تسليع المعرفة من جهة أخرى. لكنّ هذين العاملين لا يكفيان لتفسير سبب دخول هذا النمط من الرأسمالية، منذ مطلع الألفية الجديدة، في أزمةٍ اتسمت بتقلّص فرص الاستثمار وانغلاق دائرة المعرفة العلمية. وقد قدّم كلٌّ من سيدريك دوران وويليام ميلبرغ تفسيراً أعمق لتلك الأزمة من خلال كشف ديناميتين من ديناميات الركود الاحتكاري: تضاؤل فرص الاستثمار، والتداول غير الملموس في سلاسل القيمة العالمية. فقد بَيَّنا أنّ الشركات الدوائية العملاقة، بفضل تمتعها بقوة احتكارية كبيرة، لا تواجه ضغطاً تنافسياً فعلياً يدفعها إلى الاستثمار؛ كما أنّ هيمنتها السوقية تُثبط من عزيمة المنافسين على الاستثمار. وفي الواقع، فإنّ العوامل الفاعلة في هذا التراجع في وتيرة الابتكار أعقد مما ورد في تحليل باغانو وسِلْ؛ ومن ثمّ أقترح وجود 4 ديناميات شكّلت هذا التراجع، وساهمت في أزمة رأسمالية الاحتكار الفكري في الصناعة الدوائية.
تفكيك الديناميات الأربع لتراجع الابتكار في شركات الأدوية الكبرى في ظل رأسمالية الاحتكار الفكري
(١) احتكار شركات الأدوية الكبرى للمعرفة ضمن علاقة الأكاديمي – السريري – الشركاتي
يشير مصطلح «بيغ فارما» إلى كبريات الشركات الدوائية العالمية، من قبيل فايزر وجونسون آند جونسون وميرك وروش وغيرها. هيمنت هذه الشركات على هذا القطاع منذ أكثر من قرن. استقطبت هذه الشركات نخبة العلماء، وأتاحت لهم قدراً من الاستقلالية، وأغدقت عليهم الرواتب السخيّة، لكنّها تعاونت بالأساس مع الحكومات والجامعات والمستشفيات والمختبرات السريرية الصغيرة ومراكز البحث والتطوير، بهدف ابتكار منتجات دوائية جديدة وتحويل براءات الاختراع إلى سلع دوائية منتجة بكميات ضخمة.
بمقدار ما تتمكّن رأسمالية الاحتكار الفكري من إحاطة الأفكار بسياجات الملكية الخاصة، فإنّ هذه الملكية الفكرية الخاصة تُنتج أثراً تعطيلياً على فرص الآخرين في التطوير
إنّ الدعم الحكومي هو المصدر الأهمّ في صناعة الأدوية لابتكار عقاقير جديدة وتسويقها تجارياً. فالمعاهد الصحية الوطنية في الولايات المتحدة، إلى جانب الوكالات العامة المموّلة من الدولة في بلدان أخرى، تشكّل الداعم الرئيس لأهم الاكتشافات الثورية في هذه الصناعة. ومنذ منتصف التسعينيات، شهد تمويل المعاهد الصحية الوطنية (تتلقى الجزء الأكبر من مخصصات الحكومة الفدرالية الأمريكية للأبحاث الطبية الحيوية الأساسية) ارتفاعاً ملحوظاً، قبل أن يبدأ في التراجع بدايةً من أوائل الألفية وحتى العام 2015. وفي العامَين 1994 و1998، أنفقت الحكومة الفدرالية الأميركية على هذه الأبحاث ضعف ما أنفقته دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة. وتوفّر الهيئات الحكومية القسط الأكبر من الدعم للجهود البحثية في الكيانات غير الربحية، كالمستشفيات والجامعات. وفي الولايات المتحدة، سمح قانون «بايه-دول» الصادر في العام 1980 للمستشفيات والجامعات الأميركية أن تسجّل براءات اختراع على المنتجات المُكتَشفة بتمويل حكومي، وأن ترخّص هذه البراءات لشركات هادفة للربح. وبهذا الشكل، استطاعت شركات صناعة الأدوية في الولايات المتحدة أن تجني ثمار الأبحاث الرائدة التي أُنجزت في المعاهد والجامعات العامة، وأن تحوّلها إلى منتجات تجارية.
شكّلت الشركاتُ الدوائية الكبرى شبكاتٍ من التعاون والمنافسة ضمّت شركاتٍ كبرى أخرى وجامعاتٍ ومعاهدَ بحثية وشركاتٍ ناشئة. يشدِّد التوجّه المتزايد نحو التواطؤ داخل الاحتكارات الفكرية، وهو الدينامية الأولى في تراجع الابتكار، على الإنتاج المشترك لوحدات معرفية نمطية، خصوصاً في المجالات العامة، تكرّس من خلالها هيمنتها على قطاع الصناعات الدوائية، بدلاً من مجرّد الاتفاق على الأسعار وشروط البيع والدفع كما في الماضي. وتعتمد هذه الشركات العملاقة بازدياد على تعاونها مع الجامعات والمعاهد البحثية والشركات الناشئة، وهي الجهات التي تتولّى عملياً القيادة في العمل الذهني. وقد تمثّل أحدُ أبرز آثار هذا التحوّل في تراجع نسبة الباحثين الأساسيين والمؤلفين الرئيسين المنتمين إلى شركات الـ«بيغ فارما» في الأوراق البحثية المنشورة. وعلى الرغم من الاعتماد المتزايد على الابتكار الخارجي، فإنّ ملكية براءات الاختراع تبقى في يد الشركات الدوائية الكبرى، وليس في يد الجامعات أو المعاهد البحثية أو الشركات الناشئة، بل إنّ بعض هذه الشركات الناشئة تستحوذ عليها لاحقاً الـ«بيغ فارما». وهكذا يغدو الإنتاجُ المشترك للتقنيات سلوكاً احتكارياً تجيزه البيئة التنظيمية الحالية، ويُحكِم قبضة الـ«بيغ فارما» على التفوق التكنولوجي. ومن أجل خفض التكاليف وزيادة كفاءة التجارب السريرية الواسعة النطاق، كثّفت شركات الأدوية الكبرى اعتمادها على «منظمات البحوث التعاقدية» (Contract Research Organizations) وسيطاً ثالثاً لتنفيذ التجارب خارج أميركا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا، في بلدان مثل الصين والهند والبرازيل وبولندا. ونتج عن هذا الوضع ما يمكن تسميته علاقة افتراسية بين القطاع الأكاديمي والسريري والشركات، إذ باتت الشركات الناشئة والمعاهد البحثية والباحثون السريريون بمثابة كيانات تابعة تؤدي الوظائف اللامركزية أو الثانوية لصالح الـ«بيغ فارما»، بينما تظلّ الأخيرة في موقع الهيمنة وتحصد الفائدة الأكبر من هذه العلاقة.
(2) استخراج القيمة من خلال ديناميات تسعير الأدوية
في الوقت الذي تُنتَج فيه الأدوية التجارية بدعمٍ مباشر من الحكومات، لا تخضع أسعارُ الأدوية في الولايات المتحدة لأي تنظيمٍ مباشر من قبل السلطات العامة، وهو ما يمنح شركات الـ«بيغ فارما» حرية تحديد الأسعار عند مستويات تفوق بكثير أسعار أدوية مماثلة في بلدان أخرى. على سبيل المثال، بلغ سعر الجملة لدواء جانوڨيا، وهو الدواء الأعلى مبيعاً لشركة ميرك لعلاج السكري، 1.99 دولاراً في أوروبا، مقابل 8.20 دولاراً في الولايات المتحدة في العام 2013.
في ظل سوق ضعيف التنظيم، تحوّلت شركات الأدوية الكبرى إلى «صانعة أسعار» لا «متلقّية أسعار»، وهذه هي الدينامية الثانية في مسار تراجع الابتكار. فبحسب باران وسويزي، تمنح الرأسمالية الاحتكارية، وخاصة في صورتها الحديثة، الشركات الكبرى سلطة «صناعة الأسعار»، على خلاف الرأسمالية التنافسية حيث الشركات «تتلقّى الأسعار». ويرى الكاتبان أنّ الأسعار في الأسواق شبه الاحتكارية تُحدَّد في الغالب عبر نمط من التواطؤ الضمني، إذ تتبع الشركات عادةً القائد السعري، ما يجعل الأسعار لا تتجه إلا في اتجاهٍ واحد: الصعود. وفي صناعة الأدوية، وعلى الرغم من ادّعاء شركات الـ«بيغ فارما» ارتفاع كلفة اكتشاف الدواء، وضرورة الأسعار المرتفعة لاسترداد الاستثمار، فإنّها لا تكشف عن الكلفة الحقيقية للبحث والتطوير. وبدلاً من ذلك، تقدّم الشركات حساباتها استناداً إلى تقديراتٍ مضخّمة، مثل مقدار الربح الممكن تحقيقه لو استُثمِرَت أموال البحث والتطوير في صندوق مؤشرات مثلاً. إنّ الأموال المنفقة فعلاً على الأبحاث الأساسية ضئيلة. ولأزيدنّك فإنّ التواطؤ اليوم بين الاحتكارات الفكرية، بقدر تركيزه على الإنتاج المشترك لوحدات المعرفة، قد ترافق مع حماية احتكارية للمنتجات الطبّية عبر حقوق الملكية الفكرية نتج عنها جمودٌ في مرونة الطلب على الأدوية. وكما يبيّن كلٌّ من ماريانا ماتزوكاتو وفيكتور روي، تستطيع الشركات الكبرى في هذا القطاع فرض أسعار من دون منافسة حقيقية، أي أنّ هذه الأسعار المرتفعة لا تعبّر عن الطلب الفعلي على المنتج، بل تمثّل «ما يمكن للمجتمع تحمُّله» في شكل ريع تستخرجه الشركات من فترة الحماية القانونية لبراءة الاختراع.
شهدت السنوات الأخيرة تزايد تداخل شركات الأدوية الكبرى مع الفاعلين الماليين، وبدأت هذه الشركات في استخدام جماعات الضغط واستراتيجيات تسعيرية مختلفة لربط نفسها بالأسواق المالية. على سبيل المثال، كانت تسعيرة دواء التهاب الكبد سي من شركة جيلياد ساينس خاضعة لتحكّم الفاعلين الماليين، على نحوٍ يعكس المنطق القائل «كل جيل جديد من العلاجات يحدّد أرضية سعرية جديدة» ويؤدي إلى «زيادة في الأسعار». لقد غيّرت أمولة شركات الـ«بيغ فارما» طرائق استخراج القيمة. ففي كتاب «الأزمة التي لا تنتهي»، يلاحظ جون بيلايمي فوستر وروبرت مكتشيزي أنّ الاقتصادات الرأسمالية الحديثة، في ظل غياب تقنيات مزلزلة وحوافز استثمارية قوية، باتت تعتمد بازدياد على القطاع المالي لتعظيم الأرباح. وقد لاحظا «جدلية الإنتاج والمالية» في بُنيتين سعريتين: تسعير الناتج الحقيقي وتسعير الأصول المالية. وبالاستناد إلى هايمان منسكي، يشير الكاتبان إلى أنّه إذا تقدّمت الدينامية الثانية على الأولى، يتحول رأس المال النقدي إلى اقتصاد مضاربات محض. وهذا يعكس ما يحدث فعلياً في صناعة الأدوية. فإلحاح المساهمين على تحقيق نموٍّ قصير الأجل يضعف من قدرة الشركات على تحمّل المخاطر طويلة الأجل اللازمة لتطوير أدوية جديدة، ولهذا تراجعت استثمارات الـ«بيغ فارما» في البحث والتطوير، واتجهت ببساطة إلى شراء مركّبات دوائية قاربت على إنهاء مراحل تطويرها الأخيرة.
على وجه العموم، يُقدَّر إنفاق شركات الـ«بيغ فارما» على البحث والتطوير في العام 2022 بين 10 و25%، مقارنةً بمتوسط يبلغ 31% في صناعة الأدوية عموماً. وهكذا، فإنّ دينامية تسعير الأدوية أتاحت لشركات الـ«بيغ فارما» والمستثمرين الماليين استخراج «قيمة» من احتكار المعرفة ومن خلال عمليات احتكارية لتعظيم أرباح المساهمين، مثل عمليات إعادة شراء الأسهم، لكنّها بالمقابل خفّضت من استثمارات تلك الشركات في البحث والتطوير، وزادت من اعتمادها على الابتكار الخارجي، كما أُشير في الدينامية الأولى التي تُقحم الـ«بيغ فارما» في اقتصاد مضاربات.
(3) تدويل القوّة الاحتكارية الفكريّة لشركات الـ«بيغ فارما»
شكّلت صناعة الأدوية منذ نشأتها بصيغتها الحديثة في الثمانينيات قطاعاً عالميّاً بامتياز. وفي حين حدثت تحوّلات في خريطة توزيع الشركات الكبرى، ظلّت الطبيعة العالمية للصناعة على حالها [45]. فقد حافظت سويسرا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة على موقع الريادة في هذا القطاع، مع تقلّد الولايات المتحدة الأميركية موقع الهيمنة عقب الحرب العالمية الثانية. شنّت الولايات المتحدة ومعها بضع شركات كبرى حملة منظّمة لتوسيع نطاق حماية حقوق الملكية الفكرية الأميركية على المستوى العالمي، في مسعى لضمان أرباح ضخمة لشركاتها. أطلق فوستر وماكتشيزني على هذه الظاهرة، وهي الدينامية الثالثة في تحليلنا، اسم «تدويل القوّة الاحتكارية». لقد شهِد العالم في العقود الأخيرة من القرن العشرين، من وجهة نظرهما، انتشاراً لشركات متعددة الجنسيات، وتدويلاً للسلطة الاحتكارية. ولتحقيق هذا التدويل لرأس المال الاحتكاري الفكري، جرى استخدام وسائل «فوق اقتصادية» لاستخراج القيمة، مدعومة بالقوة المهيمنة للولايات المتحدة، وذلك لصالح فرض حماية صارمة على حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.
تمنح الرأسمالية الاحتكارية، وخاصة في صورتها الحديثة، الشركات الكبرى سلطة «صناعة الأسعار»، على خلاف الرأسمالية التنافسية حيث الشركات «تتلقّى الأسعار»
طوال الثمانينيات، مارست قطاعات الملكيّة الفكرية الخاصّة، وفي مقدّمتها صناعة الأدوية، ضغوطاً متزايدة على الحكومة الأميركية لحملها على توسيع نطاق حماية حقوق الملكيّة الفكرية في الخارج. ومنذ العام 1981، اضطلعت اللجنة الاستشارية لسياسات التجارة والتفاوض بدورٍ محوريّ في نقل وجهات نظر الصناعات إلى الرئيس، وصياغة استراتيجيات متصلة بحقوق الملكية الفكرية لتوجيه السياسة التجارية الأميركية. واستجابةً لمطالب القطاع الخاص، أقرّ الكونغرس تعديلات على قانون التجارة والتعرفة لعام 1984، نصّت على عَدّ الإخفاق في حماية حقوق الملكية الفكرية خرقاً يستدعي التدخل بموجب المادة 301. ومن ثمّ، أصبحت حماية الملكية الفكرية الصارمة مكوّناً أساسيّاً في السياسة التجارية الأميركية.
في التسعينيات، أقنع تحالفٌ ضمّ صناعات الأدوية والبرمجيات والترفيه والزراعة إدارةَ بيل كلينتون وحكومات الدول الصناعية الأخرى بفرض نظام موحّد لحماية حقوق الملكية الفكرية على بقيّة دول العالم. وقد بذل المدافعون عن الصناعات الأميركية، وبالتحديد صناعة الأدوية، جهوداً مضنية لمأسسة حماية التجارة القائمة على الملكية الفكرية من خلال اعتماد منظمة التجارة العالمية في العام 1995 اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس). شكّلت هذه الاتفاقية أداةً قانونية لتأسيس نمط رأسمالية الاحتكار الفكري في قطاع الأدوية، عبر تحديدها معايير دنيا لحماية هذه الحقوق، وإلزام الدول الأعضاء بإنفاذها في قوانينها الوطنية. وبالرغم من تأكيد إعلان الدوحة للعام 2001 بشأن اتفاقية «تريبس» والصحة العامة حق الدول الأعضاء في اعتماد التراخيص الإلزامية لضمان النفاذ إلى الأدوية الأساسية، فقد أتاحت الاتفاقية أيضاً للدول الأعضاء أن تُدرج في اتفاقاتها الثنائية والإقليمية بنوداً تتجاوز معايير «تريبس» لحماية حماية الملكية الفكرية. وقد قاد مكتب الممثل التجاري الأميركي «حملةً نشطة» لإبرام اتفاقيات تجارة واستثمار حرّة إقليمية وثنائية تصبّ في هذا الاتجاه وتُقصي ما في «تريبس» من مرونة. وهكذا، تحوّلت اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية الثنائية ومعاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية إلى منظومة تُعرف بـ«تريبس بلس» حوَّلَت حقوق الملكية الفكرية إلى أصولٍ استثمارية.
بهذه الطريقة، ساهم الترويج النشط لاتفاقيات التجارة والاستثمار الحرة الثنائية والإقليمية في تشكيل الشروط المؤسسية لأنظمة الملكية الفكرية، بما يخدم الممارسات الاحتكارية والعوائد الريعية، ومن خلالها تمكَّنت الشركات العملاقة من التوسّع عالمياً وجني ريوع فكرية ضخمة بفعل امتلاكها حقوق ملكية فكرية على نطاق عالمي. وفي قطاع الأدوية، أنشأت شركات الـ«بيغ فارما» سلاسل سلعية تستحوذ من خلالها على حصة غير متكافئة من الأرباح الأميركية والعالمية، بفضل سيطرتها واحتكارها لحقوق ملكية فكرية قوية. علاوة على ذلك، صاغت الولايات المتحدة بنية الاقتصاد السياسي العالمي والإقليمي بحيث يُعتَرَف بحقوق الملكية الفكرية أصولاً غير ملموسة. وحين تتحوّل هذه الحقوق إلى أصول غير ملموسة، تستدعي بدورها «مستوى أعلى من الأمان عبر تقليص حالة عدم اليقين». يتحقق هذا السعي نحو «الأمان» من خلال إحكام السيطرة على إنتاج المعرفة واحتكارها عبر الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، المدعومة بالهيمنة الأميركية، لكنّه في الوقت نفسه يسفر عن نشوء فقاعات أصول تُخلّف كُلفاً اجتماعية فادحة على مستوى العالم.
(4) إقصاء المنافسين من خلال عدم التماثل بين الإقصاء التكنولوجي ونشر المعرفة
لقد بيَّنتُ فيما سبق ثلاث ديناميات توضّح كيف استحوذ رأس المال الاحتكاري في صناعة الأدوية على موقع الهيمنة، واستخرج الريوع الفكرية من خلال ملكيته لحقوق الملكية الفكرية على النطاق العالمي. لكنّه لم يكتفِ بذلك، بل ساهم أيضاً في تقويض الابتكار الطبي عبر استغلال القدرة التعطيلية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية والحماية التنظيمية في صناعة الأدوية. لقد قيّدت هذه الآليات التعطيلية (الدينامية الرابعة) قدرة المنافسين، من أمثال شركات الأدوية الجنيسة، على دخول الصناعة، وزادت كلفة الأبحاث المستقلة التي تجريها الشركات الناشئة.
دأبت شركات الـ«بيغ فارما» على الترويج لبراءات الاختراع بوصفها حافزاً ضرورياً للابتكار، أي باعتبارها حلاً لمشكلة السلع العامة وما يرتبط بها من فشل في السوق. يظهر الترخيص الإجباري حين تسمح الحكومة لكيان آخر بإنتاج منتج أو تنفيذ عملية من دون موافقة صاحب البراءة. وبالرغم من أنّ صناعة الأدوية تقدم البراءات دائماً بوصفها أداة تشجّع على الابتكار الطبي، فإنّ استخدامها العملي ينحصر في الغالب بتطوير تحسينات طفيفة لأدوية حائزة على الموافقة، لا في اكتشاف تركيبات كيميائية جديدة تحقق تحسينات علاجية جوهرية. وهكذا، تُستخدم البراءات لتحقيق ما يعرف بـ«التخضير الأبدي» أي إطالة أمد الحماية السوقية لأدوية معينة. طُرحت مقترحات إصلاحية تهدف إلى الحد من قابلية منح البراءة للتغييرات الطفيفة أو للمنتجات الصحية التي لا تحقق أثراً ملموساً في النتائج العلاجية. واقترحت مبادرات أخرى، مثل صندوق الأثر الصحي، ربط العائد المالي بما تحققه الأدوية من تحسن في الصحة العامة. إلا أن الـ«بيغ فارما» لا تزال تتشبّث بشراسة بحقوقها في البراءة، وتمنع نقل المعرفة إلى المستخدمين أو المبتكرين الآخرين، حتى حين تُمارَس عليها ضغوط قوية للقيام بذلك، كما حدث في محاولات نقل تقنيات لقاحات كوفيد-19 من أوروبا والولايات المتحدة إلى بلدان الجنوب. ولشرح الكيفية التي استغلت بها شركات الأدوية الكبرى الآليات التعطيلية لتقييد المنافسة وتعزيز سلطتها الاحتكارية، لا بدّ من الوقوف على ثلاث آليات رئيسة: قصور نظام الترخيص الإجباري، والتوسع في استخدام الأسرار التجارية، وإقرار الحماية القانونية للبيانات.
منذ الثمانينيات، ومع إدراك الولايات المتحدة أنّها فقدت تفوّقها التنافسي في القوة الاقتصادية والابتكار التكنولوجي، بدأت في ابتكار أعداد كبيرة من الآلات والمنتجات والعمليات، شكّلت صناعة الأدوية جزءاً محورياً منها. حين تكون حقوق البراءة محمية بطريقة مفرطة تقيّد بشدة فرص الوصول إلى الابتكارات، نرى مأزقاً بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة لحاملي البراءات. وقد عبّر جيمس بويل عن هذا المأزق بوضوح حين قال: «تُنتج حقوق الملكية الفكرية احتكارات مثلما تُنتج حوافز؛ بل إنها تُنتج حوافز لأنّها احتكارات. وإذا نحن أهملنا المجال العام، فسنميل إلى منح عدد مفرط من حقوق الملكية الفكرية، ونضع بالتالي قسطاً كبيراً من القوة السوقية شبه الاحتكارية المدعومة من الدولة بيد الأطراف المهيمنة في السوق». بمعنى آخر، تتمثّل الفائدة من حماية حقوق البراءة الحصرية في تحفيز الابتكار من خلال منح قوة سوقية تستند إلى دعم حكومي، إلا أنّ منع المنافسين من الوصول إلى الابتكار يُفضي بالضرورة إلى نشوء «توتر بنيوي بين الإبداع والنشر».
لتحقيق التوازن الأمثل بين إبداع المعرفة و نشرها، يبرز الترخيص الإجباري أداة فعّالة لتحسين إمكانية الوصول إلى اللقاحات وجعلها في متناول الجميع. لو أنّ شركة موديرنا رفضت إنتاج كميات كافية من اللقاحات، أو طرحتها بأسعار لا يقدر الناس عليها، لكان بوسع الحكومة الأميركية أن تتخذ خطوات لمنح ترخيص غير حصري لمصنّعين آخرين. إذ ينص قانون البراءات الأميركي، في المادة 28 USC §1498، على أنّ بوسع الحكومة استخدام الاختراعات المحمية ببراءات، وأن يتقدّم أصحاب البراءات بدعاوى ضد الحكومة بتهمة التعدي، والمطالبة بـ«تعويض معقول وكامل عن ذلك الاستخدام أو التصنيع». كما يمنح قانون بايه-دول الحكومة الأميركية حقوق «التدخّل»، وهذه تُتيح نظرياً لطرف ثالث الحصول على ترخيص إجباري لاستخدام اختراعات موّلتها الوكالات الحكومية.
الـ«بيغ فارما» لا تزال تتشبّث بشراسة بحقوقها في البراءة، وتمنع نقل المعرفة إلى المستخدمين أو المبتكرين الآخرين، حتى حين تُمارَس عليها ضغوط قوية للقيام بذلك، كما حدث في محاولات نقل تقنيات لقاحات كوفيد-19 من أوروبا والولايات المتحدة إلى بلدان الجنوب
على الرغم من مرور أكثر من 40 عاماً على إقرار حقوق التدخّل في إطار قانون بايه-دول، فإنّها لم تُستخدم قطّ للحصول على تراخيص إجبارية. في أوائل الألفية، حين تصاعدت المخاوف من تفشي الجمرة الخبيثة، أعلنت الحكومة الأميركية نيتها إصدار تراخيص تتيح إنتاج مضاد حيوي تابع لشركة باير بسعر أدنى من سعر الشركة، لكنها لم تبدأ مفاوضاتها إلا بعدما أقدمت كندا على منح ترخيص لشركة محلية لإنتاج نسخة جنيسة. وانتهى الأمر باتفاق بين باير والحكومة الأميركية على خفض السعر. وقد بدا ضعف تطبيق هذه الحقوق جلياً في خلال جائحة كوفيد-19؛ إذ تقدّمت الهند وجنوب أفريقيا بطلب إلى منظمة التجارة العالمية لإعفاءات من براءات الاختراع لتسريع الابتكار في الدول النامية، إلا أنّ واشنطن لم تعلن تأييدها إلا بعد تصاعد الضغط الدولي، وأسفرت المفاوضات في النهاية عن إعفاء محدود من الالتزام المنصوص عليه في المادة 31(و) من اتفاقية تريبس. ولم يعالج قرار المنظمة جوهر المعضلة المتمثّلة في أنّ حقوق الملكية الفكرية تقف عائقاً بنيوياً يحول دون تطوير القدرات التصنيعية للمنتجات الطبية الأساسية، بما فيها العلاجات والتشخيصات. كما أقامت شركة غيلياد دعوى قضائية ضد الحكومة الروسية بعد إصدارها ترخيصاً إجبارياً لعقار ريمديسيفير في نيسان/أبريل 2021 لعلاج كوفيد-19.
تتيح مشاركة المعلومات للآخرين الاستفادة من التقنيات الهامة، وبالتالي تسريع وتيرة الابتكار والنمو الاقتصادي. بيد أنّ الطبيعة المعقدة لمنتجات علوم الحياة، كالأدوية البيولوجية مثلاً، تجعل من نشر المعلومات المتعلقة بها أمراً بالغ الصعوبة. فمنذ الموافقة على أول دواء بيولوجي، وهو الإنسولين البشري المؤتلف في العام 1982، شهد هذا النوع من العلاجات قفزة كبيرة، ليشكّل اليوم أكثر من ثلث الأدوية الجديدة المعتمدة و46% من إجمالي الإنفاق على الأدوية. وبما أنّ الأدوية البيولوجية مركّبات علاجية جزيئية ومعقدة مشتقة من مصادر حية، تتطلب عمليات تصنيع خاصة تشمل تحديد السلالات الخلوية، واختيار الكائنات المضيفة، وإجراءات التنقية، فضلاً عن الظروف الثقافية والإعلامية المحيطة بها، وكلها تؤثر في خصائص المنتج النهائي ونشاطه العلاجي. تميل شركات الأدوية المبتكرة إلى حماية المعارف التقنية الجوهرية المتعلقة بتلك الأدوية من خلال أسرار تجارية («تشمل معارف مشفّرة وغير مشفّرة تتعمّد الشركات إخفاءها»). وبما أنّ القانون لا يُلزمها بالكشف عن هذه الأسرار ما دام ذلك لا يُخلّ بشروط براءة الاختراع، تميل هذه الشركات إلى إبقاء معارفها التقنية طيّ الكتمان.
بالإضافة إلى براءات الاختراع والأسرار التجارية، استفادت شركات الأدوية الكبرى أيضاً من فترات الحماية القانونية لبيانات التجارب السريرية لتعزيز قدرتها الاحتكارية في السوق. فقد منح قانون منافسة أسعار الأدوية واستعادة براءات الاختراع لعام 1984، المعروف بقانون هاتش-واكسمان، فترة حماية قانونية للبيانات مدتها خمس سنوات للكيانات الكيميائية الجديدة، وثلاث سنوات لأي دواء «يتضمن طلب ترخيصه تقارير عن تجارب سريرية جديدة». وفي العام 2009، أقرّ الكونغرس قانون منافسة أسعار الأدوية البيولوجية والابتكار، ووقّعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانوناً في العام 2010، وقد عدّل هذا القانون آلية الموافقة على الأدوية الجنيسة بموجب قانون هاتش-واكسمان. وبموجب التعديلات الجديدة، أصبحت الأدوية البيولوجية ذات الجزيئات الكبيرة تخضع لفترة حماية مدتها 12 سنة على بيانات التجارب السريرية.
بموجب قواعد حماية البيانات، تفرض «إدارة الغذاء والدواء الأميركية» على الشركات المصنّعة للأدوية الحيوية المماثلة القيام بعمليات هندسة عكسية، وفي بعض الحالات، إجراء تجارب سريرية خاصة بها. وإجراءات الحصول على الموافقة، التي تتطلب استثمارات قد تصل إلى مئات ملايين الدولارات، تُمثّل عائقاً كبيراً آخر أمام دخول المنافسين إلى مجال الأدوية البيولوجية. ومن هذا المنظور، تمثّل الحماية المتزامنة عبر براءات الاختراع والأسرار التجارية والحماية القانونية تركيبة جذّابة، أقله لشركات البيغ فارما، تستخدمها لتعطيل المنافسة وتعزيز موقعها الاحتكاري في قطاع الصناعات الدوائية.
وعليه، فعلى الرغم من أنّ قطاع الصناعات الدوائية يدرّ عائدات هائلة، يعزف رأس المال الاحتكاري الفكري عن ضخّ استثمارات جديدة في البحث والتطوير، باستغلاله الآثار التعطيلية للآليات الثلاث المشار إليها. وفي ظل هذه الشروط، وبالاقتران مع الديناميات الأربع السابق ذكرها، فإنّ رأسمالية الاحتكار الفكري في الصناعة الدوائية لا تمضي فحسب في اتجاه منطق الاستحواذ والريع، بل تسير أيضاً نحو علم مغلق وابتكار طبّي آخذ في التراجع والانحسار.
نُشِر المقال في 1 حزيران/يونيو 2025 في Monthly Review، وترجم إلى العربية ونشر في موقع «مجلة صفر» بموافقة من الجهة الناشرة.